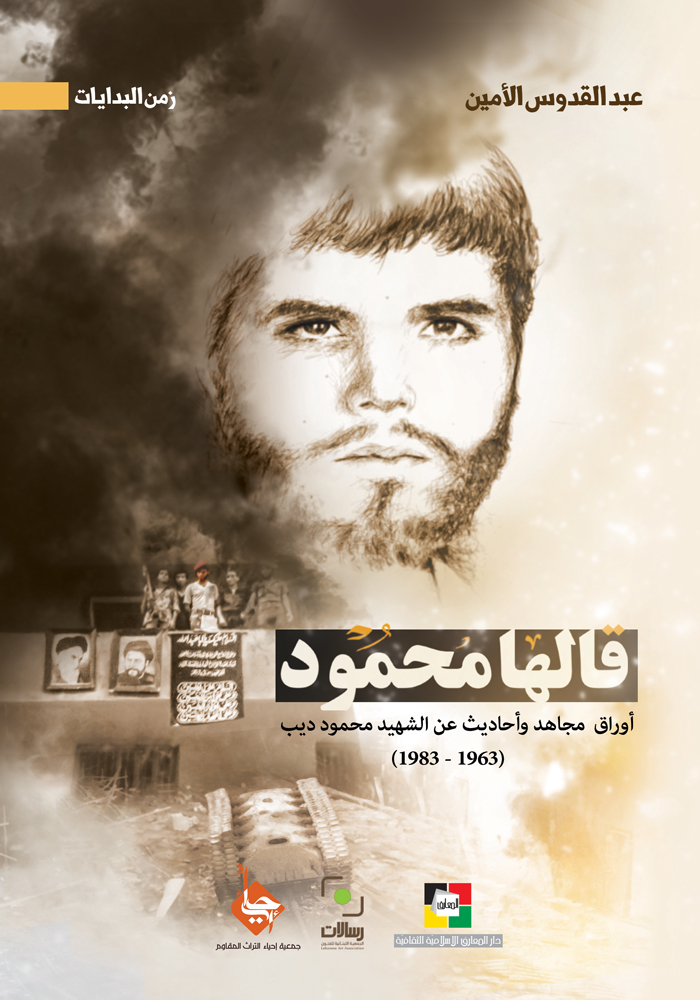شكر ودعوة
❞ شكر ودعوة
نشكر الشهود الذين زودونا بالمعلومات القيمة وكل من شارك في هذا الانتاج ضمن سلسلة زمن البدايات ونأمل من الذين عايشوا تلك المرحلة أن يزودونا بما يناسب انتاجاتنا القادمة ضمن هذه السلسلة❝
4
1
تصدير
تصدير
نحِنُّ إلى زمن التّعب الشهيِّ
ننشُدُه بمجاهديه الذين طالما عقدوا الحبال على خصورهم بدل الزّنّار العسكريّ
واكتفوا بواحدة من المعلّبات، مسحوا عنها غبرة الأرض، وتقاسموها ورغيفًا، وبعضُ الأرغفة يابسٌ...
ولطالما ركنوا ليلاً إلى جدار قديم على حدود بيروت، أو إلى شجرة في جبل، ثم استلقوا بكل تعبهم، وهم يتأملون غمزات نجمة، حالمين ببيت زوجيّ صغير، ذي أثاث وضيع، فيه طفل جميل يحبو، لا تبلغه صواريخ الظالمين، ولا إجرام طائراتهم الحربية. هنالك لطالما ارتسمت فوق شفاههم ضحكة عشق لا تشبه هذا العالم.
هنالك حملت خيوط الفجر أدعيتهم إلى السماء، ثم قبّلوا «القرآن» ومضَوا إلى «عملية جديدة» تسبقهم عيون ترصد بعين الله...
11
3
تصدير
أولئك الذين أفردهم الزمن، وقد اجتمعت عليهم أمم الاستكبار، وسلّم معظم أمّتهم بالأمر الواقع: «العين لا تقاوم المخرز».
وكان أحسن من فيها «يقبّل يد الظالم ويدعو عليها بالكسر»، وآخرون دونهم يقبّلونها ولا يدعون، أو يقبلونها ويتقاضون مقابل ذلك إما عمالة أو مهادنة.
يبدأ زمن البدايات، السلسلة الجديدة من أدب المقاومة، من إرهاصات انطلاقة المقاومة الإسلامية في لبنان، والاجتياح الإسرائيلي سنة 1982، في لغة روائية تجمع الفنّ المبدع إلى التوثيق الحميم، وتنتخب تدريجياً ثلة من المقاومين الأولين الذين تركوا توليفةً من بصمات البطولة، التعب، العزيمة، الوجع، العرق، الصلاة والدم.
ثلّة استأنست بالمجهولية والتخفّي وصلوات الليل، وغفَت وهي ثاويةً إلى جدران مدينة بيروت، أو جذوع أشجار الجنوب وصخور جباله.
الشهيد محمود ديب يشرع أبواب هذه السلسلة، هو واحدٌ من هؤلاء العظماء الذين هجروا المضاجع، لاحقوا العدوّ الإسرائيلي من شارع إلى شارع في بيروت، ومن جسر إلى آخر، بطل مجزرة الدبابات على جسر سليم سلام في العاصمة، هو نفسه السخيّ بكلّ شيء وصولاً إلى الدم...
12
4
تصدير
إنه «فاتحةُ» سلسلتنا، سلك «صراط الذين أنعم الله عليهم» فكان أحد المصابيح الأولى في سلسلة «زمن البدايات».
محمود ديب قال كلمته التي اختزلت الزمن، فضحك لها الضوء.
لن نقطع عليك، أيها القارئ العزيز، حرارة ملاحقة عبد القدوس الأمين، والتقاط التفاصيل بكل ما فيها من حنين ودهشة أحداث، وبكل ما فيها من موسيقى أنفاس مجاهدٍ رطّبت أوراقَ الزمن المخبّأةَ في ما جمعَ من كراريس قديمة، من صدور شهودٍ ثُقاتٍ خاضوا غمار المرحلة فتتبّعها الكاتب في تَهَدُّج «سردياتهم».
لغةٌ رجّعَها عبد القدوس رواية جاذبة بعد أن «قالها محمود».
أدب المقاومة
وحدة الأنشطة الإعلامية
13
5
المقدمة
المقدمة
بقلم رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله
سماحة السيد هاشم صفي الدين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
يقول تعالى: ﴿نَّحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ نَبَأَهُم بِٱلۡحَقِّۚ إِنَّهُمۡ فِتۡيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمۡ وَزِدۡنَٰهُمۡ هُدى﴾ (الكهف، 13)
لقد تعرّف الناس إلى بعض الخصوصيات والفضائل التي صبغت تاريخ وحياة بعض شهداء المقاومة الإسلامية، وقد رأوا فيها تجسيداً وتجلياً للهداية الإلهية وتأثيرها في بناء هذا الطود المقاوم والشامخ في إطار تجربة إيمانية وجهادية فريدة في عصرنا الحاضر، إلا أن الكثير من التفاصيل المهمة والحاسمة في صنع هذا النموذج المقاوم ما زالت مطوية ولم يتم التطرق إليها لأسباب عديدة، ومنها عن قصد، حيث
15
6
المقدمة
لم يحن الوقت للإفصاح عنها، وبعضها عن غير قصد، وهي جديرة بالتتبع والتفحص لمعرفة جوانب ضرورية في تكوين المشهد منذ بدايته ليعرف الناس وخاصةً جيل الشباب الذي لم يواكب ولم يتعرف إلى بعض الشهداء والقادة، ولم يطّلع على الظروف الصعبة والخطيرة التي رافقت هؤلاء في الأيام الأولى لانطلاقة المقاومة الإسلامية، وحيث إن نقل الصورة بأمانة هو مسؤولية وحاجة وضرورة في فهم تاريخ هذه المقاومة ومنطلقاتها ودوافعها الدينية والثقافيّة والجهادية، فإن التصدي لهذا الشأن يصبح جزءًا حيويًا من كيان المقاومة بكل أبعادها وأغوارها وتطلعاتها.
بين أيدينا كتاب (قالها محمود) هو صياغة أدبية شيّقة جمعت بعضاً من المعطيات المتوافرة عن حياة شهيد وقائد ميداني اختصر في حياته وتجربته مرحلة كاملة، وهي مرحلة المخاض والولادة للمقاومة الإسلامية، لتكشف لنا هذه السيرة في بعدها الشخصي جوانب فذة ومشرقة لشهيدنا العزيز محمود ديب (رحمه الله)، ولتوضح نمو التجربة لديه في حالاته ومآلاته منذ كان في سن ثلاثة عشر عامًا إلى يوم شهادته، فنرى حقائق تفسر لنا صلابته وشجاعته ومتانة شخصيته واستعداده الدائم للتضحية والإقدام، فتظهر أمامنا، واضحةً، عوامل القوة التي ارتكزت عليها عطاءات هذه المقاومة حتى أصبحت لائقة بالعظمة التي وصلت اليها. وحين يطّلع القارئ على مسار هذا الشهيد البطل سيعرف أكثر مستوى الإخلاص والإيثار والشهامة والرجولة باعتبارها
16
7
المقدمة
صفات جليلة عامت على مياهها الصافية هذه المقاومة، وارتشفت من معينها الزخار، فاكتست بحلل الأنوار الملكوتية لتكون بين هذه وتلك مصداق الشجرة الطيبة التي تزداد مع الأيام رسوخًا في التراب الأصيل المجبول بدماء زاكية وطاهرة، ما زالت إلى الآن ترفد الأمة بأنوار السطوع والتألق والضياء، فتبقى حجيتها قائمة بفضل الله تعالى وتستحق الانتساب إلى الأصالة الدينية المشبعة بثقافة الكرامة، الحب والعشق لسيد الشهداء أبي عبدالله الحسين (عليه السلام).
إن سيرة حياة الشهيد العزيز محمود ديب (رحمه الله) بمقدار ما تبين صفاته الشخصية ومواهبه وميزاته فإنها توضح وبشكل مختصر وبليغ الأحوال والأوضاع التي حكمت تلك المرحلة والتي اتسمت بكثير من الفوضى والضياع والتشتت، وهي بالإجمال أوضاع نتجت عن الضغوطات الهائلة التي انصبّت على رؤوس الشباب آنذاك وعلى بنية المجتمع اللبناني والعربي عمومًا، لتسقطه وتجعله منقادًا لشعارات أكبر بكثير من الأحزاب التي رفعتها والتي لم تقوَ على حمايتها، فضلاً عن تطبيقها، بل وتغلغلت في حنايا الثقافة والهوية على شاكلة ما أراد الأعداء أن يزرعوه في أمتنا التي كانت تائهة من أجل قتل روح المقاومة، ومن أجل إرساء ثقافة اليأس والهزيمة والانكسار، حيث لا جدوى من المقاومة، لأن العدو لا يقهر، ولأن الأنظمة العربية استسلم معظمها، والأحزاب تتهاوى لأسباب كثيرة، في مثل هذه الظروف ندرك أهمية الانتشال الذي قامت به
17
8
المقدمة
الجمهورية الإسلامية بقيادة الإمام الخميني { كما ندرك تماماً عظمة هذه الثلة المخلصة التي قبلت التحدي وحملت مسؤولية السباحة عكس التيار لإعادة صياغة المفاهيم والالتحام مع الهوية الأصيلة لينبثق منها الأمل الجديد، فكان الشهيد العزيز محمود ديب (رحمه الله) واحدًا من هؤلاء الأبطال، وكانت حركته الدؤوب في بيروت وشوارعها وفي ساحات المنازلة والوغى في الضاحية والجبل والجنوب، وكل هذا الجهد الاستثنائي مع إخوانه الاستثنائيين - من استشهد منهم أو من بقي في خط المقاومة - من أجل أن يشق الدروب نحو فجر جديد لمقاومة لم تهدأ ولن تستكين، وهي تتقدم بخطى ثابتة لتصنع النموذج وتبني الاقتدار وتحقق الآمال، وليبقى طريقها نحو هدفٍ محدد يجمع عز الأمة والأوطان ويحرر القدس وفلسطين ويرفع غائلة الاستكبار الامريكي.
أشكر الأخ العزيز السيد عبد القدوس الأمين (حفظه المولى) على هذا الجهد وأسأل الله تعالى أن يوفقه لإتحافنا دائماً من يراع قلمه وصفاء فكره وسلاسة أدبه بمزيدٍ من العطاء المقاوم في توثيق تجربة الشهداء العظام، وأشكر الإخوة والأخوات العاملين بجدٍّ ونشاط في مجال أدب المقاومة سائلاً الله تعالى القبول والتوفيق.
هاشم صفي الدين
الخميس 6 رمضان 1441 ه
الموافق 29 نيسان 2020م
18
9
الأوراق
أكاد أرى دهشتك وأنت تستلم أوراقي هذه وتقول: أخيرًا فعلها صاحبي.
نعم يا صاحبي، لا بدَّ من أنّ اليأس قد تسرّب إليك مني، وأتعبك إلحاحك. أشهر طويلة، كنت أنت خلالها لجوجًا، ولكنني ورغم خجلي منك لم أستجب، لم أكن أستطيع على الرغم من قناعتي بما كنت تقول عن الوقت والعمر والذّاكرة.
لم يكن خوفك على ذاكرتي وإقناعك لي بأنني سأنسى مع الوقت هو الذي دفعني لأكتب؛ حيّةٌ هي في داخلي تلك السنين، أراها تنبض وتتحرك في معزل عن الزمن مهما طال، لم أكن لأنسى، ولا أخاف النسيان، قد أنسى ما حدث قبل عام وعامين، قد أنسى ما حدث بالأمس، لكنني لن أنسى ذلك الزمن، الذي أحسنتَ أنت تسميته زمن البدايات، زمن المادة الخام، زمن الأرقام الأوّلية، لا شيء يجعلني أنساه، وأنا أعلم أنها لن تبهت، ولن تغيب تلك الذكريات، كما كنت تقول.
كيف أنساها وكلّما نظرت إلى زمننا هذا، زمن البناء الكبير،
21
10
الأوراق
والإنجازات الجليلة، رأيتها جميعًا تنبع من تلك النقطة الصغيرة. كل هذا البستان الطويل العريض، المزهر المثمر، لم يكن سوى واحة صغيرة وسط صحراء مهولة الاتّساع، واحة أخرجنا نحن ماءها حفرًا بالأصابع في زمن البدايات.
كيف أنسى وهي دمي، وخفقات القلب، جلدي المغضَّن هذا، وشعري الذي غزاه الشّيب، وظهري الذي يباشر بالانحناء. فأنا كلّما نظرت إلى حاضري رأيت زمني القديم من خلاله، هو خلفه واضحًا ساطعًا، وكأنّ الزّمن الحاضر ما هو إلا جدارٌ من زجاج، يلوح من خلفه جسدي الفتي وذلك العمر. وأنا هنا في مكتبي المريح وتحت برودة التكييف، أرى عرَقي ولهاثي القديم، لهفتي وركضي المتواصل ذاك، هنا حيث العالم الرّقمي بين يديّ، ويدي هذه وهي تتحرّك فوق الأزرار تستشعر ملمس ذلك الحديد، إصبعي، وهو يمسح الشاشة العاملة بالّلمس، يحنّ بشغف لارتجافه القديم على الزّناد.
وعدتك أن أكتب، لقد قرّرت منذ زمن طويل أن أستجيب لرغبتك.لم يكن دافعي خوفي من النسيان، ولكنني لا أريد لتلك الذّاكرة أن تموت بموتي.
وعدتك لكنني لم أستطع، كنت أقف أمام الأوراق البيضاء حائرًا مشتّتًا، أتقلّب فوقها كما أتقلّب على وسادتي في الليالي الطويلة، يسحقني شعوري بالعجز، لكم كانت قاهرة تلك المحاولات، صعبة
22
11
الأوراق
وعصيَّة كالنّوم، وتصنع ما يصنعه الأرق في الروح! لقد كنت أترك أوراقي في كل مرّةٍ كما كنت أترك فراشي بعد ليلة من الأرق الطويل، مقهورًا غاضبًا أبحث عن أي شيء يبعدني عن تلك الأوراق، ثم أنغمس في عملي، أنساها أو أتناساها عامدًا، أهرب من أوراقي هروب الجبان العاجز عن المواجهة، وجزء مني سعيد بهروبي، كأنها الطريقة الوحيدة للخلاص من المحاولات الفاشلة وما يصاحبها من شعور بالإحباط والغضب.
ذكرياتي معي دائمًا، فلماذا لا أستطيع الكتابة عنها؟ وكأنها في مكان قصيٍّ، أو خلف باب محكم الإغلاق، أو كأن الدروب التي تفضي إليها ضائعة، أو لأنني لم أجد حافزًا قادرًا على إخراجها من داخلي، لم أجد مفتاح ذلك الباب المحكم الإغلاق، لم أستطع رفع الحجر الذي يغلق فوهة النّبع. بعد كل تلك المحاولات وقفت عاجزًا وكأنني على باب المستحيل.
ما الذي كسر حاجز صمتي ودفعني لأكتب إليك ما وعدتك به؟ ما الذي دفعني لأشقّ صدري وأُخرج من أقصى القلب هذه الاوراق؟
منذ أيام فقط حدث ذاك الشيء الغريب في داخلي، ماذا أسميه؟ لا أعرف له اسمًا، أهو صحو مفاجئ إثر انفجار؟ زلزال؟... بل هو انقلاب، كما في المسرح الدوّار، وجدت نفسي في المقلب الآخر، وفجأة أصبح المستحيل ممكنًا، وانتظم كلّ شيء دفعة واحدة وصار في المتناول، وكأن دربًا شُقَّ إلى الأوراق واسعًا.
23
12
الأوراق
حدث ذاك حين خرجت لإنجاز عمل لي، وأنت تعرف كم أنَّ خروجي صعبٌ وقليل، وعند عودتي وجدت نفسي هناك.
ما كنت أدري أن هذا سيحدث لي. في البدء شدّني الحنين، كنت أسير في شوارع منطقتي وحاراتها الضيّقة، وشيء غريب ينمو في داخلي، وشعور لم أعهده سابقًا يحرّكني، وكأنني أعود مع كل خطوة، بكل ما في العودة من حضور وانفعال، لقد بدأت التفاصيل تستعيد أشكالها وألوانها ثم تنبض بالحياة. ملامح وخطوط تتلاقى في تسارع لتشكّل صورة قاهرة الحضور لأمير ذلك الزمان، هناك في تلك الدروب تجمّع واكتمل حضورًا؛ سيدي ومعلمي محمود، بكل حضوره البهيّ. كل شيء كان خلفه وحوله، وكلّ شيء مرتبط به، على أطراف ردائه تتعلّق التفاصيل، وتحوم الذّكريات كالفراشات بين يديه، وحول جسده الممشوق.
أمير ذاكرتي كان هناك، يجوب حيّ «البسطة»، وشارع «فتح الله» يتمدّد لاستقبال قدميه. إذ ذاك، وجدت نفسي وقد عدت تمامًا، أصبحت في قلب عالمي القديم، كأن الحياة عادت إلى شيء كان قد تجمّد في داخلي، أو كأنني قبل ذلك كنت أنظر إلى ذكرياتي كشيء جامد، أو صورة مسطحة ببُعدين، كأن الصورة الآن قد وجدت بُعدها الثالث، ورأيت الشبابيك تتفتح من أجله، والحجارة كانت تهمس باسمه:
24
13
الأوراق
_ محمود! إنه محمود! محمود قادم.
كان الصوت يخرج من داخلي أنا، هي روحي تهمس مبحوحة، أو تصرخ بلا صوت، تناديه بكلّ ما للجوارح من قدرةٍ على النداء:
- محمود! محمود.
أمام باب منزل محمود جلست، هناك على الدّرجات تحت القوس، ودكان الحاج توفيق خلفي، وروحي معلّقة على مدخل منزله كعيوني الولهى، ووجدت نفسي أقول:
_ محمود أنا هنا في انتظارك، كما في كلّ تلك السّنين، بكلّ شغفي القديم ولهفتي أنتظرك، وبكل ولهي بك وشوقي إليك... لَكَم أنت شديد الحضور يا محمود... لكم أنت شديد الحضور.
شعرت حينها فقط أنني أستطيع الكتابة، لقد انهار الجدار، واستفاقت الدّروب، ودخلْتُ، بكلّ لهفتي دخلت، كطفلٍ وجد منزله بعد ضياع وخوف، كلُّ شيء أضحى واضحًا، كأنّني ما غادرت، أو أنّ زمن البدايات اقتحم المكان، كما يقتحم الفجر نهاية ليلٍ طويل.
نعم، محمود هو المفتاح والباب، كلّ شيء بالنسبة إليّ كان متعلِّقًا بمحمود، أو هو معه وحوله وبين يديه، محمود هو ذلك الزمن، زمن البدايات، بداية البدايات.
أجل، لقد ظهر الحافز والمفتاح وانزاح الحجر عن فوهة النبع.
25
14
الأوراق
جلست تحت القوس، وتفتّحت مسام كلّ جارحة فيَّ، كل خلاياي، نوافذ موصولة بعيوني، أتلفّت في جوع، وحملتني قدماي لأخطو خطوتين إلى ذلك الباب الزجاجي المفتوح، وهناك كان أبو محمود، الحاج توفيق، جالسًا في دكّانه الصغير، هادئًا، صامتًا، خلف مكتبه الخشبي القديم، يداعب حبات مسبحته وينظر إلى البضاعة والرّفوف، ساهمًا ينظر، وكأنه ينظر إلى ما هو أبعد من الرفوف، إلى خلفها حيث عوالمه الحميمة، وأماكن دافئة يعرفها، وعلى قسمات وجهه آثار حلٍّ وترحال، آثارٌ من تعب قديم...
لَكَم أتعبتك الأيام يا حاج توفيق!
دكانه هذا كان آخر المطاف، قبله تقلّب أبو محمود كثيرًا في المهن والأماكن، محطّات شتّى منذ هجرته إلى بيروت وسكنه في منطقة «المصيطبة». حتى هو لا يستطيع أن يعدِّد المهن التي تقلّب فيها، عمل فرّانًا ثم بائع كعك، وبائعًا متجوّلًا تختلف بضاعته بعد كلّ زمن، يقلّب الخيارات إلى أحسنها رزقًا، يبحث عن رزق عياله وسط الزّحام، من حي «المصيطبة» في بيروت إلى منطقة «بكفيا» وكل الجوار، في سباق محموم، وكدٍّ متواصل، لا يتهاون ولا يشعر بالتعب، كلّما زاد همّه زاد سعيه، وكلما زاد سعيه زاد رزقه، حتى يكفي عياله، ويكفي كرمه المتدفق، ويكفي بيته المفتوح للضيوف ولكل من له حاجة، فالجيران أهلٌ في كل هذا المجتمع المهاجر كأسراب الطيور، أعشاش
26
15
الأوراق
تتكدّس، بيوت صغيرة متقاربة حدّ الالتصاق، كأن الحيَّ منزلٌ واحد تقطنه عائلة كبيرة واحدة.
القرية أوسع مكانًا، لكنّه الرزق، في كلّ هذا المحيط ما كنت لتجد أحدًا لا يحن إلى القرية! القرى جميلة واسعة، لكنّها منسيّة، تعمّد السّاسة والإقطاع إهمالها، ساكنوها الطيّبون فقراء، فقراء جدًّا، وليس لهم سوى السماء وأمطارها، كلّما زاد سكانها ضاقت فرص العمل وازداد الرّزق صعوبة، وكان عليهم أن يهاجروا مرغَمين. ألا تهاجر الطيور؟ ألم تكن أرض الله واسعة؟ القرية واسعة، لكنَّ الرزق محال، وبيروت ضيقة والرزق ممكن.
القرية تبقى في القلب والوجدان، وعند الحاج توفيق على وجه الخصوص، تراها معه في طريقة عيشه العفويّ، لقد حمل قريته معه حين جاء، كأنه ما تركها، حملها معه، جاء بكلّ طباعها البسيطة الحميمة، وضعها حيث استقرّ به المقام، ربّما ليشعر أنه مازال فيها، وهو لا يألف سواها، تراها في أثاثه وأسلوب عيشه، في طيبة القلب وفي السلوك، في التعامل مع المحيط، مع الجار والصديق والضّيف، أغلبهم كان كذلك، أغلبهم حمل قريته أو كأن القرية جاءت إلى بيروت فتح الله، بكل طيبة أهلها وإيمانهم الصافي كينابيع قراهم، إيمان نادر لا تجده إلّا عند العرفانيين وأمثال الحاج توفيق من أهل القرى، وهذا شيء عجيب! فالسّالكون في دروب
27
16
الأوراق
العرفان يحتاجون إلى الكثير من الجهد والمجاهدة للوصول إلى ذلك المستوى من الإيمان النقي؛ وأمثال الحاج توفيق وصلوا بدون تلك المحاولات، بفطرتهم كما هي وصلوا؛ وما الجهد والمجاهدة إلا من أجل إعادة الفطرة نقيّة إلى مكانها، وهم ما بارحت فطرتهم مكانها ولم تشبها شائبة.
يقسم الحاج توفيق، لو كان لديه قطعة من الأرض يزرعها وعليها بيت صغير ما غادرها أبدًا. وهل يحتاج العيش الرّغيد إلى أكثر من منزل بسيط على قطعة أرض صغيرة! يخرج إليها مع مطلع كلّ فجر كما العصافير مصحوبًا بزغاريدها، يملأ صدره النسيم العليل وتستشعر يداه برودة الندى. من كرم الأرض الذي لا يضاهى يأكل مع عياله، ذاك حلم عزيز، خبأه الحاج توفيق تحت شغاف قلبه.
سنوات، والحاج توفيق يجمع المال ما استطاع، يضاعف الجهد الذي هو مضاعف أصلًا، لشراء أرض في الضيعة، أرض صغيرة وبيت أصغر، يسع حلمًا ظلّ يتواضع ويتواضع ليكون بالإمكان تحقيقه.
لأبي توفيق ودكانه مكانٌ خاصٌ في الذاكرة، ذاكرتي أنا الممتلئة بمحمود، لَكَم انتظرتُ محمود في هذا الدكان، ولَكَم جالست أبا توفيق، حتى قبل لقائي بمحمود.
لنبدأ منذ البداية، من مقدمة ذلك الفصل، فصل ربيع ذاكرتي،
28
17
الأحاديث
زهور محمود وعطره الأخّاذ، كان ذلك حين انتقلت عائلتي للسكن في هذه المنطقة وكان محمود لا يزال مسافرًا في السعودية.
كنت على معرفة بـ«نعمة حيدورة»[1] قبل انتقالي إلى هذه المنطقة، فهو عضو ناشط في حركة أمل التي انتميت إليها، وله حضور وتأثير في منطقتي، وصادف أنه من سكان هذه المنطقة، فوجدت عنده ملاذي في هذه البيئة الجديدة عليّ، وصرت لصيقًا به باعتباره الوحيد الذي أعرفه هنا.
كل يوم كانت تزداد معرفتي بـ«نعمة حيدورة» وأزداد حبًّا له، وتعلقًا به. كنت سعيدًا بتلك المعرفة، سعيدًا جدًّا، فهو شخصية فذّة، شديد التدين، واسع الثقافة، ساحرٌ في شخصيته وقدرته على التأثير، شفافٌ رقيقٌ ترى الحب في عينيه، في ولائه اللامتناهي لأهل البيت (عليهم السلام)، شاعرٌ عرفاني السلوك، ظلّت قصائده في أهل البيت تتردد كندبيات زمنًا طويلًا، شيخٌ في علمه وإيمانه، لقد قادني إلى مكان ما كنت لأصل إليه لولاه، لقد جعلتني رفقته شخصًا آخر، أو أن تلك الرفقة قد أحسنت بنائي في فترة حساسة من عمري، كان «نعمة حيدورة» نعمة ربانيّة أُرسِلت إليَّ في الوقت المناسب.
[1] الشهيد نعمة عبد المنعم حيدورة من مواليد ميس الجبل سنة 1961 م. شارك في المواجهات بين حركة أمل والأحزاب اليسارية في بيروت الغربية، وكان له دور تأسيسي ثقافي وتبليغي بين جيل المقاومة في بيروت. استشهد في كانون الثاني لعام 1982م، قبيل الاجتياح الإسرائيلي الثاني.
29
18
شكر ودعوة
ولأنني جديد على المنطقة، لازمته طوال الأشهر الأولى ملازمة دائمة، وفيها حدثني كثيرًا عن ابن خالته محمود، حديث إعجاب وحب، شوقًا إليه ولهفة، يتحدث عنه وكأن نقصًا أصاب الدنيا بغياب محمود. وبدأت معه شخصية محمود تتشكّل بألوانها وخطوطها الأولى في ذهني.
ومع «نعمة حيدورة» زرت الحاج توفيق، والد محمود، لأول مرة. وبين نعمة والحاج توفيق تكرّر الحديث عن محمود واستطال، لتتضح شيئًا فشيئًا معالم صورته في داخلي وتزداد ألقًا وحياة.
وكما أحببت نعمة أحببت الحاج توفيق، فالحاج توفيق رجل لا يجد صعوبة في الدخول إلى قلبك، كالهواء اللطيف، كالنسيم العليل يدخل وإن أُغلقت الأبواب دونه تكفيه الشقوق الصغيرة ليتسرب هادئًا إلى داخلك. وتكرّرت زياراتي للحاج توفيق.
كنت أناديه بأبي محمود، كان ينظر إليّ مستغربًا، فلم يكن محمود أكبر أبنائه، كان أوسطهم، لحظات ثم يغفر لي خطأ الكنية ويقبل بندائي، كأنه يوافقني ويرى محمود كبيرًا كما أراه.
تمكّن الحاج توفيق بعد ولادة محمود بزمن من شراء أرض على أطراف ضيعته «ميس الجبل»:
_ اشتريتها، كانت بعيدة عن الضيعة... هي أرخص لأنها بعيدة عن الضيعة...
30
19
الأوراق
ما كان بإمكان الحاج توفيق أن يصبر ليجمع المزيد من المال، المال الذي يمكّنه من شراء أرض أقرب، المال صعب وقطار العمر لا ينتظر، خاف على حلمه من المجهول والانتظار، عصفور في اليد، رائحة التراب والأخضر الذي يطل برأسه من بين حباته الحمر، حلم دنا وتدلّى، خير من عشرة، وسارع الحاج توفيق إلى شرائها خافق القلب، يسرق الوقت ويسابق العمر، يذهب إليها في كل وقت متاح، ويبدأ في بناء البيت.
_ عندما بنيت بيت الضيعة كان محمود صغيرًا، في الثامنة أو التاسعة ربما.. صغيرًا كان، لكنه مثل الرجال، وحياتك...
يأخذه أيام العطلة، يحاولان استغلال كل العطلة، وفي عطلة الصيف الجميلة بوقتها الطويل، هي في حديقة الذاكرة ربيعٌ زاهر.
محمود، وفي كل عطلة، ودون أن يطلب إليه أحد، تراه يسرع في توضيب متاعه، ويعد نفسه للذهاب إلى الضيعة، ثم ينظر إلى أبيه بعينيه السوداوين الواسعتين باسمًا في تحفُّز صامت.
حماسة محمود للذّهاب إلى الضيعة كانت صارخة الوضوح، ربما لفضائها الواسع، طبيعتها، جبالها والوديان، أشجارها، وربما هو صمتها الذي يسعى إليه كل من هو خارج من صخب بيروت وضوضائها، أو ربما هو حبّه لأبيه، رفقته ومساعدته، وربّما لكل هذا معًا، وربما لأسباب أخرى لا يدركها إلا قلب صغير خافق. لكنَّ محمود لا يزال
31
20
الأوراق
صغيرًا، وفي هذه الرحلات الكثير من التعب، بين السفر الطويل والعمل هناك مشقة لا تناسب الجسد الصغير.
_ هو من كان يصرّ على الذهاب معي... لم أقبل في البداية...
يضحك الحاج توفيق ويتابع:
_ بعدين بطّلت روح بدون محمود.
وتنقلب الصورة، الحاج توفيق ينتظر محمود ليأتي من المدرسة، أو لينتهي من توضيب متاعه، ومحمود الذي لم يصل بجسده إلى ما فوق خصر أبيه يسرع حاملاً ما استطاع من المتاع، يسبقه في نزول الدّرجات وينتظره في الشارع مبتسمًا يتقاسم الفرح والحماس ملامح وجهه، وفي عينيه يزاحم الفرح وميضًا من جدّية وإصرار.
وهناك يسيران مسافة في الأرض الوعرة للوصول إلى الارض سيرًا على الأقدام لأن الطريق إليها لم يشق بعد. وهناك في طرف الأرض باحة صغيرة أعدت لمشروع بناء يحاول النهوض كطفل يحبو. يجلسان على حجارة البناء لاهثَين، مبتسمَين ينظر كل منهما إلى الآخر: ها قد وصلنا أخيرًا.
هناك ملامح لغرفة ومطبخ قيد الإنشاء، وفي زاوية من باحة المشروع انتصب ما يشبه الكوخ، مصنوعًا من نسيج المكان وأدواته، أعمدة الكوخ وهيكله من الخشب المستعمل في البناء، سقفه وبعض جدرانه من أكياس الإسمنت الفارغة، وبعض من حجارة البناء
32
21
الأوراق
وصخور الأرض، أغصان وأوراق شجر، فراش وأغطية وضعت مطوية في الزاوية، وعلى مقربة من الكوخ حجارة اسودّت أجزاء منها وقد شكّلت ما يشبه نصف الدائرة، تحيط رمادًا وبقايا أغصان تفحّمت أطرافها، وبعضها أصبح فحمًا قابعًا فوق الرماد.
يسرع محمود ليجمع عيدان الأغصان وأوراقًا يابسة وبعض الخشب، يعدّ مع أبيه الموقد، يعرف محمود مستوى تلك العلاقة الحميمة بين الشاي وأبيه، ففي كل استراحة يسارع محمود لإعداد مستلزماتها، يضع الحاج توفيق يده على صدر ولده ويبعده لينفخ هو على النار فيما محمود يفرك عينيه، وإذا فتحهما شاهد ألسنة النار تولد من وسط الدخان المتصاعد، يركض ليملأ الإبريق الذي اسودّت جدرانه الخارجيّة، ويعود به إلى أبيه مع كيس الشاي والسكر، ويقفل عائدًا يتدفّق ليغسل قدحين وملعقة ويعود بهما إلى الموقد، وعلى حجرٍ هناك يجلس عاقدًا يديه على ركبتيه، تارة، ومشبكًا أصابعها تارة أخرى، ينظر مرة إلى والده وأخرى يجوب بعينيه الواسعتين ماسحًا كلّ المحيط، قد يستقرّ نظره هنيهة على أغصان شجرة يستمع إلى عصافير تخوض نقاشًا محتدمًا. وقد يركل حجرًا صغيرًا بقدمه بانتظار الشاي، هو يحب الشاي كأبيه. ويقول الأب بلهفة:
_ انتظره ليبرد قليلاً يا محمود.
ثم يبدأ العمل، العمل بدون محمود صعب، أو هو أقل استثمارًا،
33
22
الأوراق
فمحمود يدور حول أبيه، يناوله الحجارة أو الإسمنت أو يحمل وينقل ما استطاع، خشبة من هنا ودق مسمار هناك، بفتح الصنبور، بمدّ الخرطوم. واقف قرب أبيه، ينظر إلى عينيه، وإلى ما ينجزه بين يديه، وقبل أن يطلب يعرف محمود ويسارع في جلب المطلوب كما يفعل الممرّض مع الجرّاح، فوصول حركة الوالد إلى مكان ما يخبره عن نوع الحاجة.
_ حتى في وقت الاستراحة كان يعدّ لي الشاي ويصنع لي مقعدًا من حجارة... تخيّل!
عند انتصاف النهار، وتحت شجرة وارفة الظل، يهيِّئ محمود المكان، وفي الظل يفرش الحصير ويفتح صرّة القماش، يخرج محتوياتها، يرتّبها، بصل وخبز، بطاطا و... الماء... يركض محمود، ثم أعواد الموقد والإبريق الأسود و...
_ انتظره قليلاً ليبرد يا محمود.
يعودان للعمل بعد استراحة الغداء الطويلة. ويتابع الأب حديثه:
_ لم يكن يقبل أن أحمل غرضًا، أيّ غرض وهو يسير قربي فارغ اليدين؟! يعترض على ذلك بشدّة، وكأنه منكر أو حرام... كنت أخاف عليه من التعب... كان يزعل، يكره أن أعامله كصغير، وكنت مجبرًا على احترام رجولته المبكرة.
معي، يساعدني بهمته العالية... كان حولي دائمًا، حتى إذا أردت
34
23
الأوراق
أن أشرب، كان يرفض أن أجلب الماء لنفسي، رغم المسافة لا يتهاون، يركض، يجلب الماء، وهو يبتسم ابتسامته الحلوة... وأنا كنت شابًا، كان لا يدعني أعمل عملاً يستطيع أن يقوم به، يسبقني إليه، يركض ويأخذه مني. صاحب عاطفة محمود... طوال فترة طفولته وشبابه... وهذه العاطفة ليست عليّ وحدي... عاطفته تشمل الجميع، ربما عاطفته هذه هي التي أخذته إلى تلك الأماكن الصعبة.
حتى إذا ما تعبت الشمس وتغيرت ألوانها، وهي تزحف لمستقرها، سار محمود ممسكًا بيد والده، يسيران الهوينا باتجاه الكوخ، وما تيسّر من طعام وقدح من الشاي.
يقول الحاج توفيق مبتسماً وهو يعود بذاكرته:
_ يعدّ لي مكان نومي، حتى اذا اطمئن إلى رقدتي، تمدّد هو في الجهة المقابلة، ينظر إليّ مبتسمًا... أتحدث إليه فيصغي، ثم أسكت ضاحكًا وأنا أستمع لصوت أنفاسه الناعمة... يا حرام!... كان يتعب طوال النهار، يحمل أثقالًا ويعمل كالرجال.
يضحك الحاج توفيق، ويواصل الحديث عن محمود، ويعلم مدى حبي له، ومتى توقّف حرّضته على المتابعة، أريد الحديث عن محمود وعن طفولته التي لا أعرفها، ومن الحاج توفيق بالذات، فهو يحدّثك كما يحدّث نفسه، يبتسم وتسرح عيناه كأنّه ينسى
35
24
الأوراق
وجودك، ثم يلتفت إليك بين الحين والآخر ليؤكد فكرة ما أو ليتأكّد أنك تتابع.
لم يكن الحاج توفيق كثير الكلام، لكن الحديث عن محمود يستهويه، وأنا في شغفي أستحثّه على الكلام، فيقول:
_ أتعلم؟ لم أرَ ولدًا مثل ابني محمود... كان حذرًا، قلما كان يتعثر رغم حركته الدائمة، أتصدق؟ أنا كنت أتعثر أكثر منه... مع ذلك كان شجاعًا... ولا أدري كيف تجتمع الشجاعة والحذر في صغيرٍ في مثل سنه... ربّما خوفه عليّ وحبه إياي... أو أن شيئًا في محمود كان مختلفًا.
الأرض التي اشتراها الحاج توفيق كانت مواجهة ومكشوفة للأراضي الفلسطينة المحتلة، وأمامها مباشرة قرية المنارة[1] المحتلة، كثيرًا ما كانا يسمعان صوت رصاص بعيد حيث كانت قوات الاحتلال تمشّط بين الحين والآخر المناطق القريبة من الحدود، وفي إحدى الليالي كانت أصوات النار تنبِّئ عن غير ذلك، لسبب لا يعلمه الحاج توفيق الذي استيقظ على صوت إطلاق النار.
حين أصبحت الأصوات أكثر قوة، وهذا ينبئ عن قربها، والمكان مكشوف، خاف على ولده الذي أيقظته قوة الأصوات واعتدل في
[1] قرية صغيرة تقع في شمال فلسطين المحتلّة. قتل الصهاينة بعض أهلها وشرّدوا الباقين.
35
25
الأوراق
رقدته، وآثار النوم في عينيه مصحوبة بدهشة، وأهدابه الطويلة ترتفع وتنخفض في تسارع، وهو يدور بهما متسائلًا، اقترب منه الحاج توفيق:
_ لا تخف.
_ جاء الإسرائليون.
_ لا... إنهم يقصفون الوديان القريبة.
كان القصف يزداد قوة، ثم أطلقت صواريخ سقطت على الجبل الذي فوقهم.
أمسك يد ولده وخرج من الكوخ، المكان مكشوف حيث هما، ركضا إلى البرية، وعلى ضوء قمر لم يكتمل، بحثا عن مكان يحميهما من القصف، مكان غير مواجه، خلف صخور أو أي شيء، لا يستطيعان الابتعاد كثيرًا.
_ كان ينتظرني إن تأخرت، ويمدّ لي يده إن تعثرت... كان خوفي عليه هو ما يعيقني، كنت أريد الوصول به إلى زاوية محميّة من النار، كان يطيعني دون أن يسبقني ولا يتأخر عني، رغم حركتي السريعة. كان يلهث ليسير بجانبي، فقط ليجعلني مطمئنًّا عليه، كنت أنظر إلى عينيه، فلا أجد أثرًا للخوف فيهما، أستغرب وأنا أحدّق في وجهه ولا أرى سوى البراءة في عينيه الحلوتين، براءة وانتظار لأوامري.
وجدا بعد مسير وبحث مرتبك صخورًا كبيرة اجتمعت مع صخرة ضخمة لتترك خلفها مساحة كافية، جلسا خلف تلك الصخور
37
26
الأوراق
يلهثان، ابتسم محمود في وجه أبيه، تلك طريقته ليشكره أو ليعلن عن حبه له.
واستمر القصف يشتدّ ويخبو، ومع شعورهما بأمان تلك الصخرة استغل محمود مساحة هذا التواجد الصامت بلا مهام، وصار يسأل عن إسرائيل وفلسطين.
_ لم يكن ينتفض لصوت الانفجارات، ربما لثقته بي في اختيار المكان الآمن... كان ينظر إليّ ويبتسم تلك الابتسامة التي تقول: اطمئن يا أبي.
سألني عن «الإسرائيلية»[1] وقتها، وحدثته عنهم طويلًا وهو يصغي، ثم يسأل مجددًا، يحب الحديث عن فلسطين، كما أحب أنا الحديث عنها.
وغفا محمود وهو يستمع إلى فلسطين ومعاناتها في التاريخ الطويل الدامي. حكايات الظلم هذه كانت تتسرب إلى مسامع محمود مصحوبة بصوت قصف ونيران مغتصبيها، لتفسح لفلسطين مكانًا في ذهن الصغير وقلبه. وصمت الحاج توفيق حين شعر برأس ولده يتكئ على كتفه، قرّبه إلى صدره ومسح على شعره مبتسمًا، وما لبث أن غفا هو الآخر ساندًا رأسه على الصخرة.
[1] استعمال شائع لدى اللبنانيين يعني الاسرائليين.
38
27
الأوراق
حين استيقظ كان الهدوء يلف المكان، إلا من حفيف أشجار قريب، وعصافير تصدح بالأمان وتوقظ بعضها بعضًا، وضوء الفجر يغسل المكان والصخرة المأوى ووجه محمود الجميل، وجه هادئ محايد، ظل ينظر إليه بعضًا من الوقت، هكذا يفعل دائمًا قبل إيقاظه، كم هو جميل، كم أنت قريب من القلب يا محمود، قريب كأنك فيه، ثم يمسح على خده فيستيقظ محمود، يفتح عينيه الواسعتين ببطء، كأنه يعاني من ثقل أهدابهما الطويلة، يبتسم محمود للأمان الذي يصنعه وجه أبيه.
عادا إلى كوخهما والأرض، كان محمود يركض أمام أبيه، ليعد له الشاي ويهيِّئ ما تيسر من طعام الفطور، سعيدًا ببدء نهار جديد للعمل مع أبيه.
_ عدنا إلى المنزل وأكملنا أعمالنا... وهو إلى جانبي، عامل نشيط كأن شيئًا لم يحدث... أتصدق؟... كنت أستمد شجاعتي منه.
تعبنا كثيرًا في بناء ذلك البيت، قبله كان منزل الضيعة منزلنا القديم، لكنه كان ضيقًا، العوائل والأقرباء كثر، وعلى الرغم من ذلك كنا نحب جوّ الضيعة أنا والأولاد، لذلك بنيت بيت الضيعة.
أنا أحب الأرض... تعلّقنا فيها كان كبيرًا على الرغم من الجوّ الأمنيّ الصعب، وحتى في حال الخطر لم أتوقّف عن العناية
39
28
الأوراق
بالأرض... حتى وهي تحت الاحتلال... تعرّضت للمضايقات وللاعتقال والتحقيق، كانوا يسألون عن أولادي ويضايقونني.. لكني لم أتوقّف عن زيارة الضيعة... لم أستطع إكمال البيت للأسف، أكملت غرفة بشكل مؤقت، والحمام بعيد عن الغرفة... كنت أريد أن أراه صالحًا للسكن بأقل ما يمكن، وبأسرع وقت.
40
29
الأوراق
كانت الحرب الأهلية التي اشتعلت نارها في عام 1975 تمتدّ ويشتدّ أوارها بزيت إسرائيليٍّ ضدّ الوجود الفلسطينيّ المسلح، الذي كان وقتها يخوض عمليّات بطولية، ويكيل الضّربات الموجعة للكيان الذي اغتصب فلسطين، فلسطين التي كانت حاضرة في جوارح محمود، وقد تفتح وعيه عليها وكأنها خلقت فيه أو معه مذ خلق.
_ ربما أنا من زرع هذا فيه.. كم كان يصغي ويتأثر حين أحدّثه عن فلسطين ومأساتها، وعن جنود الاحتلال.
محمود أيضًا كان يرى ويسمع، يهتم كما هو دأبه، وتلك طريقته مذ فتح عينيه، يصغي باهتمام وتتسع عيناه السوداوان، والقلب مشرع النوافذ للحب كما للغضب، ففي الحب أيضًا تسكن جمرة الغضب، محمود وقلبه المجبول بالحب، المصنوع من الحب، يحب الناس ويخفق للمظلومين بشدة، فيغضب لهم ومن أجلهم، وفلسطين عنوان الظلم بشواهده الواضحة كنار على علم فوق جبل، على سمع منه وبصر.
والحرب الأهلية ما قامت إلا لقهر الثورة الفلسطينية المسلحة،
41
30
الأوراق
وكي ينقسم الجسد اللبناني يقاتل يمينه يساره، الصهاينة دعموا وشجعوا عددًا من الأحزاب والتنظيمات اليمينية، وسلّحوها لمواجهة الوجود الفلسطيني المسلح، ووقفت الأحزاب اليسارية إلى جانب الثورة الفلسطينية، وانقسمت الأرض بين شرق وغرب.
محمود في الصفوف الابتدائية الأخيرة، كان الحب قد تدفّق من قلبه لفلسطين وثوارها من الفدائيّين، ووصل إلى درجة الشّغف، أبطال في عيون الطفل، تتّسع دهشتها بهم، بعملياتهم، بانتقامهم من الظّلم، يسمع عن عمليات القصف بالنار، بعبور الحدود على الرغم من كل شيء، في أنحاء العالم، مطار هنا وسفارة اسرائيلية هناك، وعبر البحر في زوارق من مطاط، مجهزين بأسلحة وغضب، و«دلال المغربي» وشباب تلتمع الثورة في عيونهم، احتضن صورهم كما تحتضن السماء نجومها، ينشد أناشيدهم، تسمع صوته وهو يستحم:
_ هذا هو دربي
_ لنقاتل لنقاتل لنقاتل ياشعبي
_ فلنطلق كل النار
وهو يضع حقيبته وينزل إلى المدرسة:
_ يا جماهرنا الشعبية
_ فجّرنا الحرب الثورية
42
31
الأوراق
يرفع ذراعه عاليًا وهو يسير:
_ رشاشي بايدي
_ اخويا وصديقي
_ وبدي ضلني ماشي.
يحفظ الكثير من الأناشيد الفلسطينية إن لم يكن كلها.
يقاتل معهم في خياله، يشاركهم في أحلام يقظته، ينتقم من الصهاينة ويذيقهم الويل جراء ظلمهم.
لكن طبع محمود لا يطيق الصبر على الأحلام طويلًا، يفتح لها على الواقع نافذة لتخرج كما تخرج العصافير من أعشاشها، وأحلام محمود ما أسرع أن يتحول زغبها ريشًا، وسريعًا ما تتعلم الطيران.
في سنوات المتوسطة فتح الأبواب لأحلامه، وقرّر الانتماء للثورة، لـ«منظمة التحرير الفلسطينية». سعى لذلك بهمّة وقوة، وعمل أضعاف ما يعمل من يكبره سنًّا، ألزمهم بانفتاحه وذكائه وحركته السريعة بقبوله، وتلقّى بعض التدريب، وعمل بجدٍّ في النشاط الحزبي والعسكري.
وفي عام 1978 اجتاح الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وطارت أحلام محمود إلى مدى واقع الحرب، حمل سلاحه واتجه جنوبًا معهم، كان فتى بين رجال كبار، يعقد الحاجبين على غضب عارم، وفي عينيه
43
32
الأوراق
حماس يصاحبه فرح خفيّ، وهناك شارك لأول مرة في التصدّي لقوات الاحتلال، ركض في الأراضي الوعرة وأطلق النار، من خلف الصخور وتحت الأشجار الوارفة الظل، احتمى من غارات الطائرات الحربية في أحراج «النبطية» وجوارها، والفرق فادح ومهول في الإمكانات، ثم جاءت الأوامر من القيادة بالانسحاب.
سبعة أيام احتل فيها الجيش الاسرائيلي شريطًا من القرى الحدودية بعمق 10 كيلومترات، ثم انسحب تاركًا العميل «سعد حداد»[1] يسيطر، بدعمٍ من الصهاينة، على قرى هذا الشريط، كما سيطر المدعومون من إسرائيل على شرق بيروت ومناطق أخرى ضمن دائرة الحرب الأهلية التي بقيت تدور، ومحمود فيها منغمس في القضية الفلسطينية، تاركًا كلّ شيء غيرها؛ لقد أصبحت مع الوقت قضيّته التي يتبناها، أصبحت هي همه، أفراحه وأحزانه... كأنه نذر نفسه في خدمتها... في هذا العمر!
_ تعلّق به المقاتلون الفلسطينيون كثيرًا، كنت أراهم كيف يعاملونه، كأنه رجل لا يصغرهم سنًّا، لم يكن قد تجاوز الثالثة عشرة بعد حين عرض عليه الفلسطينيون أن يفتحوا له مركزًا في فتح الله.
[1] ضابط في الجيش اللبناني من بلدة مرجعيون تحالف مع العدو الاسرائيلي معلنًا سنة 1979 عن قيام دولة لبنان الحر على الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة، قاد حتى سنة 1984 ما اسماه «جيش لبنان الجنوبي» المتعامل مع الكيان الصهيوني.
44
33
الأوراق
«الحرب الأهلية» تدور عنيفة متفلّتة من قوانين الضبط، ومحمود فيها صبيٌّ لم يتجاوز الثالثة عشرة، كان ذكيًا، سريع الحركة، عيناه المفتوحتان تظهران جوع روحه... مفتوحتان على صدر يريد أن يعبَّ ما استطاع في نهمٍ إلى المعرفة، معرفة استيقظت الحاجة إليها باكرًا جدًا، وباكرًا تعاطف مع كل هذا المحيط الفقير وحاجاته والمظلوميات التي تكاد لا تحصى... دفعه كل هذا للشعور بالمسؤولية في عمر اللعب والمراهقة الأولى، ليحرّض نفسه باكرًا على العمل، فاقتحم الدّروب وهو يتلفت كمن يبحث... يريد أن يفعل شيئًا، أي شيء غير أن يقف ساكنًا... لقد اتخذ القرار، قرار التغيير، وانخرط في الزحام، زحام بيروت، زحام أفكارها ومعتقداتها المتنوعة، أحزابها التي جمعت كبيت العنكبوت ما استطاعت اصطياده من كلّ تلك الطاقات، ومحمود طاقة فذّة، هذا الفتى المراهق الذي يتّقد نارًا ويغلي طاقة وحماسًا عجيبًا.
وهو في هذه الأحزاب فرد فاعل في إخلاص فريد، إخلاص من يظن أنه على وشك تحقيق أحلامه، قاب قوسين أو أدنى من الثورة التي ستحقق طموح الفقراء والمستضعفين والمشردين في الأرض.
حمل السلاح... كان بين الرجال الكبار كبيرًا وقادرًا... يثير الإعجاب إلى حدود الدهشة وقدرته الجسدية التي تخطت عمره بكثير. حماسه الذي ضاق به جسده والمكان، كعاصفة تريد أن تعرف دربها. لم يكن للخوف مكان في هذا القلب الصغير الخافق بكل ذلك الحب
45
34
الأوراق
والحماس. جرأة قلبه وقوة جسده وذكاؤه الحاد كان يثير الذهول، سريع الفطنة، يرتجل المواقف ارتجالًا، والغريب أنها تصيب وتقنع، حتى غدا - وهو الفتى بين الرجال - رجلًا يعتمد عليه في أصعب المهام... وظل كعادته يتلفّت لا تسهو عليه خافية، وعيناه ظلّتا نافذتين على روحه، مفتوحتين جائعتين إلى المعرفة والعطاء.
بعد الصف الثالث المتوسط، ترك المدرسة وحمل سلاحه، وبقي مع الفلسطينيين ثم استقر في «الجبهة العربية» مع «أبي العباس».
خلال هذه الفترة، أثبت وجوده كمقاتل شرس وشجاع لا يعرف الخوف، كانت قوته الجسدية واضحة جدًا ومثيرة للإعجاب، حتى أنه لقب بـ«الوحش»، لم يجدوا لهذا الكم من القوة والشجاعة سوى هذا اللقب.
ما كان الانضمام إلى الأحزاب وحمل السلاح مستساغًا حينها، لم يكن عملًا مرغوبًا به، في جوّ الحرب الأهلية المتفلتة من الضوابط. وأضحت مصداقية تلك الأحزاب تضعف يومًا بعد يوم عند أغلب الناس، لكثرة الشوائب التي كانت تصاحب سلوكهم، ولسمعتهم التي ما كانت جديدة عند عموم المدنيّين من الناس.
وشخصية الحاج توفيق مسالمة طيبة تكره التسلط والفوقيّة، والسلاح يغيّر بروح حامله، وكأن ذاك الحديد ممغنط، قادر على سحب التواضع والرحمة من قلب حامله.
46
35
الأوراق
المسلحون؛ ذاك الاسم له وقع على الأذن، على الأذن غير مريح، كنغمة نشاز، تلك صفة ذميمة بالنسبة إلى الحاج توفيق:
_ مع المسلحين؟ أعوذ بالله.
لقد أرغم ولده الكبير على السفر إلى السعودية، ليبعده عن هذا الجو، لكن ابنيه الثاني والثالث عملا مع الأحزاب، وكان هذا يؤلم الحاج توفيق، لكن ألمه صار غضبًا حين التحق محمود مع الأحزاب بشكل فاعل وجدي، حتى إخوته اعترضوا بشدة، يناقشهم ويشرح ويبرر بوعي لافت، وإذا قالوا: ولكنك ما زلت صغيرًا، صرخ فيهم: أنا لست صغيرًا. تستفزه هذه الكلمة، فهو يرى غير ذلك، يرى نفسه كبيرًا ويرى هموم الناس كما لا يراها أحد، واثقًا من قدرته على التغيير، وفعل ما لا يستطيع غيره فعله.
يحاولون ثنيه عن هذا المسار، يطالبونه أن يدع أمر الجهاد والسلاح والفلسطينيين والأحزاب ويعود إلى منزله الى حيث يكون الصغار، لكنه لم يكن صغيرًا إلا في السن، حتى قوته الجسدية كانت أكبر منه، وكيف يلتزم المنزل وفي عينيه أحلام وثورة، ويرى نفسه قادرًا ويريد.. يريد أن يحدث تغييرًا، يحاول قلب مفاهيم الركود السائدة، تغيير هذا الحاضر الذي لم يكن أبدًا راضيًا عنه، كان جوابه لكل معترض:
_ إن لم أحاول أنا وغيري، من الذي سيحاول؟ إن لم أضحِّ أنا وغيري، من الذي سيضحي؟
47
36
الأوراق
لا هو أقنعهم ولا هم استطاعوا إقناعه... وظل محمود قليل الحضور في المنزل وحاضرًا بقوة في ساحات القتال.
لم تكن ساحات القتال وحدها تشغله، كان همُّ ناسه والمحيط يتناوب على قلبه فيعتصر الإنسان فيه، ليس محمود من يغضّ البصر، ليس محمود من لا يهتم، الفقر قاس، والاستضعاف شديد، وفوضى الحرب الأهلية تنشر الفساد والظلم كالوباء.
على مقربة من الحي، هناك خلف الجامع، وفي الطريق الضيّق، كَمَنَ لرجالٍ يعرف وقتهم وأوصافهم، سمع أنهم يبيعون المخدرات في ما يشبه العصابة، تابعهم، تحقّق ورصد، ثم حمل سلاحه ونزل إليهم، من سيواجه الوحش، ملعون أبو هذه المنطقة ومحمود فيها، فروا بخسائرهم بلا عودة، وبقي محمود يتابع قضية توزيع المخدرات بلا كلل.
_ قلت له: هناك دولة يا ولدي وهي المسؤولة عن هذه الأمور، هل هي مسؤوليتك أنت وحدك يا محمود؟.. أتعرف ماذا قال لي؟
لم أجب على السؤال، فالحاج توفيق لا يسألك لتجيب، إنما يسألك ليشدّ من وتر حماسك وليتأكد من إصغائك، يتابع وفي عينيه إعجاب واضح:
_ قال لي: إن هؤلاء يدمرون حياة أولادنا وشبابنا. إن لم أقف أنا وغيري لمواجهتهم ستنتشر المخدرات في كل المنطقة...
48
37
الأوراق
ومرّت رحى الحرب تسحق، ويزداد توقُّد الإنسان في محمود، يلمع ذهبه من احتكاك قسوتها، يزداد حبًا وعطاء ومشاركة، تجعله آلامها وقسوتها أكثر عطفًا واهتمامًا بمحيطه حتى يقطر حبًّا، واقتربت رحى الحرب بقسوتها من دائرته الصغيرة، انفجرت قذيفة داخل المنزل عن طريق الخطأ، وأدت إلى استشهاد شقيقه علي، كان يكبره بثلاثة أعوام، تذوَّق طعم الأسى والموت في المنزل، اتّخذ لحزنه مكانًا قصيًا، وفي الزوايا المعزولة بَكاه طويلاً، وحوّل حزنه مودّة ورحمة لأبويه، ضاعف من اهتمامه بهما وبالعائلة، يحاول جاهدًا ترميم الفراغ، يدور حولهما ويتواجد في المنزل أكثر، عساها غيمة الحزن تنسحب وتذروها الرياح، لم يشاهد لرقّته وحنانه مثيلاً، كما يقول الحاج توفيق، ويعجب كيف يطلقون عليه لقب الوحش. وحين يسمع عن بأسه وشجاعته يحار: كيف يكون هذا في شاب بل في مراهق، يجمع هذه الصفات التي لا تجتمع، هو يرى حنانه وعطفه أكثر، بل يكاد لا يرى القسوة فيه، يرى قوته في قدرته على المساعدة. دخل صاروخ إلى المنزل واخترق جدرانه... وقتها احترقت شاحنة والده الصغيرة، فتأثّر الوالد كثيرًا، حدّثني مطولاً الحاج توفيق عن تلك الحادثة، ليس عن عربة النقل التي كانت تحترق، بل عن تصرّف محمود، حديثه ومواساته، ممحاة للأحزان محمود.
كم هو فخور به، في رجولته المبكرة، وشهامته التي تسمو به وترتقي فوق مصاف الرجال، حديث الناس: «نعم الولد»... «الله يخلي لك اياه»... «ابن أصل»... «ونعم التربية».
49
38
الأوراق
_ عجيب محمود! قبل بلوغه لم يكن كذلك... كان هادئًا، يفكر كثيرًا ويسأل كثيرًا، معنا دائمًا وفي المنزل، يكاد لا يفارقنا.. تغير تمامًا بعد البلوغ.. أتعرف؟.. كأنه انتقل من الطفولة إلى الرجولة مرة واحدة... لكنه حافظ على تلك العلاقة بيننا، وعطفه وحنانه لم يتغيرا... لكن حضوره تناقص حتى أصبح قليلاً جدًا.. كان صغيرًا وكنت أخاف عليه، وشباب الأحزاب ليسوا مثل محمود.
يهز الحاج توفيق رأسه نافيًا بشدة، وأنا أجاريه في نفيه ذاك، أجل ليسوا مثل محمود، ما كان يقصده الحاج توفيق كان واضحًا عندي، ففي تلك الفترة كان للأحزاب سيطرة مطلقة، ومن يملك السلاح يملك السلطة، وكان أفرادها يتمتعون بثقل في منطقة «فتح الله».
و«فتح الله» قرية، وفي بيروت قرى كثيرة مثلها، صنعتها تلك العوائل التي نزحت من قراها طلبًا للعيش، إنها قرى وإن كان البناء عموديًا وإن كانت البيوت شققًا صغيرة كالعلب. لقد شكلت تلك القرى مجتمعات مختلفة، مجتمعات ظلّت غريبة عن بيروت، لقمة صعبة، لا بيروت استطاعت الهضم، ولا القرى الغريبة لانت أو غيّرت طعمها، وأهلها الطيبون فقراء، بسطاء ومستضعفون، أكثر مما تعرف بيروت أو تريد، هم حاملو طباع القرية ولبيروت طبع مغاير، بيروت المال والسلطة والدنيا بكل زخارفها، وفي الحرب
50
39
الأوراق
الأهلية أضحت بيروت غابة من الباطون بكل قانون الافتراس واللهاث خلف الدنيا، وفتح الله قرية، وسكانه المهاجرون أغلبهم من الطائفة الشيعية، وبيروت طوائف، بعضها منعّم حتى التخمة، وبعضها مهمل ومسحوق حتى النسيان.
كمٌّ من الأفكار الجميلة، معتقدات ومُثُل عليا وأحلام، أحلام المستضعفين والمظلومين، أحلام الثوار، حملها من كان يعيش الإنسان فيه، حارب من أجلها ومن أجل قضيته الكبرى فلسطين، وانتمى إلى أحزاب لا تعدّ ولا تحصى. كل تلك الأفكار والمثل العليا والأحلام، كانت تئنُّ حائرة في وسط عاصفة الحرب الأهلية، كطفل ضاع في الغابة.
أحاول أن أوضح لك ملامح ذلك الزمن، ولا أدري يا صديقي إن كنتُ قد نجحت في ذلك، أو أنني استطعت أن أنقل صورة واضحة عن تلك السنوات التي أعقبت اندلاع الحرب الأهلية.
دعنا نأخذ منطقة «فتح الله» نموذجًا، لأن محمود كان فيها، وأنا أريد الحديث عن محمود بالذات.
كان السلاح هو السيد الحاكم المطلق الصلاحية، وحاملوه هم أحزاب متعددة، أحزاب فلسطينية وأحزاب لبنانية رديفة، في تجمّع أطلق عليه وقتذاك اسم «الحركة الوطنية».
وكان الاصطفاف على أشدِّه، اصطفاف أساسه ودواعيه هو
51
40
الأوراق
القضية الفلسطينية، وقد قسّم ذلك الاصطفاف بيروت إلى نصفين: شرق بيروت وغربها، وبعد فترة وجيزة تشظّى كلّ قسم إلى قطع، وفي كلا النصفين تشظى، كانقسام الخلايا السرطانية، في شرق بيروت، كذلك في غربها.
كيف تاهت الحرب الأهلية وكيف ضاعت أهدافها؟ من سرق تلك الأفكار والأحلام؟ وكيف غرقت الأحزاب في هذا المستنقع؟ لا أحد يدري، ولا أحد يريد الاعتراف، والمستنقع يزداد وحولة وقذارة وفسادًا يومًا بعد يوم.
أحزاب في ميثاقها ونظامها الداخلي علمانية صرفة، لا تعنيها القوميّات والطوائف، وفي الداخل يتكتل أفرادها في قوميات ومناطق وطوائف، بل حتى عشائر وعائلات.
وتدور معارك صغيرة هنا وهناك، لا أحد يدري متى تبدأ ومتى تنتهي، ولماذا، قد تنشب بين عائلة وأخرى على خلاف فرديّ، أو أن عائلة تريد أن تتحكم بعائلة أصغر منها. ما أسهل أن تنشب تلك المعارك، كما تشتعل الغابة من شظية زجاج مكسور، قد تشتعل الحرب في الشوارع الضيقة لأسباب لا تخطر على بال، نشبت مرة من نزاع بين طفلين على لعبة، وأخرى لأن دكانًا لا يريد دفع خوّة لهذا ودَفَعها لذاك. البحث عن المال والسلطة كان سيد الأسباب، وما السلاح سوى وسيلة، والأحزاب النافذة هي مصدر هذا السلاح،
52
41
الأوراق
والانتماء إليها مفهوم الأهداف، واضح السعي، لا ينتمي أفراد العائلة الفلانية لهذا الحزب، لأن العائلة اللدودة تنتمي إليه. أسباب كثيرة تحدّد الانتماء، قلمّا يكون الفكر والأهداف أحدها، وإن كانت الأهداف حافزًا أحيانًا عند بعض الشباب المتحمس؛ لكن هذا الحافز لا يلبث أن يضيع في تلك المتاهة كما ضاع كل شيء.
يحار المستضعفون والفقراء وهم يبحثون عن الحماية، يدفعون من أجلها خوّة وخدمات تزيدهم فقرًا واستضعافًا، يلجأ من لا يستطيع شراء الحماية إلى محمود، وهو القوي المهاب، الشجاع الذي لا يتردد، ومحمود ليس مثل باقي المسلحين، كما قال الحاج توفيق.
«نعمة حيدورة» يشبّه محمود بالحمزة عم النبيP في موقعه المحامي والشجاع، في الحماية، وفي شعور الضعفاء بالأمن في حضوره.
ونعمة حيدورة رغم الاختلاف في شخصيته عن محمود، يحبه كثيرًا، ولا يكف عن مدحه:
_ محمود طيب طاهر، يكره الظلم ويواجهه بلا حساب، هو لا يحسب لنفسه حسابًا.
وببلاغته يتابع القول في مدح محمود:
_ ويزدحم حب المستضعفين في قلب محمود فينافسه على حب نفسه حتى يدفعها لهم.
53
42
الأوراق
سكان «فتح الله»، هؤلاء الشيعة النازحون هم أكثر الناس استضعافًا، ويتدخّل محمود عشرات المرات ولا أحد يستطيع مواجهته، اسمه وحده يكفي.
شوهد مرة في الطريق يعيد بضاعة أخذها مسلّح بالقوّة من بائع متجول فقير، كان يعيد البضاعة إلى تلك العربة، ثم يضع يده على كتف صاحبها مواسيًا، ويقول له مشجعًا:
_ لا تخف... إن عادوا إليك قل لهم إن الوحش قريبي.
_ الله يحميك يا رب.
ذلك الدعاء كان غذاءه الروحي، ولَكَم كان يخجل من هذا الشكر والدعاء، حتى أن وجهه كان يحمرّ من شدّة الخجل، ويردّد مرتبكًا:
54
43
الأوراق
_ العفو، يا عمي، العفو.
لم يفعل شيئًا، لا يجد أن الأمر يستحق، هو واجب، أو هو أمر بديهيٌّ لا يستطيع إلا أن يقوم به، تلك المبادرات حتمية وتلقائية، والشكر منهم والدعاء يعتبره عطاء كريمًا يستدعي الخجل.
وفي مكان آخر، يصعد الدرجات ثلاثًا، ثلاثًا، ويطرق باب مريض بالسكري ثم يقول بمودة وهو مطرق الرأس:
_ جبتلو الدوا وعلبتين زيادة، خفت يخلص من عنده الدوا وأنا غايب...
_ عذبت حالك.. الله يخليلنا اياك يارب
_ العفو، يا عمي، العفو.
ولم تكن منطقته وحدها همَّه، فقد شوهد في الشارع الثاني يقف أمام دكان صغير، يصرخ رافعًا سلاحه إلى الأعلى وهو ينظر إلى مكان محدد:
_ هيدي الدّكانة إلي.. مفهوم يا زعران!
وخلفه تقف العجوز صاحبة الدكان، مبتسمة شامخة برأسها سعيدة بتلك الضمانة.
كان يعمل دهانًا وفي صناعة الديكور؛ لكنه لم يجمع مالًا أبدًا... وقال لي صديق وهو يحدثني عن محمود بدهشة وإعجاب:
_ كنت أبحث عنه حين رأيته يمشي في الشارع مستعجلًا، وليس من السهل أن تلحق بمحمود حين يكون مستعجلاً، قلت له وأنا ألهث: أبو حسين بالمستشفى ونحنا لازم نجمع... وقبل أن أكمل كلامي كان قد مدّ يده إلى جيب بنطاله وأخرج كل ما فيها حتى ظهرت بطانة الجيب، ووضعها في يدي، دون أن يعدّها أو ينظر إليها، وأكمل سيره العجول. لم أذهب لسواه... المبلغ الذي دفعه محمود كان كافيًا، وعلمت أن محمود كان قد قبضه للتوّ أجرة ما قام به من عمل في الديكور، ورشة عمِل فيها عدة أيام.
«فتح الله» وسكانها الشيعة هم الأكثر استضعافًا وحرمانًا، وبؤر
55
44
الأوراق
الفساد تزداد اتساعًا، والفقراء عمومًا، ومن كل الطوائف، كانوا يشكّلون استثمارًا لا يتخلى عنه النافذون، وأصحاب السلطة المسلحة، والشكاوى تزداد على محمود، وتضيق به صدور النافذين والمسلحين، لكن محمود فعّال في منظمة التحرير، وأصدقاؤه من النافذين، أمثال «أبي الحديد» كانوا يسيطرون على المنطقة، والمسلحون من الأكراد والفلسطينيين وسواهم يحركهم العصب الطائفي والقومي، وإن كانوا ينتمون لأحزاب علمانية، ومن ضمنه هذا التجمع السكاني الذي يكرهونه، ويعتبرون ساكنيه مواطنين من الدرجة الثالثة، ووجود محمود محاميًا ومدافعًا قد شكَّل لهم مشكلة حقيقية.
يزداد الفساد يومًا بعد يوم، ويزداد معه الكره لمحمود ومنطقته التي تكاد تأمن شرهم بوجوده.
يحيكون الدسائس والمؤامرات ويغدرون، وتشتد الضغوط حتى من الكبار، وتزداد الأمور سوءًا وقبحًا، ومحمود يرى، وتتكشف أمامه أمورٌ ما كان ليصدِّقها من قبل، خيوط الفساد تمتد إلى أماكن أعمق مما كان يظن.
رأى كذبًا وغشًّا ومصالح فردية. انتهاز هنا واستغلال هناك، ضعف في الفكر والانتماء، جحود في مكان وكفر في آخر، ثم خيانة، خيانة لكل شيء؛ للناس، للفقراء، للإنسان، خيانة للثورة التي جاء من أجلها، خيانة وفسادٌ من الذين زعموا أنهم رفاق النضال، سارقو أحلامه وقاتلو الثورة.
56
45
الأوراق
يسير في الطرقات وفي صدره ألم مرير، ويرى على الجدران صورًا لفاسد يعرفه، قُتل وهو يحاول سرقة أحد المحلات، وتحت الصورة كتب بخط عريض: «الشهيد المناضل... استشهد وهو يقوم بواجبه الوطني... شهيد الوطن... شهيد فلسطين»
ثم بدأ التحول واضحًا في خط محمود، وبدأ يبتعد عن كل ذاك ويزداد اقترابًا من «نعمة حيدورة» وأمثاله، ثم شاهد أكثر وتألم أكثر وازداد اقترابًا حتى انقطع عن قديمه.
الانسحاب من الأحزاب لا يعني سوى الموت وقتها، لكنهم لم يقتلوه أو لم يستطيعوا قتله، استعملوا معه أساليب تنوعت ما بين الترهيب والترغيب، كانوا يعرضون عليه الكثير من السلطة والإغراءات المالية وسواها ليعود، كانوا يستعينون حتى بالنساء لمحاولة إرجاعه إلى ما كان عليه، كان واضحًا أنهم بحاجة إليه، وواضحًا مقدار أهمية محمود عندهم.
ويتعرض في الوقت نفسه لمضايقات شديدة، نفسية ومادية، وملاحقات يحاولون فيها إخافته، وحين يئسوا، ولم يستطيعوا مواجهته مباشرة، حاولوا الغدر به مرارًا لكنه كان يقظًا كعادته، ثم قرّروا قتله مهما كلّف الأمر، فبقاؤه خارجًا بكل ما يعرفه أمر غير مسموح به، فأعدّوا لاغتياله عدة وعددًا، وفي وسط شارع «فتح الله» قرب الجامع، قدِموا إليه من جهة الشارع، وكانت مواجهة بطوليّة لا مثيل
57
46
الأوراق
لها، أصيب خلالها في بطنه وانسحب المسلحون بجرحاهم والقتلى، وعلم محمود أنهم سيعودون مستغلين إصابته، عالجه الأصدقاء في مكان بعيد، وضغطت عليه العائلة والأهل والأصدقاء وألزموه بالسفر إلى أخيه في السعودية.
أعرف تمامًا ما أحدّثك عنه، فقد عايشت في تلك الفترة كل تلك التفاصيل، فأنا من جيل محمود، أسمع وأرى ما كان محمود يسمعه ويراه، وإن كنت في منطقة أخرى، وكأن المكان هو المكان، في التعصّب والظلم، في الزّيف والخيانة والفساد، وكنت عطشًا وجائعة روحي، أبحث عن واحتي وشجرة الظل، ركن أركن إليه وعين ماء، عن شيء ثابت أستطيع التمسك به وسط كل العاصفة، وكان لي ذلك كله حين انتقلت إلى فتح الله، وفي «فتح الله» عرفت «نعمة حيدورة» عن قرب، وكأني اكتشفت عالمي الذي أريد، هذا الرجل الملائكي المجبول بحب أهل البيت عرف كيف يأخذ بيدي وقلبي حتى بتُّ لا أفارقه إلا مكرها ولوقت قصير، أسكن إلى ظله وأشرب من ماء إيمانه الحلو. ذلك المؤمن الطاهر، لم أجد إيمانًا كإيمانه، كان في مكان لم أستطع أنا الارتقاء إليه رغم اقترابي، لكنه رفعني إلى مكان لم أكن لأصل إليه من دونه.
حدثني كثيرًا عن محمود، يحبه حبًا جمًّا، ويرى محمود مثالًا في القدرة على العطاء، وكم فقدَت «فتح الله» بغيابه، يحدثني عن محمود والشوق في عينيه، تفاصيل كثيرة عرفتها عن محمود منه،
58
47
شكر ودعوة
حتى بت أراه كما يراه، واضحًا حيًا في حركته الدائبة العجولة، في ابتسامته وفي غضبه، وكأنني كنت مع محمود طوال الوقت، وبتّ أشتاق إليه كما يشتاقه «نعمة».
تلك الأشهر الطويلة من الحرب كانت قاسية مريرة، وتزداد وحشية وقسوة كل يوم، عاصفة من فوضى السلاح تنهش الأرواح والأجساد والمباني، وحشٌ تفلّت من عقاله، و«فتح الله» تتمسك بفكر «الإمام السيد موسى الصدر»[1]، وتجاهد للبقاء عصيّة على الرغم من الإمكانات الضعيفة، وغارات الأحزاب والسلاح المتفلّت لا تتوقف. أنا وعصبة من الشباب مع «نعمة حيدورة» نقف في مواجهة هذه الغارات التي تتعاقب دون هوادة، ويذكر «نعمة» محمود وحاجتنا إليه في هذه العواصف، محمود في عين «نعمة» متراس وجدار صدّ... قاسية جدًا كانت تلك الأيام...
لن أتحدث في هذا طويلًا، لن أدخل في التفاصيل، ففي التفاصيل ألمٌ لا أريد استعادته. فاغفر لي يا صديقي فراري وأنا أركب قاطرة الاختصار الشديد.
[1] عالمٌ ومفكرٌ وسياسي، ولد في قم عام 1928م ونشأ فيها. تلقى علومه الدينية والحوزوية بين مدينتي قم والنجف الأشرف، وبعد سنوات انتقل إلى لبنان، وأقام في مدينة صور جنوب لبنان. فأسس لمجتمع مقاوم نشر فيه حس الانتماء والوطنية من خلال إنشاء حركة المحرومين وأفواج المقاومة اللبنانية (أمل). خطفه النظام الليبيّ البائد ورفيقيه محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين إثر زيارة له إلى ليبيا عام 1978م.
59
48
الأوراق
بأشد الاختصار: كانت فترة قاسية، قاسية جدًّا، واشتدت الهجمة الشرسة بعد ذلك واستشهد نعمة، وآه من وجع استشهاد نعمة!
بكيت على استشهاده، بكيت كثيرًا، وشعرت بفراغ لا يطاق، كان شوقي لـ»نعمة» مرًّا، لم أذق مرارة مثلها من قبل، وجع كسكين يفري قلبي حتى خلتني لن أستطيع البقاء، أيام قاهرة مرّت، وجاء في وسطها الخبر الجميل، كنسمة عليلة وسط الهجير والاختناق.
محمود قادم، الثائر قادم، لم يطق صبرًا... سمع باستشهاد ابن خالته... لم يمضِ على سفره سوى عام وبعض عام، لم يكن هذا فعل المهاجرين، ولم تتغير دواعي هجرته، بل ازداد الأمر سوءًا هنا. لقد قام من وجع وثورة، قام من فوره على غضب وجاء.
وأنا كنت في انتظاره، كصحراء متشققة تنظر إلى سماء ملبدة بالغيوم، حبست دموعي من أجله، وجمعت حبي وشوقي وملامح الحبيب «نعمة»، وصنعت منها رداء كي ألبسه في استقبال محمود.
حين اقترب موعد وصوله تمدّد الوقت، وانفتح باب لهفتي على مصراعيه، كنت كطفلٍ ينتظر هدية كبيرة مجهولة، بكل إرادته يريدها، بكل شغف الطفولة كنت أنتظر، وكلما اقترب الوقت ازداد طولًا، وجاء.
لم أمهله طويلًا ليرتاح، منحته ما استطعت من هذا الزمن المتطاول،
60
49
الأوراق
وذهبت إليه بأقدام أحاول فكّ ارتباطها بلهفتي كيما أستطيع السير باتزان، وفي طريقي إليه كنت أسمع:
_ محمود جاء
وكأن العيد جاء وضحكته في العيون، في عدم التصديق ودهشة الإجابة:
_ حقًّا؟! متى؟
محمود، حبيب المكان والجوار، الكل هنا يعرفه، شعرت بازدحام الحب، وأنا في وسط هذا الازدحام أبحث عن مكاني، وتسرّب إليّ الخوف من ضيق المساحة، وأنا أدافع عن حقي بمساحة أكبر في هذا الحب، لا أدري من أين جئت بهذا الحق وأنا أدخل منزلهم المتواضع عبر الدرج الضيق الطويل، وهناك من يسبقني على الدرجات، أفسح الطريق للنازلين من عنده، ولا يسبقني الصاعدون، كان المكان يغص بالزائرين ويغص بلهفتي لمرآه، وما إن خطوت خطوة عبر باب دارهم المفتوح حتى هالني ما اكتشفته، لا أدري كيف غاب ذلك عن ذهني طوال هذا الوقت. وقفت وأنا أردّد مذهولًا:
_ أنا لا أعرف محمود.
وقفت حائرًا، أبحث بين الوجوه عن وجه لم أره سابقًا، إلا في صور قديمة غير واضحة. عمن أبحث إذًا؟؟ من هو محمود بين كل هؤلاء الرجال؟!
61
50
الأوراق
نظرت في وجوه الجالسين والواقفين، البيت الصغير يغص بالزائرين وأنا حائر بين ارتباكي ولهفتي، أريد أن أرى محمود، هل أصرخ: من هو محمود بينكم؟.
أنقذني من ارتباكي رؤيتي لصديق لي وهو قريب لمحمود، كان يقف على الشرفة مع آخرين لكثرة الزوار، فتوجهت إليه مخترقًا الحضور من دون أن أتلفت، وصلت إلى صديقي وتنفست الصعداء، ألقيت عليه تحيتي، ووقفت بالقرب منه، كان يحدث رجلًا لا أعرفه، انتظرته لينهي حديثه. ورحت أشغل نفسي بالنظر خارج الشرفة، إلى الدرجات والشارع، وتمرّ الصور أمامي من دون أن تستقر في ذهني المشغول، ثم خفق قلبي بقوة، كأنه دق دقة واحدة عظيمة، وأنا أسمع صديقي يقول:
_ أهلا محمود.
نظرت مبهورًا إلى محمود، وقد جمدت الصدمة ملامحي، إنه فتى، صبيٌّ في عمر الزهور... وجهه ناعم طافح بالبراءة، لحيته وشارباه بالكاد خطّتا، جسده فقط هو الكبير، بصدره الواسع وعضلاته المفتولة.
كنت أعلم سنه، وأعلم أنه يصغرني بعامين على الأقل، ولقد رسمت له صورة في ذهني، وقد تشكلت كاملة بعد كل ما سمعته عنه من أبيه ومن «نعمة» ومن سواهما، صورة بدت راسخة لا تريد الاعتراف
62
51
الأوراق
نظرت في وجوه الجالسين والواقفين، البيت الصغير يغص بالزائرين وأنا حائر بين ارتباكي ولهفتي، أريد أن أرى محمود، هل أصرخ: من هو محمود بينكم؟.
أنقذني من ارتباكي رؤيتي لصديق لي وهو قريب لمحمود، كان يقف على الشرفة مع آخرين لكثرة الزوار، فتوجهت إليه مخترقًا الحضور من دون أن أتلفت، وصلت إلى صديقي وتنفست الصعداء، ألقيت عليه تحيتي، ووقفت بالقرب منه، كان يحدث رجلًا لا أعرفه، انتظرته لينهي حديثه. ورحت أشغل نفسي بالنظر خارج الشرفة، إلى الدرجات والشارع، وتمرّ الصور أمامي من دون أن تستقر في ذهني المشغول، ثم خفق قلبي بقوة، كأنه دق دقة واحدة عظيمة، وأنا أسمع صديقي يقول:
_ أهلا محمود.
نظرت مبهورًا إلى محمود، وقد جمدت الصدمة ملامحي، إنه فتى، صبيٌّ في عمر الزهور... وجهه ناعم طافح بالبراءة، لحيته وشارباه بالكاد خطّتا، جسده فقط هو الكبير، بصدره الواسع وعضلاته المفتولة.
كنت أعلم سنه، وأعلم أنه يصغرني بعامين على الأقل، ولقد رسمت له صورة في ذهني، وقد تشكلت كاملة بعد كل ما سمعته عنه من أبيه ومن «نعمة» ومن سواهما، صورة بدت راسخة لا تريد الاعتراف
62
51
الأوراق
بهذه الصورة الجديدة المغايرة والمختلفة كثيرًا، تزاحمها بشدّة، كأنها لا تريد الاعتراف بهذا البديل الواقعي. أن ترسم صورة في الذهن لشخص لم تره أمرٌ باطل باطل.
ربما لأنه كان كبيرًا في داخلي، كبيرًا جدًّا... وهذا الوجه المحبّب هو وجه فتى، وحدها عيناه اقتربتا من صورة الخيال، عينان واسعتان تبتسمان بشدّة، وأنا كنت غارقًا فيهما، حين وصلني صوت صديقي وهو يعرّف عني، مدّ محمود يده. لَكَم كانت دافئةً وقويَّة، ووضع يده الثانية على كتفي، وبين أدبه الجم وابتسامته الطيبة سمعت صوته ذا الرّنة الخاصة يرحّب بي في اهتمام بالغ، وبدافع من طبع غاية في الأدب والاحترام:
_ أهلًا وسهلًا... هذا شرفٌ كبير...
لا أدري ماذا قلت حينها. وهل تكلّمت أصلًا، أم تمتمت بكلمات بلا حروف، لكن ما حدث بعد ذلك هو الأهم.
سمعت كلمات الصديق وهي تدخل عميقة إلى مسامعي، من خلف ارتباكي وذهولي، يحدث محمود عني في تعريف إضافي:
_ أقرب الناس للشهيد نعمة.
كنت ما أزال غارقًا في وجه محمود عند سماعه لتلك الكلمات، فشاهدت ذلك التغيير المتسارع، لقد تأثّرت ملامح محمود بشدّة، لقد حنّت ولانت حتى كأنها تئن، مدّ ذراعيه وقربني إليه محتضنًا
63
52
الأوراق
إياي، وفي حضنه لا أدري ما الذي حدث لي، لقد تفلت شيء ما في داخلي دفعني إلى البكاء، كأنني كنت أنتظر حضنه لأبكي دموعًا حارّة حبيسة لنعمة حيدورة، بكيت وبكى، ورأيت دموعًا غزيرة في عينيه، نظر إليّ من بين دموعه مطولًا، سابحًا بملامح وجهي المبلل بالدمع، كأنه أراد أن يعيد النظر إلى وجهي من خلال نعمة حيدورة هذه المرة، ثم أعاد احتضاني من جديد.
علمت حينها كيف يكون الشهيد حيًّا، حاضرًا في الدّمع والاحتضان، حاضرًا بين رجلين يلتقيان لأول مرة وكأنهما عاشا كامل العمر معًا.
جلسنا متقاربين، لم نتحدث، ولم تغادر ذراعه كتفي، يرحب بهذا ويودّع ذاك، ثم يعود إليّ مرحبًا، وتعود ذراعه إلى كتفي، ما فارقني إلا قليلًا، ولم نفترق بعد ذلك إلا قليلًا.
64
53
الأوراق
خرجت معه في المرة الأولى، أخذته إلى حيث يريد، كان مدهوشًا طوال الوقت، فالتغيير كبير، أكبر من غيابه، لم يكن التغيير في البناء الخارجي هو الذي أذهله، بل التغيير في البناء النفسي والمعنوي، في الرجال نوعًا وكمًّا، في تلامذة الشهيد نعمة وأمثاله، كلما عرّفته على مجموعة جديدة خرج من عندها سعيدًا مذهولًا، والضحكة في زوايا عينيه تزداد وضوحًا، وكان هذا الشعور متبادلًا بينه وبينهم، فالجميع كان يعرفه، بعضهم التقى به قبل سفره، ومن لم يلتقِ به قال عند اللقاء:
_ آه الوحش... ومن لا يعرف الوحش...
كانت سعادة محمود أكبر من أن يخفيها، يهزّ رأسه فرحًا، يزم شفتيه ويرفع حاجبيه بإعجاب شديد، لقد وجد الوضع مختلفًا تمامًا عما تركه، الأرض أكثر اخضرارًا وأقل وحشة، وحماس الشباب في تدفّق واضح الأثر، وجد مجتمعًا متدينًا، وشعلة الثورة تعتمل في القلوب، قبس وهاج من الثورة الإسلامية في إيران.
وما أسرع ما حمل سلاحه وانتظم إلى مجموعاتنا الصغيرة... لا
65
54
الأوراق
ليس هكذا، بل ما أسرع ما انضممنا إليه. كنا سعداء به جميعًا، ودون أن ندري، أو يدري هو، ودونما قصد كان يمارس القيادة، لا عن عمد ولا عن سابق تصميم، هكذا كما يأخذ النهر مجراه، أفسحنا له مكان الصدارة من دون أمر تنظيمي أو ترتيبات.
لم يكن أكبرنا، فأنا أكبر منه بالسن وبالترتيب التنظيمي، لكننا مع كل خطوة كنا نراه يسبقنا، فنجد أنفسنا بجانبه أو خلفه.
الفارق كان واضحًا، لم يكن تفوّقه محصورًا بأمر محدد، قد يكون في خبرته العسكرية وحسن تدريبه، أو في نشاطه المتدفّق وسرعة حركته، في المرونة والقوّة الجسدية اللافتة، أو ربما بذكائه وبصيرته النافذة التي بها يرى ما لا يراه سواه، ذلك الحماس أو هذا الذي ينبض في صدره كان مختلفًا، أو في هذا كلّه وكأنه خلق ليكون كذلك.
الأيام تمرّ سريعًا، والأحزاب تزداد شراسة في مواجهتنا كحالة إسلامية وليدة، يريدون وأدها في المهد، ينظرون إلينا كخطر يهدّد وجودهم، حركة تتفرد في إيمان لم يعرفوه، الإخلاص والصدق، والتفاف المستضعفين حولنا، بساط يسحب من تحت أقدامهم.
ومما زادهم شراسة وتصميمًا على القضاء علينا، علامتان واضحتان في هذا الصراع؛ «السيد موسى الصدر» وحضوره المتنامي بعد اختطافه من قبل «معمر القذافي»، أرادوا إطفاء جذوة نوره، فكانوا كمن يطفئون النار بالزيت، وكذلك فعل حاكم العراق بقتله «السيد
66
55
الأوراق
محمد باقر الصدر»[1]، والله متمُّ نوره...
عجيبة فريدة تلك الحالة الإسلامية وهي تنمو، كمصداق لكلمات الله. حدثان أخذا الصراع إلى مكانه العالي، وكانت الأحزاب تعمل بالتمويل الخارجي، ونظاما ليبيا والعراق هما الممول الأساس للكثير من تلك الأحزاب، وهذه الحركة الإسلامية الوليدة تنتمي إلى هذين السيّدين وإلى الثورة في إيران، تلك الثورة التي أخافت الأنظمة العربية، وبدأت تستشعر معها حرارة النار. والخوف من عدوى الثورة، جعلهم يصدرون الأوامر بالحسم.
والغريب الذي كان يحدث هو أننا كنا نكبر ونزداد قوة وحضورًا بعد كل هجمة، نحن الحلقة الأضعف في هذا الصراع، المدافعون بلا إمكانات، كأن تلك الهجمات الشّرسة المتتابعة لم تكن سوى غذاء يومي يزيدنا عددًا وقوة، لم يجد أحد تفسيرًا لما يحدث، أعدادنا القليلة جدًّا، والإمكانات المعدومة، إذا ما قورنت بأعداد الأحزاب التي اجتمعت ضدّنا بكل إمكاناتها، حتى أنا كنت مدهوشًا لما يحدث، فالمنطق العسكري يقول غير ذلك، لم نجد له تفسيرًا سوى ما كان يردّده محمود: «ويمكرون ويمكر الله».
[1] مرجع ديني وفيلسوف كبير، مجدّد في الفقه والأصول، من مواليد الكاظمية - العراق 1935م قتله النظام العراقي الصدامي مع أخته بنت الهدى سنة 1980م.
67
56
الأوراق
أجل يا صديقي هم أرادوا والله أراد، هذا هو التفسير الوحيد لكل ما كان يحدث.
كلما اشتدت الهجمات اشتدّ ساعدنا وكثر التعاطف، واتسع الانتشار، حتى أصبح لنا أماكن ومناطق كاملة النفوذ، استدعى ذلك منهم قرارًا حاسمًا بإسقاط وجودنا المتنامي بكل الوسائل، وبدعم من دول كثيرة على رأسها العراق وليبيا، أعدوا العدة واستنفروا الطاقات لإسقاط الأماكن التي تحت سلطتنا، وأشدّها كان على فتح الله، تلك المنطقة الصغيرة بشارعها الضيّق، لقد تعرّضت لضغط كبير، ربّما لموقعها الجغرافي، فهي كانت في القلب، شوكة في القلب، في وسط القلب، فوقها هناك شارع محمد خالد حيث سيطرت الأحزاب لا سيما «حزب البعث العراقي»، والكثير من السلاح المتفلت.
في إحدى المعارك الشرسة التي أرادت الأحزاب من خلالها وضع النقاط على الحروف كما قالوا، وإحدى النقاط وأولها نقطة صغيرة، كما يرونها، هي فتح الله، وكان لشارع فتح الله مدخلان، ومن كلا المدخلين شنوا هجومًا مباغتًا، وكان الضغط شديدًا، ولم يستطع المهاجمون التقدم أبدًا، وكأنهم أمام جدار، لم يصدق أحد ذاك الذي كان يحدث، لا تفسير له سوى ما كان يقوله محمود عن إرادة الله، وإلا كيف يكون الحديث بالمنطق العسكري عن هجوم مباغت أعدّ له مسبقًا وبكتمان، وفي المقابل لم يكن سوى محمود
68
57
الأوراق
مع اثنين من الشباب فقط، ثلاثة كانوا، والهجوم على المدخلين، أعدّ لهذه «الكماشة» أن تكون صاعقة سريعة، على ذلك المدخل، واشتد الهجوم حيث كان محمود وحيدًا... لقد وضع الشابين على المدخل الثاني، بعد أن أعدّ لهما خطة دفاعية واضحة، وكان الهجوم أشدّ على المدخل الأوسع حيث محمود، لكنه كان مثل كتيبة بل كأنه كان جيشًا... كان قادرًا ويشبه المعجزة... لقد تحدث من شاهد ذلك الهجوم... لم يصدقوا أنه كان وحيدًا هناك، كأن هناك سحرًا أو معجزة.
بعد مشاركاتي العديدة مع محمود صرت أفهم تلك المعركة، وذلك السحر، لقد كان مميزًا بهذا، قادرًا أن يوهم المهاجمين أن هناك عشرات المقاتلين يتصدون لهم، يهزمهم معنويًّا قبل أن يهزمهم عسكريًّا ويتحرك وكأنه مجموعة مقاتلين... وله طريقة فريدة في كسر شوكتهم، يبحث خلال مطاردتهم، وفي خضم المواجهة عن محرّكهم وقائدهم، من طريقة تحركهم، ومن خلال بعض ردود الفعل، وبحسّه العسكري الفائق كان يجده ويعرف مكانه، وبالدّقة المعروفة عنه يرديه صريعًا، ويستغل الارتباك الحاصل بحركته السريعة تلك فيشتّتهم، هذا ما حدث في ذلك الهجوم، وهزموا هزيمة نكراء، وفي ظنّهم أن عشرات المسلحين كانوا يدافعون على المدخلين.
لمحمود أساليب عديدة، ومع الوقت صرت أفهم منطقه العسكري
69
58
الأوراق
وأجاريه في كل تفاصيله. كنا أول خليّة حقيقية تشكلت في حركة أمل، أول نواة واضحة في تلك المنطقة عندنا، أول المعارك الكبرى في المنطقة الغربية من بيروت بين حركة أمل والحركة الوطنية خضناها نحن، وشاركت معه في أول معركة كبيرة، والثانية والثالثة، واشتدّت المعارك وتوالت بعد ذلك، وكان حضوره يشتد وضوحًا وتأثيرًا مع مرور الوقت. والجو كان مشحونًا بشدة في بعض الفترات، وفي بداية الهجمة على وجه الخصوص، قتال وحواجز وحصار، كان الجوّ ضاغطًا بشكل يومي، ففي كل يوم كان هناك هجوم على أناس نعرفهم، ومناطق ينتسب شبابها إلينا، وفي أماكن مختلفة.
كنا في المنطقة ثلاثين شخصًا في تلك الفترة، موزعين على تلك الأماكن المتقاربة في البناء والوجدان، ومحمود بيننا، قائد بلا تنصيب، نراه كيف يجازف ويقتحم ويطلق النار، يرمي القنابل، يقطع الشارع المستهدف كالعاصفة، كيف تستطيع أن تتردد أو تجبن مع وجود محمود؟! كنا نرى أنفسنا غير ما نحن عليه، غير ما نعرفه عن أنفسنا، كأن جسرًا يمتد من قلبه إلى قلوبنا، جسرًا يتدفق عليه ذلك الإحساس الفائق بالشجاعة والثقة.
في كل المعارك كنا جنبًا إلى جنب، اختبرناه ونحن نراه بأم العين، مميزًا وفريدًا، لا يهاب الموت أبدًا، بل هو لا يعرف الخوف، هو الذي جعل الأحزاب تهاب «فتح الله» وجوارها، الخوف شيء غير موجود في خاطر محمود ولا يخطر على بال أبدًا.
70
59
الأوراق
اسمح لي يا صديقي أن أتوقف هنا، أريد أن أنظر إلى الصورة التي تشكّلت في ذهنك لمحمود، أنا واثق يا صديقي أنك قد أخذتها إلى مكان آخر، فقد حدث لي ذلك من قبل، كما رسمت أنا لمحمود صورة في خيالي قبل أن ألتقيه، أريد أن أعيد الصورة إلى مكانها في ذهنك، صورة قريبة من الواقع، لكم هو صعب أن تضع محمود في مكانه، سأكتفي بأن أذكّرك بأن محمود، في كل هذا، فتى لم يصل إلى الثامنة عشرة بعد، ولم تتضح بعد لحيته وشارباه، هذا ما كنت أريد أن أقوله قبل أن أعود للحديث عنه، لأشعر أنك تتابعني بشكل صحيح.
من أبرز صفاته الشخصية أنه مرح، يحب المزاح، طيب القلب حلو الحديث، وقد تجد هذا غريبًا أيضا.
كنا ستة أو سبعة، في مجموعة مصغّرة، كثيرة التواصل، أعمارنا بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، كان بعضنا يحمل سلاحًا أطول منه، وصحبة محمود لطيفة جدًّا ومؤنسة، كنا نفرّ منه حين يستعمل يده في المزاح، ولا نستطيع مجاراته جسديًّا. هو لم يكن أكبرنا سنّا، تعلّقنا به وبصحبته. لقد جمعتنا الهجمة ضدّنا من قبل الأحزاب واعتدائها الشرس اليومي، من أجل ذلك كان التواصل مع محمود تواصلًا يوميًّا، وحين يكون التواصل يوميّا تصبح العلاقة حميمية، تشبه العلاقة بينك وبين نفسك، يصبح الفراق صعبًا؛ إذا غاب لساعات من أجل شأن خاص كنا نفتقده جميعنا وأنا على وجه الخصوص.
71
60
الأوراق
كنا كعائلة صغيرة، نشرب الشاي معًا، وفي السهرات الطويلة، التي تكاد تكون يومية، عائلة واحدة، بيت واحد، أي بيت من بيوتنا نستطيع الدخول إليه دونما حرج، نأكل ونشرب كأنه منزلنا.
محمود في تلك الفترة كان واضح الظهور، كأنه اكتمل، أو كأنه استقر في مكان، كان قد تبلور فكره الديني، وهدأت روحه على مرفأ أوت إليه أفكار وانتظمت، وبات أقدر من السابق على العطاء الفذّ، أصبح يعلم إلى أين تتجه بوصلة قلبه، كأنه نهر رفعت عن مجراه الصخور والعوائق، استقرّ إلى الحركة الإسلامية الوليدة كما يستقر المهاجر... أصبح من الثورة الإسلامية في إيران ولها. بات يعرف من هو أبو الحب الذي يتربع على عرش قلبه ووجدانه، بات يعرف قائده ويذوب في طاعته، وترى ذلك في عينيه كلما حضرت سيرة الإمام الخميني، أو جاء اسمه.
في تلك الفترة العزيزة من زمن البدايات، اتضح لمحمود ولنا فيها الدّرب، أترى يا صديقي حين تسير على هدى وترى كلّ شيء، كيف تستطيع قطع المسافات في طريق واضح جليّ، طريقنا كان كذلك، وإن تميّز بقلّة سالكيه، ولكنّه نيّرٌ إلى حدٍّ بعيد... واضح لا يعتريه غموض أو شكّ... تلك الشموس الثلاث أضاءت لنا حتى جوانب الدّرب وزواياه... حسموا بوجودهم خياراتنا، كانت الدّروب مظلمة قبلهم والأفق غائمًا، يكتنفه ضباب شديد، ثم جاءوا، أشرقوا من
72
61
الأوراق
كلّ الجهات، صدر لبنان وصدر العراق، والإمام الخميني، فانطلقنا قاهرين لا نخاف لومة لائم ولا وحشة طريق، ما كان ينقصنا سوى هذا الوضوح ليتدفق مكنوننا المقدس.
أتَراني أبالغ يا صديقي؟! لو كنت تدري كم كان الظلام دامسًا قبلهم، آه... ما أشدّ حلكته، لكم تعذّبنا أنا ومحمود وكلّ ذاك الجيل في زمن البدايات، جيلكم لن يستطيع أن يعرف قيمة تلك الشموس، مثَلكم كمَثَل الصحيح، وهل يعرف الصحيح قيمة العافية؟
محمود كان أكثرنا أنسًا بتلك الشموس، بالإمام الخميني على وجه التحديد، فتلك الشمس كانت حاضرة بكل نورها، الإمام الخميني يتابع ويعلّم مثل نبي، إنه إمام زمن البدايات.
ثقافة الولاية التقطنا صورها الأولى من محمود، أبجديتها الوليدة، أحرفها الأولى، فهي جرت في عروقه مجرى الدم، يتنفسها مع كل شهيق وزفير، عندما يسمع أحدهم يقول: (الخميني). هكذا خالية، يُستفز، تتغير ملامحه، ويقف عاقدًا حاجبيه وقد اتسعت عيناه غضبًا: الإمام الخميني... قل: الإمام الخميني... هذا إمامنا، سيدنا، ولي أمرنا. يقول نعم وبكل وضوح إنه يطيعه طاعة مطلقة، راية الإمام المهدي، راية الإسلام المحمدي الأصيل إمامه يحملها، وهو خلفه يخفق قلبه كما الراية، لا يعتريه شكّ ولا لجزء من الثانية. منه تعلمنا الثورة، الثورة الوهاجة الموصولة -كما كان يقول- بثورة الإسلام في إيران،
73
62
الأوراق
بحبل من نور يراها موصولة، كحبل السرّة، كما يتصل الجنين بأمه، يأخذ منها كل شيء، حتى وجيب القلب، الطعم واللون والرائحة. هكذا كان محمود يراها، ويرى إمامه قائدها وسيد قلبه.
اتضح الدرب، ومحمود علامة واضحة على ذاك الدرب، يراه كل من كان يسير هناك، خافقًا عاليًا... كان يتنقل من محور إلى آخر، ومن متراس إلى آخر، مربوط القلب، عاشقًا. لقد تدفّق محمود كالسّيل... كلُّ صخور الشّك زالت، نهر عرف طريقه فسعى إلى مصبِّه مستعجلاً.
ظلت المواجهات مع الأحزاب قائمة حتى بعد أن يئسوا من إسقاطنا، وإن بدت الوتيرة أخفّ والهجمة أقل ثقلًا، وكنا أكثر قوة وقدرة على الدّفاع مع محمود.
إن كنت تريد محمود فلا بأس عليك، ستجده حتمًا، وكأن محمود في كل مكان!! أو كأنه يحمل معه جهازه الطنّان البالغ الاستجابة في إرساله والاستقبال قبل اختراع الهاتف المحمول.
إن احتجته في الجانب العسكري لا مبرر للسؤال عنه، كيف تسأل وهو هناك، لا تحتاج للبحث، فهو أمامك أو حولك، في قلب معركة الدّفاع هو رمحها وترسها وقطب رحاها.
معركة دفاع لا ندري أين ومتى وكيف تبدأ، ولأيام ليست حربًا كلها، وإن كنّا في جهوزية دائمًا ومشغولين للاستعداد لأيّ هجوم
74
63
الأوراق
مباغت، لكنها أوقات سلم، ومحمود لا يهدأ، لا معنى أن ترتاح في السّلم، وأن لا يكون عليك مهام، أن لا تكون موجودًا، الراحة موت عند محمود، ومحمود حيٌّ بكل معاني الحياة وألوانها، ولأوقات الهدوء الأمني لون مختلف، درب آخر، طريق العمل الثقافي والاجتماعي مفتوح دائمًا أمام خطوات محمود الواسعة كما في الطريق العسكري، خطان متقاربان متوازيان ويلتقيان.
بل كان يركّز على الجوانب الثقافية والعقائدية أكثر من تركيزه على الجانب العسكري، فالجانب العسكري لم يكن سوى دفاع عن النفس، نتجنب اللجوء إليه ما استطعنا، الهم الأول هو الجانب التربوي، فهو عطش وجوع.
هناك على مقربة مسجد جمعية الإرشاد مركز ثقافي أسميناه المكتبة، وهو عبارة عن شقة متواضعة، جعلناها مركزًا نجتمع فيه كلّ يوم تقريبًا، وذلك قبل العام 1982م، أي خلال السنوات من أواخر السبعينيات إلى الثمانين وما بعدها، وفي المركز الكثير من النشاطات الكشفية والثقافية.
هذا المركز كان بيت محمود الثاني، بل الصحيح أن هذا المركز كان بيته الأول، ليس سكنًا، ليس لراحة الجسد وسكنه كما البيوت، بل بيت حياته، حياة روحه، بيت عطائه المتدفق، يدخله سعيدًا ويهتم بكل شاردة وواردة فيه.
75
64
الأوراق
كم من مرة أتيت إلى المركز ورأيت محمود مستغلًا خلوّه وفراغ الأنشطة فيه، وقد رفع أكمام قميصه وبنطاله، وحبّات العرق تلمع فوق جبهته، وخصلات من شعره الأسود تستقرّ مبتلّة فوقها، ينظف المركز بالماء والصابون، بهمّة سريعة عالية، يسابق الزّمن قبل أن يدخل أحد إلى المركز يشغله، وكنت أنا الذي لا أجيد مثل هذا العمل ولا أحبه، ولكنني لفرط خجلي من محمود أدعي أن ذلك يستهويني ليسمح لي بمساعدته، وإذا ما انتهينا ووقفت ألتقط أنفاسي شكرًا لله على الخلاص، أتلفت إلى محمود كيما أستريح قربه، أجده قد باشر في تنظيف زجاج النوافذ، المركز ما زال فارغًا وعليه أن يستغلّ الوقت، أذهب لمساعدته وأنا أحبس تأفّفي في صدري.
للجميع مشاغلهم الدنيويّة، في العائلة والعمل، وأمور الرزق، ومشاغل كثيرة لا تنتهي، أما هو.. وذلك شيء عجيب، كان مثلنا لم يكن ميسور الحال، وكانت لديه مشاكله أيضًا، لكنها لم تكن لتشغله، العمل الإسلامي هو ما كان يشغله، ما نقوم به هو همّه، ليست مسألة أولويات، الجهاد أولًا وثانيًا وعاشرًا لديه، والجهاد عنده ليس عسكريًّا فحسب، إنما هو ثقافيٌّ واجتماعيٌّ وكشفيٌّ أيضًا... حتى تنظيف المركز كان جهادًا عنده، كل ذاك الجهاد كان أولًا، ومحمود يقدّم عليه كل شيء عداه، لذلك كل ما طلبته تجده، ليس حاضرًا فقط، بل تجده فعّالاً، مبادرًا ومبتكرًا أيضًا.
وقعنا مرّة في مشكلة أربكتنا إرباكًا شديدًا؛ كانت الرحلة الكشفيّة
75
65
الأوراق
إلى قرية كيفون، وقد أتممنا كل شيء والكشافة جاهزون وفي الانتظار، والوقت يضيق، حين أخبرنا المسؤول عن التجهيز أن الباص لن يأتي، كانت لدينا بدائل وأمامنا باصات نستأجرها في مثل هذه الحالات، لكننا لم نوفّق ولم نجد حيث نعرف، في منطقتنا في بيروت الغربية، وفي ساقية الجنزير، المشكلة لم تكن متوقعة، وأن تغلق هكذا أمامنا كلّ السبل، وتنقطع بنا السبل، ونفقد الحيلة. الكشافة ينتشرون في الباحة، عدة التخييم والمتاع على الأرض وكذلك مصداقيتنا كانت على الأرض، كنا قد فقدنا الأمل حين دخل محمود، لا ندري لماذا تعلّقنا به واتجهنا إليه جميعًا، وفي وجوهنا أملٌ مستعاد لا تبرير له، فلا علاقة لمحمود في هذا لا من قريب ولا من بعيد، ولم يوكل بمثل هذه المهمة من قبل، فهي تحتاج إلى معرفة خاصة وخبرة بأماكن «الباصات» ومن يعمل في هذا المضمار، ومن له معرفة وخبرة طويلة لم يجد حلًّا، فماذا يستطيع هو أن يفعل، لكنه محمود وذلك الرجاء المتعلق به دائمًا، ودهشنا من ردّة فعله السريعة، وهو يقول:
_ تُحلّ إن شاء الله
_ كيف؟!
_ لا عليكم.
أخذ بيد المسؤول عن التجهيز وذهب معه إلى الضاحية، إلى أين؟! إلى الضاحية!!
77
66
الأوراق
إلى حيث لا توجد باصات للتأجير، ولكنني ولسبب لا أعرفه كنت مطمئنًا أنّ الحلّ قادم لأن محمود قد تدخّل، وإن لم يغادرني الاستغراب، إلا أن جزءًا مني يسكن ويركن إلى هذا الأمر الحتميّ. حين وصل إلى الضاحية توجّه من فوره إلى طريق خلفيّة، ومسؤول التجهيز خلفه صامت يحاول جاهدًا اللحاق بخطوات محمود السريعة، يصعد خلفه لاهثًا، ويقف على باب إحدى الشقق يلتقط أنفاسه. طرق محمود باب رجل يعرفه، رجل يعمل في نقل موظفين إلى أماكن عملهم، أخذه محمود جانبًا، لم يستغرق الأمر غير دقائق لا تحسب، سريعًا عادا، محمود وقدرته على الإقناع: اليوم عطلة... الأجر والثواب والأجرة... نزهة في يوم صحو جميل. فيبدأ الرفض بالانسحاب من ملامح الرجل، ثم ابتسامة محمود، ويد على الكتف، ولمسة مودّة على الخد، ويتخلّى الرجل عن يوم العطلة ويعمل إكرامًا لمحمود. عاد إلينا سريعًا بباص جيّد، ودخل الباحة وهو يطلق نفيره وسط دهشتنا وفرح الكشافة.
هذا هو، ولطالما كان يذهلني، على الرغم من وجود ذلك الجزء مني الذي كان يكفّ عن القلق فور ظهور محمود، وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من كلّ التجارب لا أكف عن الدّهشة والتساؤل: لماذا لسنا كمحمود؟! كأن محمود يعرف نافذة سحرية لا نراها، بابًا على المستحيل، يمدّ يده ويقطف زهرة الحل.
78
67
الأوراق
يغلق أي نقص في أي مكان. لقد تعلم الموسيقى الكشفية وأصبح بارعًا فيها لأنها كانت حاجة، أي نقص كان يعتبر نفسه المعني وحده وعليه أن يضيفه لقائمة جهاده.. وأظل دومًا أتساءل: من أين يأتي بكل هذا؟ بكل تلك القدرات وتلك الطاقة؟!!.. وتبقى الدهشة، ونظلّ نرى أنفسنا قصارًا أمام طول محمود، تلاميذ يتبعون أستاذهم دون أن نتخلى عن الاستغراب والإعجاب، وفي كل مرة أتساءل: لماذا هو مختلف؟!
قليلاً ما تراه هادئًا ساكنًا، وهو في قمة حركته الدؤوب السريعة تلك تراه ضاحكًا، سريع البديهة، يمازح هذا ويلاحق ذاك بنكتة حلوة، ونهرب من قبضة يده القوية إن استطعنا إلى ذلك سبيلًا. محمود السريع البديهة، السريع الحركة هو نفسه سريع التأثر، في ردّة فعله سرعة الغضب أمام أي سوء يراه، شديد الانفعال حين يرى ظلمًا هنا أو قبحًا هناك، هو نفسه في الجانب الآخر شديد التأثر، كأن جوارحه مصنوعة من رقائق بالغة الحساسية، أو كأن قلبه مكشوف بلا قفص صدري، لا دروع ولا حواجز من التي هي عندي أنا الذي أحسب لكل شيء حسابه. محمود القوي هو نفسه في الجانب الآخر، في شخصية محمود شيء آخر يبهرني وهو رقته... تلك الرقّة المتناهية، أجل، رقته... لا تعجب، كنت أرى تلك الرقة في مشاهد لا تعد ولا تحصى وتظل تبهرني لشدّتها، رقة مبالغٌ فيها، أو هي غريبة في مكانها، في محمود القوي، وكيف أن تلك الشخصية القوية تتلاشى وتذوب،
79
68
الأوراق
كأن لديه حساسية خاصة، تسبب له ضعفًا أو انهزامًا، هذا الانهزام والتلاشي كان واضحًا في محمود أمام الفقراء وأمام ذوي الحاجات الخاصة، ليس عطفًا أو إشفاقًا، إنه أكثر من ذلك بكثير، كأنّه كان يريد بكل جوارحه أن يكون منهم، أو أنهم أعلى شأنًا منه، كأنه يراهم في مكان يحب أن يكون فيه، فهو يجالس بائع القهوة المتجول وترى السعادة واضحة في عينيه، ينزل عنه حمولته ويجلس معه على الرصيف، يطيل الحديث وفي نبرة صوته وملامحه احترام بالغ، يمسح أنف هذا الولد المسحوق فقرًا، ويساعد ذاك في لبس حذائه، هذا الاحترام الشديد الذي تراه في عينيه لهؤلاء الناس، كأنهم سادته وأصحاب الفضل عليه، كأنه يراهم في مقام أعلى مما يستطيع هو الوصول إليه.
وفي أماكن أخرى كنت أرى تلك الرّقة فيه، واضحة جلية، غريبة في تجاورها مع الشخصية القوية الفذّة التي لا تعرف الهزيمة.
كنت أراه في مجالس العزاء، ماذا أستطيع أن أقول؟ كأني أرى طفلًا يبكي أهله في صمت، علاقته بأهل البيت لم تكن كما نعرف، كلنا نتأثر ويحزننا مصابهم، على محمود كان الأثر أكثر وضوحًا، تراه في وجهه كلّما ذكروا، وكأن الأمر مربوط إلى قلبه بوترٍ مشدود. يقرأ القران كمن يدخل إلى صفحاته ويذوب بين الحروف، تأثره الشديد بالدعاء ودموعه، كثير السجود... حتى أخاله يغفو ساجدًا أو يغيب.
80
69
الأوراق
قليل غيابه، إن استأخرته تجده في الجامع، هناك فقط ينسى نفسه وقد يتأخر، تجده في زاوية الجامع ساجدًا، تسمع أنينه الخافت، يبكي ويتوسل، كم يشتد رجاؤك حين تطلب أمرًا أكبر مما تستحق؟؟ كذلك كان محمود في عبادته، كأنه يتوسل أمرًا يراه أكبر من استحقاقه. كنت أقف أمام ذلك ذاهلاً تتزاحم الأسئلة في ذهني أنْ: علام وكيف؟! أي روح تلك التي بين جنبيه؟! كيف يستطيع الشعور بالتقصير وهو أكثرنا عطاء؟ بل يسبقنا بمسافة لا نستطيع معها حساب الفارق.
لم أكن أستطيع في كل هذا مجاراته أو حتى الاقتراب مما هو فيه، ليس أمامي سوى الذهول والأسئلة، ثم الرضوخ لفكرة أنه في مكان مختلف، وأنه أرقى مما أعرف بكثير، كنت أنتظره حتى يرفع إليّ وجهًا اغتسل بالدّمع، وقطرات من دمعه متروكة في مكان السجود.
في المركز أنشطة متنوعة، وعمل ثقافي مكثفٌ، وهناك لجان، ومجموعات صغيرة أخرى غير حركة أمل تتواجد في المركز وتستعين بمحمود. حركة أمل في وقتها كانت عنوانًا عريضًا، مضافًا إليه بعض التجمعات الإسلامية، طلابية وأهلية، لكنها جميعًا كانت تحت هذه الهوية، أي الحالة الإسلامية المتدينة الموالية للثورة، ولأنها كذلك، كانت تنضمّ إلى قلب محمود، يفتح لها باب حبه على مصراعيه، محمود لها عنصر فعال، وعضو ناشط ثقافي واجتماعي وعسكري.
81
70
الأوراق
وهذه المكتبة كما كنا نسميها، كانت مركزًا لهذه اللجان الإسلامية العاملة تنطلق منها كلُّ النشاطات الثقافية والدينية من أدعية وجلسات تثقيف ودروس، فقه وعقيدة وتفسير قرآن، سلوك وسيرة وأخلاق، و، و... ومحمود تلميذ نجيب، لا، بل هو عاشق ولِهٌ، مشتاق راغب، كرحالة في صحراء وجد بعد جهدٍ عين ماء، يُقبِل فرِحًا، لا يترك درسًا ما استطاع. كانت هناك شخصيات رئيسية وعلماء يتناوبون في المركز، وكتب وحلقات. كان هذا المركز في المصيطبة كمكتبة ثقافية وهناك الجامع «مسجد جمعية الإرشاد» وجلسات أسبوعية لا يغيب عنها محمود. كان جزءًا من هذا كله أو هو في قلبه، ترتفع وتيرة هذا النشاط وتتغير تبعًا للحالة الأمنية وقتها.
محمود، هذا المقاتل الشرس يريد أن يعرف، يرى في المعرفة بندقيته الثانية، يحملهما معًا، العسكر والثقافة، وكأنما يتنافسان عليه، وهو يستجيب لهذا التنافس رغم الصعوبات، وكأنه لكليهما معًا، كاملاً لكل واحدة منهما، يحاول بلا نقص.
افتقدته مرة، وكان الدّرس قد بدأ منذ دقائق، وتذكّرت أن منطقة قريبة طلبت منه المساعدة في مواجهة اعتداء عسكري، دخلت إلى قاعة الدرس وقد هيأت نفسي لأشرح له الدرس في وقت لاحق، وفي الدقائق الأولى من الدرس وجدته يدفعني ويحشر جسده قربي، ورائحة البارود وهو يلتصق بي أحبّ إلي من عطور الدنيا.
82
71
الأوراق
_ وسّع.. آخذ المطرح كلو.
أفسحت له مكانًا وأنا أبتسم سعيدًا إذ لا أنس بلا محمود، وقلت:
_ شو؟
أجاب باختصار المشغول وهو ينظر إلى حيث الشيخ، وقد تفتحت كلّ جوارحه استعدادًا للاستماع إلى الدّرس:
_ مشي الحال.
أنا أحبُ العلم، والمعرفة تعنيني كثيرًا، لكن محمود وحبه للمعرفة شيء آخر، هو شغف وزيادة.
جاءني يومًا على عجل، وكمن اكتشف كنزًا:
_ هناك دورة ثقافية في...
قاطعته مستغربًا وأنا أعلم بمشاغله:
_ بدك تروح جد؟!!!
_ طبعًا، العلم نور... أو بدك ضلّني أعمى مثلك.
ضحكت وفي داخلي الحقيقة واضحة: لو قورن مسعاي الى المعرفة بمسعى محمود لبدا واضحاً عماي أمام بصيرة محمود.
من أواخر السبعينيات وحتى بداية الثمانين كان له دور واضح
83
72
الأوراق
في النشاطات الثقافية والكشفية، وشارك في الدورات الثقافية التي كانت تقام حينها، وكذلك في المخيمات الكشفية في منطقة بحمدون ومدينة بيروت، في كلّ هذا الإعداد التربوي كان فعالاً على الصعيدين: في التعلّم والتعليم، وكان هذا عملاً يوميًا شاقًا، أي الدرس والتدريس، وأحيانًا يتواصل إلى ما بعد منتصف الليل في نشاط مكثّف، من خلال برامج مدروسة ومنظمة، في الدروس التي يتلقاها محمود، وفي الدروس التي يعطيها على شكل حلقات للأفواج الكشفية, وعبر كراسات نأخذها من اتحاد الطلبة المسلمين، أو سلسلة «الإسلام رسالتنا». ويشارك في نشاطات آخرى وفي مناطق أبعد.
شارك في سنة 1979م في دورات للكوادر، تلك الدورات الصعبة، التي أعدت لتأهيل الأساتذة، وتخريج المعلمين، وهي أرفع الدورات مستوى على الصعيد الثقافي.
هذا «الوحش» الذي تهابه ساحة المعارك هو نفسه، وعن بصيرة وبصر، يرى الطفولة وحاجاتها، كأنه حين يغمض عينًا للتصويب، يرى من تحت جفونها أطفالاً بحاجة للرعاية، هدف آخر كما في العين المفتوحة، إن كان في تلك غضب وثورة ففي هذه حب فوار، ومن خلال الكشاف نثر هذا الحب، بذورًا في بستان البراعم والجوالة والزهرات و... كنت أنظر إليه والأطفال حوله، يا لهذه الرقة في عينيه، من أين تأتي بكل هذا الحب يا محمود؟!! لكم هو شديد الاهتمام بهم، والعمل الكشفي يأخذ منه الكثير، في الوقت والعاطفة، حين
84
73
الأوراق
يتحدث عن الكشاف يتدفق حماسًا، تتحرك يداه في تفاعله وحماسه وهو يتحدث، ترى الحب وأنت تنظر إليه حين يتحدث بالأمور الكشفية، ملامحه تتفتح كما الزهور، وكأن ربيعًا حلّ في ثناياها... إنه جهاد التربية، ومسؤولية الجيل الجديد، كما يقول.
لم تكن النشاطات السياسية أو العسكرية منفصلة أو مستقلة عن النشاطات الثقافية أو الكشفية، كانت تتداخل وهي تسير بشكل متوازٍ، فمحمود وهؤلاء الشباب هم أنفسهم العاملون في مجال الثقافة يتحركون في الجانب الآخر، قد تختلط الحركة، فعلى سبيل المثال تعمّدنا يومًا أن نذهب كحركة كشفية في نشاط يقيمه بيار الجميّل حينها، لنطّلع عن قرب مع التصوير والاستطلاع المتعمد، وكان اسم فوجنا «فوج مصعب بن عمير»، وكنا تابعين لوزارة الداخلية، وعندنا الغطاء الرسمي المطلوب، ونستطيع أن نذهب إلى أماكن قد تكون صعبة على سوانا، ونشارك في المهرجانات الكبيرة، ونستفيد من هذه المهرجانات لزيادة المعرفة والاطلاع على الحالات الأخرى والمناطق الأخرى، وفي كل هذا كانت شجاعته واضحة، جرأة وإقدام عن معرفة، مع الدّقة وحسن التدبير، حين كنا ندخل إلى مناطق الكتائب، وهم في وقتها قوة رئيسية، كان يأخذ الكاميرا ليصور الشخصيات والأماكن خارج النشاط، يحاول دائماً أن يستثمر كل شيء.
85
74
الأوراق
العمل الكشفي، المركز ونشاطاته الثقافية والاجتماعية، كل هذا كان يحتاج إلى المال، جعلنا لكل هذا صندوقًا نجمع فيه ما أمكننا من مال، نجمعه من مالنا الشخصي، نقتطع من مدخولنا ورواتبنا مبلغًا نحاول ما استطعنا جعله أكبر بضغط مصاريفنا الأخرى، ومحمود يضع في الصندوق أغلب ما ينتجه، بل هو يفعل ذلك بلا حساب.
وإن احتجنا إلى أكثر من ذلك نأخذ أشهرًا من الصيام مقابل بدل مالي، ونوزع الأيام علينا شهرًا بشهر، ومحمود أحد أبرز الصائمين، كنا نحسب حسابه في هذا الصيام من دون أن نسأله، ونعلم أنه يوافق بلا تردّد، وإن قصّر أحدنا لظرف شخصي عن أداء ما تعهد به حملها عنه محمود ليصوم أيامًا إضافية. وإن كان مشروعنا أو جدّ جديد لنشاطات أخرى، ومشاريع أكبر جمعنا مالاً من التبرعات، صنعنا دفاتر إيصالات، طبعناها على نفقتنا الخاصة، كنّا نوزعها علينا، لكل منا دفتره، يجمع ما استطاع من التبرعات اعتمادًا على معارفه الشخصية، ويغيظنا محمود كعادته حين يشارك في جمع التبرعات، يعود بدفاتره فارغة من أوراقها، ويلومنا على تقصيرنا، ويسخر من قلّة ما نأتي به من تبرعات، نشاطه وفعاليته في جمع التبرعات كانت تذهلنا، وحين نسأله كيف يفعل ذلك كان يضحك هازئًا بإمكاناتنا وقدرتنا في التأثير والإقناع، ويقول ضاحكًا: هذا اختصاص وفن يحتاج إلى تدريب ومهارات، وهو مستعد ليعطينا دورة في هذا الاختصاص. ونحن نعلم أن الأمر ليس كذلك، وأنها واحدة من صفات محمود
85
75
الأوراق
التي لم يتعمد أبدًا إيجادها أو تطويرها، يخرج تأثيرها من دون عمد، كما يخرج العطر من الأزهار، كما يؤثر المشهد الجميل والأنغام المنسجمة على الحواس والروح، ربما لأنه جريء، صادق وواضح، أو ربما لقناعة الناس وثقتهم به، وحبهم له، أو لأنه ناشط كثير الحركة، كثير المعارف. كان لدينا مال يكفي دائمًا بسبب هذه الحركة.
هذه الأجواء ظلت كذلك، نحن جماعة المكتبة، هذه الفئة المتدينة، كان لها طابعها الخاص المستقل، ومحمود فيها يعرف الجميع، مشاركًا في كل عمل جديد، أينما كان.
ظل الأمر كذلك، حتى أواخر عام 1881م، وكان انتصار الثورة في إيران قد شكّل فاصلًا في ذاك الزمن، وكنا مع محمود المتحمس جدًا للثورة وقائدها، نتواصل مع الثورة، مع وزارة الخارجية عبر سفارتها في بيروت، ومحمود موصول بها قلبًا وروحًا، نتابع معه كل شاردة وواردة تتعلق بالثورة، والوقوف على رأيها وتطلعاتها وما نستطيع أن نفعله.
موصلون بها، كتجمع متديّن في تلك المنطقة من بيروت، وتقرّر خلال ذلك الوقت ذهابنا إلى إيران والإقامة لأيام في معسكرات «الحرس الثوري» للتدريب، كان محمود مرشحًا للذهاب معنا، إلا أنهم أجّلوه للدورة الثانية، كان أصغر منّا سنًّا، ومشكلة لحيته التي لم تكتمل، لم يكن ينبئ شكله عما كان عليه، وكان العدد المرشح محدودًا. أجّل محمود إلى الدورة الثانية، وأنا تأخرت عنها لظروف
87
76
الأوراق
خاصة، رغم كل محاولاتي وحماسي للذهاب، توالت العراقيل أمامي، وكلما أزحت عائقًا بدا أمامي ما هو أكبر منه، ولأنني أؤمن بأن الذي أبطأ عني هو خير لي، علمت بعدها أن بقائي مع محمود كان غاية في الأهمية.
وبقينا أنا ومحمود، ويشتدّ يومًا بعد يوم تقاربنا الروحي، في تواصل دائم، مع هذا التجمّع الفعال والمتجانس، نواصل هذا النموّ الفائق، وقد زاد زخمه وحماسه برعاية الجمهورية الإسلامية في إيران، وكأن الأمر استقر في مكان ما، أو كأننا نرتقي درجاته بهدوء مدروس.
في السادس من حزيران 1982 ميلادية انقلب المشهد رأسًا على عقب، انقلب دفعة واحدة، خيّم صمت مهيب؛ لقد اجتاح الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، صمت ذاهل لم يعتده محمود، كمن جمدته الصدمة، امتد هذا الذهول في الأيام التي تلت، وتكدّس فوقه استغراب ودهشة، وقد تحوّل إلى عدم تصديق، ووتيرة الذهول ترتفع، أين كل هذا السلاح وهذا الكم من المسلحين المدربين؟! لم نسمع غير مقاومة مشتّتة هنا وهناك، في «قلعة الشقيف» وفي «المخيمات»، مقاومة لم تكن لتوقف زحف الاحتلال، رياح خريف تعصف، القرى والمواقع تتساقط كأوراق يابسة، خمسة أيام اجتاحت قوات الاحتلال ثلث الأراضي اللبنانية ووصلت إلى تخوم بيروت، تحوّلت دهشة محمود إلى غضب، يزرع المكان طولاً وعرضًا، كما الأسد الذي رأيته في إحدى
88
77
الأوراق
الحدائق وقد ضاق عليه القفص، محمود ضاقت به الدنيا على وسعها... يردّد:
_ يا ناس... يا عالم! هذا هو العدو الإسرائيلي الذي انتظرتم قتاله.. إنه هنا... إنه في لبنان...
محمود امتلأ قهرًا، القهر الحارق يسري في دمه، ينتفض له كيانه كله... كنا جميعًا في ذهول وغضب، لم نكن نتوقع مثل هذا التخاذل، كان محمود يغلي، فالمقاومة ممكنة، ووقف الاجتياح وارد مع هذا العدد الكبير من السلاح والمسلحين، لكن قلبي كان يخفق من أجل محمود، وهو يزرع المكان ثم يتوقف واضعًا يديه على رأسه ثم يعاود المسير ذاهبًا وعائدًا يريد الذهاب إلى الجنوب.
ما لبثت القوات الإسرائيلية أن تقدمت باتجاه بيروت.
حين أصبح الجيش إلاسرائيلي على مشارف بيروت نسيت الأحزاب مشاكلها الداخلية وعداءها معنا، لم يعد يهمهم وجودنا، تشتت جمعهم، وتفلتت العناصر، انفرط العقد، البعض منهم ثبت على سلاحه ومبادئه، وعدد لا يحصى كان همهم الهرب، هرب الكثير من عناصر تلك الأحزاب، كل من يستطيع الهرب لم يعدم وسيلة، هرب دون تردّد، وبعضهم ترك مكانه ودار يبحث عن ملجأ، اختبأ لأنه لا يستطيع تنفيذ ما كان يخطط له من تمويه لحضوره العسكريّ، وغيره تحوّل إلى شخص مدنيٍّ لا يعنيه أمر القتال من قريب أو بعيد، وكأن
89
78
الأوراق
هذا القادم ليس عدوه، أو أن هذه الأرض ليست أرضه... تحوّلت الأمور السياسية وتبدّلت القناعات.
لا أستطيع أن أحدثك عن كل ذلك الخذلان والصدمة. لم يعد يحمل السلاح إلا القلة القليلة من الرجال، والسلاح مرميٌّ في براميل النفايات وتحت الأشجار وفي المكاتب المهجورة. تُرِك السلاح، واللباس العسكري يتكدس في غرف المراكز، استبدل باللباس المدني الآمن.لقد كان لوقت قريب فخرًا وسلطة, ذاك اللباس وذاك السلاح أصبح فجأة عارًا أو وباء، مصدرًا للخوف، تهمة نزعوها عنهم بسرعة بعد أن لبسوها وتاجروا بها واستغلوها سنين طويلة. ومحمود يضرب بأقدامه الأرض قهرًا وغضبًا، ينظر إلى هذا السلاح العزيز وهو يترك كأنه العار الذي يتبرأ منه الشرفاء.
_ السلاح يستمد شرفه من حامليه...
هكذا كان يقول محمود وهو يجمعه من «المزابل»، يمسح عنه الأوساخ بكل تقديس وإجلال وفي عينيه ألم ومرارة.
تجنّدنا جميعًا لهذه المهمة المقدسة التي كانت بعد ذلك أهم الهدايا التي قدمها زمن البدايات للزمن الذي تلاه، جمعنا كمًّا كبيرًا من السلاح والذخيرة، نسيت الأحزاب خلافها معنا، وبعضها مع البعض الآخر، حتى إن بعض العناصر سلّمنا مخازن كاملة وهو يشدّ على أيدينا شاكرًا. ونحن على عجالة ننقلها إلى أماكن أخرى
90
79
الأوراق
أو نستبقيها في أماكنها لنعود إليها لاحقًا بانتظار الليل أو وسيلة نقل، بعضها تمّ نقله إلى الضاحية في وسائل شتى، وبعضها وُضِع في مستودعات مخفيّة مموهة، وفي عيون محمود انتظار متحفِّز لا يعلم كيف وأين ومتى، ولكنه يعلم علم اليقين أنه لن يسكت على هذه الحال مهما كانت الظروف والأحوال، وأنه لن يكدّس غضبه طويلاً، يستعد لإطلاقه، في أقرب سانحة، في أقرب فرصة، ويقول إن لم تأتِ تلك الفرصة السانحة فسيصنعها هو، كما يصنع كل محتاج حاجته، أوليست هي أم الاختراع؟! ومعه كنت واثقًا أنه قريب، وأننا قريبًا جدًا سننزع هذا الباطل، ونجتمع مع الحق على قلتنا، فهو قرار حاسم لا عودة عنه، ويصبّ محمود جام غضبه على أحاديث الهزيمة: مقولة الانحناء أمام العاصفة، والعين التي لا تقاوم المخرز... السلاح بين أيدينا وهذا العدد الهائل من الرجال الذين قاتلوا في شوارع بيروت وأزقتها، عن أي عواصف، وعن أي مخرز يتحدثون؟
كانت الأسلحة في «المزابل»[1] كثيرة جدًّا، هناك «مزبلة» كبيرة في منطقة «زقاق البلاط»، وجدنا كمًّا كبيرًا من الأسلحة، وكلها أسلحة جديدة، جديدة تمامًا، كان هناك ما يقارب الأربعين مخزنًا، وأربعة مسدسات، وكان هناك الكثير من البنادق القديمة وسواها من الأسلحة. لم نأخذها وقتها.. صندوق السيارة لا يحتمل أكثر من ذلك،
[1] أماكن رمي النفايات
91
80
الأوراق
ثم وإلى الأمام وفي منطقة «الظريف» وجدنا كمًّا ضخمًا من الطاسات الحديدية. ملأنا السيارة منها، ثم أخذناها إلى المعمل، وهناك أزلنا لونها بالحف ثم طليناها باللون الأبيض بالفرشاة، ووزعناها على عناصر الدفاع المدني.
في البناية خزان مازوت كبير معطّل؛ وضعنا أحسن ما نجمعه من المراكز والمكاتب فيه، كل عملياتنا التالية كانت من تلك الأسلحة، وضعنا فيه ما يقارب الأربعين بندقية، وأسلحة الهاون، وسواها، ومن شارع «كليمانصو» بحمولة ناقلة كاملة من الأسلحة والأجهزة، وشحنات كاملة أخرى بعد ذلك، ليس من المزابل بل استلمناها منهم، من المقاتلين السابقين الذين استقالوا أو استقال منهم السلاح» كما يقول محمود. مدافع هاون استلمناها بشكل رسمي وعن طيب خاطر.
محمود يريد الذهاب إلى الجنوب، كان يفرك يديه كأنه أمام مائدة دسمة، لم يوافقه أحد على ذلك، وسرعان ما بدأت طلائع الاحتلال تقترب، فكان على أحر من الجمر لملاقاتهم.
كنا ثلّة قليلة من المقاتلين، عناصر بمبادرات فردية لا أوامر عليا ولا كتابنا وكتابكم، نجتمع بقرار من قلوبنا والغضب، متحفزون بشعور من تحرّر من ذلك القيد، لم تعد القيادات موجودة، القاعدة تفلّتت والعناصر فرّت بمعظمها، لم تبقَ سوى عصائب هنا وهناك، عنيدة
92
81
الأوراق
ثابته، ينظر إلينا العابرون من النّازحين والهاربين بلباسهم المدني، ونحن نرتدي لباسنا العسكري ونتأبط أسلحتنا، يلوون برؤوسهم إشفاقًا أو عن رضا، ظنَّنا الناس مجانين، ونحن نبادلهم الظن، ونحن نرى أننا في المقلب الآخر، حيث يجب أن نكون، أغلبنا كان من ذلك التجمع المتدين الذي ثبت بكامله، وتخطينا نداءات الانسحاب، أغلب الشباب لبس الثياب المدنية ونزح مع النازحين، توقفوا عن القتال، لم يبق غير تلك العصائب المتمرّدة القليلة منا ومن بعض الأحزاب، في ثورة وتمرد على هذا التخاذل غير المبرر، ومحمود أكثرنا تمرُّدًا وثورة، ننظر إلى عينيه المتّقدتين بالحماسة والغضب، فتسري إلينا كموجات ضوئية تبعث الضوء وتدفق الحياة، نستمد منه بعضًا من نار تلك الثورة التي تتّقد فيه.
كنت مشغولًا بتنظيم نقل السلاح حين فقدت محمود ولم أجده، فقيل لي إنه ذهب بسيارة «رينو» استعارها من صديق لنا، ذهب جنوبًا، وظل يقترب بالسيارة، حتى وجد رجالاً من «الجبهة الشعبية» هناك، نصحوه بعدم التقدّم، تركهم وتقدّم مسافة طويلة، حتى وجد نفسه أمام العدو الإسرائيلي مباشرةً، ظنّوه مدنيًا، قالوا له: ارجع، فاختبأ هناك، صنع متراسًا، وما إن تقدّموا حتى أطلق النار، أصاب بعضهم في تلك المباغتة، قبل أن يصعد الجنود إلى آلياتهم. كان سعيدًا فهو يواجه الاحتلال لأول مرة، وجهًا لوجه، وبقي يتنقّل من مكان إلى آخر، يمترس هنا وهناك ويطلق النار، ظلّ كذلك حتى نفذت ذخيرته.
93
82
الأوراق
حين عاد كان يلهث مبتسمًا ورائحة البارود، عطره الدائم، تفوح منه، لم يتكلم من شدة تعبه، قدّمت له ماء، بعد جلوسه، شرب ثم قال:
_ ليتني أخذت ذخيرة أكثر.
وانبرى يحدثنا سعيدًا بما جرى، فقاطعه صديقنا صاحب السيارة صارخًا:
_ والسيارة... أين السيارة؟
سكت محمود ثم نظر إليه وقال بكل برودة وهو يرفع إبريق الماء إلى فمه مجددًا:
_ طلعت عليها الدبابة.
قام الصديق واقفًا معترضًا بشدّة، نظر إليّ يشكو سوء أمانة محمود، وإذا بمحمود يقول له:
_ اشكر ربك إنك ما كنت فيها.. لو كنت فيها كنت صرت علكة.. اشكر الله يا صبي.. اشكر الله.
فضحك الصديق وضحكنا جميعًا، فمع محمود لا تملك إلا أن تضحك وإن كنت في فم الموت.
نظّمنا أنفسنا في مجموعات وانطلقنا عند الفجر، التقيناهم في منطقة «الدامور»، ومن «الدامور» إلى «خلدة»، وهناك دارت تلك
94
83
الأوراق
المعارك الشرسة. كنا أكثر من ثمانين مقاتلًا، وبدأ العدد يقل شيئًا فشيئًا، استشهد من استشهد وجرح من وجرح، وترك عدد من الرجال ساحة القتال حين اشتدت الهجمة، حتى وصلنا إلى ساحة «الشويفات»، كنا أقل من عشرة رجال، وهناك رابطنا خمسة أيام، محمود وأنا وآخران. تشكّلنا من جديد على مجموعتين، مجموعة معي، ومجموعة مع محمود، خمسة أو ستة أيام، انقطعنا خلالها عن العالم كله ونحن نقاتل حتى أغار علينا الطيران، ثم أصبحنا ثلاثة، أنا واثنين معي، وأربعة بمكان آخر مع محمود، نأكل مما تركه النازحون... كل يوم نرمي قذائف الـ «بـ7» ونرمي ما لدينا من الصواريخ، نهاجم ثم نعود، ونبتعد حين يغير علينا الطيران، ثم صار العمل يزداد صعوبة مع كل دقيقة.
حتى أنا لم أكن أجيد التعامل مع الصواريخ، لا أعرف كيف أثبتها، وضعنا حجارة بدل التراب، والصاروخ يهتز بين أيدينا وهو ينطلق. الصواريخ التي لم نتدرب عليها سابقًا، تلك التي كنا قد أخذناها مع الأسلحة من الهاربين لنقاتل بها.
ثم ركز الطيران علينا، فاتفقت مع من معي، بعد نفاذ الصواريخ، أن نقاتل بأسلحتنا الفردية، كلٌّ في مكان، منفردين حتى نفاذ الذخيرة، وإن نجونا نلتقي في بيروت. ووسع الطيران دائرة قصفه بشكل ثابت ومحكم، وشتتنا تشتيتًا.
95
84
الأوراق
ساعات لا أدري عددها، الشمس توشك على المغيب، توجّهت بعدها إلى حيث محمود أريد الاطمئنان عليه، وهناك علمت أنه أصيب في منطقة «كليّة العلوم»[1]، خفق قلبي بشدة، وشعرت أن قدميَّ تخوناني، وأنا أدور أسأل عنه في كلّ الأماكن المحتملة، كثيرة هي الأسئلة التي كانت تتزاحم على لساني تتعثر بلهفتي، والأجوبة تحاول تهدئتي.
_ الإصابة ليست بليغة...
_ إنه عنيد...
_ معالجة أولية...
_ أصر على الذهاب...
_ لا ندري إلى أين.
لم يشأ محمود أن يبقى ليتم علاجه، وقلقي لا يغادرني، أسرعت الخطى إلى «فتح الله»، أصعد الدرجات قافزًا، غادرني تعبي وأنا أتوسل أن أجده في المنزل، الظلام دامس والباب مفتوح، صرخت أناديه وأنا أدخل ملهوفًا:
_ محمود.. أأنت هنا يا محمود؟
_ ادخل.
[1] ويسمى اليوم حيّ الجامعة وذلك لاشتماله على كلية العلوم، يقع في الضاحية الجنوبية لبيروت.
96
85
شكر ودعوة
كان صوته الخافت صادرًا من الغرفة الجانبية، ونورٌ واهنٌ يتسرب من عتبة الباب المغلق، وبكل لهفتي دفعت الباب ودخلت.
طالعتني جعبته والقاذف على الأرض، وعلى مقعد قرب الباب وجدته غارقًا مستنزفًا، عاري الصدر وسلاحه على ركبتيه، والنور الشاحب من الشمعة اليتيمة يلقي بظلاله على ابتسامته الواهنة، حاول القيام عند دخولي فركعت أمامه، وأنا أنظر إلى بطنه، كان الجرح مكشوفًا والدم يلون بنطاله والمقعد، لم يكن هذا وحده هو الذي مزق قلبي، احمرار بطنه وصدره، حدّقت جيدًا فوجدت الجلد قد تقشّر وسلخت أجزاء منه، في الصدر، وفي البطن أكثر، وحيث الجرح، فصرخت من لوعتي:
_ ما هذا يا محمود؟!!
قال مبتسمًا يؤنبني في مزاح:
_ لمَ تولول مثل النساء؟.. ما في شي
_ أين احترقت وكيف؟؟
رأيت الكثير من الجراح، لكن جرح محمود ما زال مطبوعًا في ذاكرتي بوضوح شديد، حاول تعديل جلسته فآلمه جرحه والحروق. عاد إلى جلسته الأولى وهو يقول ممازحًا:
_ كنت ألعب بالنار.
97
86
الأوراق
قمت أساعده وهو يروي لي ما حدث ضاحكًا، يتقطع حديثه بين جملة وأخرى حين يداهمه الألم، فأرفق بمساعدتي له ما استطعت، وأنا أصغي بلهفة لأعرف ما حدث.
حين عاد إلى البيت كان يريد إزالة الدماء الخارجة عن الجرح ليصلّي. الكهرباء مقطوعة، والشمعة اليتيمة لا تكفي للرؤية الواضحة، وهناك ضوء يعمل على الغاز المعبأ بقنينة صغيرة، حمل القنينة يحاول تركيبها وهي قرب بطنه حين أفلتت وانتشر الغاز ثم النار على الجرح وعلى كامل البطن، ومع ذلك استطاع إغلاق فوهتها من جديد، والانشغال بإطفاء النار.
تابع يقول:
_ بتعرف وجع النار أصعب من وجع الجرح.
وأردف ضاحكًا:
_ الله يعينك عجهنم يا مسكين... رح تموت من الوجع.
نظفت له جرحه، وجلبت من حقيبة الإسعاف شاشًا ومرهم حروق، أضمّد جراحه وهو يمازحني، ناصحًا إياي أن أعمل بالتمريض، لأنني غير صالح للقتال ولأن التمريض لا يحتاج إلى القوة والشجاعة ذاتها.
بعد صلاة أداها بصعوبة وهو جالس، وطعام من خبز قديم لم
98
87
الأوراق
نجد سواه، تمدّدنا وعاد الحزن إلى ملامحه ونحن نتحدث عن المعارك والخذلان، ثم غفا وغفوت أنا على الأريكة المقابلة.
خرجنا في اليوم الثاني مبكرين، لم يكن الجرح ولا أي شيء آخر يعيق محمود، كان علينا أن نتجمع ونضع عتادنا في المتناول، نوزّع أنفسنا وما تبقّى من الرجال، ونتابع خطوات العدو، الذي كان يعتمد الطيران والقصف الشديد، منحنا الكثير من الوقت لجمع السلاح ونقله.
99
88
الأوراق
بعد رحيل المقاتلين الفلسطينيين، كان «مصطفى الترك»[1] ممّن حصلوا على دبابات، وكان يملك المال ويسيطر على كل المنطقة، وتحت إمرته عدد كبير من العناصر، وكان له حضورٌ قويٌ في منطقة فتح الله بالذات؛ ولذا، ذهب إليه محمود معلنًا قراره بمواجهة جيش الاحتلال، طالبًا إليه أن يمدّه بالرّجال والسلاح.
فقال له مصطفى الترك:
_ ولك يا وحش هول الرجال «شوفيني حبّيني».
يقصد أنهم يحملون السلاح للزينة فقط، أما عند قتال العدو فهم غير موجودين، وقال له:
_ أعطيك من السلاح ما تريد ولكن لا يوجد رجال...
وفي محاصرة بيروت ومحاولة الدخول إليها بهدف اجتياحها وتنظيفها من السلاح ومن المقاتلين، تشكّلت المجموعات على عجل، وكنت مع محمود في مجموعة واحدة، مهمة المجموعات هي
[1] قائد حركة أنصار الثورة أيام الحرب الأهلية في لبنان عام 1975م.
101
89
شكر ودعوة
مواجهة الجيش الإسرائيلي الذي كان يتقدم من عدة اتجاهات، فاتحًا جبهات عديدة دفعة واحدة.
كنا مجموعات متفرقة بلا تنسيق واضح، مجموعة فتح الله، مجموعة وادي أبو جميل... مجموعة هنا ومجموعة هناك، مع أفراد من الاحزاب حالهم كحالنا، وهكذا كانت المعارك التي خضناها مع الإسرائيليين، الإصابة التي تعرّض لها لم تستطع منع محمود، على الرغم من الألم والوضع الصعب كان يقاتل... لم يكن يهدأ أبدًا...
كنا ثلاثين رجلًا تقريبًا، حين جاء الأمر الحاسم بإلقاء السلاح، لقد كان الأمر غير منطقي وغير مقنع بالنسبة إلينا، أن العدو قربك وأنت ترمي سلاحك، كان الأمر بإلقاء السلاح غير مقنع، وكنا نراه غريبًا لا يصدق، لم نكن مقتنعين به أبدًا، لقد كان أمرًا يستدعي الغضب وليس الرفض فحسب، لم يترك فينا سوى الغضب وعدم التصديق، لقد ترك الكثير من الشباب سلاحهم قبل ذلك، كان على القيادة ترك الأمر على ما هو عليه، بقينا نقاتل ولم يعد يعنينا سوى القتال، فذاك كان خيارنا الذي لا نستطيع التخلي عنه، إن لم نستطع منع الاحتلال سنجعله عليهم أصعب ما يكون، وبقينا نقاتل في مجموعات منفصلة، ونعمل بلا تنسيق.
ومحمود، أكثرنا حماسًا، امتطى دراجته النارية وحمل سلاحه وقنابله والقذائف وما عاد يُرى في مكان واحد، عليه فقط أن
102
90
الأوراق
يعرف أين هم، ومن أين دخلت تلك الفرقة، وتلك الدبابة، كان ينتظرهم كصيّاد ماهر، وكنا نكمن لهم في الدروب وعلى شرفات المنازل... على أحد المداخل كان الصيد ثمينًا؛ دبابات وآليات ضخمة... ما كان أحد يظن أن محمود سيسعى إلى إيقاف «الرتل»، لكنه استطاع بوقفة جريئة، وبقذيفة غاية في الدقة أن يدمّر الأولى ويركض إلى الزاوية الثانية، ونحن نضرب في أماكن موجعة في جسد ذلك الرتل الطويل، بدفق من الحماس والقوة نستمده من إيماننا ومن الطاقة الصادرة عن محمود، كدوامة من الشجاعة والسرعة... سريع كرصاصه وقذائفه... هذا هو محمود وتلك طريقته، كأنه لا يرى الموت.
نزلنا إلى داخل بيروت، شاهدنا قوات الاحتلال على طريق «الجبهة العربية». وكان محمود يرفع صوت المسجّل بالأناشيد الثورية، وعلى دراجته الناريّة، بكل سلاحه من شارع إلى شارع.
أخذنا شاحنة صغيرة من شركة مياه بيروت في منطقة برج أبي حيدر، وضعنا عليها قاذف «بـ7،» «وهاون عيار 60»، ومن «الطريق الجديدة» إلى «الجامعة العربية»، ركنّاها هناك، أخذنا أسلحتنا... ومن حائط إلى حائط، ومن بناية إلى بناية، ومن دهليز إلى آخر، وصلنا إليهم وأطلقنا رصاصنا والقذائف. كان هناك مقاتلون فلسطينيون من الجبهة، اعترضوا بشدة على مواجهتنا لجيش الاحتلال من هذا المكان، ومنعونا من إكمال القتال، فعدنا إلى «فتح الله».
103
91
الأوراق
كان الإسرائيليون قد وصلوا إلى «وادي أبو جميل» قرب الكنيسة. كان هناك عدد من المسلحين من تنظيم «المرابطون» فسألناهم:
_ أين أصبح الإسرائيلي؟ فقالوا:
_ على البحر.
وكانوا يدخلون إلى «وادي أبو جميل» من جهة منطقة «الصيفي»، وكانت هناك إنزالات بحرية من جهة المرفأ، في محور «الكنيسة»، هناك تمركزنا نحن ومحمود وبعض الإخوان. قضينا يومين أو ثلاثة أيام متواصلة على ذلك المحور. المحور الرئيس كان كنيسة «وادي أبو جميل». رفعنا السواتر، جهّزنا الاستحكامات ورابطنا هناك... كانت الدبابات تتقدم فنصدّها فتتراجع، ومن جهة البحر أيضًا... كان محمود هو الأساس.
«وادي أبو جميل» ومحور «الكنيسة»، هذا المحور هو الأكثر وضوحًا في ذهني، لأننا رابطنا فيه أيامًا، صنعنا فيها سواتر عالية، وكانت الدبابات تتقدم، ونحن نصدّها نهاجم بكل قوتنا، ثم نتراجع في تكتيك عسكري سريع... وكذلك من جهة البحر، كان محمود هو المحرك الأساس، وهو القادر الفعال في سرعة الحركة التي كان يتميز بها، في الوقت الذي كنا نحن نقاتل خلف الساتر كان هو بين الحين والآخر يقف على الساتر، كان يقف على المتراس يضرب القذائف ثم ينزل، وبعض الصواريخ الصغيرة التي لم نكن قد استخدمناها بعد،
104
92
الأوراق
يضربها وينزل، والإنزالات مستمرة على البحر، كان حين يراهم يغادر الساتر وينزل إليهم، حين تنزل الدبابة من البحر إلى الشاطئ يكون محمود قد سبقهم إلى الساحل يطلق قذائفه ويصيبها ونرى الدخان يتصاعد منها ثم ينسحب. عندما نراه نتشجع ونركض خلفه، كنا ستة أشخاص.
من فوق الساتر يطلق قذائف الـ «بـ 7» لم يستطع أحد فعلها، وحده محمود كان يفعل ذلك، يخرج مكشوفًا أمام النار، منا من كان يستطيع رفع رأسه قليلًا عن الساتر، أما هو فكان يقف على الساتر ويطلق قذيفته. هي ميزته وحده، لا أحد مثل محمود، لا أحد.
ثلاثة أيام والإسرائيليون يحاولون الدخول فيتكبّدون الخسائر ثم ينسحبون سواء برًا أو بحرًا؛ كنا كلما نفذت ذخيرتنا يذهب أحدنا ليأتي بذخيرة جديدة، من أماكن حددناها سابقًا، ووزعناها لهذه الغاية، لم يكن السلاح مشكلة أبدًا، فهو في كل مكان، سلاح مكدس بلا رجال، أكملنا القتال في الزواريب، ظهرنا محمي من جهة «فتح الله»، ونحن نواجه الجيش الإسرائيلي في الشوارع الضيقة وعلى المنعطفات، نحن ومحمود وقلة آخرون أخَّرنا اجتياح بيروت، حين نراه يقاتل بهذه الطريقة ننسى الخوف، وننسى أننا نقاتل جيشًا ضخمًا وحدنا، لقد عطّلنا الكثير من الدبابات، وكان مظهرهم وهم يتراجعون مفرحًا، ويزيدنا حماسًا، ومواجهات البحر كنا نراها بوضوح ونرى القتلى
105
93
الأوراق
والإصابات الكبيرة... تلك المشاهد كانت تعزّز من نشاطنا وتزيدنا جرأة وقوة.
ثم وصلنا إلى منطقة «برج أبي حيدر»، واشتبكنا مع الإسرائيلي هناك. كنا ستة أشخاص، كان محمود يلبس قبعة بيضاء فظنوا أنه يريد تسليم نفسه فأطلق عليهم قذيفته، ثم اشتبكنا معهم على «البسطة» وفي «البربير» لساعات ثم عدنا.
ظللنا على هذه الحال حتى بات الأمر مستحيلًا، واستطاع الجيش الإسرائيلي الدخول من أماكن متعددة برًا وبحرًا، ولم يعد بمقدورنا المواصلة، وكان معنا شاحنة نقل صغيرة حين تراجعنا إلى «فتح الله» «وهاون عيار 60» على ظهر الشاحنة، لقد كان اجتياحهم بطيئًا، ولكنه كان كثيفًا حتى وصلوا إلى «برج المر»، وصعدوا بشكل مكثف إلى جسر «المصيطبة». كنا نتحرك بصعوبة ونحن على «اللاند»، نوقف الشاحنة والمدفع على منعطفات أحد الأزقّة، وحين يصلون نخرج من المنعطف ونطلق خمس إلى ست قذائف، ونذهب إلى زاوية أخرى ونرى المكان الذي كنّا فيه يتهدم من شدة القصف عليه، وبعدها ضاقت أماكن التحرك، ضاقت كثيرًا...
وصلت إلى «جسر سليم سلام» أرتال ضخمة وآلاف الجنود والدبابات... على جسر سليم سلام شكلنا مجموعات، وهناك خضنا معركة أسطورية كان بطلها محمود، كان إطلاق القذائف بالنسبة
106
94
الأوراق
إليه يشبه إطلاق الرصاص، عشرات القذائف أطلقها محمود، فاقت الخمسين، في عمل مستحيل لم يكن أحدٌ قادرًا على مثله، أسطورة لا مثيل لها، على الجسر وفي كل تلك المواجهات.
المعارك تدور سريعة مكثفة، وعلى محاور عديدة، وقوات الاحتلال تنزل بكل جحيمها المتوحش كمطر غزير من كل حَدْب وصوب، ومع كل مقاومة تنزل الحمم أضعافًا في قصف مدمر، وهم يتحركون في البلد، ويتوجهون إلى الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
هذا المنظر كان موجعًا، موجعًا للغاية، ومحمود ينظر بأسف مرير، لم نستطع تركهم هكذا يدخلون براحة، جمعنا معه كل القنابل المتوافرة ومن خلف الجدران والمنعطفات كنا نرمي القنابل ونغيّر أمكنتنا. محمود هو الأسرع في إطلاق القذائف، 13 آلية عُطِبت على الجسر، كانت النار مرتفعة والإصابات كثيرة جدًا...
ومنظر لن أنساه، كنت أنا ومحمود، وبعض الإخوة، وكانت هناك بناية قريبة لم يكتمل بناؤها بعد، تسللنا إليها وصعدنا إلى سطحها فوق الطابق العاشر، هذا الارتفاع جعلنا نرى المكان أمامنا واضحًا، كل شيء كان واضحًا من ذلك الارتفاع، هناك أربع أو خمس آليات مجتمعة وحولها الجنود كأنهم كانوا ينتظرون أمرًا ما، أو أنهم يرتاحون. لم يكن موقعنا الذي اخترناه صالحًا بالمنطق العسكري، فنحن على سطح الطابق العاشر والانسحاب إن لم يكن محالاً فهو
107
95
الأوراق
صعب جدًا، لكننا كنا ننظر إلى محمود وابتسامته، ولا نرى بعدها أي شيء آخر. قال محمود بصرخة فرح:
_ يلّا شباب.. واحد، اثنان، ثلاثة.. يا علي
وبدأنا بإطلاق قذائفنا دفعة واحدة، أفرغنا كل ما لدينا، رأينا الآليات والنار وجثث الجنود، رأينا آلياتهم تحترق والجثث المنثورة على الأرض. نزلنا ركضًا على الدرجات، الطوابق فوقنا تتعرض للقصف، حجارتها والأتربة تتساقط علينا، وكنا نضحك من أعماق قلوبنا، أقسم لك أنني لم أضحك مثل تلك الضحكات إلا حين كنت طفلًا ألهو، وضحكات محمود واضحة فوق صوت القذائف التي تنهال فوقنا...
مواجهات كثيرة، منها مثلاً عند صيدلية «سترس»، ضربنا لهم آلية وسيارة، كان معنا رجال من الأحزاب ومن «فتح»، قلّة هم الذين بقوا، كان يجمعنا معهم قضيتنا الكبرى، العداء لإسرائيل، شباب «البسطة» و»فتح» ومعهم من الناصريين، وغيرهم، الانفجار الكبير حين فجّر الجسر، كانت هناك إصابات كبيرة، ومواجهات متفرقة سريعة ومكثفة، على باب «مار الياس»، ومن خط «مار الياس» إلى «حي اللّجا»، كانت المجنزرات تسير في الشوارع وتسحق السيارات، وفي «البسطة التحتا»، أيضًا جرت معارك مهمة في بناية التعاونية، وقرب الإطفائية كان هناك تجمع للآليات الإسرائيلية كنت مع محمود، صعد معي في السيارة ومعه عدد من القذائف، حين وصل إلى مواجهتهم أخرج جسده من شباك السيارة وأطلق قذائفه بدقة
108
96
الأوراق
في وسط الآليات تمامًا، السيارة تسير بنا وهو يطلق قذائفه، ومن نافذة السيارة أرى فعل محمود.
ثم ضاقت المساحة بعد ذلك وسقط المكان بأغلبه، لكننا ومع محمود بدأنا بحرب عصابات فريدة التكتيك، ليلًا كان محمود يركب دراجته وسلاحه على فخذه وعلى كتفه ومعه مقاتل آخر يحمل قذائف «بـ 7» والقنابل تنتشر كقلائد على جسده، يواجه الجنود في معارك خاطفة؛ قذائف وقنابل، زخّات رصاص، وقبل أن يستيقظوا من هول المفاجأة يكون هو قد غاب تمامًا في الظلام...
آخر معركة في فتح الله قرب مركز الباشورة القريب من رياض الصلح وسط بيروت، ثم نزلنا إلى تحت في آخر «فتح الله»، ونزلنا من هناك إلى آخر «البسطة». بقينا ثلاثة أو أربعة وأنا ومحمود، محمود و«صلاح فارس» ركبا الدرّاجة الناريّة ليلتقيا بأنصار الثورة، وبقيت أنا في دائرة ضيقة التحرُّك وتزداد ضيقًا مع الوقت، وحين عاد محمود كانت مساحة التحرك قد نفذت، وتقرر انسحابنا إلى الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.
حين وصلنا إلى «الضاحية» وجدنا هناك ملالات على جادّة «المشرفية» ودبابتين، وقرّرنا الهجوم إلا أننا وجدنا الناس قد تجمعوا قرب الدبابات تجمعًا مدنيًا، ما جعلنا نتخلى عن السلاح.
وافترقنا أنا ومحمود، كلٌّ إلى قريته.
109
97
الأوراق
في القرى، كان للعدو الإسرائيلي سياسية معتمدة، وهي تحييد أهل الجنوب، لم يكن الضغط شديدًا هناك، وحتى العملاء في الداخل تعاملوا بشكل مرن حينها، الأوامر لم تصدر لهم بالتشدّد، ولم تكن المعاملة قاسية في وقتها، ففي القرى انتماءات الرجال معروفة مع الأحزاب الفلسطينية والعلمانية، وقد تركوا السلاح وجاءوا الى الجنوب، والعدو يحيِّد هؤلاء التاركين وإن كان يعرفهم بأسمائهم، يعرفهم ويتجاهلهم عامدًا، يعرف مكنوناتهم، ليس سوى جبن وضعف في الحوافز، كانت هذه نظرة الصهاينة العامة للمسلحين غير الفلسطينيين، الهاربين من المواجهات في بيروت.
كان الجو كئيبًا حزينًا، والساعات بالنسبة إليّ مضت دهورًا طويلة مجبولة بالقهر، شعور بالخزي والعار وأنا في كنف عدوي، وأرى محمود في ذهني، من خلف حواسي أراه، يتقلّب ويصيبه أضعاف ما يصيبني. هذا التواصل الروحي كان كالحقيقة الواقعة، فلم أستطع البقاء.
عدت بعد أيام إلى «فتح الله»، وهناك وجدته قد سبقني، فهو كما كنت أراه أكثر مني وجعًا، وجدته في «فتح الله» مع القلّة المتبقية من الإخوة، وكان «أبو جعفر»، و«أبو خريف» صاحب المشاكل العصبية، مؤمنٌ طاهرٌ أبو خريف، ولكنه يتعرض لبعض المفاجآت من خلل في شبكته العصبية. تتبدل دنياه حين يكون مع محمود، حتى أننا
110
98
الأوراق
كنا على يقين أن جملته العصبية تنتظم حين يكون مع محمود، كان عاشقًا، شديد التعلق بمحمود.
تلك الأيام كانت غريبة، جديدة ومختلفة في كل شيء، كانت فاصلًا زمنيًا، كأن قطار الزمان قد توقف عندها يستريح، ونحن نتطلع إلى هذا الوضع الجديد، كمن يريد أن يعرف أين استقر به المقام، الحياة تعود ولكنها على غير ما كانت، قوات الاحتلال والقوات المتعددة الجنسية كانوا على أطراف بيروت، في الجوار وفي الجبل، خارج مناطقنا وفي بيروت الشرقية، على الأطراف وفي المراكز المحصّنة، ولا وجود للقوى المسلحة على الأرض، كنا نحاول لملمة الأوراق بعد تلك العاصفة، ومنها السلاح الذي كنّا قد جمعناه، وأصبحت أنا ومحمود كروح واحدة في جسدين، ولم نعد نفترق إلا نادرًا، على الرغم من أن عملي يحتّم عليّ الحركة أكثر منه، ومرّ وقت، لا أدري كم من الزمان مرّ، قبل أن نخوض تلك التجربة الفريدة.
كنت أريد الذهاب خارج بيروت بمقتضى عملي، وهناك حاجز للعدو الإسرائيلي، يطلق عليه اسم المعبر، وهناك في منطقة «صوفر»[1]، حيث كان الخطّ الفاصل، يمنعك الحاجز من الوصول إلى البقاع إلا بتصريح مسبق، ذهبت إلى حيث تؤخذ التصاريح، دهشت لتلك الطريقة الغريبة، لا أدري لماذا اعتمدوها، تقف السيارة أمام مدخل
[1] منطقة من جبل لبنان.
111
99
الأوراق
مغلق، يسألك الجندي وهو بعيد عنك في مكان يشبه برج مراقبة، وبالإشارة، إما يطردك معلنًا عدم وجود تصاريح، أو يسمح لك بأخذ التصريح مشيرًا إليك أن تذهب إلى مكان قريب، حيث وضع العدوّ مستوعبًا صغيرًا، تذهب إليه سيرًا على الأقدام. دخلت إلى حيث أشار الجندي، ووجدت ضابطًا وراء مكتب، طلبت تصريحًا للعبور إلى البقاع، وبعد تحقيق سريع عن عملي ومكان ذهابي والأسباب، أعطاني التصريح، وأنا أستطلع المكان مستغربًا هدوءه، في ذلك الوقت بعد انتصاف النهار.
حين عدت حدثت محمود بما جرى، وكان يحمل عودًا أخضر ينزع عنه أوراقه، وحين أنهيت حديثي، نظر إلى العود كأنه معجب به، هزّه أمام عينيه وقال بعدم اهتمام، كأنه يحدث نفسه:
_ ولمَ لا.. غدًا إن شاء الله.
صرخت فيه لأعيده إلي:
_ عن ماذا تتحدث.. غدًا ماذا؟
_ غدًا نأخذ تصريحًا.. ونأخذ روح الضابط بطريقنا.
وعلى ذلك اتفقنا، وجدنا من بين الأسلحة التي جمعناها حاجتنا، مسدس من عيار 5.5 مع كاتم للصوت، لكننا لم نجد له سوى عشر رصاصات، ولأننا لم نكن ندري أكان يعمل أم لا، جرّبناه بطلقتين، فلم
112
100
الأوراق
يبقَ معنا سوى ثماني رصاصات. أخذنا المسدس، وانطلقنا إلى ذلك المكان، في الوقت ذاته تقريبًا، رفضت طلب محمود الذي أراد أن ينفذ بنفسه العملية، لأنني أعرف المكان، وأعرف ما عليّ فعله تمامًا، لذلك قاد محمود السيارة حتى وصلنا إلى حيث الباب المغلق، أشار إليّ الجندي أن أدخل إلى المستوعب، سعدت بانحسار المعضلة الأولى، ترجّلت من السيارة تاركًا محمود خلف المقود، متأهّبًا لأي طارئ. حين دخلت، كان المكان أكثر إنارة من السابق، ربما لحركة الشمس التي اختلفت بتأخر الوقت، وكان الضابط وحده كالمرة السابقة، رفع الضابط رأسه عن أوراقه بكثير من الملل حين دخلت، ونظر إليّ باحتقار، وسألني بانزعاج عما أريد، فقلت وأنا أحضّر نفسي لتحقيق طويل، أنتظر فيه غياب نظره عني لأسحب مسدسي وأطلق النار، لكنه فاجأني بقوله:
_ اسمك؟..
فقلت على عجل دون أن أفكر... هكذا تناولت أول ما خطر في ذهني:
_ اسماعيل حنّو.
لا أدري من أين جئت بهذا الاسم، وسقطت في ذهني فورًا ردّة فعل محمود حين يسمع بالاسم، وصرت أفكر كيف أحمي فخذي من كفه الذي سيصاحب ضحكته، نظر إليّ الضابط قليلاً، زمّ شفتيه وبدأ الكتابة، كنت مدهوشًا لموافقته الفوريّة، بلا أي تحقيق، ربما شاهد
113
101
الأوراق
ابتسامتي البلهاء، وكان عليّ أن أستغلّ فرصة انشغاله عني بكتابة التصريح، أخرجت سلاحي وأطلقتُ رصاصتين، فسقط دونما ضجة، وضعت سلاحي تحت قميصي خلف الحزام، وألقيت على الضابط النظرة الأخيرة وخرجت. سرتُ بهدوء إلى السيارة، أتقدم باتجاه محمود، أنظر إليه وهو يراقب عني حركات الجندي، وصلت إلى السيارة وانطلقنا بهدوء حتى إذا ما ابتعدنا عن الحاجز وتجاوزنا المنعطف أسرعنا بالسيارة. ونسيت حماية فخذي من لسعة كفه وهو يقهقه عاليًا، كنت سعيدًا بضحكته وأنا أروي له ما حدث، وهو يقول بكلمات تقطعها شدّة الضحك:
_ يخرب بيتك.. منين جبت هالاسم... أصلًا ما في عيلة حنّو
وظلّ يردّد زمنًا بعدها:
_ حنّو؟؟ .. آه يا حنون إنت.
وضعنا السيارة بعد منطقة «بحمدون»، في مكان يعرفه محمود، تحسبًا لإفادة الجندي الذي شاهدنا كما شاهد السيارة، وأخفينا المسدس فيها، ونزلنا إلى الشارع، كنا قد ابتعدنا بالسيارة مسافة طويلة، أكملنا سيرنا على الأقدام، ما هي إلا خطوات وبدأنا نسمع صوت الرصاص، وانقلبت المنطقة بكاملها، خرجنا إلى الشارع العام، لم نجد سيارة، ثم بدأت الدّوريات، وزادت كثافة الحركة العسكرية فاختبأنا في مكان قريب.كان المكان آمنًا وبعيدًا عن العيون، اشتدّ
114
102
الأوراق
البرد، ولم نجد بدًّا من المبيت هناك بعد أن غابت الشمس وانتشر الظلام، كانت ليلة جميلة رغم البرد، نمنا ليلتنا والمطر يتساقط، وفي اليوم الثاني، بدّلت قميصي الخارجي احتياطًا وعدنا إلى بيروت، في سيارة نقل، تاركين سيارتنا في مكانها الآمن.
في الوقت الذي نزلنا فيه، وكنا قد ابتعدنا عن الخطر تقريبًا، والجوُّ كان لا يزال متوترًا، وما زلنا نسمع صوت رصاص بعيد، والخوف من الدوريات قائمًا، وأنا في قلقي منشغل بمراقبة ما حولي أتابع أيّ حركة قد تبدو غريبة، وفي منطقة «عاريّا» شدّني محمود من يدي بقوّة، وقال: أنظر، كانت هناك مجموعة من الدبابات وعناصر من الحرس، وهمس في أذني:
_ تعال لننزل.. إنه دسم.
لم أوافقه، كنا متعبين بلا نوم، وكان الخطر ما يزال قائمًا، ومحمود يريد أن يراقب ويستطلع لهدف جديد. ضحكت وأنا أنظر إلى حماسته، تلك العملية كانت قد فتحت نافذة في هذا الجوِّ الكئيب، تنفّسنا منها ولم يعد أحد قادرًا على إغلاقها، هكذا كنت أشعر وأنا أنظر إلى محمود وهو يتلفّت ليحفظ المكان الذي مسحته بعيني معه.
عدنا بعد يومين، وقد جلبنا ما نستطيع به تمويه السيارة، وأضفنا إلى سقفها حديدا وبضاعة، وأصرّ محمود على الوقوف على مقربة من ذلك الهدف الدّسم، واستطلاع المكان، وحفظ الطريق، وفي
115
103
الأوراق
الأيام التي تلت أتم الرصد ووضع خطة تحرك، كان يصل إلى محطة بحمدون ويعود، لم يكتفِ بمراقبة الهدف الأول، بل وجد في طريقه هدفين آخرين.
اعتمدنا الهدف الأول، وكما خطط كان علينا أن نتدرّب لنكون أسرع، وأكثر دقة، فذهبنا في يوم عطلة إلى منطقة «بئر حسن»، وهناك كانت المنطقة خالية، وتلال من الرمل، كأنها أُعدت لنا، تدرّبنا أنا برشاشي وهو بقذائفه، لأننا قدّرنا أنها ستكون عملية خاطفة وسريعة، سيكون فيها إطلاق نيراننا كثيفًا وفي وقت قصير، في حركة سريعة ومدروسة.
ذهبنا إلى الهدف الأول الذي اخترناه، وجدنا جنديين واضحين، يحرسان المكان أمام الكوخ، وما في داخل الكوخ لم يكن معلومًا، لا العدد ولا الأسلحة، وعليّ أن أستعمل رشاشي لقتل الجنديين وعليه إطلاق القذيفة الأولى خلف رصاصي مباشرة، وأن أتابع بعدها إطلاق النار لمعالجة من سيخرج حيًّا أو من سيكون قادرًا على المواجهة، استطعنا الاقتراب كثيرًا، أطلقت رصاصي فسقط الجنديان وكانت قذيفة محمود في منتهى الدّقة، لقد طار المكان بمن فيه، تبعته القذيفة الثانية ورصاصي، ولم يخرج أحد من ذلك المكان سوى النار والدخان. لم أصدّق وأنا أكف عن أطلاق النار، سهولة العملية وانسحابنا الفوري.
وبعد أيام، توجّهنا إلى الهدف الثاني في «عاريّا» أيضًا، كان هناك
116
104
الأوراق
مركز كبير، وفيه عدد من الجنود، تخرج منه وتدخل سيارات في دوريات من جنديين أو ثلاثة، تخرج سيارة ثم تعود، نحن خطّطنا ليكون أكبر عدد في المركز حين نهاجمه. وضعنا في السيارة قذيفتين وقاذفًا ورشاشين وثمانية مخازن وانطلقنا، وما إن وصلنا حتى رأينا آلية نصف مجنزرة تخرج وفيها عدد من الجنود يقارب العشرة، فرحنا بهذا الصيد الثمين في آلية واحدة. صارت هي الهدف، انتظرنا الدّورية خففنا سرعة السيارة لتسبقنا الآلية، وسرنا خلفها بعيدًا نسبيًّا، محافظين على مسافة ثابته، شاهدنا منظرًا عجيبًا، فتح الباب الثاني من الآلية، كانت أبواب الآلية مفتوحة، كلا البابين من الخلف مفتوحان على وسعهما، نظرنا إليها وهي محشوة تصعد بطيئة بالجنود، وما إن وصلت إلى آخر منطقة «عاريا»، أول منطقة «الكحّالة»، حتى اقتربنا منها بسرعة، وبحركة فائقة من محمود أطلق القذيفة الأولى بين البابين تمامًا، وفي قلب السيارة، خرجت من نافذتي وأنا أطلق رشاشي دون توقُّف، أصيبُ من أراه، ومع قذيفة محمود الثانية كانت الآلية تتطاير أجزاؤها وهي كتلة من النار، أطلقت الكثير من الرصاص عليها. ثم درت بالسيارة إلى الخلف، ومحمود لا يزال يطلق النار من رشاشه، أدرت المقود في وسط الطريق، وغيّرت اتجاه السيارة، والتهمنا الطريق التهامًا، ونحن نقفل عائدين بسرعة قصوى. لم يكن على الدرب من أحد، تمهلنا قليلاً بعد ابتعادنا، قلت له: فلنرمِ السلاح، لدينا الكثير منه، قد نتعرض لدورية أو تفتيش،
117
105
الأوراق
رفض، ورفض بشدة، رمي السلاح جريمة في نظر محمود، كأنه يحمل عقدةً نفسية أمام هذا الطلب، وضع السلاح في أرض السيارة وغطاه بقماش كان على المقعد وبعض ثياب.
كنا قد ابتعدنا كثيرًا عن كل تلك الطرق المؤدية إلى مكان العملية حين كنا نسمع أصوات الإسعافات وإطلاق النار، وهي تصلنا من البعيد، وكأنها زغاريد فرح من عرس تركناه. نظرت مبتسمًا إلى محمود، وجدته ينظر ساهمًا إلى النافذة، وقد أسند رأسه على يده اليسرى ويمسح بإصبعه زاوية عينه، ضحكت وأنا أرى سبابة يده الثانية تتحرك وهي ترسم خطوطًا قصيرة في الهواء، هكذا يفعل حين يخطط، إنه يخطط للهدف الثالث. ضحكت، وأنا في سريرتي كنت أعلم أنني قادر على إقناعه بالتخلي عن الهدف الثالث الذي يفكر فيه، فالمنطقة أصبحت صعبة بعد كل الذي فعلناه. قادر على إقناعه بالبحث عن هدف آخر، في منطقة ثانية، فمحمود ليس متهورًا، وإن أوحت شجاعته الفائقة بذلك، وهكذا كان.
انتخبنا هدفًا آخر، وكان الهدف الجديد قرب مستشفى الحياة. شرق شارع «غاليري سمعان» في بيروت. لم يكن هذا الهدف بعيدًا، راقبناه كثيرًا... كانوا يخرجون بعيدًا عن المستشفى، أبعد من مركزهم بقليل، ينصبون حاجزًا كبيرًا هناك، تتموضع فيه الدورية لفترة محددة، اتفقنا أن هذه الهدف لا يحتاج إلى قذائف، إنما إلى
118
106
الأوراق
إطلاق نار مكثف. جهّزنا بنادق ذات فعالية عالية، أحضرنا بندقية «جي3»، وبندقية «فال»، وكمًّا كبيرًا من الرصاص. بالقرب من مطعم «الزغلول»، بناء لا يزال قيد الإنشاء، صعدنا إلى طابق مشرف على المكان، حتى أصبح الهدف في مساحة الرؤية واضحًا تمامًا. ولإصابة أكبر عدد من الجنود قرّرنا أن يأخذ كلّ واحد منا هدفًا ويتأكّد منه، وباسم أمير المؤمنين(عليه السلام) نعلن لحظة الإطلاق، لتنطلق النار دفعة واحدة مباغتة على أكثر من مكان.
أخذنا وقتنا في اختيار ساعة الصفر، وكما في أكثر الأوقات، كنا نحضر المشروبات الغازية وبسكويت ماركة «دبكة»، وبكل هدوء نراقب المكان، ليس الهدف وحسب، إنما حوله وفي المحيط، وكنا قد أحضرنا قبل ذلك كيسين من الرمل، لنسند عليهما الرشاشات، كان الرمل من هناك، من مكان قريب إلى البناية، قبل يوم كنا قد أحضرنا كل شيء إلى هذه البناية، نقلنا السلاح والذخيرة، أخفيناها تحت أكياس الرمل، وألقينا فوق الجميع بعض المهملات والحجارة، ودققنا بالتفاصيل، بعد أن أتممنا المراقبة والرصد، ودرسنا خط الانسحاب. وفي اليوم التالي صعدنا، ورتبنا كل شيء بهدوء وببرودة أعصاب، فالمكان كان غاية في الهدوء والسكينة، وضعنا بنادقنا، وسرعان ما أخذنا أهدافنا، هو إلى يمين الحاجز وأنا إلى يساره، وصدرت منه «يا علي» حميمة دافئة، احتضنها القلب وكأنها لم تصدر من الشفاه، كأنها صنعت من خفقات القلب ناعمة حلوة، للآن أسمعها تتردد في أذني.
119
107
الأوراق
كان الإطلاق الأول غاية في الفعالية والوضوح، وبعد ذلك انتشر الجنود يحاولون الاختباء، ورصاصنا يلاحقهم، لقد حقّقنا أهدافنا من الضربة الأولى، وكنا نصطاد حركتهم بسرعة فائقة في الطلقات الثانية. كانت عملية باهرة النتائج غاية في الإحكام والدقة.
كنا نعمل في سيارة «البيجو»، وفي السيارة قرآن صغير بسحّاب، نعتمد عليه في القرار النهائي لاختيار الأهداف وفي التوقيت:
_ «جيدة، ..جيدة»، «لا تفعل.. لا نفعل».
لا أحد يعرف ما نفعله، ولا نقول لأحد ما الذي فعلناه، في المعمل الصناعي تحت الدرج غرفة لنا نضع فيها الأغراض والسلاح المستعمل في العملية.
كان محمود يأتي دائمًا لزيارتي حيث أعمل، كنت أشعر أن لديه معرفة بكل شيء، فهو يساعدني في عملي كصانع ماهر، كشخص خبير متمرس فيه، كانت لديه قدرة مميزة، على التحليل والابتكار، خلّاق في أفكار جديدة، حتى في عمل لم يمارسه سابقًا، قدرته تلك كنا نراها في غير مكان.
كان لدينا عدد من الصواريخ الصغيرة، عدد كبير، حصلنا عليها من الفلسطينيين، وهي معروفة بالحجم، «3,5 بوصة»، كانت لدينا الصواريخ من دون قواعدها، وإطلاق ذلك الصاروخ بلا قاعدته أمرٌ في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلًا، كلّما نظرنا إلى ذلك الكم من
120
108
الأوراق
الصواريخ نتحرّق في حسرة، كنّا في يأس من جدوى تلك الصواريخ، وفي إحدى زياراته نزل معي إلى المخزن، ورأيته يقلّب في أنابيب موضوعة جانبًا، نظر إليّ وقال بثقة:
_ هذه الأنابيب تفي بالغرض.
وجدته يشير إلى قطع من الأنابيب تسمى بـ«أنابيب عشرة على عشرة»، أخذنا قطعًا منها وصنعنا منها قاعدة، لقد تحسّنت السيطرة على الصواريخ كثيرًا، وأصبح بالإمكان استعماله، لكنّنا لم نستطع إصابة الهدف الضيّق الحجم، الهدف الكبير ممكن، كلّما صغر مكان الهدف، احتجت إلى إصابة أدق، فقام هو بشراء صفائح من الزنك بالقطر المطلوب، ولفّها عند معمل يعرفه، ثم جاء بها وأخذها إلى حدّاد إفرنجي وعمل على تلحيمها بواسطة «البابور»، وهناك صنع عدة قواعد جيدة تمامًا، حتى أصبحت الإصابة دقيقة، بل تكاد أن تكون مثالية.
وهنا واجهتنا مشكلة أخرى مختلفة ظهرت بعد الاستخدام، لقد خضعنا لدورات تدريبيّة، لم نكن جاهلين بالعمل العسكري، كنا فنيًا وتقنيًا نعرف الكثير من المعلومات، ولا شك أيضا أننا كنا نحتاج إلى المزيد.
في «خندق الغميق» مركز للقوات متعددة الجنسية يطلّ على المقبرة. وهناك بناية تطل على هذا المركز كنا نرصدهم منها، فهي مشرفة تمامًا على المركز، وبعد رصدٍ طويل استغرق أيامًا، حملنا
121
109
الأوراق
لم تكن في مستوى التهوّر، لكنني وافقته، وذهبنا إلى هناك، انتظرته في مكان قريب وشاهدت حركة الجنود والتفتيش، رأيتهم يقتربون من البناية، ثم حجبهم الجدار عني، استبدّ بي القلق، صرت أبحث عن طريقة للتصرف، وأنا ألوم محمود وألوم نفسي، لماذا سمحت له بهذا التهور، أعلم أنه سيكون حذرًا ذكيًّا كعادته، لكني ظللت أقرّع نفسي وبي ضيق شديد، وأنا أترجل من السيارة من دون أن أدري ماذا أفعل، رأيته يسير من الجهة المقابلة، من خلف المقبرة، رميت نفسي في مقعد السيارة وأنا أقسم أنني لن أسمح له بمثل هذا لاحقًا.
لقد صعد إلى الطابق الثاني وعند وصوله، سمع أصوات الجنود قرب المدخل، فرمى بنفسه من الطابق الأول إلى المقبرة.. كان قلبي ما زال يخفق بشدّة حين عاد، واجهني ببرودة وهو يحدثني، مستغربًا انفعالي:
_ ما بك؟!!
_ ماذا كان سيحدث لو أمسكوا بك؟؟
_ كنت سأشير إليك وأقول لهم إنك من أطلق الصواريخ.
ولمّا وجدني مازلت منفعلاً قال:
_ الأمر سهل.. لو أمسكوني كنت فعلت أي شيء.. ادّعيت الجنون... أو أنني أجمع نفايات مثلًا.
عاد إليّ استقرار نفسي، مقتنعًا تمامًا بما يقول، لعلمي بقدرته.
123
110
الأوراق
كان عنيدًا، لا يستطيع أن يترك سؤالًا دون إجابة، وظل يسأل لماذا لم يخرج الصاروخان، صرنا نبحث عن إجابة في ما نعرف من معلومات، ففي هذه الحالات تكون هناك أسباب كثيرة، ربّما هو عيب في الصاروخ، في التصنيع، والاحتمالات كثيرة، لكنها لم تكن واضحة وحاسمة لتستطيع إقناع محمود، وأصرّ محمود على الإتيان بالصاروخين لمعرفة الخلل، وبعد المراقبة والاستطلاع، صعد إلى البناية، وشاهد الصاروخين في مكانهما لم يكتشفا بعد، أخفاهما في الطابق نفسه، في مكان معزول مموّه، وعند حلول الظلام تحركنا، في سيارة «البيجو 504». كنت أقود السيارة، كان الجنود قد طوّقوا كامل المنطقة وفتّشوا كل المحيط، من دون أن يصلوا إلى أماكن تواجد الصواريخ، لا أدري لماذا، لكن محمود قال بثقة وقناعة كاملة:
_ أعمى الله بصرهم من أجلي.
هذا ما كان يراه محمود دائمًا ويعتمد عليه. كل هذا التعب والمجازفة كان يجدها محمود مبرّرة:
_ رحم الله امرءًا عمل عملًا وأتقنه.
كنت مقتنعًا في سريرتي على الرغم من اعتراضي، فأنا لا أريد أن تخذلنا الصواريخ في عملية قد تكون غاية في التعقيد والأهمية، جاء بهما وأنا في قلقي كنت بالانتظار، وضعنا الصاروخين في السيارة وانطلقنا إلى مكان آمن، وهناك صرنا نبحث عن الخلل.
124
111
الأوراق
كان إطلاق الصاروخ كهربائيًا، سألنا وبحثنا مع ما لدينا من المعلومات القديمة والجديدة، عرفنا أن الرطوبة وصلت إلى الصاعق، وهذه الرطوبة منعت من الاشتعال، أي أنها مع قوة الكهرباء الضعيفة تصبح الرطوبة قادرة على منع الاشتعال، واكتشفنا أننا نحتاج إلى كهرباء أقوى لتخطي هذه المشكلة، لا تكفيه بطارية «9 فولت»، وقررنا أننا بحاجة إلى بطارية سيارة، «12 فولت»، «50 إلى 60 أمبير».
هكذا كنا نعمل، بالإمكانات، الضعيفة المتوافرة، كنا نستعمل ساعة الزمبرك، نثقبها ونوصل فيها شريطين، كانت كل أعمالنا يدوية، دون استعمال للساعات المؤقّتة أو الرقميّة، في المعمل ويدويًا كنا نجهز كل شيء.
ومن العمليات الجميلة تلك العملية على طريق المطار، كان لقوات متعددة الجنسيات مركز هناك يسمى (نقطة 113)، في أول منطقة «الغدير»، ومركز للمسلحين المتعاملين مع الاحتلال. اخترنا هذه النقطة بعد معاينتها، واتفقنا على أن نراقبها بدقة، وزعنا الوقت بيننا، هو كان في النهار وأنا في الليل لارتباطي بعملي في النهار، كنت أعيره السيارة أحيانا، وكنا أحيانًا نستعمل الدراجة الناريّة حين لا تكون معنا السيارة.
بعد المراقبة والتخطيط، كان علينا جمع الصواريخ مع القواعد
125
112
الأوراق
التي صنعناها، واخترنا مكان وضع الصواريخ، ليكون مشرفًا على المكان المستهدف، ويجب أن يكون قريبًا من الشارع لتأمين خط الانسحاب. حملنا الصواريخ، ومن ضمنها الصاروخان اللذان فشلا في العملية السابقة، وفي ساعات الفجر الأولى، نصبنا الصواريخ لنستطيع تحديد الهدف على ضوء النهار كي يكون الهدف واضحًا، وقبل بدء حركة المارّة، ثم غطينا وموّهنا الصواريخ، اشترينا شريط كهرباء طويلًا، اشتريناه من منطقة بعيدة عن مناطقنا، لمجرد الاحتياط، كنا حريصين على أن لا يُكشف أمرنا، واستعملنا، زيادة في الحرص، سيارة ثانية مستأجرة، سيارة مرسيدس «قطش»[1]، تأكدنا من أن شرارة «القدّاحة» في السيارة تعمل، وصلنا إلى المكان، ثبّتنا الشريط ومددناه، كانت المسافة من الصواريخ إلى السيارة عشرين مترًا تقريبًا، مددنا الشريط على طول تلك المسافة، وجلسنا في السيارة وضع محمود «القداحة»: «بسم الله»، وزغردت الصواريخ. وبدأ العد؛ واحد، اثنان، ثلاثة.. وما أن أطلق الصاروخ السادس، حتى بدأنا بسحب الشريط على عجل من نافذة السيارة، لم يكن سحب الشريط لغاية أمنيّة، بل لغاية مادية، أنت لا تصدّق، فهذا الشريط نريد استعماله في أماكن أخرى، وقد جمعنا ثمنه بصعوبة، فليس من السهل الحصول على شريط طويل وجديد مثله، وما إن أصبح الشريط بكامله في السيارة، حتى كانت السيارة تلتهم الطريق بسرعة فائقة، وعلى زجاجها تلمع ألسنة اللهب، شاهدنا بأعيننا كيف كان المستوعب الكبير يحترق...
[1] نوع من سيارات المرسيدس المصنوعة في السبعينيات.
126
113
الأوراق
محمود سعيدًا:
_ شفت.. طلعوا كلن.
قامت الدنيا بعدنا ولم تقعد، وتحدثوا في الأخبار عن إصابات عديدة، كانت العملية جيدة، وذات أثر واضح ضمن العمليات التي قمنا بها.
لم تكن تلك العمليات متقاربة زمنيًا، ثم تباعدت في الفترة الأخيرة حتى انقطعت.
ذهب بعدها محمود إلى إيران لفترة قصيرة من الزمن، شعرت بطولها يمتد حتى ليكاد لا ينقضي. كلَيلَةٍ موحشة طال سهادها، كنت أجهد في العمل مع الإخوة، مرة لأخففّ وطء شوقي ووحشة أيامي من دونه، ومرة لأحاول لمّ الفراغ الذي تركه. يا لوحشة فراقك فينا، وما يفعله غيابك! في صمت المنازل وجدرانها، في وحشة الساحات وطول الدروب، لماذا كنت أشعر معك أن الدروب قصيرة؟! هي الآن طويلة جدًا، وفي السهرات وإن اجتمع الإخوان بقيت سهرات مطفأة أو شحيحٌ نورها، يلف كثيرًا من دقائقها الصمت، وما تلبث السهرة أن تنفك، يتعلل الأخ تلوَ الآخر بمهمة أو تعب، علل ليست حقيقية، العلة الحقيقة هي غيابك، نذكرك في غضبك وضحكاتك، جدك ومزاحك، ونعد لك الأيام حتى تعود.
127
114
الأوراق
وعاد محمود، زهيًّا يانعًا كأخضر الربيع، يبعث الحيوية كشروق شمس يوم جديد، كبداية يوم مفتوح على المدى، وتلك السعادة التي غمرتني بعودته لا تشبه أي شعور آخر. وعدنا نخوض في الساحات معًا ونسلك الدروب التي عادت قصيرة من جديد، قصيرة جدًا.
عاد محمود روحه لامعة مصقولة، كزجاج تقلب بين الشمس والمطر الغزير، واضحًا مشعًا عاد، عاشقًا حاسمًا في انتمائه لولاية الفقيه بأكثر مما كان، وقد كان كثيرًا، ولكنه حين عاد أضحت بصيرة، بصرًا كالحديد، يلبس قميصًا بلون عسكري، يرتديه غالبًا أو دائمًا لأن على ظهره رسمت القدس وقبة الصخرة كما الشمس يعلن انتماءه بلا حذر.
وقتها كانت الحكومة المقرّبة من الاحتلال، تتجه تدريجيًا لإعلان العداء للخط الثوري، حتى أعلنت في وقت لاحق قطع علاقتها بالجمهورية الإسلامية في إيران، وأغلقت سفارتها في بيروت.
في واحدة من سهراتنا جاءنا محمود، وقد أعدّ في النهار لافتات تندد بقطع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وتندد بالحكومة
129
115
الأوراق
العميلة، وعددًا كبيرًا من صور الإمام الخميني، ونظر إلينا في عبوسه الذي نعرفه كلما أراد تنفيذ مهمة، وحسم أمرها، ويريد بعبوسه حسم أي نقاش، ووضع أمامنا عددًا من الأقنعة وقال حاسمًا: أريد تعليقها في كل مكان، الآن في هذا الليل، من يريد أن يذهب معي فليأخذ قناعًا. لبس الإخوة الأقنعة واستعدوا للذهاب، ورفض هو أن يلبس قناعًا، فرفضت أنا وصديق ثالث أن نلبس أقنعة أسوة به. وانطلقنا، نلصق الصور والكلمات في الشوارع والساحات والأماكن العامة، ويصر محمود على الذهاب بالصور إلى الأماكن الأكثر حساسية وبعدًا عن الثورة، سعيدًا يتحرك بسرعة، إلى آخر الليل، حتى عدنا وأيدينا جميعًا فارغة. نمنا من تعب، لنستفيق على سعادة محمود بما تركته تلك الصور من أثر وضجة.
وبقينا نعاند مع محمود توجّه الحكومة المعادي. وتمر الأيام قصيرة سريعة، حلوة ومرة.
منزل ذاكرتي مأهول بالكثير من تفاصيل تلك الأيام العزيزة، أيام محمود وزمن البديات، ذاك الزمن الذي بقيت فيه أكثر الأماكن إضاءة في الذاكرة، والذاكرة يا صاحبي كمدينة كبيرة، بعضها مأهول وبعضها مهجور مستثنى، مضيء هنا ومعتم هناك، جميل معشوشب مزهر وإلى جانبه صحراء، وبين هذا وذاك ما هو وسط قد غامت بعض أجزائه. وأجزاء واضحة لقبحها وأخرى واضحة لجمالها.
130
116
الأوراق
أكثرها وضوحًا وحضورًا حين صرت أرى على محمود بعض التغيير، وأنا أستشعر أي تغيير في محمود، مهما كان طفيفًا ومموّهًا، لفتني غيابه غير المبرر، وحين يأتي كان صمته أكثر من المعتاد، بل كان صمتًا طويلاً، وإن تحدث فباختصار، ثم يلوذ بالصمت، ويشرد بذهنه، يترك جسده عندي ويغيب مسافة طويلة، حاولت أن أستحثه، أن أعيده إلى ما كان عليه، كان مشدودًا إلى مكان أجهله، مشكلة أجهلها، لا أستطيع تركه وشأنه لشدة تعلقي به وخوفي عليه، قلقي عليه جعلني أتوقع أن في هذا التغيير مشكلة ما تواجهه ولا يريد الافصاح عنها وكلما سألته مابك؟ قال:
_ ما في شي... ما رأيك بـ...
ويغير الموضوع، وأراه يغيب عني أكثر مما اعتاد، وكلما سألته:
_ ما المشكلة يا محمود.
تهرب أو قال مازحًا:
_ أنت أكبر مشكلة بحياتي.. مشكلة كبيرة مثلك تكفي.
ولم أعد لسؤاله على الرغم من قلقي عليه، ثم بدأ محمود أكثر شرودًا مما مضى وأكثر صمتًا، وفي وقت هادئ، وفي واحدة من تلك الليالي الساكنة، وبعد صمت طويل سألني دون أن ينظر إليّ:
_ لماذا وضع الله في المرأة أجمل كل شيء
131
117
الأوراق
لم أجد جوابًا لهذا السؤال الذي فوجئت به، فقلت مستغربًا:
_ كيف يعني؟ .. لم أفهم!.
يحدثني وقد تاهت عيناه في المدى الليلي العميق الممتد أمامه، بصوت خفيض ساكن يكاد لا يسمع، يحدثني عن هذا الكائن الرقيق الذي -كما قال عنه- يكاد لرقته يتكسر، وعن قدرتهن العجيبة في الإمساك بالزمان والمكان، حتى لا يعود لأي وجود أثر، ثم ينظر إليّ في حنق، ويقول غاضبًا:
_ لماذا أحدثك في هذا الموضوع وليس في صدرك سوى حجر؟
ضحكت كثيرًا، لا من غضبه ومزاحه، بل لأنّني أمسكت بطرف الخيط، الخيط الذي يقودني إلى المنطقة المجهولة، المنطقة التي كانت أسئلتي تدور حولها ولا تجد مدخلًا، أدور حولها حاملًا قلقي على محمود وما اعتراه من تغيير، سعيد أنا بإمساكي طرف الخيط الذي سيقودني لمعرفة المشكلة والخروج بمحمود منها، أو السير معه في خضمّها، هو لا يريد أن يتحدّث، لكنّه عامداً جعلني أمسك بطرف الخيط، يقول: «في صدري حجر»... لماذا يتحدث عن المرأة الآن؟ عن رقّتها؟ عن المعاني الجميلة فيها؟ ما الذي حدث ليدرك الآن ذلك؟ كم من النساء مررن أمام حياته الصاخبة الغنيّة؟ بعضهن جميلاتٌ وأكثر، رقيقاتٌ وأكثر، لم يكن يعنيه هذا، وكأنّ كلّ النساء شقيقاته، أو هنّ كباقي البشر، كالآخرين جميعاً، يعنيه إن احتجن للمساعدة، أو
132
118
الأوراق
تعرّضن لخطر، هن جزءٌ من هذا المحيط الذي يهتمّ به، إنسان، والانسان رقم عند محمود، رجلًا أو امرأة، طفلًا أو مسنًّا، والأنثى ضمن هذه الدائرة دون تمييز. ما الذي جرى إذاً؟!.
صحيح أنّني لم أفكر بالمرأة، كشريكٍ لانشغالي أوّلاً، ولحساب الأولويات والظروف المناسبة، لكن قلبي - الذي وصفه محمود بالحجر - كان يخفق إن مرّت جميلة بالقرب منه، وإن أنا أدرت رأسي أتابعها بانجذاب، نهرني محمود، وشدني اليه قائلا:
_ امشِ.. لا تكن مراهقاً سخيفاً.
وإن تحدّث الرفاق عن جمال هذه، وروعة تلك، كان يعترض، يتحدث الرفاق همسًا بمثل هذه المواضيع، أو يقطعون الحديث حينما يدخل، أما هو فلم يتحدث عنهنّ يومًا بهذه الطريقة التي يتحدث بها الآن، نظرت إليه ابحث عن جواب، كان صامتًا ينظر إلى أبعد نقطةٍ في المدى، ثمّ يرفع عينيه الى ما فوق خط الأفق، ينظر إلى السماء وكأنّه يريد الابتعاد أكثر، قلت لنفسي: فتح هو باب هذا الحديث، وأمسكني طرف الخيط عامدًا.
أحرّض نفسي وأدفعها، أن لا تفلت طرف الخيط، دقّ الحديد وهو حام. نظرت إليه بإصرار وقلت:
_ قلبي من حجر، فما الذي حلّ بقلبك؟!
نظر إليّ وقال بعبوس وحزم:
_ أترك قلبي خليك بحالك.
133
119
الأوراق
ثمّ عاد بوجهه إلى الأفق، وعاد إلى صمته. ندمت على كلامي وسؤالي، ليس محمود من تحرّضه الأسئلة، محمود كالطيور الحذرة التي كنّا نقطع الأنفاس كي لا تطير، محمود يحرّضه الصمت، لذت بالصمت وأنا ما زلت على لهفتي ممسكاً بطرف الخيط ، سمعته يقول كأنما يحدّث نفسه بهمس:
_ أمر عجيب... ... خارج عن الإرادة.
ثمّ التفت إليّ وقال:
_ هل شعرت يومًا بالحب لامرأة ... غير أمّك و عمّتك طبعاً.
ضحكت وزغردت عصافير قلبي لا من تهكّمه و مزاحه، بل لأنّني بدأت أسير مع الخيط، قلبي يخفق، فأنا على وشك الدخول، باب السرّ يتململ. قلت: لا، وحدّثته عن وجهة نظري وأنَّ لكلّ شيء وقته وظروفه. أطرق برأسه كمن ينظر إلى شيءٍ في الأرض وسمعته يقول:
_ إلّا هذا يا صاحبي... ... يأتي هكذا... من عالم الغيب.
نظرت إليه وأنا أمسك قلبي وقد لانت ملامح وجهه، ذهب العبوس منها والشدّة، بدا كالطفلٍ حائرًا ممّا يعتريه، صامتًا أنظر إليه وأقول في نفسي: تكلَّم يا صديقي تكلَّم، جئت إليَّ اليوم لتسكب أوجاعك على أرض قلبي فافعل، كلّي آذان صاغية. وكأنّما سمع ندائي الصامت، التفت اليّ وقال:
134
120
الأوراق
_ أتذكر منذ فترة، حين كان القصف شديدًا وجمعت منك ومن الأصدقاء مالًا؟
تسارعت دقات قلبي، لقد بدأ الجدار بالانهيار، فقلت أتابع تحريضه بلهفة:
_ لشراء حصصٍ تموينيَّة للعائلات... أليس كذلك؟.
هزّ برأسه أن نعم، صمت وأعاد بصره إلى الأفق، ثمّ بدأ بالكلام بصوت خفيض، يفصل بين جُمله صمت متردد، كان في البداية كمن يبحث عن الكلمات، وبعدها اتصلت الجمل، واتضح الصوت، وانساب الكلام هادئًا بلا عوائق، وكأنه لم يكن يتحدث إليّ، كمن يحدّث نفسه، نسي وجودي أو تناساه، أو كأنّه يحدّث ملائكةً انتشروا على مدى الأفق الذي ينظر إليه. لقد انفتح الباب، طارت أسراب كلّ العصافير المحجوزة في قفصه الصدري، وأنا أمسك قلبي وأستمع إليه كما لم أستمع لأحد.
حدثني عن ذلك اليوم المشهود له بالقصف الشديد، كان في محلة «المصيطبة» يعمل مع صديقٍ لنا على جمع الحصص التموينيّة وتوزيعها على المحتاجين، الشوارع كانت خالية، وكذلك المباني، فقد نزل السكان الى الملاجئ والغرف الداخليّة في الطوابق الأرضيّة، وإذا بمحمود ومع صوت الانفجارات القويّة، يرى فتاةً
135
121
الأوراق
لم تتجاوز الخامسة عشرة تقف على الشرفة، تنشر الغسيل ببطء وتمهّلٍ، رابطة الجَنان وكأنّ شيئًا لا يحدث، تعجّب من أمرها وهو يرى حركتها الهادئة، وثباتها أمام أصوات الانفجارات، نظر إليها جيّداً في إعجاب بشجاعتها، حدّق في وجهها عساه يرى أثراً للخوف، وإذا به يرى جمالًا رائقاً في هدوئه يصعب على العيون مغادرته، تعجب محمود مرّة ثانيةً! هذه المرّة تعجّب من نفسه واستنكر: «دع بنات الناس لحالهنَّ... لكم هي شجاعة ورقيقة... ما بالك يا محمود!!...».
سحب محمود نظره بقوّة أخفض رأسه وتوجّه بجسده إلى داخل المبنى يتابع عمله كمن يفر. لكنّه كلما خرج بالحصص في مواجهتها يعيش صراعًا لا عهد له به: «لنر فقط إن كانت ما تزال واقفة وتعمل بنفس الهدوء السابق» ينظر باتجاهها... حمامة سلام تقف بين الثياب المنشورة كملكةٍ يصطفّ حولها الحرس، تتلفت برأسها الناعم المتوّج بغطاء رأسٍ أنيقٍ، تمسح المكان بعينين ساحرتين، «محمود... ما بالك يا محمود؟» ويعود الصراع الداخليّ، ويجرّ محمود بصره وجسده، يدخل ثمّ يخرج بالحصص... «هل مازالت واقفةً؟» رفع بصره وما كاد يستقر على الوجه المحبّب حتّى التفتت إليه واصطدمت العيون، خلّف الاصطدام تياراً اخترق جسد محمود وقلبه، انسحب جريحًا إلى الداخل، لقد أصيب، أصابته غير تلك الإصابات التي يعرفها جسده، إصابة مختلفة
136
122
الأوراق
في الشكل والمضمون، في استجابة الروح.
في المرة التالية خرج هو وصديقه، لم يجد بدّا من سؤاله:
_ أتعرفها؟
_ من؟
_ هذه التي تنشر الغسيل؟
_ هي قريبة زوجتي...
حين شاهدَتهما ينظران إليها ويتحدّثان ارتبكَت وسارعَت في عملها، وفرت إلى الداخل، وبحركتها الاخيرة قبضت على قلبه كقبض المنتصر على الأسير.
حين عاد إلى منزله كان جسده يئنّ تحت سطوة التعب من العمل السريع في الحصص التموينيَّة، وروحه تئنّ من سطوتها وسطوة الصراع الداخلي. سار وحيداً إلى المنزل، يجرّ نفسه بكلا التعبين، وطيفها ظل يحوم حوله، لا يريد المغادرة، شاغله وتشاغل عنه بعمل هنا وهناك، لكنَّه ما لبث في الليل أن عاد يحوم، معزّزا هذه المرّة بسكينة الليل، ومحمود يتقلّب من جمر تلك السطوة، يقرّع نفسه ويلومها، والصراع يشتدّ: «ما بالك يا محمود؟ الخلق والدين وبنات الناس أمانة يامحمود... لا تفكر برؤيتها مرّة ثانية».
تمرّ الايام والصراع يشتدّ دون حسم ومحمود الذي يجيد حسم الصراعات يلوم نفسه، لم يجد الّا وسيلة واحدة لحسم هذا الصراع،
137
123
الأوراق
القصد الشريف، وحسم الأمر، يعرف عنها ويتعرّف اليها، فإن تعزَّز ائتلاف الروح ستكون شريكته وزوجته. واشترط على نفسه أن لا يتجاوز أبسط المعايير الدينيّة وأخلاق البيئة.
حسم أمره واستعان بصديقه وزوجته القريبة منها، عرف ما يريد عن الأهل والسمعة وغير ذلك الكثير، وأراد التعرّف إليها عن قرب، فساعدته في ذلك قريبتها حين اصطحبتها الى حديقة «الصنائع العامّة» متنفّس تلك المنطقة، قد اعتادت الفتاة الذهاب إليه سابقًا، لقاء في مكان عام قريب وبصحبة زوجة صديقه، وكان اللقاء مؤنسًا، أو كما قال محمود: كأنَّك وجدت نفسك.
لم يلتقِ بها وحيدةً إلا بمصادفاتٍ نادرة يقطعها بنفسه أو يقصّرها ما استطاع، لكنّه بعد وقت قصيرٍ بدأ يشعر بالذنب، يلوم نفسه،: «إن كانت اللقاءات الأولى مبرّرة بالمعرفة فما بالك تستمر يا محمود وقد سكنت روحك إليها؟» لم يرض محمود لنفسه ذلك رغم الأيام القليلة وقصر اللقاءات.
كان يرافقها وهي تنزل الدرجات من عند شقيقته، توقّف بعد الدرجات الأولى ونظر إليها وقال بحزم:
_ سأذهب الى أهلك غدا وأطلبك منهم.
نظرت إليه على اتساع عينيها لثانية، ثمّ وضعت كفيّها على وجهها وانخرطت في البكاء، صدمه الموقف الغريب! ارتبك وحار في ما يفعل!
138
124
الأوراق
بدا كطفل أخطأ خطأً جسيمًا من دون قصد، وهرب من فمه الكلام قبل تنسيقه، ما بكِ؟ ... ماذا؟ .... أرجوك! ... آسف!... هل؟ ... ماذا أصابك؟ أرجوك لا تبكي، قولي لي. وبكاؤها يشتدّ، وكأنها لا تستطيع الكلام، يدفعها البكاء إلى مزيد من البكاء، حتى إذا قال لها: إن كنت لا تريدين الزواج بي؟ قالت على الفور وهي تبكي:
_ أريد ولكنّك فاجأتني... لم أتوقع هذه السرعة.
تريث الأهل في البداية، رغم معرفتهم لمحمود وأهله، سمعته وسمعة أهله الطيبة ليست كل شيء، اعترضوا لصغر سنه، يعيش الخطر وعدم الاستقرار، سكناه خارج برِّ الأمان، وهذا ما لا يريدونه لابنتهم، ومحمود لا يسرق ولا يعرف الدخول من غير الأبواب، ويريدها، على سنّة الله ورسوله، يريدها.
وكما هو دأبه إذا أراد ما هو مقتنع به، حاول من جديد، سعى بنفسه، وحضر عندهم زمنًا تفتّح أمامهم عطرًا نديًّا لا يمكن إغفاله، حديثه وما تميز به، صعب على من يعرف محمود عن قرب أن يكون في غير صفه. أخذهم كل ذلك الى الموافقة.
بعد زمن قصير، شهر أو أكثر بقليل، عجّل في عقد القران على الرغم من الظروف الأمنية، عُقد القران دونما احتفال، جرى العقد في المحكمة بأضيق دائرة من الأقرباء.
139
125
الأوراق
وبموازاة هذا الجميل، نمت أوجاع شتى، إذ انسحبت قوات الاحتلال والمتعددة الجنسيات إلى أماكن مغلقة، مفسحة المجال لحكومة أصبحت منحازة للخيار الإسرائيلي تمامًا وبوضوح، وقد تبنته خيارًا وحيدًا، حتى أجبر الجيش اللبناني على تغيير عقيدته ليصبح اليد الإسرائيلية الضاربة، وتقرر تصفية الخيارات الأخرى بكل الحسم العسكري والقوة الظلوم، مستغلة حاجة الناس للأمان، وتلك الثغرات الهائلة التي تركتها الحرب الأهلية وأخطاء الكثير ممن حمل السلاح، عملت مخابراتها وأجهزتها الأمنية المدعومة بتعقب كلّ الفاعلين على الأرض، ونحن منهم، وعلى رأسهم محمود فهو الأول في القائمة.
خُدع الكثير من الناس، حتى بات البعض مقتنعًا بما تريده الدولة، بل ساعدوها في الحصار الأمني والعسكري على «فتح الله»، واستقدمت قوة من منطقة «الأوزاعي»، ومن «خندق الغميق»، ومن «وادي بو جميل»، وحاصرت «فتح الله»، وحاولت اجتياحه لاعتقال هذه المجموعة التي أصرت على العناد، تمامًا كما كانت الأحزاب تحاصرنا وتحاول اقتحام المكان.. لكنها كما في الماضي لم تتمكن من ذلك رغم تكرار المحاولات.
ومرّ زمن عصيب، عصيب جدًّا... في بدايته، كنا نعمل ما نستطيع رغم المطاردات والتضييق. بقينا في صمودنا، ننتقل دائمًا إلى الخط الثوري، وقد أصبح لنا مع الوقت وجود بمساعدة إيران والحرس
140
126
الأوراق
الثوري، ودائمًا هناك من يحاول منع وإخماد ثورتنا وجذوتها.
تجمع أثناء حصار بيروت الكثير من السلاح، وعدد من كان هذا خيارهم ما زال كبيرًا، والمجموعات ما زالت عاملة تنشط وتتواصل. فتح محمود مركزًا قرب الدرج العريض أمام المنزل، كان هناك في بناية حويلي، وفي المستودع كنا نجمع الذخائر والأسلحة المتروكة بعد الاحتلال وذلك الاستسلام المهين. ومن هناك كنت أنا ومحمود ورفاقنا نوزع الأسلحة لأمثالنا. وننقل ما استطعنا من السلاح المتوفر لدينا، والذي خزنّاه سابقا، إلى الضاحية ومن الضاحية إلى الجنوب وأماكن أخرى، نضعها بأكياس وننقلها سراً في إعداد مسبق للمرحلة التي تلت، ومن ذلك السلاح كان المدد الأول لأعمال المقاومة بكل انتماءاتها، ومع هذا السلاح وضعت الخطوط الأولى للعمل الكبير.
بعضنا مطلوب بالاسم، وعلى رأسنا محمود، كان من بين إخوة محمود أخوه محمد، الأكبر منه بقليل، تعرض للاعتقال بسبب محمود، آلم ذلك محمود كثيرًا، فهو أكثر إخوته قربًا منه، منذ أصيب محمد في منطقة «الكحالة» خلال حرب السنتين في أول الأحداث، ومحمود ملتصق به.
وظل محمود طريدًا لا يعرف الراحة، ومتى ارتاح محمود؟ خارج المنزل دائماً أو في أكثر الأحيان، حياته كلها قلق، لا هدوء فيها، فهو بالنسبة إلى أهله دائم الغياب، لم يكن تواجده في المنزل إلا قليلاً، ولم
141
127
الأوراق
تكن هناك إلا صورة الخطر والمعارك، من الأحزاب والفلسطينيين، إلى مواجهات مع الاحتلال، ومع الجيش والمخابرات، كان دائمًا مطاردًا أو مقاتلًا خارج المنزل.
أقيمت عليه دعاوى كثيرة، فطاردته القوى الأمنية بحجة تلك الدعاوى، كانوا يريدونه بأية حجة وبأية وسيلة.
منزله ملاصق لمنزل الشهيد «صلاح فارس»، كلما جاء أحد لاعتقاله يقفز إلى السطح ويخرج من منزل صديقه متخفياً، وكان الحي كله قاطبة يحميه، فما أسهل أن يغطى انسحابه.
رجال الاستخبارات يعرفون مكان تواجده لكنهم لا يجرؤون، ترتعد فرائصهم بمجرد التفكير بمواجهته، كانوا يهربون منه وهو المطلوب لديهم.
جاء دركي جديد في أحد الايام، عملاق ضخم الجثة، فخورٌ، واثق من جسده وسلاحه، طرق الباب، وكان محمود في المنزل، بعيدًا عن سلاحه حين فتح الباب، سمح محمود للدركي باعتقاله من دون مقاومة، ربما لأنه خاف على أهل بيته من معركة داخل الدار، فاعتقله ووصل به إلى السيارة، ووضعه فيها طالبًا منه أن يقود، وما إن سارت السيارة مسافة، حتى شدّ محمود فرامل اليد، فماجت السيارة واختل توازنها، استغل محمود هذا الوضع وعالجه بضربة قوية على وجهه وغادر السيارة.
141
128
الأوراق
كان الدرك يسعون لاعتقاله لأن اعتقاله سيرفع من رتبهم، غير أن هذا الدركي الضخم لم يكن يعرف محمود. جاء إليه وحيدًا، وبشكل مفاجئ ظنًّا منه أنه سيعتقله ويحصل على رتبة جديدة، إلا أن ما حدث كان مختلفًا عن تصوّره، عاد متورم الوجه، مهانًا، وعاقبته قيادته على ذهابه منفردًا وبلا إذن، ونقل إلى عمل آخر بعد تخفيض رتبته.
وتمرّ الأيام، نشعر أننا في نفق يزداد ضيقًا، ومحمود بكل طاقته يحاول المتابعة ونحن معه، قلة تحاول دون أن تتخلى عن خياراتها، في الولاية والثورة ومقارعة الظلم، في حين اختار العديد من الإخوة الركون إلى هذا الوضع، والتخلي عن ذلك الخط الصامد والمقاوم الذي كان رمزه محمود وطاقته التي يمد بها من تبقى من الإخوة في منطقتنا، لم يستطع محمود الركون أو التخلي، لم يتسرب إلينا اليأس كما تسرّب إلى عدد من رفاق الجهاد، فنحن مع محمود، وباب اليأس مع محمود مغلق بجدار، يبحث عن فرصة في درب، ومنفذ ليواصل العمل، حتى وإن كان التوقف عن العمل له ما يبرره، كان يرفض هذا التبرير بشدة، ويعتبره جبنًا ليس إلا، عليه البحث عن فرص وطريقة لمتابعة العمل الذي يرى محمود أن لا بدّ منه، المتابعة على الرغم من كل شيء أصل الفكرة عنده، هي الحياة بكلها، يردد جملة للامام الصدر المغيب، ويؤمن بها إيمانًا حاسمًا: أنتم يا أخوتي الثوار كموج البحر متى توقفتم انتهيتم. يرددها أمامنا كلما شعر فينا ببعض التراخي أو شاهد في عيوننا إحباطًا متكاسلًا.
143
129
الأوراق
ومن تلك الفرص، ما طرح عليه في الذهاب إلى الجنوب، وكان أساس الفكرة إبعادنا نحن ومحمود عن الخطر هنا، والذي أقنع محمود بالذهاب هو ما قيل له عن مهمة ترتيب أمر السلاح والذخائر، تلك التي جمعناها في الفترة السابقة ونقلناها إلى الضاحية ومنها إلى الجنوب، كان المطلوب متابعتها وتوزيعها إلى أماكن أخرى في الجنوب، تخزينها كرصيد مجمد حتى يحين الوقت، وتتهيأ الظروف، وتسنح الفرص لمقاومة الاحتلال في الجنوب، رغبة بعيدة عن الواقع في ذلك الوقت، حلم يتابعه محمود في يقظته كما في المنام. كان ذلك حين وصل الأمر إلى مكان ضيق تصعب فيه الحركة، ووصل الأمر إلى ذروته بعد وصول معلومات أمنية خاصة، طلبت القيادة منا أنا ومحمود وأسماء أخرى، أن نغادر إلى الجنوب. وفي الضاحية وزّع علينا الحاج مالاً كيفما اتفق، ومن كان لديه مال يعطي من ليس لديه، بلا حساب للكم والكيف، وأمّن لنا طريقة للخروج من الحواجز مع ضباط للجيش وعائلاتهم.
ذهبنا إلى بلدة «سلعا»، وكان الجو أكثر توترًا، تركنا «سلعا» وتوجهنا إلى قرية «صريفا»، حيث لا يعرفنا أحد، ذهبنا سيرًا على الأقدام وحين نرى حاجزًا ننزل إلى الأحراج والوديان، نلف مسافة طويلة من خلف الحاجز، حتى وصلنا إلى «صريفا».
لم يكن الجنوب وقتها جاهزًا لمقاومة الاحتلال، لأن العدوّ كان
144
130
الأوراق
يرتدي رداء المنقذ، ويعامل أهالي القرى بودٍّ متعمّد، لم تكن البيئة على العموم بيئة حاضنة للمقاومة، ومهمتنا محدودة في لقاء بعض الإخوة المتابعين سرًّا، ومساعدتهم في مهمة إخفاء السلاح ونقله إلى أماكن أخرى، والاطلاع منهم على الأوضاع بشكل عام.
بقينا في «صريفا» أيامًا ثم توجهنا الى «الشهابية»[1]، ومنها الى بلدة الشرقية، وسكنّا في بيت عم أحد الإخوة الذي معنا، وسكنا هناك أيامًا، التقينا فيها بأحد المجاهدين هناك، وعملنا على التعاون معه، أيام مرت نقلنا أسلحة، وشاركنا في رصد حركة جيش العدو وجمع ما استطعنا من أخبار عنه وعن العملاء العاملين معه، في عمل حذر، يخبرنا بالأوقات المناسبة للتحرك والمسالك التي يجب أن نسلكها.
خلال هذه الفترة التقى محمود «الشيخ راغب حرب»[2] وطلب إليه العون والإرشاد، وعاد وهو محمل بالحب والتقديس لهذا الرجل العظيم المتواضع، جاء متوهجًا كقنديل أضيف له المزيد من الزيت.
لم تكن حركتنا سهلة، في بيئة غير معدة لبقائنا، بيئة في أغلبها لم تكن على قناعة بالمقاومة، مقتنعة أن الاحتلال جاء بمهمة وسيعود دون ضرر.
[1] صريفا والشهابية: بلدتان في جنوب لبنان.
[2] عالم دين من جبشيت جنوب لبنان - كان له دور أساسي في العمل الجهادي المقاوم. اغتالته قوات الاحتلال الاسرائيلي سنة 1984 فكان شيخ شهداء المقاومة الاسلامية.
145
131
الأوراق
وبعد مرور أسبوعين تقريبًا، وبالرغم من الاحتياط الشديد، وربما لأننا غرباء عن البلد، جاءت الأخبار بأن أسئلة بدأت تدور عنا، وأن علينا المغادرة في أقرب وقت ممكن.
لم نكن نستقر بعد ذلك في أي بلد لأكثر من ليلة أو ليلتين، وبعد أن بقينا خمسة رجال ومحمود، في مثل هذه الظروف، ولأننا غرباء كان الاستقرار مستحيلاً، فالعين على الغريب كما كان يقال، وعدم الاستقرار بلا عمل تقريبًا جعل صدورنا ضيقة حرجة، ومحمود الذي ما اعتاد السكون، عاد يدور كأسد سجين يبحث عن مخرج، والمخرج عنده أي عمل مجدٍ يصرف فيه طاقته المتوقدة، أيّ منفذٍ لنهر عِشقه وعطائه.
تناقشنا في سهرة أن لا بدّ من التصرف، والتخلص من هذا الحال، وكان خيار العودة إلى بيروت، إن لم يكن في مناطقنا ففي الضاحية، واقترح أحدهم على محمود حلاً يناسبه، استطاع إقناع محمود به، ومفاده أن أصل مشكلتنا هو كوننا غرباء يجعل العين علينا مفتوحة، وبما أن هناك ثلاثة من بلدة ميس، بلدة محمود، فلماذا لا يذهبون إلى هناك ويقومون بما يستطيعون فعله. واتفقنا أن يذهب الثلاثة إلى ميس الجبل وأعود أنا مع الأخ الخامس إلى بيروت. قرار وافقت عليه على مضض، وخفت أن يطول فراقنا، وبعض قلبي في صدر محمود، اضطر محمود أن يهدئ من روعي بعهد أن لا يطول الفراق،
146
132
الأوراق
وأنه سيرتب الأمر خلال أيام، إن وجد الاستقرار مناسبًا في ميس الجبل فسوف يستدعيني لأعمل معه، وإن لم يكن العمل مناسبًا سيلحق بي إلى بيروت.
ومع الفجر نزلنا أنا وصاحبي إلى بيروت، مشدودًا إلى بعضي الذي بقي هناك في ربوع الجنوب، وكلما بعدت المسافة كان الانشداد إلى جزئي ذاك يشتدّ، وأنا أحاول مدّه بتعليل النفس بلقاء قريب.
147
133
الأوراق
وكما وعد محمود، ما لبث أن عاد، أيامٌ قليلة، هي كانت بالنسبة إلي طويلة، لكنها أقل مما توقّعت، لقد ضاق صدره بقلة العمل وجدواه، وإن كانت القرية قريته، يشتاقها ويحبها، إلا أن الحب ونهر الشوق له مصب آخر عند محمود، إلى حيث عطش الأرض والناس نهره. عاد بكل دفق الحياة فيه، يتلفت ويتحرك كما هو دأبه، وإن ضاقت الساحات. وأنا، كأن الحياة التي فارقتني بغيابه عادت مأهولة بالجديد كيوم العيد.
عملنا هناك كل ما نستطيع، ومحمود بأكثر مما يستطيع أي أحد، في كل مجال ومكان وعلى كل صعيد، رغم الضغوط والمصاعب التي تزداد يوما بعد يوم.
وصل الأمر بعدها إلى أماكن أكثر سوءًا، حين قرر النظام في البلد آنذاك الارتماء بالكامل في أحضان الدولة العبرية، من خلال «اتفاق 17 أيار»[1]، وتغيرت عقيدة الجيش وتوجّه بالكامل ليصبح بديلًا عن
[1] مشروع اتفاق سلام تم التوصل إليه في 17 أيار 1983 بين الحكومة اللبنانية، خلال عهد أمين الجميل وكيان العدو يتضمن إنهاء حالة الحرب بين لبنان والكيان الاسرائيلي وذلك عقب الاجتياح الاسرائيلي للعاصمة بيروت بأقل من عام.
149
134
الأوراق
جيش الاحتلال، ويده التي تكمل ما بدأه الاحتلال، وما لم يستطعه، وأصبح يلاحقنا في الطرقات وفي الأزقّة، ومع كل هذا الضغط كنا نضحك، في خليط عجيب كأنما تعمّدنا أن نصنع حياة نعدها لنألفها كقدر نرضى به قابلاً للبقاء، نحول الحراسة إلى سهرات أنس وضحكات، ونحوّل الرصد إلى خروج في نزهة، وحتى الطعام على تخوم المحاور ومناطق الاحتكاك، نراه ولائم أنس وترفيه، كما نرى البطاطا المسلوقة الباردة لحماً مشوياً نضعها في أسياخ من خشب، ونمررها على جمر من خيال محض، ونشكو من سخونتها اللاسعة ضاحكين. حذر مع اللهو، وضحكات في الخوف، وحب...
الحب في زمن المطاردة بطله محمود، محمود العاشق الذي تطارده المخابرات ويحاصره الحب، وهو بينهما مشاغب يحرّضه الخطر، الخطر عند غير محمود يدعو إلى عدم الحركة، إلى الابتعاد، وعند محمود يشكل حافزاً إضافياً للإبداع، للتحايل على الظروف، محمود كسابح يغريه اشتداد الموج، والحب لخطيبته يزداد مع الخطر، ويصنع محمود بدهائه فرصًا عجيبة للقاء خطيبته، تخاف عليه وترجوه أن لا يخاطر، لكنه محمود، ولعبة الخطر تلك صنعته التي كانت قبل الحب والشريك تستهويه، ومع الحب والحديث مع الشريك عن المستقبل وما يرجوه من بناء بيت يصنعه مطابقاً لرؤياه، يشكل الشوق إلى هذا الحديث حافزاً جديداً، يحمله بجرأته وبدهائه المعهود، ليذهب إلى عمق الخطر مبتسمًا، ولمعة من دفق حماس في عينيه، بكل أشكال المغامرة، مرّة يتسرب خلسة في عتمة الليل،
150
135
الأوراق
وأخرى في وسط النهار متنكرًا، قبعة مختلفة، نظارات للتمويه، يعبر الحواجز، ويسلك طرقاً لا يعرفها مطاردوه، يتنكر، كبائع متجول ربما. يراقب المنزل أو يعبر من فوق السطوح، لم يكن كل ذلك بالصعب على محمود، ويتسرب بدهاء ويصل كما الهواء من تحت الشقوق، ويطرق الباب وتصدر صرخة:
_ هذا أنت؟؟!!!... كيف فعلت ذلك؟!!.. يالك من داهية..
وينتشر ضحك عزيز، يأنس محمود بالفرح المسروق من أنياب الخطر، ويضحك سعيدًا مرتين، سعيدًا بلقاء حبيبته، وأخرى لانتصار حركته الخفية وخداع المراقبين. وجود محمود هو الذي يجعل تلك الحياة مقبولة رغم كل شيء، بل إن فيها شيئًا من رائحة الأنس التي تنبعث من زوايا قلبه لتعبق في المكان.
ويستمر محمود على كل الأصعدة المدنية والعسكرية، بطريقه وأسلوبه؛ لا يقول لنا افعلوا واذهبوا، كان هو من يفعل ونحن خلفه، جرأتنا وعدم خوفنا كان امتدادًا لشجاعته.
ثم صارت المطاردة أكثر صعوبة، خاصة على محمود، فيضطر إلى الغياب والهرب وإذا دخل إلى «فتح الله»، يأتي سرًا عبر مخيّم «صبرا»[1]، والطرق الضيقة البعيدة عن عيون المخابرات والعملاء.
[1] مخيم شهير في إحدى ضواحي بيروت نفّذ فيه العدو الاسرائيلي والمليشيات العميلة مذبحة مروّعة بحق اللاجئين الفلسطينيين خلال الاجتياح عام 1982م ذهب ضحيتها مع شهداء مجزرة شاتيلا حوالى 3000 شهيد.
151
136
الأوراق
ثم أخذت الأمور منحى عسكريًّا مباشرًا، حين اتخذ الجيش قراره باقتحام فتح الله، ولم يعد راضيًا بالوقوف قرب مداخلها، فوقفنا مع محمود، اشتبكنا مع الجيش وهو يحاول الدخول إلى «فتح الله»، بدأت المعركة الكبيرة حين ضربوا المدرسة في «وادي أبو جميل»، جلبنا مع محمود الكثير من السلاح، من حيث وضعناه، جمعنا الأسلحة في الفان واشتبكنا معهم، وطوقوا «فتح الله»، من كل الجهات، واشتدت المعركة، كان الجيش في أحد المراكز في البسطة الفوقا، أطلق محمود أكثر قذائفه من جهة منطقة «الوزان»، أكثر من 17 قذيفة «بـ7»، ودخل الجيش إلى المناطق يوم الأربعاء، كانت دباباته تصعد على السيارات، والجنود يطلقون النار بشكل عشوائي، وأغلقت علينا الممرات، ولم نستطع الوصول إلى حيث الأسلحة بعد أن نفذت ذخيرتنا، كنا في حي اللجا، وأسقط ما في أيدينا، فتح لنا الإخوة طريقًا للذهاب إلى منطقة «الشياح»، كنا عشرة شباب. ذهبنا وأجسادنا المتعبة تحمل أرواحًا أكثر تعبًا.
لم ننم ليلتها، كان قد أصابني الكثير من الإحباط الممزوج بالغضب، كنت أشدّ يأسًا من أي يوم خلا، فجلس محمود بالقرب مني يحدثني ويحاول إعادة الهدوء إلى روحي التي اضطربت بشدة، وأشد كلامه تأثيرًا حين قال:
_ هل تخلى ربك يومًا عن الحق؟ أتظن أن ما قمنا به لم يثمر؟.. كيف تظن ذلك ونحن لم نعمل إلا من أجله... تلك إساءة ظن بالله.
152
137
الأوراق
ابتسم وهو ينظر أمامه وكأنه يرى شيئًا في الجدار، وقال بثقة عجيبة:
_ سيسقط اتفاق «17» أيار قريبًا، وسيثمر كل فعل فعلناه، سأذكرك بهذا وستقول قالها محمود.
ابتسامته وتلك الثقة الشديدة في نبرة صوته، أعادتني بافضل مما كنت.
وأشرق يوم الخميس يوم زفاف محمود، يوم عرسه الذي انتظرته أنا كما ينتظره هو، وكأنني أنا العريس. وصار يحدثني عن جيش من أولاده وأولادي، جيش لا بكثرة العدد، بل بالفعل والإيمان، وأنا أتخيل أطفالاً مثل محمود، نسخًا تتكرر، وأبتسم لصور بعيدة عن أطفالي وأطفاله، وزمن آخر أراه من عيون محمود.
بعد هذا الحديث مباشرة جاءت الأخبار أن الأهالي يتعرضون لسوء معاملة واعتداءات من قبل الجيش وهو يقتحم المنطقة، فقام محمود وقمت معه، وفي ذهننا كل تلك الصور عن أمهات وأطفال، عن عرض وأهل، يتعرضون للتنكيل، ومحمود كالأسد الثائر. لم تمكنه حميته من السكوت والوقوف وقفة المتفرج.
ذهبنا إلى هناك، وفي الحسينية كان هناك أكثر من عشرين رجلًا حين كان يصرخ محمود غاضبًا:
153
138
الأوراق
_ ما هذا الذل... ما هذا الذل؟!
لم أرَ محمود غاضبًا كما في ذلك اليوم. يريد سلاحًا بأي وسيلة، وتدخّل أحد الأشخاص وأعطانا سلاحًا كان قد خبأه في مكان قريب. أخذ كل واحد قذائف، أخذناه على عجل، ومن بناية غير مكتملة بدأنا المعركة، ثم نزلنا أنا ومحمود، كل واحد منا في شارع، وواجهناهم على الجسر، لمدة أربع أو خمس ساعات، وكنا خلالها قد ابتعدنا عن بعضنا، ولم أعد أعرف عنه شيئًا، ثم اشتدت المواجهات واشتد القصف علينا، كل على حدة، صرخت إليه مرارًا... كنت أسمع من جهته القصف يشتد، كنت أقاتل وقلبي الى الاتجاه الذي ذهب إليه، يشتد القصف وتشتد الثورة في داخلي، ثم أعود لأنظر إلى المنطقة التي يقاتل فيها محمود وحيدًا، رأيتها تشتعل قصفًا ونارًا، صرخت أناديه بكل ما في صوتي من قدرة على النداء، كأني أنادي عمرًا كاملًا، ثم حملت سلاحي وركضت إليه، خطوات قليلة وانفجرت أمامي قذيفة على الجدار، وتطايرت شظايا ونار وحجارة، حملني الانفجار إلى الجهة المقابلة، وتحت سقف سقط مستندًا على الجدار المقابل، وجدت نفسي تحته، أشعر بلسعات على صدري وكتفي، ثم شعرت بالسائل الحار يتسرب إلى بطني، نظرت إلى جهة محمود، جمعت ما تبقى لي من قوة وحاولت الزحف، لم تسعفني ذراعي وشعرت بثقل في ساقي. رفعت جسدي مرة ثانية وسقطت، صرخت: محمود، محمود!
154
139
الأوراق
وبدأت أشعر بالموت يقترب مني، وكنت أريد أن أراه، كجزء أخير، صورة أخيرة لأجمل ما في دنياي، لكن الوعي بدأ يتسرب مني، رفعت يدي واسمه يتسرب ضعيفًا متكررًا من فمي، ويدي تزداد ثقلًا ورأيتها تقترب من الأرض.
استيقظت في المستشفى وكان اسم محمود ما يزال عالقًا في فمي، قيل لي إنه مصاب وسيشفى قريبًا، وحين سألت عن مكان الإصابة قالوا لي إنها في ساقه، نظرت إلى ساقي الملفوفة مبتسمًا، سرى في داخلي اطمئنان مريح، وابتسمت على الرغم من وجعي، وأنا أتخيله يدخل غرفتي على عكاز، ملفوفًا بالضمادات وهو يصرخ بي:
_ قم، ما بك مثل العجائز.
لكنه لم يأت... أيامًا وأنا أنظر إلى الباب وفراغه، أنتظر دخول محمود الصاخب المحبب. فراغ الباب وصمته يتّسع.. لهفتي يصبح لها وقعٌ آخر، لسعة من نار، تكبر وتشتعل حريقًا يمتدّ بالسؤال: هل أخفوا عليّ شيئًا؟ أهي حالتي الصحّية؟!... خطر الانفعال!... هل أخفوا عليَّ... هل محمود؟!!... لا... هذا محال... الرحيل لا يشبه محمود... الغياب لا يشبه محمود...
امتدّت النار وصرخت كلّ خليّة في جسدي، أريد إجابة الآن... الآن...
155
140
الأوراق
ورضخوا. وما كان هاجسًا أحاول استبعاده أصبح جوابًا واضحًا؛ لقد غادرنا محمود... رحل محمود.
حقيقة أضحت مؤكدة، لكنها في داخلي صعبة التصديق، بل هي مرفوضة كجسم دخيل. لم أبكِ، كانت روحي تغلق الأبواب دون تلك الحقيقة، جسدي رفضها أيضًا وارتفعت حرارته، شكل الدنيا بلا محمود، أي شكل ستأخذ؟ فراغ مهول. ثم أنهكني حرب العناد وعدم التصديق، وانهارت مقاومتي، أغلقت بابي وسقطت باكيًا.
علام يا محمود! علام تركتني! أما كنت معك وخلفك دائمًا؟!...
لماذا عبرت وحيدًا؟ لماذا عبرت سريعًا مبكرًا؟ تركتني والمكان موحش بلا وجودك الصاخب، العتمة في هذا الزمن حالكة حالكة من دون حضورك المتوهّج، أحلامنا والأمنيات والرجاء، أطفالي وأطفالك وجيش من الصغار ... و...
بكيت أيامًا... وللآن... وأنا أدمل الجرح الذي خلّفه غياب محمود، لكنه لا يزال بارزًا كندب طويل...
أتم العشرين من عمره وغادر، غادرني عريسًا شهيدًا، غادرني مبكّرا، وكل شيء مبكّر في محمود...
بعد استشهاد محمود بزمن يسير، وكنت لا أزال أعاني من إصابتي حين قامت انتفاضة كبرى، أسقطت اتفاق 17 أيار، وتوالت بعد ذلك
156
141
الأوراق
المشاهد، وأزيح الستار عن حقيقة كان يعرفها محمود، حقيقة كان لا يستطيع حتى الخيال إدراكها، فهي كالمستحيل، ومحمود أدركها بكل الوضوح.
خلال كل تلك السنين التي تلت استشهاد محمود، وحتى الآن، وأنا أنظر إلى ما نحن فيه من إنجازات، يظلّ صوت محمود يتردّد في مسامعي:
_ سيثمر كل فعل فعلناه، وستقول قالها محمود...
157
142
الأحاديث
من حديث لوالد الشهيد:
وُلد محمود سنة 1963 في شهر آب، قبل ولادته كان لديّ ثلاثة أبناء: وفيق، علي، ومحمد. فقد كنا نسكن في فتح الله منذ العام 1967م.
منذ صغره كان محمود سريع الحركة والتجاوب؛ فقد بدأت ببناء بيت في «ميس الجبل» سنة 1975م، وفي كل عطلة صيفية كنا نذهب إلى القرية لإتمام العمل في المنزل، وكنت أعمل بنفسي في أغلب الأحيان لأوفّر أجرة عامل، ومحمود كان معي دائمًا، لا لأنه أكبر إخوته بل لأنه صاحب همة، سريع الحركة، مطيعٌ وخدوم، كان يناولني كل ما أحتاجه.
كان المنزل في مكان متطرّف عن بيوت القرية، محاذيًا لفلسطين المحتلة، وكانت بلدة «المنارة» المحتلّة قبالتنا. كنا نتعرض أحيانًا لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الذين كانوا يمشّطون المناطق المتطرفة خوفًا من التسلل، لم يكن محمود يشعر بالخوف من القصف، كان حذرًا لكنه لم يخف ولم يرتبك.
161
143
الأوراق
كان يركض ليحمل عني، ويبادر لمساعدتي دون أن أطلب، وكذلك كان مع والدته، مع كل العائلة، مع الجيران وأهالي الحي. وكان كريمًا جدًا، ما في جيبه ليس له.
لم أكن أرغب أن يحمل محمود السلاح، لكنه كان يرى ذلك ضروريًّا لحمايتنا وحماية الحي من «الزعران»، من تجار المخدرات ورجال السوء، ومن الأحزاب المتقاتلة. كنت أقول له: «ما لك ولهم؟ أنت تضع نفسك في هذه المعمعة وتلك المشكلات»، فيقول: «إن لم أفعل أنا وغيري من سيفعل؟».
أحداث كثيرة مرّت، عشت في قلق عليه حتى وافق على السفر إلى السعودية عند أخيه بعد أن تعرض للإصابة في إحدى المعارك، لم يمكث هناك طويلًا، قلبه وهمّه هنا، وكان يسأل عن الأخبار بشكل مستمر، وما إن علم باستشهاد ابن خالته «نعمة حيدورة» حتى عاد على الفور.
كان هم الناس همّه، يفكّر بهم ولا يفكر بنفسه، وهكذا بقي حتى آخر أيامه، الحامي والمدافع عن حقوق الفقراء.
كان يشارك في مجالس العزاء، وفي أيام عاشوراء يتفرغ للمجالس ويشارك في اللطم والخدمة وإعداد الطعام، ويشتري من مصروفه الخاص ما تحتاجه المجالس وما يطعم به الناس في تلك المآتم الحسينية. حتى أنه وفي غير أيام عاشوراء كان يحضر الطعام لرفاقه ويطعمهم على حبّ أبي عبد الله الحسين (عليه السلام).
162
144
الأوراق
وتمرّ الأيام، ومحمود يزداد قوة ونشاطًا وعملًا، حتى بات قائدًا يلتف حوله الشباب، وثبت لي على وجه اليقين أن محمود سوف يستشهد. كنت أعدّ نفسي لاستشهاده، فمثله لا يبقى.
وقبل استشهاده، ليلة الجمعة، شاهد في منامه أنه كان مع أخيه الشهيد علي، ذهب معه إلى العمل، وإذا بسيارة قد صدمت العربة المحمّلة بالبضاعة فسقطت البضاعة على الأرض، وشاهد شخصًا ينزل من السماء.
في الفترة الأخيرة أراد محمود أن يتزوج، وأرادنا أن نخطب له عروسه التي أراد، ذهبت معه إلى منزلهم وكنت سعيدًا جدًّا بهذه الخطوة، وقد عرّف بي عند أهل العروس بقوله: «هذا تاج رأسي»، وفي اليوم نفسه الذي حدّده ليتزوج استشهد، لقد استشهد عريسًا.
163
145
الأحاديث
والدة الشهيد:
ولد في الصيف، بعد صلاة الصبح، وكانت ولادته مميّزة لسهولتها ويسرها. احترنا في تسميته وهو رابع أطفالي، فاستقر الأمر على قرعة وضعنا فيها أسماء عدة واخترنا له اسم محمود، وكان محمودًا في كل صفاته.
في صغره كان كثير الحركة، مشاغبًا، لا تراه جالسًا أبدًا، يتحرك ويدندن بأناشيد يحفظها عن ظهر قلب، وكثيرًا ما كانت حركته تسبب له الأذى والألم، يسقط ويتعثر، لكنه كان يقوم وكأن شيئًا لم يحدث. لا زلت أذكر عندما انسكب عليه إبريق الشاي الساخن، وكيف حملته إلى الإطفائية وركضت به وهو يحاول حبس بكائه.
رغم شغبه كان لطيفًا بالنسبة إليّ، كان مطيعًا، محبًّا، لا يتوانى عن مساعدتي وتلبية حاجاتي دون تأفف. كان صغيرًا جدًّا عندما جاءني يبكي وفي حالة استغراب ودهشة عندما سمع رجلًا يكفر في الشارع.
دخل المدرسة في منطقة «المصيطبة»، مدرسة الغول، وكان من الأوائل في كل المواد. ومع أنه لم يكن يحب اللغة الفرنسية إلا أنه لم
164
146
الأحاديث
يرسب بها قط. أحبه أساتذته كثيرًا وكانوا يقولون عنه أنه ذكي لكنه مشاغب. منذ صغره كان لا يتحمل الاستفزاز أبدًا ولديه عزة نفس.
لم يكمل محمود دراسته بسبب الحرب، ولم يكن قد تجاوز الثالثة عشرة عندما دفعه حبّه لفلسطين والفدائيين للانتماء إلى حركة «فتح». وبدأ قلقي عليه الذي لم ينتهِ. وبدأ يغيب عن المنزل...
في إحدى المرات تأخر كثيرًا في العودة، وسألت عنه، ولكنّ أحدًا لم يعرف أين هو، فجلست إلى الشرفة مهمومة، وإذ به يعود مرتديًا معطفًا عليه دماء، فقلت له: «هكذا يا محمود! أهكذا تعذبني!»، فاعتذر إليّ وقال إنها إصابة بسيطة. قيل لي أنه أصيب في «وادي جيلو».
أصيب مرات عدة؛ في يده، في بطنه خلال صراع الأحزاب، ومرات عدة قبل الاجتياح وبعده.
كان محبًا للاطلاع، ويسأل دائمًا ويقرأ، كثيرًا ما كنت أستيقظ ليلًا فأراه يقرأ طيلة الليل، فحين يعطيه «نعمة حيدورة» كتابًا لم يكن يتركه حتى ينهيه.
بعد عودته من السعودية أصبح أكثر تدينًا، وكان يحضر دروسًا في أماكن عدة، وينقل ما يتعلمه إلى رفاقه.
كان يحب إيران والإمام الخميني كثيرًا، لا يكف عن ذكره، يقول: «إمامي الإمام الخميني»، وينشد أناشيد الثورة الإسلامية في إيران.
165
147
الأحاديث
أقنع أخته بالحجاب، اشترى القماش بنفسه لأخيط لها الحجاب، وطلب إلي أن أخيط حجابًا لفتاة لم أعرفها، وكان يشجع رفاقه لإقناع أخواتهم بارتداء الحجاب. وعندما علم أن إحدى المدارس تعترض على ارتداء الحجاب ذهب إليهم وحذرهم وهددهم، واشترى هو ورفاقه الملابس والأقمشة والكتب ووزعوها على الفتيات لتشجيعهن على ارتداء الحجاب.
كان محمود بطلًا لا يهاب الموت، مشهورًا في قوته وشجاعته. قاتل إسرائيل عندما وصلت إلى بيروت وكذلك في الجنوب، قاتل ضد الظلم وضد العملاء، قاتل ضد الجيش الذي كان في تلك المرحلة يقف إلى جانب إسرائيل.
كثيرًا ما كان يذكر الشهادة، خاصة في السنة الأخيرة، فإذا ما استشهد أحد الشباب، كان محمود يقول: «لقد ذهب إلى الجنة، يا لسعادته! وأنا ما زلت هنا».
أحب الشيخ راغب كثيرًا، وكان يتمنى أن يسكن معه، ودائما كان يطلب مني أن أقول: «مقاومة إسلامية»، لا «مقاومة» فقط.
كنت سعيدة جدًّا عندما أراد الزواج، فحين خطب قلت أنه سوف يهدأ قليلًا، اقترب عقد قرانه ولم تكن الدنيا لتسع فرحتي يومها، وحين قرر أن يتزوج، وجهزنا كل شيء وتحدد الموعد، استشهد، عرسه كان في السماء.
166
148
الأحاديث
ومن حديث لشقيق الشهيد:
الوالد يحب الضيعة كثيرًا، وأصر على شراء أرض صغيرة على الرغم من ضعف الحال، وبنى بيتًا صغيرًا، أو هو أقل من بيت وكان خلال فترة البناء يأخذ محمود معه. أحب محمود الضيعة، ربما من تلك الرحلات وما بعدها وما كان يراه ويسمعه، كره محمود الإسرائيليين وأحب الفدائيين الفلسطينيين، كان يقول أنه سيقاتلهم حين يكبر.
حمل السلاح باكرًا، كان في الثانية عشرة من العمر وانتمى إلى حركة فتح، تدرب وأثبت جدارته حتى أنه شارك في التصدي لقوات الاحتلال في النبطية في اجتياح 1978. وذاعت شهرته وانتشر اسمه ولقب بـ«الوحش» لجرأته وقوته الجسدية.
كنت أصغر منه بثلاث سنوات، وفي عمر الطفولة هذه السنوات تجعل الفارق كبيرًا، أو هكذا كنت أشعر وقتها، كنت أراه كبيرًا وكبيرًا جدًا مهيبًا ممشوقًا قويًا بطلًا، تعزز تلك الصورة سمعته وتقدير الناس له، وكنت أرى ذلك بنفسي وأسمعه من الناس، يسألونه ويعتمدون عليه، وبعضهم كان يشكو إليه ويطلب مساعدته، أرى
167
149
الأحاديث
أصدقاءه وطريقة تعاملهم، كان كثير الأصدقاء وكثير المعارف، أرى حب الجميع له.
الصورة الواضحة جداً بالنسبة إليّ أو أكثر شيء أتذكره هو خوفي عليه، كنت أنتظر على الدوام أن يقال لي أن محمود قتل أو أصيب كشيء حتمي سيحدث قريبًا أو قريبًا جدًا غدًا أو بعد غد، كان يشكل ذلك هاجسًا عندي، ولا تغيب عن خاطري صورته مع سلاحه الرشاش والقاذف والذخيرة، تلك الأسلحة التي يبعدها عن المتناول، وكم كنت سعيدًا حين أصبح يسمح لي بمشاركته في تنظيف السلاح ولمسه.
كان صورة مثالية يعززها حضوره القليل وغيابه المتكرر والخوف عليه، وهو في حضوره لطيفٌ جدًا، بشوشٌ، يحب المزاح، خوفي عليه عزّزه الواقع مع الوقت؛ كان شخصًا مستهدفًا، قبل ذهابه إلى السعودية، فهو أبي الضيم، ويحب المحيطين به وهم فقراء مستضعفون، وكانوا يستعينون به للدفاع عن أنفسهم وأرزاقهم، كان يحميهم ويكسب بذلك عداوة النافذين والمتسلّطين من القوى المسلحة، حتى كثر أعداؤه واشتد خوفنا عليه ومحاولات اغتياله تكررت، وكذلك المواجهات المسلحة حتى أصيب في بطنه إصابة بليغة، ألزمه الأهل والأصدقاء بعدها بالمغادرة إلى السعودية ليلتحق بأخي الأكبر.
هنا هدأ قلبي وسكن خوفي عليه وقلت عاش محمود، لكنه عاد
168
150
الأحاديث
وبعد دخول الجيش الفئوي في مساندة الاحتلال، لاحقته مخابرات الجيش وأصبح محمود مطاردًا لا يستقر في مكان وبدأ نوع آخر من الخوف عليه، وكنت أرى جرأته وشجاعته وحركته السريعة.
يسألون عنه ويراقبون المكان، ولكنه كان يأتي إلى المنزل، مرات عدة كانوا يطرقون الباب ويكون في الداخل، فيقفز إلى سطح الجيران ويختفي.
وفي مرة أصيب في قدمه، وكان المحيط يحميه، ويخبئه الناس ويعيقون اعتقاله.
اعتقل مرة وفرّ بمساعدة الناس، ومرة أركبوه بالسيارة ولكنه استطاع الفرار بقوته الجسدية وجرأته وذكائه.
وعندما تسلط الجيش ومارس التعسف والإذلال لم يستطع محمود الصبر على ذلك الظلم وظل يقاتلهم حتى استشهد.
وبقي اسمه يتردد لسنوات عديدة، وبقي الناس الذين لا يعرفونني حتى إذا علموا أنني شقيق الشهيد محمود اختلفت معاملتهم لي، وترحموا عليه وعلى أيامه وعيونهم تطفح بالحب والأسى.
رحم الله الشهيد محمود.
170
151
الأحاديث
شقيقة الشهيد:
يكبرني محمود بسبع سنوات، وكان شخصًا مهمًا بالنسبة إليّ، وأول الذكريات وأقدمها هو أول يوم ذهبت فيه إلى المدرسة، كان عمري 4 سنوات تقريبًا وبكيت كثيرًا في ذلك اليوم لأنهم يريدون إرغامي على الذهاب إلى المدرسة، فأخذني إليه وهدأ من روعي واشترى لي الحلوى التي أحبها وطيّب خاطري حتى هدأت نفسي ورضيت بالذهاب، وأخذني إلى المدرسة بنفسه.
منذ نشأتي كان محمود ملتزمًا، لاسيما بعد عودته من السعودية، علّمني الصلاة، وتابعني حتى حفظت كلماتها بصبر وابتسامة، كنت أقف إلى جانبه وهو يصلي وأتابع حركته في الصلاة، وأصلّي أمامه حتى اطمأن إلى صلاتي. كانت لديه هيبة عند الناس، لكنني كنت أشعر بحنانه ورقته، اهتمامه ومتابعته لي، كان صبورًا، طويل البال علينا نحن بشكل خاص، كان يتفهم صغر سني بشكل لافت، جعلني هذا أُكثِر من دلالي عليه.
أقنعني بالحجاب، قال إنني أصبحت في سن يجب أن لا أخرج بلا
171
152
الأحاديث
حجاب، اشترى لي قماشاً خاطته والدتي، كان حجاب النساء أمرًا في غاية الأهمية عنده، سعى مع رفاقه الذين حذوا حذوه في الاهتمام بحجاب أخواتهم، كانوا يشترون غطاء الرأس وقماش الثوب الشرعي من مالهم ويقدمونه هدايا، حتى أن أمي شاركت بالخياطة، عرّفني على أخت صديقه لتتعلم مني واشترى لها حجابًا، وخاطته أمي لنتحجب معًا.
واستمر اهتمامه بي حتى بعد خطبته، لقد اشترى لي ثيابًا مع ثياب عروسته، كان يخجل من أمي وأبي لشدّة احترامه لهما، يداري أمي كثيرًا، كان حنونًا عليها، يخاف عليها من التعب.
تعامل معنا برفق ولطف، وكرفيق وصديق، بحنان وطول بال، وتعلّمنا منه الكثير، إيمانه وحبه لأهل البيت، وكان إذا سمعنا نقول إن فلانًا قال كذا أو فعل كذا يقاطعنا على الفور ولا يدعنا نكمل، الغيبة ممنوعة مطلقًا، يرفضها بشكل حاسم.
لا أتذكر يوماً أنني انزعجت منه، بل كنت ألجأ إليه وأشتكي وأطلب المساعدة، ومحمود حاضر للمساعدة في كل حال ليس لي فقط.
صورته في ذهني أنه كان مشغولًا دائمًا، تلك المشاهد هي أول ما أستعيده من ذكراه، مثال ومشهد استعيده دائماً كلما ذكرته، أنه كان يغسل رأسه وجاؤوا يطلبونه لأمر، ذهب معهم وهو ينشف رأسه وترك المنشفة خارجاً أمام الباب على حافة الدرج.
172
153
الأحاديث
كان قلبي يخفق من أجله على الدوام، لقد تعذّب كثيرًا محمود، أصيب مرات عدة وكان تحت الخطر دائماً، وفي الفترة الأخيرة كان مطارداً، يعيش متخفياً في حياة صعبة.
تحدّث عن الشهادة وحبه لها، كما كان يتحدث وقتها أيضاً ويكثر من الحديث عن الصلاة والحجاب وعن الخط الإسلامي والتمسك به، كأنما كانت تلك الأحاديث وصاياه لنا.
افتقدته كثيراً، ما كنت لأصدق أنه لن يعود.
ترك فراغاً كبيرًا، ليس في قلوبنا وحسب، بل في محيطنا كله، ظل ذكره يتردد لسنوات عديدة ومايزال، كلما جاء ذكره رأيت الأسى في العيون.
كثيراً ما أراه في أحلامي، يأتيني في المنام كأنه لم يستشهد، كما كنت أحيا معه، يتناول معي طعام الفطور، وكنت أراه في مكانه في الجنة.
هنيئاً لمحمود العريس الذي زفّ إلى الجنة.
173
154
الأحاديث
خطيبة الشهيد:
كنت في الخامسة من عمري، أسكن مع اهلي في محلة المصيطبة، وفي الأيام التي كان فيها الوضع الأمني متوتراً جداً والقوات الموالية للاحتلال تسعى بكل قوتها للسيطرة على المنطقة وجوارها بعد أن بسطت سلطتها على أغلب مناطق بيروت، اشتد القصف حينها ونزل السكان يتكدسون في الملاجئ المتوفرة.
في أحد الأيام كان القصف أشد من الأيام السابقة، لم يكن يتملكني الخوف، «فليحدث ما يحدث» تلك مقولتي التي تجعلني أبادر إلى الخروج لقضاء ما نحتاجه، ومن تلك الحاجات غسل الملابس وتجفيفها.
خرجت الى الشرفة، وبدأت بنشر الغسيل، ببطء وتمهل، أنظر الى الشوارع الخالية، يؤنسني مرور الشباب بأسلحتهم، هم لا يخافون، فلماذا أخاف؟ رأيت في المبنى المقابل شابين يعملان على توضيب حصص تموينية لتوزيعها على المحتاجين في الملاجئ. صرت أتابع حركتهما وهما يخرجان المؤن، أشعر بالأمان بوجودهما المؤنس وأنا
174
155
الأحاديث
اتابع نشر الغسيل، كان أحدهما جميل المحيا قوي البنية نشيطاً، فإذا به ينتبه لوجودي.
أنا أعرفه، هو محمود، كان معروفاً ومحبوباً، توقف قليلاً وهو ينظر إليّ ثم تابع عمله، ثم رأيته يتحدث إلى صديقه وينظر إليّ، إنه يتحدث عني، أربكني ذلك، انهيت نشر الغسيل على عجل ودخلت المنزل.
كنت أعلم أنه يتردد الى المبنى المقابل وصديقه الذي يسكن هذا المبنى هو زوج قريبتي، ماذا كان يقول له محمود عني، هل اعترض على وقوفي على الشرفة.
بعد أيام وحين هدأ القصف قالت لي قريبتي أن محمود يريد أن يتحدّث إليّ واتفقت معها على أن أراه في حديقة الصنايع، تلك الحديقة العامة كانت المتنفس الوحيد للتنزه واللعب لكونها قريبة من مساكننا.
ذهبت انا وقريبتي الى الحديقة، وهناك تعرفت على محمود عن قرب. كنت أسمع عن شجاعته وقوته، عرفت هناك كم هو طيب وخجول هذا الشجاع، مؤدب في غاية اللطف، لقد مر الوقت سريعاً وكان قلبي يخفق بشدة واتفقنا على لقاء ثانٍ في الحديقة العامة نفسها.
175
156
الأحاديث
لقد تأثرت كثيراً بتلك الشخصية الشجاعة واللطيفة في نفس الوقت. ولفتني كثيراً أدبه وتواضعه، ما حدثني عن نفسه أبداً. كان يتحدث عني وينصحني ويريد لي الخير، ويحدثني عن أهميّة الحجاب ويطلب مني أن يكون حجابي أفضل.
كنت أعرف شقيقته، تقربت منها أكثر، وصرت أتردد الى منزلهم. لم تكن اللقاءات كثيرة.
في أحد الأيام وأنا أنزل معه درجات المبنى، وقف ليقول لي سأطلبك من أهلك غداً، فإذا بي انخرط في بكاء شديد، كنت طفلة لا أجيد التعامل مع مشاعر غريبة متدفقة، كردة فعل لم أجد أمامي سوى البكاء.
نظر إليّ في دهشة وخوف، خاف عليّ وارتبك لا يدري ماذا يصنع، ولماذا كل هذا البكاء والنحيب، لا يدري ماذا يقول، كان يردد بارتباك، لا تبكي، ما بك.. أرجوك.. اهدئي وقولي لي ..
وأنا لا أجيب، وحين سألني إن كنت لا أريد الزواج به، قلت له وأنا أبكي: أريد ولكنك فاجأتني بهذه السرعة.
هم يعرفونه، هو شخصية معروفة ومحبوبة وسمعة أهله الطيبة لا يختلف عليها اثنان، لكن وضع المسلحين والخطر الذي يصاحب
176
157
الأحاديث
حياتهم، صعوبة الحياة وعدم الاستقرار، جعلهم يتريثون، فهم لا يريدون لابنتهم الصغيرة هذه الحياة.
ثم زارهم هو، وتحدث إليهم، وكان حضوره وحديثه مؤثراً، كما هي عادته، وتبدل موقف أهلي وتمت الموافقة.
تعددت لقاءاتنا، لكنها لم تكن كثيرة، فهو مشغول دائماً، والجهاد عنده فوق كل شيء، أهداني صوراً للإمام الخميني وكتباً، تلك هداياه التي يحبها.
واشتد خلال هذه الفترة تعلقي به، حتى بين اللقاء واللقاء، أسترجع في كل الوقت تفاصيل اللقاء السابق وأعيش فيه لأعوض عن حاجتي إليه، عساه يخفف من شوقي، حديثه الحلو عن الحياة والدين والايمان والثورة وايران، ثم ازدادت الظروف صعوبة، الحالة الأمنية تزداد سوءًا، وأصبح محمود ملاحقاً ومطلوباً من قبل المخابرات، وأنا في تناقض بين خوفي عليه وشوقي الى لقائه، أنتظر اللقاء بفارغ الصبر وأحميه بدعائي، أصبح يتجنب الحواجز والطرقات العامة، يعز عليّ أن يخاطر بنفسه من أجلي، بذكائه وجرأته وسرعة البديهة كان يخترع طرقاً وأساليب ليتجنب الملاحقة ويلقاني، أخاف عليه وأشتاق الى لقائه، وتلك كانت مشكلتي الكبرى.
لكم كان عطوفاً ومحباً، وكان كريماً جداً لا سيما مع الفقراء والمحتاجين، يسألني عن الذين اعرفهم ليأتي لهم بالمؤن والمال وحتى
177
158
الأحاديث
الملابس، أما هو فلم يكن لديه الكثير من الثياب، كنت أراه في نفس الملابس غالباً، كان بعضها يبدو عتيقاً، وحين أسأله أن يشتري ثياباً جديدة يقول سأفعل إن شاء الله، لكنه لا يبالي، ينسى الأمر أو يتناساه، كل ما يتعلق به هو شخصياً ينساه، في راحته وطعامه وأسلوب عيشه لا يبالي بنفسه أبداً، يتعلم منه المرء كيف يهتم بالآخر وينسى نفسه.
يهتم بي وبما ألبس، ويقدم لي الهدايا بأي مناسبة لا سيما الحجاب وغطاء الرأس، معه كنت أشعر بأهميتي، أشعر بالاعتزاز والثقة بالنفس، هو من عزز ثقتي بنفسي وتعلمت منه الكثير عن الدين في المعاملات والعبادات، في الأخلاق الجميلة، والاهتمام بالناس كل الناس. على قلة الوقت الذي قضيناه سويًا كان أستاذاً في كل شيء.
صعوبة اللقاءات والخطر الذي يصاحبها.. ورغبتنا بأن نكون معاً، جعلته رغم الظروف يسارع إلى عقد القران، وأن يكون لنا منزل بعيد عن الخطر.
بعد عقد القران استأجر لنا منزل في أقصى الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقة حي السلم منزل بسيط من غرفتين، حددنا يوم الزفاف، يوم الخميس آخر آب سنة 1983 وبدأنا بشراء الأثاث البسيط، أبسط أثاث ممكن.
اكتمل التحضير للانتقال الى منزلنا في أبسط احتفال بسبب الحالة الأمنية السيئة.
178
159
الأحاديث
وجاء الموعد المرتقب.
في ذلك اليوم نفسه، طرق الباب شقيقه بصحبة صديق آخر، فتحت لهما الباب ودخلا، وبعد أن جلس شقيقه قال لي كلمات متقطعة أو هكذا سمعتها، سبقها بقوله لا تخافي كل شيء بخير، محمود أصيب وهو في المستشفى.. لا تخافي .. صدقيني أنه بخير .. في قدمه .. و .. ما كنت لأسمع بقية الحديث لقد انهارت قواي .. صرت أصرخ وأبكي وأنا أحاول ارتداء ثياب الخروج، رفض ذهابي الى المستشفى، قال إن الحالة الأمنية لا تسمح بذلك، وإن ذهابي الى المستشفى محال.
قضيت ليلتي أبكي، ثم انهارت أعصابي لشدة التوتر.
وحين أبلغوني بالشهادة رفض عقلي التصديق وصرت أصرخ بهم لأنهم يلبسون الاسود.
لم أره إلا قبل الدفن بقليل، خافوا من ردة فعلي، لم يسمحوا لي برؤيته قبل الدقائق الأخيرة. حين رأيته تغيَّر كل شيء، أعادني إلى رشدي محمود في لقائه الأخير، كان نائماً في كامل بهائه، يسبح في طمأنينة فائقة، حتى إنني رأيت في وجهه ابتسامة تحوم، ابتسامة سعيد مطمئن. بكيت بهدوء هذه المرة، بكيت بمحضره دون صراخ، صرت ألومه على تركه لي وأطلب منه المسامحة.
179
160
الأحاديث
من حديث لصهر الشهيد:
استشهد «نعمة حيدورة» في السابع من كانون الثاني عام1982م وعاد محمود بـ 15 من الشهر نفسه، هذه العودة حرّكت الأجواء، كمن أسقط حجرًا في ماء راكد، شعر الأصدقاء بالأمان والقوة وعودة الروح بقدر ما شعر الخصوم بالخطر والتحسُّب، خافوا من عودته لأن عودته كانت بعد استشهاد قريبه نعمة، خافوا من انتقامه وحميّته التي يعرفونها، لم يكن أحد يجهل جرأته وإقدامه، فبمجرد عودته جعل الجبهة الأخرى تهدأ وتحسب ألف حساب لحركتها باتجاه «فتح الله»، على الرغم من أنهم حاولوا مرارًا وتكرارًا التخلص منه، وقد نجا من غير محاولة اغتيال.
كان الحق يعنيه، لم يكن للخوف عنده مكان، ولا للتردد، المسألة عنده مسألة حق أو باطل، فهذا حقٌّ يجب مساندته، لا وسط لديه، مهما كان الحق ضعيفًا والباطل قويًا. تراه مسموع الرأي، مطاعًا، راجح العقل، قوي الهمة. عندما حصل الاجتياح أصبح محمود ينتقل من مكان إلى آخر حيث يكون الصهاينة؛ قيل أنهم أصبحوا في خلدة
180
161
الأحاديث
فذهب، وصلوا إلى أطراف الضاحية فتوجه إلى هناك، وكذلك عندما دخلوا بيروت.
وعند جسر سليم سلام، كان محمود رجل تلك الملحمة، لم يكن يسأل من يذهب معه وما هي الإمكانات التي بين يديه، كان يتحرك بالمتوفر من الإمكانات بلا تردد أو انتظار، يذهب وكفى، ليأتِ من أراد أو حتى فليذهب وحده، لا فرق، المشكلة عنده أنه لا يستطيع أن يبقى يراقب من بعيد دون أن يحرك ساكنًا.
وخلال تلك الحركة التي كانت سريعة مقتحمة لم يكن عشوائيًّا، ولم يتحرك دون تخطيط، بل كان يخطّط بدقة ودائمًا ما كانت خططه ناجحة، فهو صاحب عقل عسكري، وكان يستشار في ذلك ويُعتمد عليه.
قد يستغرب السامع إذا قلنا أن محمود شخص حنون، طيب القلب من فرط شجاعته وصلابته، إلا أنني أعتقد أن قلبه الطيب ومحبته الكبيرة هي التي منحته تلك القوة وتلك الشجاعة، فإن غيرته وشهامته نابعة من هذا القلب الطيّب المحب، لا يقبل الظلم لأحد، حبُّه للمستضعفين، لناسه وأهله هو ما يجعله يقدّم التضحيات ويخاطر بنفسه، لقد كان مستعدًّا لأن يضحي بنفسه حتى لا يتعرض رجل كبير السن مثلًا للإهانة. وهذا لا ينطبق على أهله وناسه فقط، بل على كل مظلوم.
180
162
الأحاديث
رقة القلب تلك تظهر من خلال عبادته وبكائه في الدعاء والزيارة. نعم، لقد كان رقيقًا، طيب القلب، في كل مكان هذا القلب الرقيق كان دليله، وليست الحسابات الخاصة بالربح والخسارة، فإن أمره الشخصي لم يكن يعنيه أبدًا.
كان لصيقًا بالناس، قريبًا منهم، كأنهم يعيشون فيه، إن رأى الحزن في وجه أحدهم يظلّ يلاحقه، يسأل ويتابع حتى يعلم سبب الحزن، ويسعى بكل ما أوتي من قوة لإزالة السبب، وكان الناس يحبونه ويصارحونه لأنهم يعلمون بصدقه وعطفه وأمانته على أسرارهم.
لم يكن يحب التعامل بشكل فوقي، بل يفضل أن يعامَل كعنصر عادي رغم مؤهلاته القيادية، يشارك بنفسه من أصغر مهمة إلى أكبرها، هو من يقود المعركة وهو من ينقل الذخيرة على كتفيه، ينقل مخزنًا كاملًا بلا تأفف، وكل الناس عنده سواسية، يتعامل مع الفقير المستضعف كما يتعامل مع الوجيه، بل للمستضعفين في قلبه مكان خاص.
182
163
الأحاديث
الشيخ أبو أحمد:
محمود رجل لا يعرف الخوف أبدًا، مقدام مغامر إلى أبعد حدود، إذا ذهب في مهمة لا يعود إلا بها، بل أكثر من ذلك، فعلى يديه كانت تتم المهمات بأفضل الوجوه، فهو لا يعجزه شيء.
كانت مهاراته العقلية والبدنية والفنية الكبيرة تعينه على تنفيذ المهام، خبرته وتجربته العميقة في استعمال الأسلحة، عقله الاستخباراتي الحذِر والدقيق، استعماله لما بين يديه على قلّة الإمكانات تجعل ما بين يديه كافيًا، فهو يصنع إنجازات كبيرة لا تشبه الإمكانات القليلة المتوافرة لديه.
على الدراجة النارية، مع قاذف ورشاش وذخيرة، كان محمود يقاتل كمجموعة من الرجال من مكان إلى آخر، صورٌ لا تغيب عن الذهن لرجل لا يتكرر.
كان صامتًا، قليل الكلام، والأغرب أنه كان رقيق المشاعر، يتحسس الجمال في كل ما يراه حوله، مرهف الحسّ إلى حدٍّ بعيد؛ في تدينه،
183
164
الأحاديث
في علاقته مع الأهل والمحيط، في غيرته على أهله ومحيطه، شهامته بعيدة الحدود.
كان محمود مطاردًا ومطلوبًا باسمه بشكل لافت ومكثّف لا سيما في الفترة التي سبقت استشهاده على وجه الخصوص، فكان يتنقل باسم غير اسمه.
في المعركة الأخيرة، أطلقوا باتجاهه قذائف مدفعية، سقط على الأرض، فشاهده أحدهم وعندما هدأ القصف استطاع سحبه بسيارته إلى المستشفى إلا أنه استشهد في الطريق.
ذهبتُ إلى المستشفى وسألت عنه - أنا أعرف اسمه البديل - فأخرجوه من براد المستشفى، تعرفت إلى جثمانه. كانت دقائق قاسية جدًّا، اشتدّ تأثيرها عليّ؛ محمود، هذا البطل الجسور ممددٌ قد تجمّد الدم على جسده. نظرت إلى وجهه الهادئ ورأيت دمعة تجمدت تحت عينيه الجميلتين المغمضتين، فازداد تأثري، ما كنت لأعرف متى نزلت هذه الدمعة! كانت تعبر عن شيء، أو عن أكثر من شيء! عن مظلومية محمود؟ جهاده الشاق؟ تعبه وتفانيه وعمره القصير؟ أو أن تلك دمعة المحبين الذين يرون إمامهم في اللحظات الأخيرة؟ هل هذا ما أخرج دمعة محمود وبقيت على خده حتى تجمّدت؟
دفن محمود في ميس الجبل، بعد تشييع مهيب رغم الظروف الأمنية آنذاك...
184
165
شكر ودعوة
صديقه الحاج أبو ياسر:
تعرفت إلى محمود قبل أن يسافر إلى السعودية، فهو شخص معروف ومشهور، بل يمكن أن نقول إنه كان علمًا من الأعلام قبل سفره، ومع انتمائه للأحزاب، وتلك المشكلة الشهيرة مع أحد التنظيمات الذي كان محمود ينتمي إليه، حيث اختلف معهم وتطور الإشكال، فدخل عليهم المكتب وكانوا أكثر من ثلاثين مسلحًا احتجزهم وأخذ منهم أسلحتهم، وبعد تلك الحادثة دفعه أهله للسفر إلى السعودية حيث كان أخوه.
وفي العام 1982م، وبعد استشهاد ابن خالته نعمة حيدورة عاد إلى منزل أهله في «فتح الله»، فتطورت علاقتنا معه، فأنا من سكان شارع فتح الله، وكنا جميعًا ننتمي لحركة أمل، كمجموعة من المتدينين الثوار، نحمي المنطقة والحي؛ شارع القاضي وشارع فتح الله، وكنا مطوقين من أحزاب شتى، حتى أصبحت فتح الله بصمودها اسمًا وعلمًا، مع العلم أننا كنا نمتلك قاذف «بـ7» واحد.
في اجتياح العام 1982، وصلت قوات الاحتلال إلى خلدة
185
166
الأحاديث
والشويفات وبيروت، فقاتل محمود في المعارك كافة، وأصيب، كان يقاتل في كل مكان يصل إليه، طيلة فترة حصار بيروت، والذي استمر عدة أشهر. من الشويفات، حيث بقيت محاور لمقاومةِ دخولِ الصهاينة، حتى مقتل بشير الجميل، وبعد دخول الاحتلال إلى بيروت ومجزرتي صبرا وشاتيلا، وحصلت مواجهات على مداخل بيروت وعند جسر سليم سلام.
وقبل سليم سلام، كان محمود يمتلك شاحنة صغيرة، وضعنا عليه مدفع «هاون 60»، ونزلنا إلى البلد، حيث كان جيش الاحتلال لجهة «مرفأ بيروت»، فأطلق عليهم النار وعدنا إلى فتح الله.
كان هو الأساس في تلك المواجهات، فلقد رمى 56 قذيفة بـ7، لا زلت أذكر أن 70% من تلك الآليات أحرقها محمود بنيران قذائفه، لقد جزّر فيهم.
قلبه قلب أسد، لقد كان شيئًا يشبه الجنون، استمرت المواجهة من الصباح حتى الخامسة بعد الظهر، وبعدها انسحبنا إلى أحد المجاهدين، لم يعد محمود قادرًا يومها على السمع لكثرة ما اطلق من قذائف، ونام في ما يشبه الغيبوبة.
كنا وقتها سبعة أشخاص، وجيش الاحتلال كان قد وصل إلى مرفأ بيروت وجاءت المعلومات أنهم سيتوجهون من رياض الصلح، انسحبنا ودخلت قوات الاحتلال، لم تصل القوات إلى «فتح الله»، وصلت قرب
186
167
الأحاديث
الجامع فقط، وثبّت الجنود نقطة على البسطا التحتا بجانب المخفر، وعلى «برج أبي حيدر».
بعد ذلك توجّهنا إلى الضاحية، وكانت أعمارنا صغيرة، ولذا لم نلفت الأنظار إلينا وبقينا هناك ثلاثة أيام، إلى أن انسحبت القوات الصهيونية من المناطق الداخلية لبيروت وتمركزت خارجها، وأخذت القوات العميلة تبحث عن الشباب وعلى رأسهم محمود، لاعتقاله، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك رغم كل المحاولات، فخرج من بيروت وتوجه إلى بلدة الشرقية في جنوب لبنان، حيث عمل مع المقاومة هناك، ثم عاد بعد أشهر إلى بيروت واستمر في عمله في مقاومة الاحتلال.
عام ونصف تقريبًا هي المسافة الزمنية من عودته إلى استشهاده.
كان محمود قريبًا إلى القلب، حسن المعشر إلى حد بعيد، لم يكن يعرف السباب، إيمانه صافٍ، أما بالنسبة إلى ولاية الفقيه وإلى الإمام الخميني فإن محمود لا يناقش في أي أمر يصدر، ما يقوله الإمام لا نقاش فيه ونقطة على السطر، هو تربية مساجد «الخندق الغميق»، «رأس النبع»، «العاملية»... لقد افتقدناه كثيرًا.
187
168
الأحاديث
صديقه الحاج أبو خليل:
نحن سكان الحي نفسه، أو بالأحرى من حيّين متجاورين، وكانت تربطنا علاقة عائلية وتواصلنا لم ينقطع، في تلك الفترة كان محمود في السعودية، سنة 1981م، وقتذاك حدثت انتكاسة أمنيّة كان قلب محمود خلالها مع أهله وناسه على الرغم من سفره، وعندها استشهد ابن خالته الشهيد «نعمة حيدورة»، الذي كان على علاقة قوية بمحمود وقد جمعتهما صلة ودٍّ مميزة. لم يطق محمود صبرًا على البقاء بعيدًا، فترك كل شيء وراءه وعاد أدراجه إلى لبنان، وصرت تسمع صدى عودته وتسمع تردادهم لمقولة:
_ «عاد محمود، عاد الوحش».
ذلك اللقب الذي اشتهر محمود به، فعلى الرغم من أنه كان طيبًا جدًّا وودودًا وخدومًا ومتدينًا، إلا أن أهم صفة امتاز بها هي شجاعته وقوته.
كنا نلتقي كل يوم منذ عودته، في تلك المرحلة التي لم تشهد أبدًا أي نوع من أنواع الاستقرار الأمني ولا أي شكل من أشكال
188
169
الأحاديث
الهدوء، فكنا دائمًا ما نتصدى لتلك الأزمات الأمنية، وقد تعرضت حياته للخطر أكثر من مرة من جراء محاولات اغتياله، والكمائن التي أرادوا بها القضاء على حياته، وقد أصيب في واحدة منها.
طوال تلك الفترة كنت معه؛ وقاتلنا سويا في فترة الاجتياح الإسرائيلي، في محور الغربية كما في محور كنيسة أبو جميل، وكلما حاولت قوات الاحتلال أن تتقدم كنا نتصدى لهم مع محمود، نلتف عليهم أحيانًا ونهاجمهم، عملنا بجهد كبير، واستطعنا بذلك تأخير تقدم العدو لأيام.كان محمود يقاتل كمجموعة من الرجال، مهما كانت قوة وعدد من يواجههم، لم يكن يأبه لهم أو يرف له جفن.
قاتلنا جنود الاحتلال بشكل يومي، دون توقف، إلا سويعات من الراحة، من وادي أبو جميل إلى المصيطبة، كنا نقاتل برشاشات الكلاشينكوف والقليل من قذائف ال «بـ7» والقنابل، كل تلك الأسلحة والذخائر كنا نجمعها من الأحزاب الهاربة، نأخذها ونقاتل بها.
عندما تقدم الصهاينة من جهة المرفأ انسحبنا باتجاه جسر سليم سلام لمواجهة تقدمهم. وهناك حدثت مواجهة عنيفة جدًا، تكبدت خلالها قوات الاحتلال خسائر جسيمة، ولا أبالغ إذا قلت أن نصف تلك الخسائر كانت بفعل نيران محمود وحده، والنصف الآخر بنيران سائر المجموعة. كان يقفز كالأسد، يلتف على الدبابة، يطلق قذيفته التي لا تخطئ، ثم يتوجه إلى آلية أخرى فتشتعل بمن فيها.
189
170
الأحاديث
لم أعرف أحدًا بطيبة قلب محمود، ومرحه الدائم حتى في أخطر الأوقات، كأن الخطر لا يعنيه ولا علم له بالخوف. كان يلعب الملاكمة والكاراتيه، يحب الرياضة، كثيرًا ما كنا نتعرض للضرب منه على سبيل الممازحة.
محمود إنسان متدين جدًا، وللمسجد حضور قوي في حياته فلم يكن يصلي إلا بالجامع، وكان مطلعًا، حسن الثقافة، معلوماته مهمة، وكان لا يترك الاهتمام بالثقافة رغم انشغاله العسكري بما يتوفر لديه من قراءة أو حضور للمحاضرات، يخاف الله، في سيارته يستمع للقران الكريم وفي بعض الأحيان للأناشيد الإسلامية.
لا تجد في الحي ولا في الجوار شخصًا لا يحبه، ولا يمكن أن يحدث إشكال بينه وبين أحد، فالجميع كان يحبه ويحب السهر معه ومرافقته.
أكملنا القتال مع محمود ضد الاحتلال، هو كان لديه سيارة «جيب» صغيرة، كنا نبحث عن موقع للجنود الصهاينة، فهو لم يكن يستطيع الجلوس وهناك جندي للاحتلال في مكان يستطيع الوصول إليه.
في تلك المرحلة اعتقل العديد من المقاومين وبعض رجال الدين ممن تبنّى فكر المقاومة وعملها، وأصبحت الأمور تأخذ منحى تصعيديًا لا سيما بعد اتفاقية السابع عشر من أيار، حيث وصلت الأمور إلى أشدها.
190
171
الأحاديث
كانت أسماؤنا في تلك الفترة تتردد على مكبرات جيش الاحتلال وعملائه في الداخل، والمطلوب من الأهالي تسليمنا لهم.
بعد مجزرة صبرا وشاتيلا، أصرّ محمود على الذهاب إلى هناك علّه يستطيع أن يقدم المساعدة، وذلك قبل استشهاده بفترة قصيرة، فرضختُ لطلبه رغم الخطر الشديد، وعندما وصلنا في الليل كانت جثث الشهداء من المدنيين في كل مكان، تأثر محمود من هول ما رأى واشتعل الغضب في داخله على الحكام العرب وعلى كل من خطط لتلك المجزرة.
علمتُ أنه قاتل في الجنوب، إلا أن محمود لم يتحدث بذلك أبدًا.
في 9/9/1983م فتحت المعركة؛ أنا كنت مع مجموعة في «برج أبي حيدر»، ومحمود في البسطة مع مجموعة أخرى، اشتدت المعركة وسمعتُ أن محمود تعرض للإصابة، ثم علمنا باستشهاده.
كان الخبر صعبًا... صعبًا جدًا، وتم تشييعه إلى الجنوب، وكان تشييعًا مهيبًا.
191
172
الأحاديث
الحاج رمضان:
امتدّت معرفتي بالشهيد ما يقارب ثلاث سنوات، من سنة 1980م حتى استشهاده، كان أستاذًا في كلِّ شيء، في الجهاد وفي تفاصيل حياته اليوميّة، مبادراته، تعامله، حسن خلقه، وهو مصداق للحديث: «كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم».
بدأ عمله الجهادي من مراحل الدفاع ضدّ هجمات الأحزاب والتقلب الأمني إلى الاحتجاج، بدءًا من خلدة ثم صحراء الشويفات، حيث بدأ عدد المقاتلين ينقص بالتدريج حتى بتنا نعدّ على الأصابع، ومحمود مستمر دون توقف.
بقينا في «صحراء الشويفات» خمسة أو ستة أيام، استمرينا بالقتال حتى أغارت علينا الطائرات بقصفها الشديد، فتفرقنا، أنا ذهبت إلى الجنوب وعدنا بعد شهرين.
شاهدنا في صباح أحد الأيام جرافات الجيش اللبناني - الذي كان واقفًا إلى جانب قوات الاحتلال في ذلك الوقت - تعمل على رفع الدشم والسواتر عن الطرقات، فعلمنا أن أمرًا يُحضَّر لبيروت من تلك
192
173
الأحاديث
الحركة الدؤوب. وفي صباح اليوم التالي، رأيت محمود وقد وضع في المسجّل شريطًا ثوريًا - كما كان يفعل دائمًا عندما يتوتر الوضع- وكان يطلب إلينا التسلح والنزول، وقال:
«انظر إلى الإسرائيليين، إنهم قرب الجامعة العربية»، ركبت خلفه على الدراجة الناريّة ونحن مثقلان بالأسلحة، وهناك قرب شركة الماء شاهدنا شاحنة نقل صغيرة وقد رُكنَت جانبًا، أدرنا المحرّك وأحضرناها، ثم وضعنا عليه «هاون60»، وكنا نحمل أيضًا قذائف «بـ7 وج3» وإينيرغا ورشاشات كلاشينكوف، وخرجنا إلى «طريق الجديدة» ثم «الجامعة العربية»، وضعنا الشاحنة جانبًا وأخذنا سلاحنا الفردي وسرنا بمحاذاة الجدران، حتى أصبحنا في مواجهتهم وأطلقنا عليهم ما استطعنا من نيران.
كنا ننتقل من مكان إلى آخر، ذهبنا إلى «وادي أبو جميل» بعد ذلك، وكانوا على الساحل، وهناك نزلنا مجموعة من خمسة مقاتلين وقاتلنا بشراسة واشتبكنا معهم على الساحل، كنا نعيق تقدّم الدبابات ما استطعنا خلف محمود، نتابع حركته السريعة، نحاول محاكاته ونقوى به ونتشجع. ثم إلى برج أبي حيدر ثم البسطا والبربير، بقينا لأيام نتنقل مع محمود من مكان إلى آخر نعيق قوات الاحتلال ونُنزل بها خسائر واضحة، ثم دخلت قوات الاحتلال، فغادرنا إلى الضاحية.
192
174
الأحاديث
وهنا بدأت المخابرات تسأل عن محمود وتطارده، وكان لزامًا عليه أن يترك المنطقة، فخرجنا إلى الجنوب متفرقين وبطرق مختلفة، حيث بقينا لأيام وعدنا إلى بيروت.
وفي الانتفاضة الاولى، قبل انتفاضة السادس من شباط التي سقط فيها اتفاق السابع عشر من أيار، كنت أنا ومحمود وأحد الإخوة نواجه الجيش - الذي كان يساند الاحتلال في ذلك الوقت - وقاتلنا في غير مكان، وحين اشتدت المعركة وتم تطويقنا، ذهب كل واحد منا إلى جهة، وفي تلك المعركة استشهد.
194
175
الأحاديث
ويقول رفيق دربه الحاج أحمد:
هو رابع إخوته، في عائلة لديها ثمانية شبان: وفيق، علي (رحمة الله عليه)، محمد، ثم محمود، وبعده سمير، سامي، عزّت، حسين وشقيقات.
حمل السلاح مع الأحزاب باكرًا جدًّا، في الثانية عشرة من عمره، وقد أطلق عليه الفلسطينيون لقب «الوحش» وهو لا يزال في الرابعة عشرة.
بعد فترة وجيزة، حدثت مشكلة بينه وبين مجموعة من الأحزاب التي كان يعمل معها، فدخل إلى المركز الذي كانوا بداخله وهاجمهم بسلاحه، إلا أنهم غدروا به عند خروجه فأُصيب إصابة بالغة، سافر على إثرها إلى السعودية لما يقارب العام ونصف، ثم عاد أدراجه عند سماعه خبر استشهاد ابن خالته نعمة حيدورة.
بعد عودته من السعودية عاش أقل من سنتين في ميزان العمر، وفي ميزان العمل كانت تساوي عمرًا كاملًا لرجل لم يكن يرى من الدنيا سوى الجهاد، ومن الإنجاز إلا حرب الظالمين والدفاع عن المسحوقين.
195
176
الأحاديث
في مخزن للأسلحة كان عبارة عن سيارة «فان»، ومقرٍّ هو خيمة على سطح قديم، في وقت كان التدين تهمة خطرة يلاحق عليها. في هذا الوقت عاد محمود وتوالت معه الأحداث الجسيمة؛ من اجتياح وما بعده، وما سجّله محمود في تلك الفترة من إنجازات وأعمال بطولية.
عند عودة محمود إلى «فتح الله» ارتفعت المعنويات، واشتدّت الهمم، قويت شوكة الشباب، حياة جديدة دبّت إثر عودته، فيها من القوّة والثقة بالنفس ما يؤهلها لمواجهة الصعوبات من حصار ومعارك. مجموعة الشباب من الذين لا يملكون تجارب في الحرب كان محمود هو الأساس في تثبيتهم وشدّ أزرهم.
عندما وصل جيش الاحتلال إلى مشارف بيروت، انسحبت القوات المسلحة من المواجهة، وعندها قام محمود -ودون توجيه من أحد- بالتصدي للاحتلال، على قلّة أو حتى ندرة المتصدين له، بدءًا من خلدة والشويفات.
بعد مقتل بشير الجميل ومجزرة صبرا وشاتيلا، ودخول جيش الاحتلال إلى أحياء بيروت، تجمعنا مع محمود عند وصولها إلى بيروت، وكان يومها يمتلك «بيك أب»، وقد ثبّت عليه مدفع «هاون 60»، فنزل به إلى منطقة الراوندي باتجاه البحر، وكانوا يتقدمون من الجهة الشرقية لبيروت، ومحمود معه اثنان من الإخوة، وبدأوا يطلقون النيران من المدفع على الجيش المتقدم لإعاقة تقدّمه، لقد
196
177
الأحاديث
رمى محمود كلّ ما بحوزته من قذائف، حتى أن صندوق «البيك أب» ثُقب لشدّة القصف المتواصل، ثم عاد محمود والإخوة إلى فتح الله.
هناك اجتمعنا، وأخبرنا محمود أن جيش الاحتلال أصبح على مقربة منا، كلّ من يريد القتال - بشكل فردي - كان يأتي إلى «فتح الله» ليلتقي بمحمود وبالمقاتلين هناك، بمبادرات فردية يتوجهون إلى «فتح الله» حتى غدت تلك المنطقة بابًا وعنوانًا للجهاد، ومحمود معهم، وبه ومعه ترتفع معنويات الجميع.
وصل جيش الاحتلال بعد ذلك إلى منطقة الباشورة، واجهتهم هناك نيران المقاتلين من «فتح الله»، وردّت قوات الاحتلال بنيران كثيفة، حتى أن جامع البسطة - على مدخل فتح الله - تلقى العديد من القذائف ودُمرت مئذنته.
تمركزنا في أحد الأبنية غير الصالحة للسكن، كان بحوزتنا صواريخ صغيرة «3.5 بوصة»، رأيناهم على منطقة «كركون الدروز» فأطلقنا صواريخنا عليهم، فردوا هم بقصف المبنى الذي نتمركز فيه بشكل عنيف، دمروا أربع طبقات من المبنى ونحن ننزل منه.
ظننا أننا عائدون إلى منازلنا إلا أن محمود أشار إلينا أن نلحق به ففعلنا، فتوجه إلى منطقة برج أبي حيدر، وكان الصهاينة قد وزعوا قواتهم على ثلاثة محاور: «البسطة، سليم سلام، كركون الدروز»، ثلاثة مسارات للتقدم حددها الصهاينة يومها، وعندما وصلنا على أطراف
197
178
الأحاديث
الجسر كانوا قد وصلوا إلى طرفه الثاني، وهناك بدأت اشتباكات عنيفة جدًّا، وقد دمرت ثلاث عشرة آلية بالكامل، ومحمود سيد تلك المعركة وبطلها.
عندما أتحدث عن تلك المعارك يظن السامع أنني أبالغ في وصفها، أو أنني أتحدث عن أساطير، لأن ما حدث فيها يشبه الإعجاز، عندما نقول أن محمود أطلق يومها 56 قذيفة بشكل متواصل وهو يتنقّل من مكان إلى آخر يكون الأمر مثيرًا للدهشة وعدم التصديق. كانوا يقولون إن الملائكة تقاتل معنا في «فتح الله».
198
179
الأحاديث
الفقيد القائد الحاج مصطفى شحادة (أبو أحمد):
تعرفت إليه سنة 1980م عند عودته من السعودية، واستمرت علاقتي به لمدة عامين تقريبًا، وتلك الفترة كانت كافية للتّعلق بهذه الشخصيّة المخلصة، المضحّية، الكفوءة. قوة الجذب في شخصيته التي تفرض الاحترام والتقدير فرضًا غير متعمد.
في كل منطقة مأهولة هناك الطيبون والأشرار، الطالح والصالح، فكان مع الطيبين خدومًا صديقًا معينًا، لطيف المعشر، ومع الظالمين مخيفًا حد الرعب، يخافون من غضبه وسطوته، «الوحش» كان لقبه، إن ذُكر اسمه ترتعد مفاصلهم، كان نجمه لامعًا، دون أن يعتدي يومًا على أحد.
كنت مسؤول شارع فتح الله، ومحمود من سكانه. كنا نقاتل مع حركة أمل، نتحمل عبء تلك المرحلة، وكان محمود حضوره أوضح وعطاؤه وتضحياته أكبر، وشجاعته أكثر تميّزًا.
في الاجتياح، قاتلنا بمبادرات فردية في «الشويفات وخلدة». أخذنا على عاتقنا مواجهة الاحتلال؛ اشتباكات وإطلاق صواريخ صغيرة
199
180
الأحاديث
«سناب»، بخبراتنا القليلة في العِلم العسكري، ولكن بروحية عالية، القتال من محور إلى محور، من كلية العلوم إلى جوارها، من بيروت الغربية إلى خلدة سيرًا على الأقدام، ثم عدنا إلى بيروت، وهناك مواجهات عندما دخلنا بيروت من مبانٍ في فتح الله، عندما وصلوا إلى جسر «سليم سلام»، وهناك حصلت مواجهات صعبة وكان محمود أحد أهم أبطالها.
كنا نصعد إلى البناية ونطلق كل ما لدينا من قذائف الـ «بـ 7»، ثم ننزل سريعًا، ليتهدم خلفنا المكان الذي كنا فيه. ومواجهات على الجسر في بدايته، عند صائب سلام، ثم إلى الأمام قليلًا في مواجهة مباشرة سريعة وقوية، بذلنا فيها - على الرغم من عدم التكافؤ - كل جهودنا.
كان المقاتلون في بيروت قلة، كانت شوارعها خالية، ثم وصل جيش الاحتلال إلى البسطة التحتا، ومن قبلُ إلى الباشورة، اشتبكنا معهم قبل وصولهم إلى البسطا التحتا، لم نكن نملك إلا قذائف «بـ7، وبـ2»، ورشاشات، وفي هذه المعارك كان محمود هو الأساس في شجاعته وإقدامه، كانت المعنويات معه ترتفع، ويزداد بأس المقاتلين في وجوده.
لا يحب المسؤولية، ولا شأن له بها، كان كل همه الإنجاز.
ولاؤه للجمهورية الإسلامية والإمام الخميني لم يكن له مثيل،
200
181
الأحاديث
فهو من السباقين إلى رفع راية الجمهورية الإسلامية في لبنان، وكانت في شارع «فتح الله»، وكتب على جدران شوارعها: «شارع طهران في لبنان». كانت روحه متعلقة هناك، يسير في الشارع وهو ينشد أناشيد للجمهورية: «إيران... إيران... إيران...» بروح عالية، وحبًّا بتلك الثورة.
وبعد ذلك، كانت أسماؤنا مطلوبة من المخابرات والجيش اللبناني - الذي كان في تلك المرحلة خاضعًا للاحتلال - فذهب معي محمود إلى الجنوب، إلى بلدة الشرقية، حيث سكنّا في منزل عمي، ومن هناك أكملنا طريق المقاومة، بقينا هناك عدة أشهر ثم عدنا إلى بيروت، وإلى الانتفاضة حيث استشهد محمود في معاركها الأخيرة.
201
182
الأحاديث
ومن حديث لأبي كميل العاملي:
في التاريخ أمثلة كثيرة عن رجال شجعان أشداء، لكن أن ترى أمامك رجلًا كمحمود فإن الأمر مختلف.
إن هذا المثال الفريد محفور في ذاكرتي لا يمكن إزالته أو إضعافه، هو مثال تأنس في العودة إليه. عندما يتحدثون عن شجاعة أحد في التاريخ - عن مولانا أبي الفضل العباس مثلًا - لا بدّ من أن يخطر ببالي محمود كي أستطيع رؤية صورة الشجاعة بشكل أوضح.
عندما تنظر إلى محمود فإنك ترى رجلًا خاليًا من الدنيا، خاليًا تمامًا، لا يعنيه ما فيها، لا تعنيه لشخصه مطلقًا، كان منصرفًا عن الدنيا، لا يرى فيها أي مكسب شخصي، هكذا عرفته مذ تعرفت إليه، وحسب رأيي إن شجاعة محمود نابعة من ذاك الشعور.
لا تزال في ذاكرتي مشاهد لا تُنسى من جرأة محمود وشجاعته، وذلك الحادث عندما كنا فتيانًا في أواخر السبعينات، وكان محمود واحدًا منّا، يومذاك كنا مجموعة في شارع فرعيّ ضيّق، وفي نهاية الشارع بناء مطلّ على المكان، وفي تلك المنطقة مجموعة من المسلحين
202
183
الأحاديث
سيطروا بوجودهم المسلح على المنطقة والشارع، فبدأوا يطلقون النار لشلّ الحركة في الطريق وترهيب الناس، فأخذنا نسير بمحاذاة الأبنية علّنا نستطيع العبور، ولكن محمود أبى ذلك، فخرج يحمل سلاحًا إلى وسط الطريق، وتحت نيران أسلحتهم أطلق صليات من رشاشه، وسار إلى حيث ارتفع الطريق وأصبح في مواجهتهم وأطلق عليهم نيرانًا غزيرة، فاندفعنا نحن إليهم بسبب ما رأيناه من محمود ففروا من المكان.
لم أشاهد هذه الجرأة وهذه الشجاعة يومًا حتى في الأفلام، فقط لأن الشارع والحي يعنيانه، يعنيه الناس أكثر من نفسه، هذا هو محمود.
تكرّرت مثل هذه المشاهد مرارًا، لن أنساها، لأنها أول ما تربيت عليه، ولأننا كنّا لا نزال في مقتبل العمر. تكرّرت بعدها من محور إلى محور، قبل الاجتياح وبعده، ليصبح محمود مثالًا للشجاعة والإقدام إلى ما بعد استشهاده.
203
184
الأحاديث
ومن حديث لرفيقه أبو جهاد عطا:
لم يكن الشهيد محمود متدينًا منذ الصغر، وقد عمل في المجال العسكري باكرًا ضمن المنظمات الفلسطينية؛ إلا أنه كان محبًّا مخلصًا لمجتمعه المتديّن، يحميه ويدافع عنه وعن مساكين ذاك المجتمع بشكل خاص، ويحترم بشدّة المتدينين فيه، وكان هذا المجتمع المتديّن يميل في غالبيته إلى حركة أمل التي كانت على خصومة مع المنظمات أو أنها لم تكن على انسجام معها في تلك الحقبة على الأقل، حتى وصلت إلى المواجهات العسكرية في بعض المناطق، وكان محمود في تلك الفترة - على الرغم من انتمائه لتلك المنظمات - ودودًا، يتقرب من هذا المجتمع المتديّن، ولم يكن أبدًا معاديًا له.
لم يكن هذا الموقف متناقضًا، وإن بدا كذلك، فمحمود متعلق بالقضية الفلسطينية، والمنظمات كانت أقدر من ناحية الإمكانات العسكرية والتدريبية على القتال.
كان وقتها نصيرًا للفقراء والمتدينين، ويحاول جاهدًا تصويب الأمور والوقوف إلى جانب أصحاب الحقوق المهدورة في وجه تسلط
204
185
الأحاديث
الأقوياء وأصحاب النفوذ، وقد خاض معارك من أجل الدفاع عن تلك الفئة المحرومة، نصرهم غير مرة، حتى أنه أصيب إصابة خطيرة في خلاف مع بعض المسلحين التابعين لأحد المنظمات، ما جعله ينتقل إلى السعودية.
لم يطل به المقام هناك، فقد عاد فور سماعه خبر استشهاد ابن خالته نعمة حيدورة الذي كان متأثرًا به. في مرحلة سفره القصيرة اتجهت شخصيته إلى التدين وتبلورت بشكل واضح حين عاد؛ إذ إنه وقف بشكل كامل مع المتدينين، وخاض معارك الدفاع عنهم وعن منطقته، وكان معروفًا ببطولته وشجاعته قبل سفره، وذاعت شهرته أكثر بعد عودته، فهو رجل لا يخاف أبدًا، ومستعدّ للتضحية إلى أبعد حدود.
انضمامه لحركة أمل في ذلك الوقت شكل ظهرًا وسندًا، كان يكبرني بعام تقريبًا، وكنت أنا ورفاقي نشعر بقوته وشجاعته ونفخر بالوقوف معه، كنا محدودين بالنسبة إليه في إمكاناتنا وتدريباتنا وهو الشجاع المخضرم بالعمل العسكري، كنا نشعر بالفارق الضخم، نهابه ونحبّه حبًّا جمًّا، يسبقة لقب «الوحش»، حين يكون معنا نشعر أن الكفّة انقلبت لصالحنا مهما كان الفارق في العدّة والعدد في الجهة المقابلة، كان مجرد حضوره أحيانًا يمنع المعركة، فيكفي أن يعرف الطرف المقابل أن محمود في مواجهته حتى ينسحب ويتوقف عن إثارة المناوشات.
205
186
الأحاديث
في تلك المرحلة توالت الأحداث: اختطاف السيد موسى الصدر سنة 1978م، انتصار الثورة الإسلامية في إيران 1979م، استشهاد السيد محمد باقر الصدر سنة 1980م.
كان محمود بالنسبة إلينا كالحمزة عمّ الرسولP بالنسبة إلى المسلمين واستضعافهم في أول الإسلام عند وقوفه مع الرسول والاطمئنان والشعور بالقوة لوجوده.
كنا مستضعفين ومحاصرين، ونعيش القلق الدائم، حضور محمود معنا كان قد شكّل تلك القيمة ومنحنا الجرأة، لقد تعرضنا للكثير من الضغوط والظلم، نحن وكل مجتمعنا المحروم، ثم جاء الاجتياح الإسرائيلي، كانت الفترة الزمنية بين الاجتياح وآخر معركة في الدفاع عن أنفسنا لم تتجاوز الخمسة عشر يومًا. لذا، حين دخلت قوات الاحتلال واجتاحت الأراضي اللبنانية اختلط على الناس الأمر، فالكثير من الناس وجد في الاجتياح خشبة الخلاص من الحرب الأهلية والظلم الواقع على المستضعفين، جهلًا منهم بالعدو وأهدافه ولذلك لم يفكروا بالقتال ضد العدو الإسرائيلي. محمود لم يكن من هؤلاء، كان ذا بصيرة، يعرف الصهاينة ويعرف خلفياتهم.
في تلك المرحلة من الانقسام في الرؤية، بعضهم أصرّ على عدم القتال وعلى وجود طرق أخرى للتعامل مع الاحتلال، منها التفاوض أو الوقوف على الحياد، وكان محمود من الذين التزموا بأفكار الإمام
206
187
الأحاديث
الخميني { بالكامل، لا سيما بقتال جنود الاحتلال، وبدأت هنا أسطورة محمود ديب.
كان بطلًا شهيرًا قبل الاجتياح، وبعد الاجتياح أصبح أسطورة، فجيش الاحتلال كان وقتها صاحب سطوة كبيرة وكان الخلل واضحًا في الميزان العسكري، وقد صنع محمود ما يشبه المعجزات في أكثر من موضع، من خلدة حتى الانسحاب الإسرائيلي إلى مشارف بيروت ودخول الجيش إليها، كان محمود في كل هذا أسطورة في القتال.
207
188
الأحاديث
وعنه تتحدث زوجة صديقه:
تعرفت إلى الكثير من المقاومين في الفترة التي كنا نسكن فيها في غرفة تعود لأحد المراكز في الجنوب، وكان محمود من بين الإخوة أصدقاء زوجي، الذين سكنوا معنا في ذلك المركز، عندها كان ملاحقًا. كان محمود مميزًا بين كل الشباب، والأكثر حضورًا في الذاكرة.
قبل تلك المرحلة كنت أعرفه، إلا أنها كانت معرفة سطحية، أما عندما سكن معنا فإن شخصيته بدت أكثر وضوحًا، كان خجولًا مؤدبًا، وعندما كنت أقدم لهم الطعام، كان يحار كيف يشكرني وهو يقطر خجلًا، يحاول مساعدتي لأنني حامل، فيرفع عني الأعباء ما استطاع، ويعاملني كأخته الكبيرة، ودائمًا ما كنت أسمع منه: «الله يطول عمرك، الله يخليك».
لا زلت أذكر أنه لم يكن يتنقل في المنزل دون أن تسبقه كلمة: «يا الله»، ونظره إلى الأرض.
تلك الفترة التي دامت ستة أشهر التي رافقنا فيها، كانت بين فصلي الخريف والشتاء، كانوا يعودون وثيابهم ملطخة بالوحل... لم
208
189
الأحاديث
أكن أعلم ماذا يفعلون إلا أنني أعلم عن خروجهم اليومي أنهم كانوا يتابعون العمل المقاوم.
لم يكن لديهم الوقت الكافي للراحة، كانوا يغيبون طويلًا ويسيرون لمسافات طويلة أيضًا، أعرف ذلك من تعبهم الذي يظهر عليهم ومن آثار البراري على ملابسهم. في تلك الفترة كان الخطر داهمًا ودائمًا، بل في كل ساعة، وعندما كان الإخوة يخرجون لم نكن نعلم إن كانوا سيعودون سالمين أم لا.
كان رجلًا هادئًا متزنًا، فكلما سمعت عن بطولاته كانت الدهشة تعتريني، فكيف يعقل أن يكون هذا هو محمود؟! هذا هو الشاب الهادئ جدًا جدًا كما أعرفه؟!
لقد كان شديد الولاء للثورة الإسلامية في إيران، وللإمام الخميني{، أذكر محمود، وكأنه أمامي الآن، عندما يسمع النشيد الإيراني الذي يبدأ بـ« الله... الله... الله...» كيف يقف ويضع يده تارة على صدره، وعلى رأسه، وكيف تغالبه دموعه فيبكي.
كانت هذه المسيرة، وكان خط الجهاد كل شيء بالنسبة إلى محمود، الهواء الذي يتنفسه، أو كأن محمود يعيش من أجله... في أحاديثه كلها، في كل ما يفعل، كان الله موجودًا.
209
190
الأحاديث
ومن حديث للسيّد شاكر:
كان محمود مثالًا للقدرة والشجاعة، ما جاء لقب الوحش الذي لقب به قديمًا بشكل اعتباطي، بل كان فعلًا على الأرض. مجحف من يقول إن محمود كان متهورًا، بل هي شجاعة تصدر عن نفسٍ منكرة لذاتها، إنكار الذات هذا من لا يفهمه يراه تهورًا، هذا التفاني في شجاعة محمود وجرأته، عدم اهتمامه بما سيحصل له، نفسه التي باعها لله، تركها بين يدي الله ولم تعد له، لا يحسب حسابها، ما يحسب حسابه هو الفعل، الفعل في ما يقدمه ويعطيه في الدفاع عن المستضعفين.
الشجاعة أمر نسبي، تجد الكثير من المقاتلين شجعان لسبب ما، مثلًا: إن فلانًا كان شجاعًا في أرض المعركة لأن سلاح الجو يغطيه، أو أن هناك إسنادًا ناريًا يشلّ حركة العدو، أما شجاعة محمود فلها أبعاد أخرى هي ارتباطه بالله ونكرانه لذاته.
أن يواجه عددًا من الآليات، يطلق القذيفة ويطلقون عليه، القذيفة الثانية، وهو تحت النار يصيب الآلية الأولى والثانية والثالثة،
210
191
الأحاديث
لو فكر وقتها أن يتحرك ليحمي نفسه لما أصاب الآليات بدقة، فهو إن تحرك فلإيجاد مكان أفضل للإصابة، لذا كانت أهدافه مباشرة ودقيقة.
يقولون إن محمود قلبه ميت، لا! محمود بشر، وقلبه قلب بشر، لكنه أعار جمجمته لله، لا يرمي نفسه في التهلكة، هو حذر ودقيق، لا يربكه الخوف ولا يبعده عن هدفه.
لم أكن أعرفه قبل الاجتياح، كنت أسمع به، تعرفت إليه بعد الاجتياح ولمست لمس اليد كل ما كان يقال عنه وأكثر، بدءًا من حصار بيروت، إلى البربير ومار مخايل، الكفاءات، الليلكي والأوزاعي، في كل أماكن الشدة والحاجة، كنت تجد محمود كجزء أساسي مع مجموعة من الإخوة.
خمسة عشر يومًا تقريبًا من نزول الاحتلال إلى خلدة، كان مرابطًا في أماكن تقدّمهم، لم يكن تقدّم الاحتلال إلا بعد خروج الفلسطينيين ومجازر صبرا وشاتيلا، بدأ التقدم بشكل قوي، وهنا واجههم محمود ورفاقه مواجهة بطولية غير متوقعة على الليلكي، بعدها من المواجهات، أثناء دخولهم وفي تواجدهم داخل بيروت، في مواجهات متعددة من كرٍّ وفرّ. محمود ورفاقه كانوا مبدعين مبادرين، في هذه الأيام الستة تمت عمليات ضد جيش الاحتلال، لا أتذكر عددها ولكنه عدد غير قليل، ومحمود حاضر في الكثير منها، بعد ذلك، وبعد كل
211
192
الأحاديث
هذا الضغط الكبير الذي جعل اجتياح بيروت صعبًا ومكلفًا، دخل الجيش اللبناني برفقة الاحتلال، كانت الرؤية أن لا نجعله أيضًا مرتاحًا في الجنوب.
من سيخرج الأسماء التي تنطبع بالذاكرة من أمثال محمود، بشجاعته، وفعاليته، قسم من الشباب أرسلوا للتدريب قبل التوجه إلى الجنوب، أما محمود لا يحتاج إلى تدريب، مؤهل وجاهز، خبرته، تاريخه وتجربته، يجعلك كل هذا تعتمد عليه، تطمئن أن ما سيتولاه سينجز على أكمل وجه، ليست ثقة شخصية وأخوية إنما هي ثقة عملية.
شخصية محمود تستقر في الذاكرة، هو شخص صامت لا يتحدث في ما لا يعنيه، هادئ، لافت في هدوئه، لكنه في مكان الحركة كتلة من النار، شخص تعب على نفسه، دقيق في مواعيده، جاد جدًّا في التزامه مهما كان صعبًا، صبور وملتزم، الإيثار والمبادرة، مثلًا حين يستلم سلاحًا، لا ينتظر من يساعده، يبادر على الفور.
شارك في نقل الأسلحة إلى الجنوب على الرغم من الصعوبة، يجمع الأسلحة في أماكن، حيث يتم توضيبها في سيارة ويخترق فيها الحواجز والصعوبات، هي ليست عملية قتالية حيث كان معروفًا بقدرته، هذا عمل مختلف من حيث القدرة على الهدوء والاتّزان والحس الأمني، وشجاعته في هذه المهام المختلفة في المعركة يطلق النار،
212
193
الأحاديث
هنا معرّض للاعتقال والقتل، أداء العارف المسيطر في مهام غير مهام ساحة القتال.
عندما انتهى الاجتياح كان بإمكانه أن يستقر ويعمل لحياته، هو لم يفعل ذلك، قاتل في الاجتياح، وبعده مباشرة دخل معركة المقاومة في الجنوب، نقل الكثير من الأسلحة والمتفجرات، حدثت بعد ذلك مضايقات من الجيش اللبناني ليصبح عنصرًا مساندًا ورديفًا لجيش الاحتلال، حدثت الانتفاضة ضدّه، وكان محمود جزءًا أساسيًّا من تلك الانتفاضة.
نحن أمام شخصية مميزة بالفعل، شخصية مميزة بإمكاناتها الذاتية فريدة وقيادية، لو بقي حيًّا لكان له شأن كبير، شخصيته القيادية متعددة الإيجابيات ليس في ساحة القتال فقط.
صورة المقاتل الشجاع صاحب الإنجازات العسكرية هي الصورة التي طغت، لكن صورة الإنسان الطيب المهتم، تعامله مع الأطفال حيث يهتم بهم بطريقة غير عادية، تدينه، تعلقه بأهل البيت (عليهم السلام) وتقواه الذي يضرب به المثل، كل هذه صفات محمود.
هو في الميدان وحش، وبين أهله ومع الناس وديع كالحمل، تراه في غير ساحات القتال ناعمًا رقيقًا خجولًا، غاية في الأدب، لا يمكن أن تتخيل محمود بغير تلك السمات.
ملتزم بالتسبيح، لا تفوته صلاة الصبح، وقبل أن يفعل أي شيء
213
194
الأحاديث
كان يتوجه إلى الصلاة، كنت أراه كيف يصلي ويطيل في صلاته، كيف يقرأ التسبيح ويعقّب للصلاة، يقرأ الدعاء، سخيّة دموعه كانت أثناء قراءة الدعاء.
حين تراه بين مجموعة من الشباب يشدّك إليه، يأخذ قلبك ونظرك، ليس لأنك تملك قدرة على الالتقاط، ليست القدرة على الالتقاط هي الميزة، إنما إرساله هو المميّز.
214
195
الأحاديث
ومن حديث لرفيق دربه الحاج صابر:
انتمى محمود في البداية الى حركة فتح ثم أصبح في جبهة التحرير الفلسطينية، التي يرأسها أبو العباس، وكان شقيقي معه، ومن هنا تعرفت إليه، وحين استشهد شقيقي توطّدت معرفتي بمحمود، واكتشفته على حقيقته، واشتد تعلقي به حتى بتُّ ملاصقًا له.
كنت معه في معارك الأحزاب قبل الاجتياح، وكنت معه في التصدي لقوات الاحتلال، وفي كل ذلك كان محمود قائدًا فذًّا لا يهاب الموت، سريع الحركة، نشيطًا، لا ترى محمود إلا وسلاحه إلى جانبه وكأنه قطعة من جسده.
كان مهابًا ومحبوبًا في الوقت نفسه، حتى أن الفتيات اللواتي لم ترتدين الحجاب كنّ إذا مرّ محمود يخجلن ويغطين شعرهنّ.
ما كان ليكف عن العمل أبدًا، حتى في الفترة التي كان ملاحقًا فيها، وبعد عودته من إيران ازداد وعيه وازداد نشاطه، وتجذّر انتماؤه وحبه للثورة وللإمام الخميني. لقد حضر في إحدى الليالي وهو يحمل مجموعة من الصور للإمام الخميني وبعض الشعارات
215
196
الأحاديث
المناهضة لقطع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، وكانت الدولة آنذاك قد اتخذت قرارًا يقضي بقطع العلاقة مع إيران، وتوجه إلينا بالسؤال: «من يساعدني في رفع هذه الصور وهذه اللافتات في قلب بيروت؟»، فاجتمعنا حوله مجموعة من الشباب، حملنا أسلحتنا وتلثم بعض منا إلا محمود لم يكن ليخفي وجهه، وأنا تبعته في ذلك، وانطلقنا في جوف الليل ولم نعد إلا والمهمة قد تمّت، ليستيقظ الناس صباحًا وصور الإمام والشعارات تملأ الشوارع.
كان محمود يكره العملاء أكثر من كرهه للاحتلال نفسه، هم أعداؤه بالدرجة الأولى، وأذكر أننا كنا يومًا في خضم المعارك وكنا متوجهين لإنجاز مهمة ما، وما إن رأى اثنين من العملاء على إحدى شرفات المنازل حتى أراد العودة إليهم وتلقينهم درسًا، إلا أن الوقت كان قد ضاق علينا فترك ذلك وهو يزبد ويرعد، ولكن إحدى قذائف الجيش التي كانت تقصفنا سقطت على الشرفة وقتلتهم، فقلت له: «لقد كفاك الله قتلهم»، وكان فرحًا بما أصابهم، إلا أنه كان يحب أن يلقى الله يوم الحساب مع وسام - حسب تعبير محمود - بأننا قتلنا هؤلاء الأنذال.
بعد سيطرة الجيش اللبناني على بيروت الغربية، وملاحقته لكل الناشطين في العمل الجهادي، وعلى رأسهم محمود، ذهبت معه إلى الضاحية، ومن هناك قررنا التوجه إلى الجنوب في مهمات الإعداد للمقاومة.
216
197
الأحاديث
لم يكن الجنوب يومها جاهزًا لمواجهة الاحتلال، لا سيما والاحتلال في أول دخوله كان قد جاء بصفة منقذ من حرب أهلية طاحنة، ، وأنه ليس عدوًّا وأنه سيرحل ما إن يستتب الوضع، وخدع الناس بذلك. خبرة محمود وجرأته، سمعته التي تسبقه مسافة طويلة، أهلته ليكون ذا دور فاعل في تأسيس نواة المقاومة هناك.
كان أكثر عملنا هو نقل الذخائر وتوزيعها إلى أماكن محددة، بقينا ما يقارب العشرين يومًا، وبعد ذلك قيل لنا أن الأسئلة باتت تدور حولنا، ربما لأننا غرباء عن المنطقة، وأننا يجب أن نغادر في أسرع وقت.
ثقافة الولاية حملناها جميعًا من محمود ديب، كانت تجري في عروقه مجرى الدم، مع كل شهيق وزفير يتنفسها، إذا ما سمع أحدًا يقول «الخميني» دون لقب كان محمود يستفز ويقف غاضبا، ويقول: « الإمام، قل الإمام الخميني، هذا إمامنا، سيدنا، ولي أمرنا». يقولها نعم وبكل وضوح أنه يطيعه إطاعة مطلقة. منه تعلمنا العقيدة والإسلام المحمدي الأصيل، منه تعلمنا الفداء والتضحية، الأخلاق والعنفوان والثورة. كل من سار مع محمود مختلف عن سواه، أصدقاؤه للآن - وإن كبروا - ترى روح الثورة فيهم حاضرة قوية.
محمود ديب ثائر، والجهاد في سبيل الله مأكله ومشربه. كثيرًا ما
217
198
الأحاديث
كان يردد أن لا تهاون مع الأعداء والمحتلين، كنا نرى روح الثورة في كلّ شاردة وواردة فيه. كان يقوم بالمهمات العسكرية والأمنية بتلك الروح، في نشاط وجرأة لا مثيل لهما، حتى إنه كان يقوم ببعض المهمات العسكرية دون أن يذكر ذلك، ونعرف بعضها عن طريق الصدفة. لذا، كل من يتحدث عن محمود لن يقول عنه شيئًا، ما قام به وحده سيبقى خافيًا، وحده الله يعلم بكل إنجازات محمود وبطولاته.
في ذلك الوقت كان العاملون قلائل، خاصة في مناطق الغربية حيث كنا، ومحمود طاقة لا تهدأ، لا تعبأ بالظروف، لذا كان يبادر بالمهمات منفردًا، إن لم يجد أحدًا يقول: «لن نترك طريق الهدى لقلّة سالكيه». كنا عندما نسمع بعملية نحدثه عنها فيصمت ويستمع، وبعدها نعرف أنه هو من نفذها، فنطالبه، فيقول لنا: «وحدي أحسن وأسلم، لم أكن أحتاج أحدًا».
كانت جرأته غريبة، أذكر مثلًا أننا احتجنا يومًا لبعض الأسلحة للدفاع عن أنفسنا أيام الحرب الأهلية، وكانت هناك حواجز لقوات الردع العربية من الجيش السوري، لم يكن يومها يصلنا السلاح إلا بشكل فردي وقليل، فقال لنا محمود: «سنحضر السلاح والذخيرة من الخندق الغميق، هناك حواجز كثيرة على الطريق»، ثم رمى أمامنا على الأرض ثيابًا عسكرية كالتي يرتديها عناصر الجيش السوري، وبينها بزّة لضابط ارتداها هو، ثقتنا به جعلتنا لا نناقش ما يقوله
218
199
الأحاديث
طالما هو معنا، وهو يسير بلا تردد ويقول لنا: «مم تخافون؟ ألا تكفيكم وجعلنا من بين أيديهم سدًّا ومن خلفهم سدًّا...» لم يصدق أحد أننا استطعنا إحضار كل تلك الذخيرة.
حين أصبت في إحدى العمليات العسكرية، في وقت كان الجو الأمني ضاغطًا جدًّا، لم نكن نملك المال لزيارة طبيب لا نثق به، كما لا يمكننا الذهاب إلى المستشفى بإصابة عسكرية فاعتقالنا هناك مؤكد، كان محمود يعرف صديقًا يعمل في مستشفى الزهراء، فأخذني وأدخلني من مخرج النفايات الطبية، ولا أدري كيف وصل صديقه والمعالج حيث تمّت معالجتي وقطّب لي ظهري في مكان منعزل وأعادني إلى المنزل، حيث أبقاني في منزل أحد أصدقائه ثمانية أيام، وكان يأتي لعيادتي كل يوم، وأحيانًا مرتين في اليوم، علمًا أنه في تلك المرحلة كان مطاردًا ومطلوبًا، وكان يسير متخفيًا ليحضر لي كل يوم الطعام وما أحتاجه بعناية وكرم، من ماله الخاص.
كان كريمًا جدًّا، كان ينفق من ماله الشخصي، كل ما يملك من مال صرفه على الجهاد وعلى ما يحتاجه المجاهدون من أسلحة ومصارفات، كان يدهشنا لشدة كرمه، فهو كان يشتري لنا الملابس إذا ما شعر بحاجتنا إليها. كان يعاملنا جميعا كالأخ الاكبر، يحب المجاهدين كثيرًا بل يذوب في حبهم، كنت على يقين أننا كعائلته، أسلوبه، طريقة تعامله كانت تقول ذلك.
219
200
الأحاديث
إذا سألنا عن مال، كان محمود يرفع ذراعه عن جيبه دون أن يتكلم، في حركة تعني أن مدّ يدك وخذ ما تشاء، أو كان يشير إلى بنطاله المعلّق ويقول: «خذوا منه واشتروا حاجاتكم، لستم مسامحين أن تضيّقوا على أنفسكم وأنا أملك المال».
أيقظته يومًا لآخذ منه مالًا، لم أعد أذكر ماذا أردت بذلك المال، فنظر إلي غاضبًا، وقال: «أتقول أنك أخي!؟ لو كنت كذلك لأخذت ما تريد».
كنا نشعر أننا برفقة عملاق، برفقة ثائر لا نعرف مثيلًا له.
كان قائدًا لنا وما كان ليتصرف تصرف القادة، لم يكن يعطي أمرًا لأحد، يذهب أمامنا ونحن خلفه، ينفذ وننفّذ معه، يعمل ونساعده، نسأله فيجيب، لم يقل يومًا انقلوا الأسلحة كان ينقلها هو ونحن نساعده، تلك كانت طريقة محمود.
كم من مرة استيقظت ورأيته يغطيني، أو يغطي أحدًا من رفاقنا. في الجنوب لم نكن نملك الثياب، كنا نغسل ثيابنا في الليل لنرتديها في النهار، حين شاهد محمود ذلك استيقظنا يومًا فلم نجده وكان الوضع الأمني سيئًا، فقلقنا عليه، وعندما عاد كان يحمل لكل واحد منا ثيابًا تناسبه، ذهب واشتراها من السوق على الرغم من الخطر، ومن ماله الخاص، وكان يرفض حتى كلمة الشكر، ما أجمل وأصدق أن يقال عن محمود أنه مصداق لقوله تعالى: «أشداء على الكفار رحماء بينهم».
220
201
الأحاديث
لم يكن أعداؤه ليواجهوه أبدًا، رأيت أكثر من مرة فرارهم عندما يعلمون بوجوده، وسمعتهم أيضًا يقولون أكثر من مرة إن محمود الوحش قادم مع رفاقه، سمعت هذه العبارة مرة في طريقي للقاء محمود.
محمود مبدع في كل شيء، مختلف وفريد، حتى في التدريب، يطور مهاراته التي لم نكن لنصدق أنها بحاجة إلى تطوير، فإن القتال كان هوايته المفضلة كما يفضل الشباب لعبة الطاولة أو غيرها، كان سبّاقًا للتدريب على القتال بالدراجة النارية، كان ماهرًا في قيادتها والقتال عليها، والقفز عن الحواجز والأماكن الصعبة، مهارته تأخذ بالألباب. في وقت لم تخطر هذه الطريقة على بال أحد هي اليوم اختصاص مستقل.
اصطحبنا مرة إلى منطقة عرمون، حيث الحزب التقدمي الاشتراكي يقيم معسكرًا للتدريب عبر أحد أصدقائه - وما أكثر أصدقاء محمود - أخذنا إلى هناك يدربنا على ما يجيده ويعرفه، فأذهل الحاضرين، كيف ترمي برشاشك وأنت تقود وتصيب أهدافك، يضع تلالا وحواجز ومسالك ويدربنا على تخطيها، وقد استفدنا من هذه التدريبات كثيرًا. كان تفكيره للمستقبل، يسبقنا بأشواط، بل كان سابقًا لعصره كله.
كان مستعدًا دائمًا، حتى أنه لم يكن ينام إلا وسلاحه قربه، مسدسه تحت الوسادة، كثيرًا ما كان ينام بلباسه العسكري حتى في حذائه، وينام في أي مكان، لا فرق عنده.
221
202
الأحاديث
أما من عامة الناس، فقد كان محبوبًا بطريقة لا تصدّق، الكل يعرفه والكل يحبه، لم أرَ محبوبًا من الناس مثله، يلقي التحية ويردها عشرات المرات في خطوات قليلة، ترى فيها ابتسامة الناس له ومحبتهم الفائضة. بعضهم كان يستوقفه أو يسير معه لخطوات كي يحدثه بضع كلمات، وهو بشوش، صاحب طرفة، هو كتلة من الإنسانية والعطف.
إذا شاهد امرأة تحمل جرة ماء أو أي حمل ثقيل فإنه يركض إليها ويحمل عنها إلى منزلها، ويعود أدراجه. إذا رأى رجلًا يحمل صندوق خضار، يترك جلستنا ويركض إليه يساعده في حمل الصندوق، يوصله إلى المكان الذي أراد ويعود إلينا لنكمل جلستنا.
تعلمنا من محمود الكثير، بل أكثر من الكثير، كان أستاذًا في كل المواد التي تعلمناها منه، وبمجرد حضوره يحضر الدرس.
ما أكثر الباكين عليه يوم استشهاده، لم أشاهد حزنًا وذهولًا كما رأيت في استشهاد محمود.
222