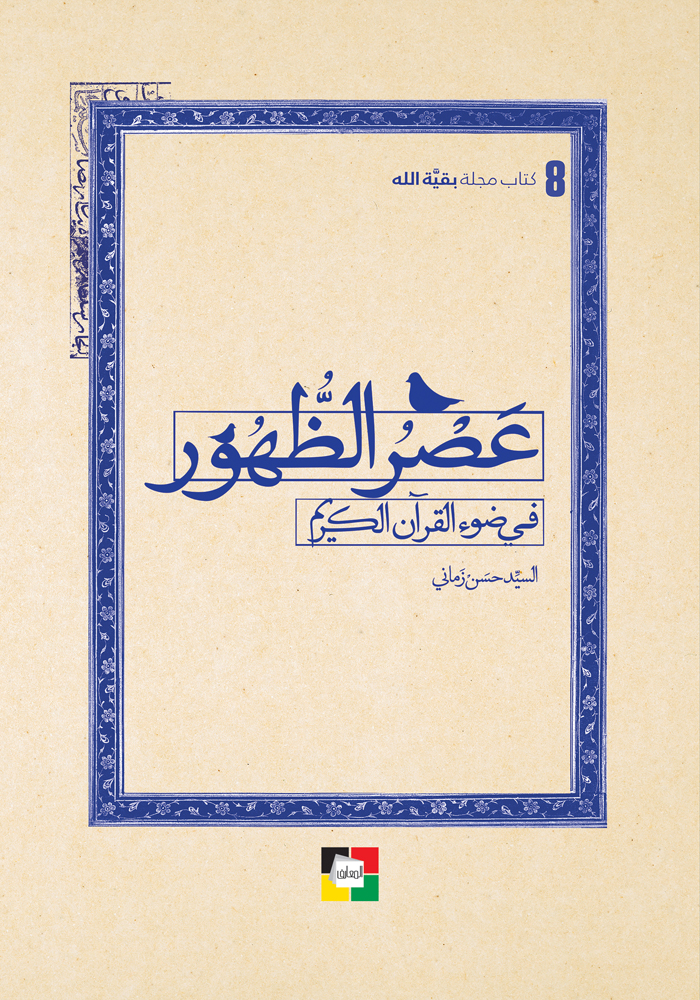مقدّمة مجلة بقية الله
مقدّمة مجلة بقية الله
الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
قليلة هي القضايا التي يتّخذ الإيمان بها أبعاداً شاملة كما هو الحال في القضيّة المهدويّة، التي ترتبط بالعقل والفطرة والتاريخ والحاضر والمستقبل، والتي لا تنفك عن حركة المؤمنين بها، أكان في نهج تفكيرهم أم في سلوكهم، حتى باتت شعاراً لهم يرفعونه في جهادهم السياسيّ والعسكري بل والاجتماعيّ والفكريّ والثقافيّ وغيره.
ولأنّ هذه القضيّة تحمل ثقلاً ومكانة كبرى من الناحية العقائديّة والدينيّة، وكذلك يتجلّى التأثر بها بشكل واضح في مسار حركة الموالين للإمام والمحبّين له (عجل الله تعالى فرجه)، فقد دأب العلماء والمفكرون والباحثون في المسائل المهدويّة على أن يغوروا في أعماق هذه القضية، فيجمعوا كلّ ما يرتبط بها من حيث البيان والدليل والسرد والتحليل، وكان القرآن الكريم والسنّة المطهّرة من أبرز موائد الباحثين في ذلك على طول التاريخ الإسلاميّ، والتي لا تذر شكاً ولا ريباً في كونها من أعظم المسائل التي يطرحها هذا الدين الحنيف.
7
مقدّمة مجلة بقية الله
ولقد جاء هذا الكتاب مبيّناً العديد من الآيات القرآنيّة الكريمة، مقرونة بأحاديث واردة عن لسان النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة الأطهار (عليهم السلام)، تتطابق في ما بينها وبين آيات القرآن، تارةً في أصل القضيّة وتارةً أخرى في بعض تفاصيلها وأبعادها.
وقد حرصت مجلة بقيّة الله كما هي عادتها، على أن تقدّم لقرائها الأعزاء جرعة فكريّة وثقافيّة مهدويّة بشكل دائم ضمن أعدادها الشهريّة، وكذلك ضمن إصدارها الكتاب السنويّ، وكان هذا الكتاب الذي بين أيديكم مسلّطاً الضوء على نكات جميلة واءمت بين القرآن والسنّة المطهّرة بأسلوب سلس وواضح، راجين من المولى العليّ القدير أن يثبّتنا على نهج رسوله الكريم والأئمة الأطهار الميامين، وأن نكون جنوداً بين يدي مظهر العدل والإيمان، عجّل الله تعالى فرجه الشريف.
8
مقدّمة المؤلّف
مقدّمة المؤلّف
الحمد لله خالق الخلق، المبدئ المعيد، وله الثناء سبحانه أنْ أرسل رسله هداةً للعباد، ولا سيما خاتمهم (صلى الله عليه وآله)، وجعل أهل بيته (عليهم السلام) مصابيح هدىً إلى يوم القيامة، سينير بآخرهم -وليّه المدّخر-، مشارق الأرض ومغاربها.
إنّ قيام الإمام المهديّ(عجل الله تعالى فرجه) هو لإقامة الحقّ في العالم، وهو الهدف نفسه الذي كان لأجله مجيء النبيّ الأكرم(صلى الله عليه وآله) وقيامه، وإنّ اليوم الذي سيظهر فيه الإمام(عجل الله تعالى فرجه) هو يوم سرورٍ وبشرى للمؤمنين والصالحين؛ ففي ظلّ دولته الكريمة خلاصهم ونجاتهم من الخوف والظلم، وفيها يكون أَمْنهم وازدهارهم.
قال تعالى في القرآن الكريم : ﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ لَا تَبۡدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾[1].
إنّ البشارة الأهمّ التي بشّر بها الباري تعالى أولياءه في الدنيا، هي بشارة ظهور الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)؛ في الرواية التي نقلها أبو عبيدة الحذّاء عن الإمام الباقر(عليه السلام)في تفسير قوله تعالى: ﴿لَهُمُ
[1] سورة يونس، الآيات 62 – 64.
9
مقدّمة المؤلّف
ٱلۡبُشۡرَىٰ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ﴾، قال: «وَالِإمَامُ يُبَشِّرُهُمْ بِقِيامِ الْقَائِمِ وَبِظُهُورِهِ وَبِقَتْلِ أَعْدَائِهِمْ وَبِالنَّجَاةِ فِي الْآخِرَةِ وَالْوُرُودِ عَلَى مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله)[1] عَلَى الْحَوْضِ»[2].
بخروج الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) سيملأ نور الله العالم بأسره، وفي ظلّ وجوده سيتجلّى الإيمان والعدل وسينتشر العلم، وتُستأصل ظلمات الشرك والظلم والجهل، وسيشرق صبح ذلك اليوم بضيائه الأبهى.
يقول مُثنّى الحنّاط إنّه سمع الإمام الباقر(عليه السلام)يقول: «أَيَّامُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ: يَوْمَ يَقُومُ القَائِمُ (عجل الله تعالى فرجه)، وَيَوْمَ الكَرَّةِ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ»[3].
هذه الرواية تذكر مصاديق «أيّام الله» التي وردت في القرآن الكريم، وأوّل المصاديق التي ذكرَتها يوم قيام الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)؛ وكأنّ الفترات التي سبقت قيامه خيّمت عليها ظلمات الشرك والظلم؛ فحالت دون انبلاج ضوء الصباح. صحيحٌ أنّ كلّ يومٍ حصلت فيه معجزةٌ أو نزل فيه أمرٌ من الله هو يومٌ من أيّام الله تعالى؛ إلّا أنّ هذه الأيّام الثلاثة هي الأكثر ظهورًا وحضورًا.
[1] لم نجد عبارة: "وآله الصادقين" في متن الرواية؛ يُحتمل أنّ المصنّف أخذ الرواية من شرح أصول الكافي حيث كانت هذه العبارة جزءًا من الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله، وقد وُضعت جميعها بين شرطتين. (المترجم)
[2] الكلينيّ، الكافي، ج1، ص429، ح83. الرواية مُعتبرةٌ من جهة السند.
[3] الشيخ الصدوق، الخصال، ج1، ص108، ح75. نقل هذا الحديث أيضًا كتاب معاني الأخبار عن مُثنّى الحنّاط عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه الإمام محمّد الباقر عليه السلام، (معاني الأخبار، ص365، باب معنى أيّام الله عزّ وجلّ). وعلى الرغم من اختلاف الرواة الذين نقلوا الحديث عن "مُثنّى الحنّاط" في معاني الأخبار والخصال؛ إلّا أنّ كلا السندين صحيحان.
10
مقدّمة المؤلّف
سنسعى في هذا الكتاب لتقديم رؤيةٍ جديدةٍ من خلال القرآن الكريم حول بحث ظهور الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، وعلى الرغم من صعوبة الحديث عن ضوء النهار في عتمة الليل؛ إلّا أنّنا سنحاول أن نُشعل شمعةً تحكي ومضةً من ضوء النهار.
وقد حُرّر هذا الكتاب في أربعة فصول:
الأوّل: نظرةٌ عامّة
الثاني: حوادث عصر الظهور
الثالث: معالم عصر الظهور
الرابع: تجلّيات عصر الظهور
نسأل الله تعالى أن تكون هذه التحفة المُزجاة محلّ قبوله تعالى وقبول خاتم الحجج(عجل الله تعالى فرجه).
11
أوّلًا: قاعدة الجري والتطبيق في القرآن الكريم
أوّلًا: قاعدة الجري والتطبيق في القرآن الكريم
القرآن الكريم كتابٌ جامعٌ نزل من عند الله عزّ وجلّ، وهو الكتاب الذي وصل إلينا عن طريق خاتم الأنبياء محمّد (صلى الله عليه وآله) طوال 23 سنة. هذا الكتاب هدىً للعالمين، يجري كما يجري الشمس والقمر، و«مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ»، وما عاش إنسانٌ على وجه هذه البسيطة، وهو في كلّ زمانٍ غضٌّ جديد، ولآياته مصاديق جديدةٌ تنطبق عليها؛ وإلّا لتوقّف به الزمن مع رحيل النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) ولما كان هدىً للناس من بعده؛ ولمزيدٍ من البيان نذكر حديثين في المقام عن أهل البيت (عليهم السلام):
الحديث الأول: عن عبد الرحيم بن قصير عن الإمام الصادق(عليه السلام)قال:
«إِنَّ الْقُرْآنَ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ، وَإِنَّهُ يَجْرِي كَمَا يَجْرِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَكَمَا تَجْرِي الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَيَجْرِي عَلَى آخِرِنَا كَمَا يَجْرِي عَلَى أَوَّلِنَا»[1].
[1] العيّاشيّ، التفسير، ج2، ص203، ح6. المجلسيّ، بحار الأنوار، ج35، ص403، ح21.
15
أوّلًا: قاعدة الجري والتطبيق في القرآن الكريم
الحديث الثاني: عن يعقوب بن السُكّيت أنّه سأل الإمام الهادي (عليه السلام): ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدّرس إلّا غضاضةً؟ قال:
«إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَلاَ لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ، فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ، وَعِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[1].
من هنا، عندما تأمر آيةٌ من آيات القرآن الكريم بقتال المشركين لتكون «كَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا»، أو تأمر بإقامة دين الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وكذلك حينما يأتي الخطاب: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ» و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ»، فليس لهذه الآيات ونظائرها اختصاصٌ بزمان النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله)؛ بل هي جاريةٌ إلى يوم القيامة. والحال هو نفسه في الآيات التي نزلت في النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) ولزوم إطاعته، فهي جاريةٌ في أوصيائه كذلك.
[1] الشيخ الطوسيّ، الأمالي، ص580، المجلس24، ح8.
16
ثانيًا: الإخبارات الغيبيّة في القرآن الكريم
ثانيًا: الإخبارات الغيبيّة في القرآن الكريم
إنّ أحد وجوه ومظاهر إعجاز القرآن الكريم النبوءات والإخبارات الغيبيّة التي جاء بها؛ فكما أخبر القرآن الكريم عن الأمم السابقة؛ كأقوام الأنبياء نوح وهود وصالح وإبراهيم (عليهم السلام)، وذكر مفصّلًا أخبار النبيّ يوسف والنبيّ موسى والنبيّ عيسى (عليهم السلام)، كذلك أخبر عن المستقبل القريب والبعيد. فتراه تارةً يُخبر عن فتح مكّة ودخول المسجد الحرام، وأخرى عن الانتصار القريب للروم على الفرس في وقتٍ كانت فيه الغلبة للفرس على الروم، وكانت الإمبراطوريّة الفارسيّة في أَوج قدرتها، وإلى جانب هذه الإخبارات فإنّ ورثة الأرض -وفقًا للرؤية القرآنيّة-، هم الصالحون والمتّقون، وهي الوراثة الصالحة المستمرّة إلى يوم القيامة؛ وقد أشارت روايات أهل البيت (عليهم السلام) إلى هذا الجانب من إعجاز القرآن الكريم.
عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين(عليه السلام)قال:
«سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ (صلى الله عليه وآله) يَقُولُ: أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِكَ فِتْنَةٌ، قُلْتُ: فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا؟ فَقَال: كِتَابُ اَللَّهِ فِيهِ بَيَانُ مَا قَبْلَكُمْ مِنْ خَبَرٍ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ»[1].
[1] تفسير العيّاشيّ، ج1، ص3، ح2. بحار الأنوار، ج89، ص24، ح25.
17
ثانيًا: الإخبارات الغيبيّة في القرآن الكريم
عن سُماعة بن مهران أنّه سمع الإمام جعفر الصادق(عليه السلام)يقول:
«إِنَّ اَللَّهَ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابَهُ الصَّادِقَ الْبَارَّ، فِيهِ خَبَرُكُمْ وَخَبَرُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَخَبَرُ السَّمَاءِ وَخَبَرُ الْأَرْضِ، فَلَوْ أَتَاكُمْ مَنْ يُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ لَعَجِبْتُمْ»[1].
[1] البرقيّ، المحاسن، ج1، ص267، ح353. الرواية مُعتبرةٌ من جهة السند.
18
ثالثًا: محوريّة القرآن الكريم في عصر الظهور
ثالثًا: محوريّة القرآن الكريم في عصر الظهور
صحيحٌ أنّ القرآن الكريم نزل على النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله)، وقد قام (صلى الله عليه وآله) بتلاوته على المسلمين؛ إلّا أنّ بعض آيات القرآن الكريم لم تتحقّق، وزمان ظهور الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) هو زمان تحقّق وجريان هذه المجموعة من الآيات، سواءٌ لجهة العمل بتمام أحكامها وأوامرها، أو لجهة اتّساع دائرة العمل بها لتشمل العالم بأسره.
إنّ القرآن الكريم هو أساس حركة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، وهو مصداقٌ من مصاديق ﴿عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلۡكِتَٰبِ﴾[1]، وهو الذي سيتحقّق على يديه في عصر الظهور ما جاء في هذا الكتاب العزيز؛ وفي هذا السياق نستعرض عددًا من الأحاديث.
الحديث الأول: جاء في رواية عمّار بن ياسر عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) حول انطباق القرآن الكريم في عصر الظهور:
«فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْرُجُ فَيَمْلَأُ الدُّنْيَا قِسْطًا وَعَدْلًا وَيُقَاتِلُ عَلَى التَّأْوِيلِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ، وَهُوَ سَمِيِّي وَأَشْبَهُ النَّاسِ بِي»[2].
[1] سورة الرعد، الآية 43.
[2] بحار الأنوار، ج36، ص326، ح183.
19
ثالثًا: محوريّة القرآن الكريم في عصر الظهور
الحديث الثاني: عن أبي الجارود عن الإمام الباقر(عليه السلام)أنّه قال: «فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا نَطَقَ وَصَدَّقَهُ الْقُرْآنُ»[1]؛ أي إنّ الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) يَمضي في جميع أقواله وأفعاله على خطى القرآن الكريم، ولا ينطق إلّا بما يوافق كتاب الله العليم.
الحديث الثالث: عن الإمام الصادق عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
«الْقَائِمُ مِنْ وُلْدِي، اِسْمُهُ اِسْمِي وَكُنْيَتُهُ كُنْيَتِي وَشَمَائِلُهُ شَمَائِلِي وَسُنَّتُهُ سُنَّتِي، يُقِيمُ النَّاسَ عَلَى مِلَّتِي وَشَرِيعَتِي وَيَدْعُوهُمْ إِلَى كِتَابِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ»[2].
الحديث الرابع: في كلامٍ لأمير المؤمنين(عليه السلام)حول محوريّة القرآن في الدولة الكريمة للإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، والعمل وفق ما جاء فيه يقول:
«يَعْطِفُ الْهَوَى عَلَى الْهُدَى إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهَوَى، وَيَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ»[3].
أكّد أمير المؤمنين(عليه السلام)في كلامه محوريّة القرآن الكريم في عصر الظهور، وبيّن(عليه السلام)أنّ الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) سيُجري إرادة الله تعالى؛ ويُغيّر بذلك مسير الناس من الضلالة إلى الهداية.
[1] الصفّار، بصائر الدرجات، ج1، ص21، ح3. بحار الأنوار، ج2، ص191، ح27.
[2] الشيخ الطوسيّ، كمال الدين، ج2، ص411، ح6.
[3] نهج البلاغة، ص195، الخطبة 138.
20
أوّلاً: اجتماع الأصحاب وبيعتهم
عصر الظهور هو عصر التغيير والتحوّل في جميع الميادين؛ عصرٌ سيشهد وقائع وحوادث عظيمة في عالم الخلق وفي المجتمعات الإنسانيّة. وفي هذا الفصل سنتناول بعض تلك الوقائع.
أوّلاً: اجتماع الأصحاب وبيعتهم
عندما يحلّ عصر الظهور سيجتمع أنصار الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) كسُحُب الخريف، من نقاط العالم كلّها إلى مكّة المعظمة، ويقومون مع إمامهم لإحقاق الحقّ وإقامة العدل.
في كلامٍ جميلٍ ومؤثّرٍ يُلامس القلب، يُشبّه أمير المؤمنين تجمّع الخواصّ من أنصار إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) بتجمّع سحب الخريف، فيقول:
«سَيَجْمَعُ هَؤُلاَءِ لِشَرِّ يَوْمٍ لِبَنِي أُمَيَّةَ كَمَا يَجْمَعُ قَزَعَ الْخَرِيفِ، يُؤَلِّفُ اللَّهُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَجْعَلُهُمْ رُكَامًا كَرُكَامِ السَّحَابِ، ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابًا يَسِيلُونَ مِنْ مُسْتَثَارِهِمْ كَسَيْلِ الْجَنَّتَيْنِ سَيْلَ الْعَرِمِ»[1].
في هذا الفصل سنتناول آيتين من آيات القرآن الكريم في ما يرتبط باجتماع الأنصار وبيعتهم.
[1] الكافي، ج9، ص52، ح22. الشيخ المفيد، الإرشاد، ج1، ص291. وقد أشارت الآيتان 16 و17 من سورة سبأ إلى سيل العَرِم؛ إذ أرسل الله سيلًا مدمّرًا على قوم سبأ لانحرافهم وإعراضهم عن الأمر الإلهيّ؛ فبدّل الله بجنتيّهم الجميلتين المليئتين بأنواع الأشجار المختلفة جنّتين مُرّتيّ الثمار قليلتيّ الأشجار: ﴿لَقَدۡ كَانَ لِسَبَإٖ فِي مَسۡكَنِهِمۡ ءَايَةٞۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٖ وَشِمَالٖۖ كُلُواْ مِن رِّزۡقِ رَبِّكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥۚ بَلۡدَةٞ طَيِّبَةٞ وَرَبٌّ غَفُورٞ ١٥ فَأَعۡرَضُواْ فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ سَيۡلَ ٱلۡعَرِمِ وَبَدَّلۡنَٰهُم بِجَنَّتَيۡهِمۡ جَنَّتَيۡنِ ذَوَاتَيۡ أُكُلٍ خَمۡطٖ وَأَثۡلٖ وَشَيۡءٖ مِّن سِدۡرٖ قَلِيلٖ﴾.
23
أوّلاً: اجتماع الأصحاب وبيعتهم
1. الآية الأولى: ﴿أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡء قَدِير﴾[1].
تفسير الآية:
تقول هذه الآية في سياق الردّ على اليهود الذين أثاروا كثيرًا من الجدل حول تحويل القِبلة: لكلّ جماعةٍ قِبلتهم التي عيّنها الله تعالى لهم: ﴿وَلِكُلّ وِجۡهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَاۖ﴾؛ أي إنّ القِبلة ليست من الأمور الثابتة التي لا تتغيّر كأصول الدين أو الأمور التكوينيّة مثلًا؛ فلا تُكثروا البحث والجدال حول تغيير القِبلة، وليكن انشغالكم في استباق الخيرات: ﴿فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ﴾، ثمّ تأتي الآية على ذكر مسألة القيامة، وأنّ الله تعالى سيأتي بالناس جميعًا إلى تلك المحكمة العظيمة ليُثيبهم ويعاقبهم وفق أعمالهم: ﴿أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًاۚ﴾.
قد تبدو هذه الجملة عجيبةً لبعضٍ؛ فكيف سيجمع الله تعالى ذرّات الإنسان المتناثرة والمنتشرة من كلّ مكانٍ هي فيه؛ من هنا تناولت الآية في ختامها قدرة الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡء قَدِير﴾.
[1] سورة البقرة، الآية 148.
24
أوّلاً: اجتماع الأصحاب وبيعتهم
للمفسّرين في هذه الآية المباركة والإتيان بالناس أين ما كانوا أقوال عدّة:
القول الأول: المُراد بقوله تعالى: ﴿أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ...﴾، هو أنّكم وإلى أيّ مكانٍ مضيتم، سيأتي الله بكم جميعًا إلى المحشر يوم القيامة، وقد ذهب أكثر المفسّرين إلى هذا القول[1].
القول الثاني: المُراد بالآية: أينما تكونوا من الجهات المختلفة يأْتِ بكم الله جميعًا؛ يجمعكم ويجعل صلواتكم كأنّها إلى جهةٍ واحدة، وكأنّكم تُصلّون حاضري المسجد الحرام، وقد ذهب بعض المفسّرين إلى هذا القول[2].
القول الثالث: المُراد من الآية أصحاب الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، الذين سيأتي بهم الله عند الظهور من كلّ نقاط العالم إلى مكّة. ذَكر هذا القول عددٌ من مفسّري الشيعة في سياق نقل الروايات التفسيريّة التي سنتناول بعضها[3].
بناءً على ما تقدّم، يُمكن القول إنّ للآية مفهومًا كلّيًّا مفاده أنّ الله قادرٌ على جمع الناس أنّى وأينما كانوا، والمصداق الأبرز للآية يتجلّى يوم القيامة عند جمع الناس في ساحة المحشر؛ ذلك المكان الذي سيُجمع الناس فيه منذ بدء الخليقة، وإن صاروا ترابًا؛
[1] راجع: الطوسيّ، التبيان في تفسير القرآن، ج2، ص24. الطبرسيّ، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج1، ص89. الثعلبيّ النيشابوريّ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج2، ص14. الطبرسيّ، جامع البيان في تفسير القرآن، ج2، ص18.
[2] الزمخشريّ، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج1، ص205.
[3] الفيض الكاشانيّ، تفسير الصافي، ج1، ص201. تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب، ج2، ص190.
25
أوّلاً: اجتماع الأصحاب وبيعتهم
فلا تُعاين لهم أثرًا. ومن المصاديق الأخرى للآية أيضًا جمع أنصار الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) في مكّة عند الظهور من مختلف نقاط العالم.
وحتّى لو اعتبرنا أنّ الآية تتحدّث حصرًا عن حشر جميع الناس في وادي المحشر، فيمكن أيضًا -بقياس الأولويّة-، أن نستفيد منها جمع أصحاب الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) من حيث قدرة الله تعالى على جمعهم؛ أي إنّ القادر على جمع البشر جميعًا يوم القيامة قادرٌ على جمع 313 شخصًا في مكّة من أماكن مختلفة لإقامة حكومة العدل العالميّة ونُصرة حجّته في أرضه؛ وفي هذا الخصوص يقول أحد المفسّرين: هذا التفسير للآية -دون شكٍّ-، يتحدّث عن «بطن» الآية، والأحاديث ذكرت أنّ لكلام الله ظاهرًا لعامّة الناس، وباطنًا لخاصّتهم.
بعبارةٍ أخرى، هذه الروايات تُشير إلى حقيقةٍ هي: «إنّ الله القادر على أن يجمع الناس من ذرّات التراب المتناثرة في يوم القيامة، لقادرٌ على أن يجمع أصحاب المهديّ في ساعةٍ بسهولة؛ من أجل انقداح الشرارة الأولى للثورة العالميّة الرامية إلى إقامة حكم الله على ظهر الأرض، وإزالة الظلم والعدوان عن وجهها»[1].
أحاديث أهل البيت(عليهم السلام):
جاء في كثيرٍ من الأحاديث عن أهل البيت (عليهم السلام) أنّ المقصود بقوله تعالى: ﴿أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡء قَدِير﴾، هم خواصّ أنصار الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) لبيعة إمامهم ونصرته.
[1] ناصر، مكارم الشيرازيّ، تفسير الأمثل، ج1، ص503.
26
أوّلاً: اجتماع الأصحاب وبيعتهم
وفي هذا القسم من الكتاب سنستعرض بعض تلك الروايات:
الحديث الأول: عن أبي خالد الكابليّ عن الإمام زين العابدين (عليه السلام)قال:
«الْمَفْقُودُونَ عَنْ فُرُشِهِمْ ثَلاَثُمِائَةٍ وَثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلًا عِدَّةَ أَهْلِ بَدْرٍ، يُصْبِحُونَ بِمَكَّةَ وَقَدْ ذَكَرَ اَلَّلهُ تَعَالَى ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: ﴿أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًاۚ﴾، وَهُمْ أَصْحَاب الْقَائِمِ (عجل الله تعالى فرجه)».[1]
الحديث الثاني: عن جابر بن يزيد عن الإمام الباقر(عليه السلام)أنّه قال حول جمع أصحاب الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه):
«فَيَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ ثَلاَثَمِائَةٍ وَثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَيَجْمَعُهُمُ اللَّهُ لَهُ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ قَزَعًا كَقَزَعِ الْخَرِيفِ، وَهِيَ يَا جَابِرُ الْآيَةُ اَلَّتِي ذَكَرَهَا اَللَّهُ فِي كِتَابِه: ﴿أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡء قَدِير﴾؛ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ»[2].
الحديث الثالث: عن عبد العظيم الحسنيّ عن الإمام الجواد (عليه السلام)أنّه قال:
«يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ عِدَّةَ أَهْلِ بَدْرٍ ثَلاَثَمِائَةٍ وَثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَقَاصِي الْأَرْضِ، وذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡء قَدِير﴾؛ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْعِدَّةُ مِنْ أَهْلِ الْإِخْلاَصِ أَظْهَرَ أَمْرَهُ؛ فَإِذَا أُكْمِلَ لَهُ الْعَقْدُ وَهُوَ عَشَرَةُ آلاَفِ رَجُلٍ خَرَجَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»[3].
[1] كمال الدين، ج2، ص654، ح21. الرواية مُعتبرةٌ من جهة السند.
[2] النعمانيّ، الغيبة، ص280، ح67. الرواية مُعتبرةٌ من جهة السند.
[3] كمال الدين، ج2، ص 409، ح2. الرواية مُعتبرةٌ من جهة السند.
27
أوّلاً: اجتماع الأصحاب وبيعتهم
وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ أصحاب الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) سيكونون ثلاث فئاتٍ:
أ. خواصّ الأصحاب وعددهم 313، وهم الذين سيتولّون إدارة العالم مع الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه).
ب. أهل العقد وعددهم عشرة آلاف شخص، ومع اكتمال عددهم يخرج الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) من مكّة ويبدأ قيامه.
ج. عموم الأصحاب وهم الذين يلتحقون بالإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) من أماكن مختلفة على امتداد الطريق، وذلك بعد خروجه من مكّة المعظمة وبدء قيامه، وعدد هؤلاء كبيرٌ وغير محدّد[1].
2. الآية الثانية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦۖ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيۡهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيما﴾[2].
تفسير الآية:
البيعة من مادة «بيع»، والبيعة تعني مصافحة شخصٍ لشخصٍ آخر التزامًا بطاعته.
[1] للاطّلاع أكثر حول أصحاب الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) يمكن الرجوع إلى الكتب التي أُلّفت في هذا المجال.
[2] سورة الفتح، الآية 10.
28
أوّلاً: اجتماع الأصحاب وبيعتهم
يقول الشيخ الطبرسيّ في معنى البيعة: «البيع الصفحة على إيجاب البيع، والبيعة الصفحة على إيجاب الطاعة»[1].
يد الله تعني القدرة الإلهيّة؛ وإلّا فليس مثله أحد، وعزّ الله عن أن يكون له في خلقه شبيه، ودلالة اليد على القدرة غير مختصّة باللّه تعالى؛ إذ تُستعمل يد الإنسان للدلالة على قدرته أيضًا، عن محمّد بن عبيدة قال: سألت الرضا(عليه السلام)عن قول الله عزّ وجلّ لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ أَسۡتَكۡبَرۡتَ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡعَالِينَ﴾[2]، قال: «يَعْنِي بِقُدْرَتِي وَقُوَّتِي»[3].
النكث نقض العهد كالحبل المقطوع. يقول الطُريحيّ: «قوله تعالى: ﴿نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ﴾ أي نقضوا عهدهم»[4].
تتحدّث هذه الآية عن بيعة المؤمنين للنبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) في الحديبية؛ البيعة التي سُمّيت ببيعة الرضوان والتي عاهد فيها المسلمون النبيّ (صلى الله عليه وآله) على عدم الفرار وعلى نُصرته والذود عنه ما دام فيهم نفس. عَدّت هذه الآية بيعة النبيّ (صلى الله عليه وآله) بيعةً مع الله؛ لأنّ طاعته طاعة الله وهو الذي يؤتي من أوفى ببيعته أجره. ويُستفاد من هذه الآية أنّ الدخان المتصاعد من إحراق حبل البيعة هذا إنّما يعمي عيون صاحبه، والأضرار الدنيويّة والأخرويّة الناتجة عن نقض العهد تُصيب -أوّل ما تصيب- ناقضه[5].
[1] مجمع البيان في تفسير القرآن، ج2، ص624.
[2] سورة ص، الآية 75.
[3] الشيخ الصدوق، التوحيد، ص153، ح2.
[4] الطُريحيّ، مجمع البحرين، ج2، ص26.
[5] مقتبسٌ من مجمع البيان في تفسير القرآن، ج9، ص171.
29
أوّلاً: اجتماع الأصحاب وبيعتهم
وفي روايةٍ عن الإمام الصادق(عليه السلام)عن آبائه الكرام عن أمير المؤمنين(عليه السلام)جاء:
«وَإِنَّ فِي الْنَّارِ لَمَدِينَةً يُقَالُ لَهَا الْحَصِينَةُ، أَفَلاَ تَسْأَلُونِّي مَا فِيهَا؟ فَقِيلَ لَهُ: وَمَا فِيهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: فِيهَا أَيْدِي اَلنَّاكِثِينَ»[1].
أحاديث أهل البيت (عليهم السلام):
عن المُفضّل بن عمر عن الإمام الصادق(عليه السلام)في حديثٍ طويلٍ جاء فيه:
«يَا مُفَضَّلُ، يَسْنِدُ الْقَائِمُ ظَهْرَهُ إِلَى كَعْبَةِ الْبَيْتِ الْحَرَام، وَيَمُدُّ يَدَهُ الْمُبَارَكَةَ فَتُرَى بَيْضٰاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ يَدُ اَللَّهِ وَعَنِ اَللَّهِ وَبِأَمْرِ اَللَّهِ، ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦۖ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيۡهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيما﴾، وَأَوَّلُ مَنْ يُقَبِّلُ يَدَهُ جِبْرِيلُ (عليه السلام) ثُمَّ يُبَايِعُهُ وَتُبَايِعُهُ الْمَلاَئِكَةُ وَنُقَبَاءُ الْحَقِّ ثُمَّ اَلنُّجَبَاءُ»[2].
[1] الشيخ الصدوق، الخصال، ج1، ص296، ح65. الفتّال النيشابوريّ، روضة الواعظين، ج2، ص507.
[2] الخصيبيّ، الهداية الكبرى، ص392. بحار الأنوار، ج53، ص1. أصل هذه الرواية ذُكر في كتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبيّ، وهو لا يُعدّ في كتب الشيعة؛ لأنّ الخصيبيّ وأتباعه، وإن كانوا يقولون بإمامة الأئمّة الاثنيّ عشر؛ إلّا أنّهم ينكرون نيابة النوّاب الأربعة، ويقولون إنّ باب الإمام العسكريّ (عليه السلام) كان محمّد بن نصير النميريّ ليكون الباب بعد عدّة وسائط هو الخصيبيّ. وقد ألّف هذا الكتاب لحاكم حلب سيف الدولة الحمدانيّ، (آقا بزرگ الطهراني، الذريعة إلى نصانيف الشيعة، ج3، ص268). (ربّما كان الإنصاف يقتضي القول إنّ هناك من بين علمائنا من ذهب إلى تخطئة من قال في صاحب كتاب الهداية الكبرى هذا القول (المترجم)).
30
أوّلاً: اجتماع الأصحاب وبيعتهم
ساق الحديث الآية على أنّها كلام الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) عند أخذ البيعة، وحتّى لو لم يُمكن الاستناد إلى هذا الحديث، يُمكن –بناءً على جريان القرآن الكريم–، أن نَعدّ بيعة الناس في الأزمنة المختلفة لحجّة الله من مصاديق هذه الآية، وأحد أكبر مصاديق هذه الآية يتحقّق في زمن ظهور الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) عندما يبايعه الأصحاب والناس على إقامة دولة العدل في العالم.
وفق ما جاء في هذا الحديث، يمدّ الإمام (عجل الله تعالى فرجه) يده على أنّها يد الله وعن الله وبأمر الله، ثمّ يتلو آية البيعة فيبايعه الناس جميعًا؛ أي إنّ بيعتكم لي كبيعة الرضوان بأمرٍ من الله، وببيعتكم هذه لحجّة الله إنّما تبايعون الله.
يُستفاد من روايات أهل البيت (عليهم السلام) في بيعة أصحاب الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) المطالب الآتية:
أهمّيّة بيعة الأصحاب
من بين أهل البيعة مع الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) حازت بيعة الأصحاب الذين ستوكل إليهم إدارة العالم مع الإمام (عجل الله تعالى فرجه) أهمّيّة خاصّة؛ فقد تعرّضت عدّة رواياتٍ إلى أوّل من يبايع الإمام (عجل الله تعالى فرجه) من أصحابه وعددهم 313 رجلًا، بينما قلّةٌ هي الروايات التي تحدّثت عمّن يبايع الإمام (عجل الله تعالى فرجه) بعد ذلك، سواءٌ في مكّة أو مَن يلتحق به في الطريق خلال مسيره إلى الكوفة؛ وهذا يكشف عن أهمّيّة وقدر المجموعة الأولى من الأصحاب وقدر بيعتهم.
31
أوّلاً: اجتماع الأصحاب وبيعتهم
وفي ما يأتي نُشير إلى بعض الأحاديث الواردة في هذا الخصوص:
الحديث الأول: يقول جابر بن يزيد الجعفيّ: قال الإمام الباقر (عليه السلام): «فَيَجْمَعُ اللهُ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ ثَلًاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجَلًا... فَيُبَايِعُونَهُ بَينَ الرُّكنِ وَالمَقَامَ»[1].
الحديث الثاني: عن محمّد بن مُسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): «وَيُبَايِعُهُ النَّاسُ الثَلاثُمِائَةُ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ»[2].
الحديث الثالث: يقول أبو خالد الكابُليّ: قال الإمام الباقر(عليه السلام): «أَوًّلُ مَنْ يُبَايِعُهُ جَبْرَئِيلُ ثُمَّ الثَلَاثُمِائَةِ والثَّلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا»[3].
الحديث الرابع: عن المُفضّل بن عمر عن الإمام جعفر الصادق(عليه السلام): «َوَقَدْ وَافَاهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَيُبَايِعُونَهُ»[4].
شروط البيعة مع الأصحاب
إنّ قيام الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) إنّما هو لإقامة العدل وتمهيد الأرض لعبادة الله عزّ وجلّ. وتقوم طريقته ونهجه في الدولة الكريمة على أساس كتاب الله وسنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ من هنا كان لا بدّ لمن يريد أن يطوي معه هذا المسير -عندما يمدّ يد البيعة إلى إمامه-، أن يحمل أهدافه نفسها وأن يمضي وفق إرادته؛ أي إنّهم سيبذلون غاية جهدهم في هذا الطريق، ويمتثلون أوامره التي هي في الواقع أوامر الله دون أيّ تردّدٍ، سواءٌ كانت ترتبط بهم أم بالمجتمع.
[1] النعمانيّ، الغيبة، ص282، ح67. الرواية مُعتبرةٌ من جهة السنة.
[2] المصدر نفسه، ص314، ح6. بحار الأنوار، ج52، ص369، ح156.
[3] عليّ بن إبراهيم القمّيّ، تفسير القمّيّ، ج2، ص204. الرواية من جهة السند مُعتبرة.
[4] الإرشاد، ج2، ص382. إعلام الورى، ص460.
32
أوّلاً: اجتماع الأصحاب وبيعتهم
نذكر هنا روايتين من روايات أهل البيت (عليهم السلام) تتحدّثان عن شروط بيعة الأصحاب لإمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه):
الحديث الأول: عن أبي بصير عن الإمام جعفر الصادق(عليه السلام)أنّه قال: «يُنَادَى بِاسْمِ الْقَائِمِ (عجل الله تعالى فرجه) فِي لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ وَيَقُومُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَهُوَ الْيَوْمُ اَلَّذِي قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِما السَّلاَمُ، لَكَأَنِّي بِهِ فِي يَوْمِ اَلسَّبْتِ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ قَائِمًا بَيْنَ اَلرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، جَبْرَئِيلُ(عليه السلام)بين يديه يُنَادِي: الْبَيْعَةَ لِلَّهِ، فَتَصِيرُ إِلَيْهِ شِيعَتُهُ مِنْ أَطْرَافِ الْأَرْضِ تُطْوَى لَهُمْ طَيًّا حَتَّى يُبَايِعُوهُ؛ فَيَمْلَأُ اَللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جَوْرًا»[1].
الحديث الثاني: جاء عن أبي خالد الكابُليّ عن الإمام الباقر(عليه السلام)أنّه قال: «يُبَايَعُ القَائِمُ بِمَكَةَ عَلَى كِتَابِ الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ»[2].
في الحديث الأوّل كان الله عزّ وجلّ محور البيعة للإمام (عجل الله تعالى فرجه) في الشعارات والخطط والتحرّك، بينما تقول الرواية الثانية إنّ الطريق إلى جعل الله محور هذه البيعة يقوم على أساس كتاب الله وسُنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله). بعبارةٍ أخرى، في العصر الذي تحكمه محوريّة الإنسان، وما أدّت إليه من ظلمٍ وفسادٍ انتشرا في كلّ مكان، يبدأ الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) حركته وقيامه تحت شعار محوريّة الله تعالى، ويدعو أصحابه للالتحاق به من أجل هذا الهدف ومن أجل دعوة الناس إلى عبادة الله الواحد من خلال كتاب الله وسُنّة رسوله.
[1] الإرشاد، ج2، ص379. روضة الواعظين، ج2، ص263.
[2] بحار الأنوار، ج52، ص308، الباب 26، ح83.
33
ثانيًا: عودة النبيّ عيسى (عليه السلام)
ثانيًا: عودة النبيّ عيسى (عليه السلام)
نبيّ الله عيسى(عليه السلام)أحد أنبياء أولي العزم، وقد بُعث بالنبوّة بعد النبيّ موسى (عليه السلام). كانت شريعته وشريعة النبيّ موسى(عليه السلام)واحدةً، وقد أدّى رسالته في بني إسرائيل. وبمعجزةٍ إلهيّةٍ ولدته أمّه مريم بنت عمران (عليهما السلام) من دون أب. ولمّا عزم اليهود والروم على قتله رفعه الله إلى السماء؛ فقاموا بصلب رجلٍ آخر شُبّه لهم أنّه هو. جاء في القرآن الكريم حول قضيّة النبيّ عيسى(عليه السلام)أنّه ما قُتل؛ وإنّما عُرج به إلى السماء: ﴿وَقَوۡلِهِمۡ إِنَّا قَتَلۡنَا ٱلۡمَسِيحَ عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمۡۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكّ مِّنۡهُۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَۢا ١٥٧ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيۡهِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيما﴾[1].
ثمّ تتحدّث الآية التالية لهذه الآية عن إيمان أهل الكتاب بالنبيّ عيسى(عليه السلام)قبل موته: ﴿وَإِن مِّنۡ
[1] سورة النساء، الآيتان 157 - 158.
35
ثانيًا: عودة النبيّ عيسى (عليه السلام)
أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهِۦ قَبۡلَ مَوۡتِهِۦۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيدا﴾[1].
عن شهر بن حوشبٍ قال: قال لي الحجّاج: «يا شهر، آيةٌ في كتاب اللّه قد أعيتني، فقلت: أيّها الأمير، أيُّ آيةٍ هي؟ فقال قوله: ﴿وَإِن مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهِۦ قَبۡلَ مَوۡتِهِۦۖ﴾، واللّه إنّي لآمر باليهوديّ والنصرانيّ فتضرب عنقه، ثمّ أرمقه بعيني فما أراه يحرّك شفتيه حتّى يخمد. فقلت: أصلح الله الأمير، ليس على ما تأوّلت. قال: كيف هو؟ قلت: إِنّ عِيسى ينْزِلُ قبْل يوْمِ الْقِيامةِ إِلى الدُّنْيا؛ فلا يبْقى أهْلُ مِلّةِ يهُودِيٍّ ولا غيْرِهِ إِلاّ آمن بِهِ قبْل موْتِهِ ويُصلِّي خلْف المهديّ، قال: ويْحك! أنّى لك هذا ومِنْ أيْن جِئْت بِهِ؟ فقُلْتُ: حدّثنِي بِهِ مُحمّدُ بْنُ علِيِّ بْنِ الْحُسيْنِ بْنِ علِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ (عليه السلام)، فقال جِئْتَ والله بِها مِنْ عيْنٍ صافِيةٍ».[2]
في مسألة حياة النبيّ عيسى(عليه السلام)وعدم موته، يُمكن الاستناد إلى الروايات التي جاءت في مصادر الشيعة والسنّة، تلك الروايات التي عبّر أكثرها عن مجيء النبيّ عيسى(عليه السلام)بـ: «نزل» أو «هبط»، ولو كان النبيّ عيسى(عليه السلام)قد مات واقعًا، لكان ينبغي استعمال كلمة «رجع» للحديث عن عودته إلى الدنيا وحضوره مع الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، لتدلَّ على رجوعه إلى الحياة. وكمثالٍ على ذلك نشير إلى بعض الأحاديث التي أشارت إلى نزول النبيّ عيسى (عليه السلام):
الحديث الأول: عن عمّار بن معاوية عن الإمام الصادق(عليه السلام)عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جَبرئيل(عليه السلام)في كلامٍ قاله له (صلى الله عليه وآله): «وَمِنْكُمُ الْقَائِمُ يُصَلِّي عِيسَى اِبْنُ مَرْيَم خَلْفَهُ إِذَا أَهْبَطَهُ اَللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ، مِنْ ذُرِّيَّةِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)»[3].
[1] سورة النساء، الآية 159.
[2] تفسير القمّيّ، ج1، ص158. بحار الأنوار، ج14، ص349، ح13.
[3] الكافي، ج8، ص49، ح10. بحار الأنوار، ج 51، ص77، ح 36.
36
ثانيًا: عودة النبيّ عيسى (عليه السلام)
الحديث الثاني: عن أبي بصير أنّه سأل الإمام الصادق(عليه السلام)عن القائم من أهل البيت (عليهم السلام) فَقَالَ: «يَا أَبَا بَصِيرٍ، هُوَ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ ابْنِي مُوسَى ذَلِكَ اِبْنُ سَيِّدَةِ الْإِمَاءِ، يَغِيبُ غَيْبَةً يَرْتَابُ فِيهَا الْمُبْطِلُونَ ثُمَّ يُظْهِرُهُ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَيَفْتَحُ اَللَّهُ عَلَى يَدِهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَيَنْزِلُ رُوحُ اَللَّهِ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ(عليه السلام)فَيُصَلِّي خَلْفَهُ»[1].
الحديث الثالث: في مصادر السُنّة عن أبي هُريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «كَيْفَ أَنَتُم إذا نَزَلَ ابْنُ مَرْيمَ فِيكم وَإِمَامُكم مِنْكم»[2].
الحديث الرابع: نقلت مصادر السُنّة عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قوله: سمعت الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) يقول: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ(عليه السلام)فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ: لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اَللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةِ» .[3]
[1] كمال الدين، ج2، ص345، ح31. بحار الأنوار، ج51، ص146، ح15.
[2] صحيح البخاري، ج4، ص143. صحيح مُسلم، ج1، ص94. مُسند أحمد، ج2، ص272.
[3] صحيح مسلم، ج1، ص95. السيوطيّ، الدرّ المنثور، ج2، ص245.
37
ثالثًا: معارك عصر الظهور
ثالثًا: معارك عصر الظهور
يؤمن القسم الأكبر من الناس في عصر الظهور بالإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) ويلتحقون به. في المقابل، يصطفّ طغاة ومستكبرو العالم في مواجهته ويحاربونه. وكما الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، يضطرّ إمام العصر أيضًا إلى مواجهتهم؛ من هنا كان أحد وجوه الشبه مع الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) خروجه بالسيف[1]. أمر القرآن كذلك في بعض آياته بحرب الكافرين وقتالهم حتّى يحكم الدين الذي يرتضيه الله الأرض، لقد نزلت هذه الآيات في صدر الإسلام؛ لكنّها لم تتحقّق في الخارج، وهي ستتحقّق في عصر ظهور الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)؛ جاء في القرآن الكريم: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَة وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ بَصِير﴾[2].
تفسير الآية:
في الآية السابقة لهذه الآية (الآية 38)، يدعو الله الكافرين للعودة إلى الحقّ، ويخبرهم أنّهم إنْ انتهَوا ورجعوا سيغفر لهم ما
[1] را: كمال الدين، ج1، ص321، ح3. الطوسي، الغيبة، ص424. هذا التوصيف يحتاج إلى تأمّلٍ لا سيّما في خصوص النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله)؛ فهو خرج بالرحمة وكان السيف خادمًا لهذه الرحمة. (المترجم)
[2] سورة الأنفال، الآية 39. وقد جاء ما يشبه هذا في الآية 193 في سورة البقرة: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾.
38
ثالثًا: معارك عصر الظهور
قد سلف، وإن عادوا إلى ما نُهوا عنه فسيجري عليهم ما جرى على من كان قبلهم. وفي هذه الآية يبيّن الله الهدف الأصليّ للإسلام، وأنّ القتال لن يتوقّف حتّى يعمّ دين الحقّ الأرض كلّها، وأنّ دخول مشركي مكّة في الإسلام لا يعني انتهاء الجهاد في سبيل الله؛ كما قال في هذه الآية: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَة وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ﴾، ولكن، متى يأتي اليوم الذي يتحقّق فيه هذا الأمر؛ بحيث يتردّد نداء التوحيد في كلّ زاويةٍ ونقطةٍ في هذا العالم؟
أحاديث أهل البيت(عليهم السلام):
ما دام الكافرون يحكمون الكرة الأرضيّة، ولمّا كانوا لا يملكون القدرة والاستحكام الكافي لمواجهة الإسلام بالمنطق والحجّة؛ فإنّهم سيلجأون إِلى القوّة في مواجهة المسلمين، ويختلقون لهم أنواع المشاكل والصعوبات من أجل إبقائهم في موقع الضعف. وكما ذكرت هذه الآية وآياتٌ أخرى، فإنّ الحلّ الوحيد للخلاص من هذه الضغوط والبلاءات هو بسط السيطرة الكاملة للإسلام والمسلمين على مستوى العالم، وهو ما سيحصل في الدولة الكريمة للإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)؛ وفي هذا القسم من الكتاب نُشير إلى عدّة أحاديث في هذا الخصوص:
الحديث الأول: عن محمّد بن مُسلم قال إنّه سأل الإمام الباقر (عليه السلام)عن قول الله عزّ ذِكره: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَة وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ﴾، فقال: «لَمْ يَجِئْ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ بَعْدُ، إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ (صلى الله عليه وآله) رَخَّصَ لَهُمْ لِحَاجَتِهِ وَحَاجَةِ أَصْحَابِهِ؛ فَلَوْ قَدْ جَاءَ
39
ثالثًا: معارك عصر الظهور
قد سلف، وإن عادوا إلى ما نُهوا عنه فسيجري عليهم ما جرى على من كان قبلهم. وفي هذه الآية يبيّن الله الهدف الأصليّ للإسلام، وأنّ القتال لن يتوقّف حتّى يعمّ دين الحقّ الأرض كلّها، وأنّ دخول مشركي مكّة في الإسلام لا يعني انتهاء الجهاد في سبيل الله؛ كما قال في هذه الآية: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَة وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ﴾، ولكن، متى يأتي اليوم الذي يتحقّق فيه هذا الأمر؛ بحيث يتردّد نداء التوحيد في كلّ زاويةٍ ونقطةٍ في هذا العالم؟
أحاديث أهل البيت(عليهم السلام):
ما دام الكافرون يحكمون الكرة الأرضيّة، ولمّا كانوا لا يملكون القدرة والاستحكام الكافي لمواجهة الإسلام بالمنطق والحجّة؛ فإنّهم سيلجأون إِلى القوّة في مواجهة المسلمين، ويختلقون لهم أنواع المشاكل والصعوبات من أجل إبقائهم في موقع الضعف. وكما ذكرت هذه الآية وآياتٌ أخرى، فإنّ الحلّ الوحيد للخلاص من هذه الضغوط والبلاءات هو بسط السيطرة الكاملة للإسلام والمسلمين على مستوى العالم، وهو ما سيحصل في الدولة الكريمة للإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)؛ وفي هذا القسم من الكتاب نُشير إلى عدّة أحاديث في هذا الخصوص:
الحديث الأول: عن محمّد بن مُسلم قال إنّه سأل الإمام الباقر (عليه السلام)عن قول الله عزّ ذِكره: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَة وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ﴾، فقال: «لَمْ يَجِئْ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ بَعْدُ، إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ (صلى الله عليه وآله) رَخَّصَ لَهُمْ لِحَاجَتِهِ وَحَاجَةِ أَصْحَابِهِ؛ فَلَوْ قَدْ جَاءَ
40
ثالثًا: معارك عصر الظهور
تَأْوِيلُهَا لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ؛ ولَكِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ حَتَّى يُوَحَّدَ اَللَّهُ عَزَّ وجَلَّ وحَتَّى لاَ يَكُونَ شِرْكٌ»[1].
الحديث الثاني: عن زُرارة بن أَعين عن الإمام الصادق(عليه السلام)قال: «لَمْ يَجِئْ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ، وَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا سَيَرَى مَنْ يُدْرِكُهُ مَا يَكُونُ مِنْ تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ، ولَيَبْلُغَنَّ دِينُ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) مَا بَلَغَ اَللَّيْلُ حَتَّى لاَ يَكُونَ شِرْكٌ عَلَى ظهْرِ الْأَرْضِ كَمَا قَالَ اَللَّهُ»[2].
الحديث الثالث: عن عبد الأعلى الحلبيّ: قال أبو جعفر (عليه السلام): «وَلاَ يَقْبَلُ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ الْجِزْيَةَ كَمَا قَبِلَهَا رَسُولُ اَللَّهِ (صلى الله عليه وآله) وَهُوَ قَوْلُ اَللَّهِ: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَة وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ﴾، قال أبو جعفر (عليه السلام): يُقَاتِلُونَ -وَاَللَّهِ- حَتَّى يُوَحَّدَ اَللَّهُ وَلاَ يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ»[3].
طبق هذه الرواية فإنّ الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) لا يقبل الجزية؛ ممّا يعني أنّه لا وجود في ذلك الزمان لحكومةٍ غير إسلاميّة ليكون هناك جزيةٌ تُدفع، على الرغم من أنّ الناس مختارون في اعتقاداتهم، وبعضهم لن يكون يومئذٍ من المسلمين[4].
[1] الكافي، ج8، ص201، ح243. الرواية مُعتبرةٌ من جهة السند.
[2] تفسيرالعياشي، ج2، ص56، ح48. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج4، ص834.
[3] تفسيرالعيّاشيّ، ج2، ص60، ح49. بحارالأنوار، ج52، ص341، ح91.
[4] يوجد في قبال هذه الروايات رواياتٌ تُفيد أنّ القائم(عليه السلام)يقبل الجزية، وقد ذكروا وجوهًا للجمع بين الطائفتين؛ فكان من الجيّد ذكرها، هذا أوّلًا. وثانيًا التعبير بنفي الحاجة إلى الجزية لعدم وجود حكومةٍ غير إسلاميّة في عصر الإمام (عجل الله تعالى فرجه) يحتاج إلى تأمّلٍ؛ فالجزية تُؤخذ من أهل الكتاب لأنّهم يعيشون تحت لواء الإسلام، ولا أدري إنْ كان السماح لهم بطقوسهم وعباداتهم وما شابه يمكن عدّه تجوّزًا حكمًا وحكومةً؛ وإلّا فالجزية وعدمها لا تدور مدار وجود الحكومة غير الإسلاميّة وعدمها؛ بل وجود حكومةٍ غير إسلاميّة، يعني عدم بسط الحكومة الإسلاميّة يدها على تلك البقعة، ولا تصل النوبة إلى الحديث عن الجزية وعدمها. (المترجم)
41
ثالثًا: معارك عصر الظهور
الفتنة: بلاءٌ لإظهار الجودة
عُدّت الفتنة في القرآن الكريم أشدّ من القتل[1]. كلمة الفتنة تعني إدخال الذهب في النار ليصبح خالصًا خاليًا من الشوائب؛ يقول الراغب: «أصل الفتنة إدخال الذهب النار؛ لتظهر جودته من رداءته»[2].
يضيف الراغب: إنّ استعمال هذه الكلمة في إدخال الإنسان النار تارةً يُراد بها العذاب نفسه، وأخرى ما يحصل عنه العذاب وهو الاختبار، وهذه الآية عدّت الضغوط التي يمارسها الكافرون على المؤمنين وتعذيبهم لهم فتنةً، وأمرَت المؤمنين بقتالهم حتّى يُرفع ذلك البلاء عنهم.
أحد الذين سيحاربهم الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) هوالسفيانيّ؛ في روايةٍ عن الإمام الصادق(عليه السلام)قال:
«إِنَّا وَآلَ أَبِي سُفْيَانَ أَهْلُ بَيْتَيْنِ تَعَادَيْنَا فِي اَللَّهِ؛ قُلْنَا صَدَقَ اَللَّهُ وَقَالُوا كَذَبَ اَللَّهُ، قَاتَلَ أَبُو سُفْيَانَ رَسُولَ اَللَّهِ (صلى الله عليه وآله)، وَقَاتَلَ مُعَاوِيَةُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)، وَقَاتَلَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(عليه السلام) واَلسُّفْيَانِيُّ يُقَاتِلُ الْقَائِمَ (عجل الله تعالى فرجه)»[3].
[1] ﴿وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ﴾ (سورة البقرة، الآية 191)، ﴿وَٱلۡفِتۡنَةُ أَكۡبَرُ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۗ﴾ (سورة البقرة، الآية 217).
[2] الراغب الأصفهانيّ، المفردات في غريب القرآن، ص371.
[3] الشيخ الصدوق، معاني الأخبار، ص346، ح1. بحار الأنوار، ج52، ص190، ح18.
42
رابعًا: مقتل إبليس
رابعًا: مقتل إبليس
كان إبليس من الجنّ، فعبد الله كثيرًا حتى عُدّ من في زمرة الملائكة. ولمّا أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم(عليه السلام)امتنع وأبى؛ فأخفق وسقط في الامتحان الإلهيّ. ولم يكتفِ إبليس بالإصرار على عصيانه وعدم التوبة؛ بل سأل الله أن يُنظره ويُمهله إلى يوم القيامة؛ ليضلّ بني آدم ويغويهم ما أمكنه ذلك انتقامًا منهم، وقد أنظره الله تعالى إلى اليوم المعلوم وهو يوم ظهور الإمام المهديّ(عجل الله تعالى فرجه).
يقول تعالى في كتابه الكريم: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ٣٦ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ ٣٧ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡوَقۡتِ ٱلۡمَعۡلُومِ﴾[1].
في هذه الآيات يطلب إبليس من الله تعالى أن يُنظره إلى يوم القيامة، فأنظره الله تعالى، ولكن لا إلى يوم القيامة بل إلى يومٍ معلومٍ لم يحدّده لنا؛ ذكر العلّامة الطباطبائيّ (رضوان الله تعالى عليه) في تفسيره:
قوله تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ ٣٧ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡوَقۡتِ ٱلۡمَعۡلُومِ﴾ جوابٌ منه سبحانه لإبليس، وفيه إجابةٌ وردّ: أمّا الإجابة فبالنسبة إلى أصل الإنظار الذي سأله، وأمّا الردّ، فبالنسبة إلى القيد وهو أن
[1] سورة الحجر، الآيات 36 – 38.
43
رابعًا: مقتل إبليس
يكون الإنظار إلى يوم يُبعثون، فإنّ من الواضح اللائح بالنظر إلى سياق الآيتين أنّ يوم وقت المعلوم غير يوم يُبعثون؛ فلم يسمح له بإنظاره إلى يوم يُبعثون؛ بل إلى يومٍ هو غيره، ولا محالة هو قبل يوم البعث».[1]
ذهب أغلب المفسّرين إلى أنّ عمر إبليس لا ينقضي ما دام إنسانٌ يعيش على وجه الأرض، وما دام فيها تكليف؛ فهم يعتقدون أنّ الناس جميعًا يموتون في نفخة الصور الأولى، ومع موتهم تنتهي مهلة إبليس[2]، ولكن يُمكن القول إنّ إبليس وجنوده باقون ما دام للذنب والمعصية وجود؛ فالكفر والفساد إنّما هما نتيجة الوسوسة، فإذا صلح المجتمع الإنسانيّ وتوجّه جميع الناس نحو عبادة الله، لا يبقى محلٌّ لإغواء إبليس ووجوده. وقد قوّى صاحب الميزان هذا القول إذ ذَكَر في نهاية البحث: «ومن ذلك يظهر أنّ الذي استندوا إليه من الحجّة إنّما يدلّ على كون يوم الوقت المعلوم الذي جعله الله غاية إنظار إبليس، هو يوم يُصلح الله سبحانه المجتمع الإنسانيّ؛ فينقطع دابر الفساد ولا يُعبد يومئذٍ إلّا الله، لا يوم يموت الخلائق بالنفخة الأولى».[3]
[1] العلّامة الطباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج12، ص159.
[2] راجع: التبيان في تفسير القرآن، ج6، ص335. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج6، ص518. جامع البيان في تفسير القرآن، ج14، ص22. الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج2، ص578.
[3] الميزان في تفسير القرآن، ج12، ص161.
44
رابعًا: مقتل إبليس
في عصر ظهور الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) سيهلك الظالمون والمفسدون، ومعهم سيُجمع البساط من تحت الشياطين؛ فيُقتلون بأجمعهم لا سيّما إبليس؛ وحول هذه النقطة نستعرض عدّة أحاديث:
الحديث الأول: في روايةٍ عن وهب بن جميع يقول: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن قول إبليس: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ٣٦ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ ٣٧ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡوَقۡتِ ٱلۡمَعۡلُومِ﴾[1]، قَالَ لَهُ وَهْبٌ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَيُّ يَوْمٍ؟ قَالَ: «يَا وَهْبُ، أَتَحْسَبُ أَنَّهُ يَوْمُ يَبْعَثُ اَللَّهُ فِيهِ اَلنَّاسَ؟ إِنَّ اَللَّهَ أَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُ فِيهِ قَائِمَنَا؛ فَإِذَا بَعَثَ اَللَّهُ قَائِمَنَا كَانَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَة، وَجَاءَ إِبْلِيسُ حَتَّى يَجْثُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا وَيْلَهُ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ، فَيَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهِ فَيَضْرِبُ عُنُقَهُ، فَذَلِكَ يَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُومُ»[2].
ويؤيّد هذه الرواية حديثٌ ينقله الحسين بن خالد عن الإمام الرضا (عليه السلام)جاء فيه:
«لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ وَرَعَ لَهُ، وَلاَ أَمَانَ لِمَنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ، وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ أَعْمَلُكُمْ بِالتَّقِيَّة، فَقِيلَ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِلَى مَتَى؟ قَالَ :إِلىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وَهُوَ يَوْمُ خُرُوجِ قَائِمِنَا أَهْلَ البَيْتِ»[3].
الحديث الثاني: عن محمّد بن عُمير قال: سألت سيّدي موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَسۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نِعَمَهُۥ
[1] سورة الحجر، الآيات 36 – 38.
[2] تفسير العيّاشيّ، ج2، ص242، ح14. بحار الأنوار، ج60، ص254، ح119.
[3] كمال الدين، ج2، ص371، ح5. الرواية مُعتبرةٌ من جهة السند.
45
رابعًا: مقتل إبليس
ظَٰهِرَة وَبَاطِنَةۗ﴾[1]، فَقَالَ: «اَلنِّعْمَةُ اَلظَّاهِرَةُ الْإِمَامُ اَلظَّاهِرُ، وَالْبَاطِنَةُ الْإِمَامُ الْغَائِبُ». فقيل له: ويكون في الأئمّة من يغيب؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَغِيبُ عَنْ أَبْصَارِ اَلنَّاسِ شَخْصُهُ وَلاَ يَغِيبُ عَنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ذِكْرُهُ، وَهُوَ اَلثَّانِي عَشَرَ مِنَّا يُسَهِّلُ اَللَّهُ لَهُ كُلَّ عَسِيرٍ، وَيُذَلِّلُ لَهُ كُلَّ صَعْبٍ، وَيُظْهِرُ لَهُ كُنُوزَ الْأَرْضِ، وَيُقَرِّبُ لَهُ كُلَّ بَعِيدٍ، وَيُبِيرُ بِهِ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَيُهْلِكُ عَلَى يَدِهِ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ»[2].
الحديث الثالث: عن عبد العظيم الحسنيّ أنّه سمع الإمام الهادي (عليه السلام)يقول:
«مَعْنَى اَلرَّجِيمِ أَنَّهُ مَرْجُومٌ بِاللَّعْنِ، مَطْرُودٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْخَيْرِ، لاَ يَذْكُرُهُ مُؤْمِنٌ إِلاَّ لَعَنَهُ، وَأَنَّ فِي عِلْمِ اَللَّهِ اَلسَّابِقِ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ (عجل الله تعالى فرجه) لاَ يَبْقَى مُؤْمِنٌ فِي زَمَانِهِ إِلَّا رَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ، كَمَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مَرْجُومًا بِاللَّعْنِ»[3].
[1] سورة لقمان، الآية 20.
[2] كمال الدين، ج2، ص386، ح6. الرواية مُعتبرةٌ من جهة السند.
[3] معاني الأخبار، ص139، ح1. الرواية مُعتبرةٌ من جهة السند.
46
أوّلًا: الظهور بإذن الله
أوّلًا: الظهور بإذن الله
إنّ خروج الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) إنّما هو بأمر الله العزيز من أجل هداية الناس، وجميع أعماله إنّما هي عن أمر الله[1]. وأهمّ الوظائف التي جعلها الله على عاتقه هي إقامة دولةٍ كريمةٍ على امتداد العالم؛ هذه الدولة التي ستتحقّق وتتشكّل بإذن الله تعالى.
1. الآية الأولى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ﴾[2].
تفسير الآية:
كان مشركو مكّة يعمَدون إلى ظلم المسلمين الذين كانوا حديثي العهد بالإسلام، ويمارسون عليهم أصناف الأذى والتعذيب؛ وقد استشهد بعضهم على إثر ما لاقى من ذلك. بدوره كان النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) يأمرهم بالصبر والتحمّل، وقد استمر الحال على ذلك إلى أن هاجروا إلى المدينة.
[1] يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذه المسألة: "وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ الْخِيَرَةُ بَلْ لِلَّهِ الْخِيَرَةُ وَالْأَمْرُ جَمِيعاً"، (الكافي، ج8، ص63، ح22).
[2] سورةالحجّ، الآية 39.
49
أوّلًا: الظهور بإذن الله
هذه الآية هي من أولى الآيات التي أَذِنت بجهاد المشركين[1]، فأُذن للمسلمين المظلومين بمواجهة الظالمين والأخذ بحقوقهم كاملة منهم.
أحاديث أهل البيت(عليهم السلام):
أوصى الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) المسلمين بمودّة أهل البيت (عليهم السلام) واتّباعهم؛ لكنّهم أهملوا هذه الوصية وقابلوا أهل البيت (عليهم السلام) بالظلم والأذى، ولو أنّه (صلى الله عليه وآله) تقدّم إليهم باضطهاد أهل البيت (عليهم السلام) وجفائهم كما تقدّم إليهم في الوصاية بهم لما زادوا على ما فعلوا.
وقد ألحق هؤلاء الظلم بالعالَمين وحرموا العالَم من الحقّ والعدالة؛ عندما أبعدوا أهل البيت (عليهم السلام) عن الحكم والسلطة.
يروي عاصم بن حميد عن الإمام الصادق(عليه السلام)أنّه قال:
لَقِيَ الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا ابْنَ رَسُولِ اَللَّهِ؟ فَقَالَ: «وَيْحَكَ، أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ كَيْفَ أَصْبَحْتُ؟ أَصْبَحْنَا فِي قَوْمِنَا مِثْلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي آلِ فِرْعَوْنَ، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَنَا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَنَا، وَأَصْبَحَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) يُلْعَنُ عَلَى الْمَنَابِرِ، وَأَصْبَحَ عَدُوُّنَا يُعْطَى الْمَالَ وَالشَّرَفَ، وَأَصْبَحَ مَنْ يُحِبُّنَا مَحْقُورًا مَنْقُوصًا حَقُّهُ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَزَلِ الْمُؤْمِنُونَ، وَأَصْبَحَتِ الْعَجَمُ تَعْرِفُ لِلْعَرَبِ حَقَّهَا بِأَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ مِنْهَا، وَأَصْبَحَتِ الْعَرَبُ تَعْرِفُ لِقُرَيْشٍ بِأَنَّ مُحَمَّدًا (صلى الله عليه وآله) كَانَ مِنْهَا، وَأَصْبَحَتْ قُرَيْشٌ تَفْتَخِرُ عَلَى الْعَرَبِ بِأَنَّ مُحَمَّدًا (صلى الله عليه وآله) كَانَ مِنْهَا، وَأَصْبَحَتِ الْعَرَبُ تَفْتَخِرُ عَلَى الْعَجَمِ بِأَنَّ
[1] راجع: مجمع البيان في تفسير القرآن، ج7، ص138. الدرّ المنثور في تفسير المأثور، ج4، ص364.
50