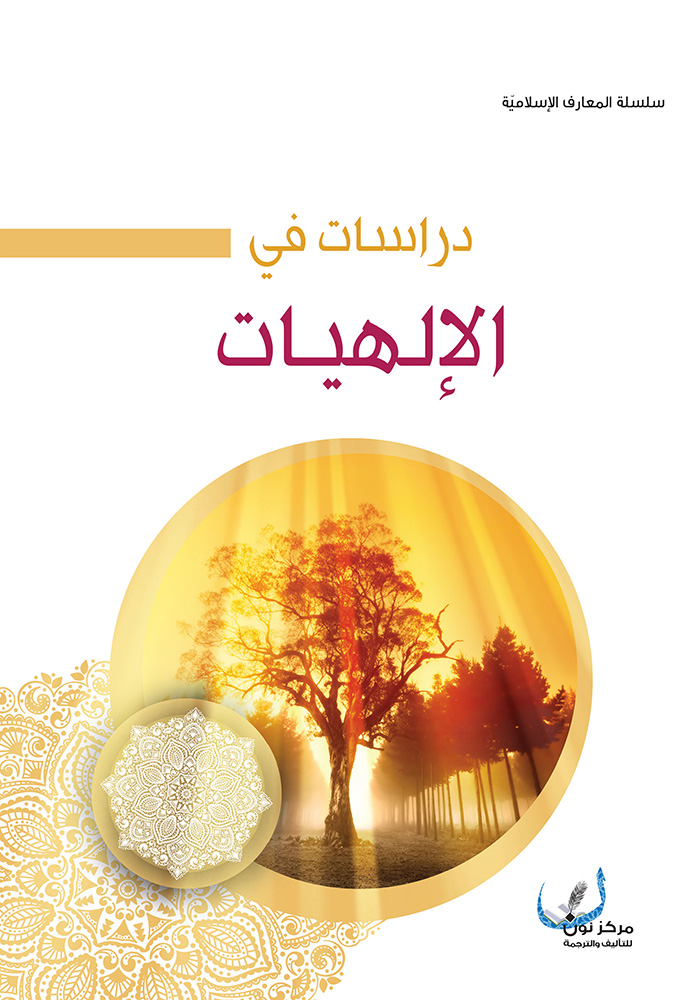المقدمة
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على النبيّ الأكرم محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الأطهار الميامين وبعد.
لقد كثُرت الدراسات وتنوّعت الأدلّة الفطرية والنقلية والعقلية وغيرها في البحث عن معرفة الله تعالى، وأرشدت نصوص أهل البيت السلا إلى طريقة هامة لمعرفة الله وهي معرفة الله بالله تعالى. "سُئِل أمير المؤمنين عليه السلام: بما عرفت ربّك؟ فقال: بما عرّفني نفسه، قيل كيف عرّفك نفسه؟ فقال: لا تشبهه صورة ولا يحّس بالحواس ولا يُقاس بالناس قريب في بعده، بعيد في قربه..."1.
وفي الدعاء عن الإمام السجّاد عليه السلام "بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدرِ ما أنت"2.
وُيستفاد من الروايات أنّ الإيمان بالله تعالى مرتبة رفيعة وخاصة وله عدّة مراحل، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: "إنّ الإيمان أفضل من الإسلام، وإنّ اليقين أفضل من الإيمان، وما من شيء أعزّ من اليقين"3. ويتضح هذا التقسيم أكثرعندما نتأمّل في بقية الروايات التي تشرح هذه الدرجات، وتُقسّمها إلى المراحل التالية:
- مرحلة الإسلام: وهو التصديق بالله تعالى وتوحيده، ونبوّة النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم إجمالاً، فعن الإمام الصادق عليه السلام: "الإسلام شهادة ألا إله إلا الله والتصديق برسول الله، به حُقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس"4.
- مرحلة الإيمان: ويعني التصديق بما جاء به الديّن الإسلامي في القلب واللسان وتجسيد ذلك بالجوارح، فقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام قال: "... والإيمان الهُدى وما ثبت في القلوب من صفة الإسلام، وما ظهر من العمل به، والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة..."5.
- مرحلة التقوى: وهي المرحلة التي يكون فيها المؤمن متوقّياً لكلّ ما يُحتمل إبعاده عن الله تعالى، فيجتنب الشبهات ويفعل المستحبّات كما يترك المكروهات، وجاء في الحديث: أنّ التقوى فوق الإيمان بدرجة، والمعروف عن تفسير التقوى هو: "أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك".
- مرحلة اليقين: وهي أعلى المراتب وأسماها، وهي مرحلة انكشاف الغطاء وتحوّل الغيب إلى الشهادة، عن الإمام علي عليه السلام: "لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً"6، بأفضيلة اليقين على الإيمان وأنه فوق التقوى بدرجة.
ومن المعلوم أنّ المعرفة والعلم بأصول الدين من العناصر الأساسية، والمقدّمات التي لا بدّ منها في سلوك سبيل معرفة الله تعالى والترقّي في هذه المعرفة إلى درجة الإيمان أو اليقين، وذلك بحسب التزامه بعقيدته وانعكاس معرفته لله تعالى على حياته العملية وسلوكه، وإلا لتحوّلت تلك المعرفة إلى حجاب بينه وبين الله، ومنعت الترقّي في السير إلى الله تعالى.
هذا الكتاب "دراسات في الإلهيات" من الكتب العقائدية التي تتضمّن مجموعة هامة من الدروس التي تُعزّز المعرفة وتُنير الطريق أمام الإنسان ليسلك إلى ربّه على هدى وبصيرة ونور. ومادة هذا الكتاب في الأصل مأخوذة من كتاب "محاضرات في الالهيات" لسماحة الشيخ علي الرباني الكلبابكاني، تم إعادة تبويبها واختصارها بما يتناسب مع المستوى والأهداف العلميّة المحددة لهذه المّادة.
ويتشرّف مركز نون للتأليف والترجمة بتقديم هذا الكتاب لجميع الدارسين والباحثين، بمنهج وإسلوب ولغة تعليمية، عسى أن يوفّقنا الله تعالى في الدنيا والآخرة.
والحمد لله ربّ العالمين
مركز نون للتأليف والترجمة
[1] الكليني، الكافي، ج1، ص85، حديث5.
[2] الشيخ الطوسي، مصباح المجتهد، ص582.
[3] أصول الكافي، ج2، باب فضل الإيمان على الإسلام، حديث، 1.
[4] أصول الكافي، ج2، باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام ح1.
[5] (م.ن).
[6] إبن أبي الحديد، شرح النهج،ج7، ص253.