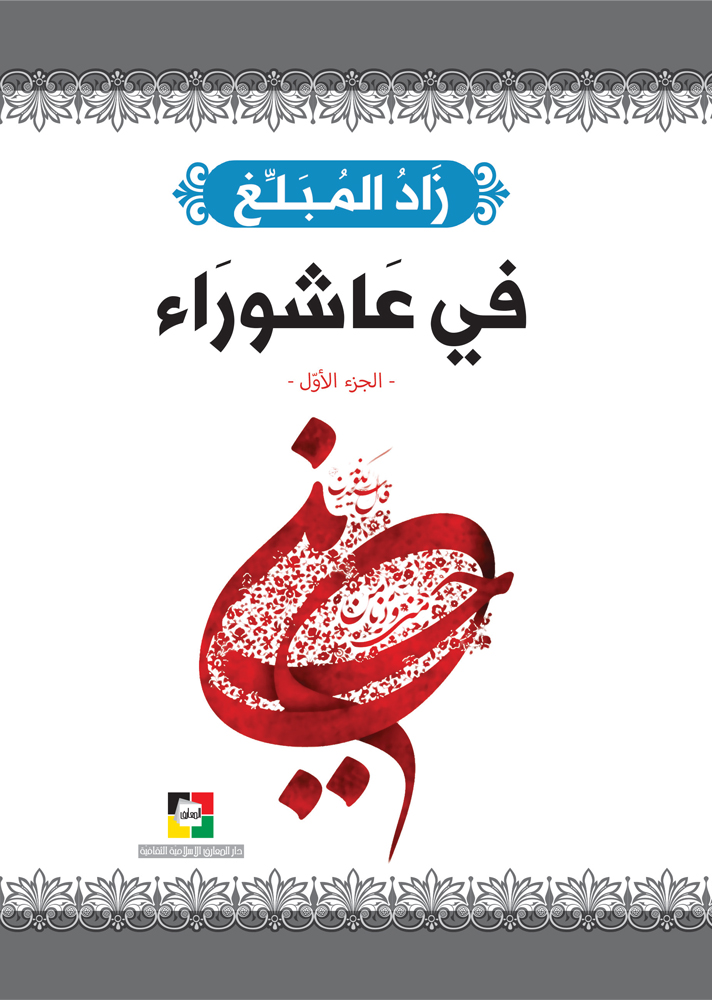المقدّمة
المقدّمة
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين.
عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال لفضيل: «تجلسون وتحدِّثون؟»، قال: نعم، جُعِلتُ فداك! قال: «إنّ تلك المجالسَ أُحبُّها؛ فأحيوا أمرَنا يا فضيل، فرحم الله من أحيا أمرنا! يا فضيل، من ذَكَرَنا أو ذُكِرْنا عنده، فخرج من عينه مثلُ جناح الذباب، غفر الله له ذنوبَه، ولو كانت أكثر من زبد البحر»[1].
دروسٌ ومواعظ، نستقيها من أعظم واقعة حدثت في التاريخ الإسلاميّ، ما زالت تنبض حيَّةً بمفاهيمها وقضاياها الإنسانيّة والدينيّة والأخلاقيّة، وهي تقود أصحابَ القلوب الوالهة والعقول النيّرة ليتّخذوها بوصلةَ سيرهم نحو الحقّ الذي لا تحيد عنه.
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج71، ص351.
10
1
المقدّمة
هذا الكتاب «زاد المبلّغ في عاشوراء - ج1»، نذرٌ قليل ممّا نستطيع تقديمه بين أيدي المحبّين والموالين، خدمةً وإحياءً لذكرى عاشوراء الأليمة. ولقد قمنا في مركز المعارف للتأليف والتحقيق، بإعادة جمعٍ للمحاضرات التي صدرت طيلة الأعوام السابقة ضمن سلسلة زاد عاشوراء، وحذف المتكرِّر منها، وتصنيفها وترتيبها ضمن محاور جامعة، ثمّ إضافة بعض العناوين المرتبطة بالأولويّات الثقافيّة لهذا العام، لتكون مادّة متنوّعة وغنيّة بالمواضيع الثقافيّة العامّة والخاصّة بهذه المناسبة الأليمة، نضعها بين أيدي المبلِّغين الكِرام، على أن يكون هذا الإصدار هو الجزء الأوّل، تتبعه أجزاء أخرى إن شاء الله.
نسأل الله -تعالى- التوفيق لنا ولكم في إحياء هذه المناسبة الأليمة، وإيصال معانيها ودررها وشعاع نورها المتوقّد، الذي كان حصنًا منيعًا ضدّ الاعتداءات المتتالية والمتنوّعة على الإسلام والمسلمين.
مركز المعارف للتأليف والتحقيق
11
2
الموعظة الأولى: الإمام الحسين بن عليّ (عليه السلام)
الموعظة الأولى: الإمام الحسين بن عليّ (عليه السلام)
تعرّف أهمّ سمات شخصيّة الإمام الحسين (عليه السلام)، وموقعه في الإسلام.
محاور الموعظة
الإمام (عليه السلام) في سطور
اهتمام النبيّ (صلى الله عليه وآله) بالإمام (عليه السلام)
سمات شخصيّة للإمام (عليه السلام)
تصدير الموعظة
رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الحسن والحسين ابناي، من أحبّهما أحبّني، ومن أحبّني أحبّه الله، ومن أحبّه الله أدخله الجنّة، ومن أبغضهما أبغضني، ومن أبغضني أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النّار»[1].
[1] المتّقي الهنديّ، كنز العمّال، ج12، ص117.
14
3
الموعظة الأولى: الإمام الحسين بن عليّ (عليه السلام)
الإمام (عليه السلام) في سطور
هو أبو عبد الله الحسين بن عليّ بن أبي طالب ثالث أئمّة أهل البيت الطاهرين، وثاني سبطَي رسول الله وسيّد شباب أهل الجنّة، وريحانة المصطفى، وأحد الخمسة أصحاب العبا وسيّد الشهداء، وأمّه فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله). أكّد أغلب المؤرّخين أنّه ولد بالمدينة في الثالث من شعبان في السنة الرابعة من الهجرة.
وضعت سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام) وليدها العظيم، وزفّت البشرى إلى الرسول (صلى الله عليه وآله)، فأسرع إلى دار عليّ والزهراء (عليهم السلام)، فقال لأسماء بنت عميس: «يا أسماء، هاتي ابني»، فحملته إليه وقد لُفّ في خرقة بيضاء، فاستبشر النبيّ (صلى الله عليه وآله) وضمّه إليه، وأذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ثمّ وضعه في حجره وبكى، فقالت أسماء: فداك أبي وأمّي، ممّ بكاؤك؟ قال: «من ابني هذا». قالت: إنّه ولد الساعة، قال: «يا أسماء، تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي...»[1].
ثمّ إنّ الرسول (صلى الله عليه وآله) قال للإمام عليّ (عليه السلام): «أيّ شيء سمّيت ابني؟ فأجابه عليّ (عليه السلام): ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله». وهنا نزل الوحي على حبيب الله محمّد (صلى الله عليه وآله) حاملًا اسم الوليد من الله -تعالى-، وبعد أن تلقّى الرسول أمر الله بتسمية وليده الميمون، التفت إلى عليّ (عليه السلام) قائلًا: «سمِّه حسينًا»[2].
[1] الفتّال النيسابوريّ، روضة الواعظين، ص153.
[2] فارس حسون كريم، الروض النضير في معنى حديث الغدير، ص250.
15
4
الموعظة الأولى: الإمام الحسين بن عليّ (عليه السلام)
اهتمام النبيّ (صلى الله عليه وآله) بالإمام (عليه السلام)
لقد تضافرت النصوص الواردة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشأن الحسين وهي تبرز المكانة الرفيعة التي يمثّلها في دنيا الرسالة والأمّة. ويمكن الوقوف عند نماذج عدّة، منها:
إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان جالسًا فأقبل الحسن والحسين(عليهما السلام)، فلمّا رآهما النبيّ قام لهما واستبطأ بلوغهما إليه، فاستقبلهما وحملهما على كتفيه، وقال: «نعم المطيُّ مطيّكما، ونعم الراكبان أنتما، وأبوكما خير منكما»[1].
رُوي عن ابن مسعود، أنّه قال: كان النبيّ يصلّي فجاء الحسن والحسين فارتدفاه، فلمّا رفع رأسه أخذهما أخذًا رفيقًا، فلمّا عاد عادا، فلمّا انصرف أجلس هذا على فخذه الأيمن وهذا على فخذه الأيسر، ثمّ قال: «من أحبّني فَلْيُحبّ هذين»[2].
«حسين منّي وأنا من حسين، أحبّ الله من أحبّ حسينًا، حسين سبط من الأسباط»[3].
«الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهما، وأمّهما أفضل نساء أهل الأرض»[4].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج43، ص284.
[2] المصدر نفسه، ج43، ص273.
[3] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص127.
[4] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج26، ص267.
16
5
الموعظة الأولى: الإمام الحسين بن عليّ (عليه السلام)
سمات شخصيّة للإمام (عليه السلام)
1. عبادته وتقواه
الإمام الحسين (عليه السلام) وهو أحد أعمدة البيت النبويّ الطاهر كان يقوم بين يدي الجبّار مقام العارف المتيقّن والعالم العابد، فإذا توضّأ تغيّر لونه وارتعدت مفاصله، فقيل له في ذلك، فقال: «حقّ لمن وقف بين يدي الجبّار أن يصفرّ لونه وترتعد مفاصله»[1].
وحرص على أداء الصلاة في أحرج المواقف، حتّى وقف يؤدّي صلاة الظهر في قمّة الملحمة في اليوم العاشر من المحرّم وجيوش الضلالة تحيط به من كلّ جانب وترميه من كلّ صوب.
وكان (عليه السلام) يخرج متذلّلًا لله ساعيًا إلى بيته الحرام يؤدّي مناسك الحجّ بخشوع وتواضع، حتّى حجّ خمسًا وعشرين حجّة ماشيًا على قدميه. وإنّ نظرة واحدة إلى دعائه في يوم عرفة تبرهن على عمق هذه المعرفة وشدّة العلاقة مع الله -تعالى-، من مقاطع هذا الدعاء العظيم:
قال: «كيف يُستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟! أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو المظهِر لك؟! متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدلّ عليك؟! ومتى بعدت حتّى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟! عميت عين لا تراك عليها رقيبًا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيبًا...
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج77، ص341.
17
6
الموعظة الأولى: الإمام الحسين بن عليّ (عليه السلام)
إلهي هذا ذُلّي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك. منك أطلب الوصول إليك، وبك استدلّ عليك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبوديّة بين يديك...»[1].
وقد اشتهرت بين محدّثي الشيعة ومختلف طبقاتهم مواقفه الخاشعة في عرفات أيّام موسم الحجّ، ومناجاته الطويلة لربّه وهو واقف على قدميه في ميسرة الجبل والناس حوله.
2. تواضعه
فقد نُقلت عنه مواقف كثيرة تعامل فيها مع سائر المسلمين بكلّ تواضع مُظهِرًا سماحة الرسالة ولطف شخصيّته الكريمة، ومن ذلك:
إنّه قد مرّ بمساكين وهم يأكلون كسرًا (خبزًا يابسًا) على كساء، فسلّم عليهم، فدعوه إلى طعامهم، فجلس معهم، وقال: «لولا أنّه صدقة لأكلت معكم». ثمّ قال: «قوموا إلى منزلي، فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم»[2].
3. حلمه وعفوه
تأدّب الحسين السبط بآداب النبوّة، وحمل روح جدّه الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) يوم عفا عمّن حاربه ووقف ضدّ الرسالة الإسلاميّة، فقد روي عنه أنّه قال: «لو شتمني رجل في هذه الأذن وأومأ إلى اليمنى واعتذر لي في اليسرى لقبلت ذلك منه، وذلك أنّ أمير المؤمنين عليّ
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج46، ص147.
[2] المصدر نفسه، ص189.
18
7
الموعظة الأولى: الإمام الحسين بن عليّ (عليه السلام)
بن أبي طالب حدّثني أنّه سمع جدّي رسول الله يقول: لا يرد الحوض مَن لم يقبل العذر من محقّ أو مبطل»[1].
4. جوده وكرمه
عن أنس أنّه قال: كنت عند الحسين فدخلت عليه جارية بيدها طاقة ريحان فحيّته بها، فقال لها: «أنت حرّة لوجه الله -تعالى-». وانبهر أنس، وقال: جارية تجيئك بطاقة ريحان فتعتقها؟! فقال: «كذا أدّبنا الله، قال -تبارك وتعالى-: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحسَنَ مِنهَا أَو رُدُّوهَا﴾[2]، وكان أحسن منها عتقها»[3].
ووقف ذات مرّة سائل على باب الإمام الحسين(عليه السلام) وأنشد قائلًا:
لم يخب الآن من رجاك ومن
حرّك من دون بابك الحلقة
أنت جواد وأنت معتمد
أبوك قد كان قاتل الفسقة
فأسرع إليه الإمام الحسين وما أن وجد أثر الفاقة عليه حتّى نادى بقنبر، وقال متسائلًا: «ما تبقّى من نفقتنا؟» قال: مائتا درهم أمرتني بتفرقتها في أهل بيتك، فقال: «هاتها فقد أتى مَن هو أحقّ بها منهم»، فأخذها ودفعها إلى السائل معتذرًا منه، وأنشد قائلًا:
خذها فإنّي إليك معتذر
واعلم بأنّي عليك ذو شفقة
لو كان في سيرنا الغداة عصًا
أمست سمانا عليك مندفقة
لكنّ ريب الزمان ذو غِير
والكفّ منّي قليلة النفقة
[1] جعفر البياتيّ، الأخلاق الحسينيّة، ص275.
[2] سورة النساء، الآية 86.
[3] الإربليّ، كشف الغمّة، ج2، ص236.
19
8
الموعظة الأولى: الإمام الحسين بن عليّ (عليه السلام)
فأخذها الأعرابيّ شاكرًا وهو يدعو له بالخير، وأنشد مادحًا:
وأنتم أنتم الأعلون عندكم
علم الكتاب وما جاءت به السورُ
من لم يكن علويًّا حين تنسبه
فما له في جميع الناس مفتخر[1]
5. شجاعته وإباؤه
فقد كان طودًا شامخًا لا يدنو منه العدوّ هيبةً وخوفًا رغم جراحاته الكثيرة في كربلاء حتّى شهد له عدوّه بذلك، فقد قال حميد بن مسلم: فوالله ما رأيت مكثورًا -أي تكاثروا عليه- قطّ قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشًا ولا أمضى جنانًا منه، إن كانت الرجّالة لتشدّ عليه فيشدّ عليها بسيفه فيكشفهم عن يمينه وشماله انكشاف المعزى إذا اشتدّ عليها الذئب[2].
وأكثر ما يبرز ذلك حين وقف ذلك الموقف الرساليّ العظيم يهزّ الأمّة ويشجّعها أن لا تموت هوانًا وذلًّا، رافضًا بيعة الطليق ابن الطليق يزيد بن معاوية، قائلًا: «إنّ مثلي لا يبايع مثله»[3].
وها هو يصرّح لأخيه محمّد بن الحنفية مجسّدًا ذلك الإباء، بقوله: «يا أخي! والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية»[4].
[1] ابن عساكر، ترجمة الإمام الحسين، ص231.
[2] الطبريّ، تاريخ الطبريّ، ج4، ص301.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج44، ص147.
[4] أحمد بن أعثم الكوفي، كتاب الفتوح، ج5، ص21.
20
9
الموعظة الأولى: الإمام الحسين بن عليّ (عليه السلام)
وكذا عندما وقف صارخًا بوجه جحافل الشرّ والظلم من جيوش الردّة الاُمويّة، قائلًا: «والله لا أُعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقرّ إقرار العبيد، إنّي عذت بربّي وربّكم أن ترجمون»[1].
لقد كانت كلمات الإمام أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) تعبّر عن أسمى مواقف أصحاب المبادئ والقيم وحملة الرسالات، كما تنمّ عن عزّته واعتداده بالنفس، فقد قال:
«ألا وإنّ الدعيِّ ابن الدعيِّ قد ركز بين اثنتين بين السلّة والذلّة، وهيهات منّا الذلة، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأُنوف حميّة، ونفوس أبيّة من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام»[2].
[1] العلّامة البحرانيّ، عوالم الإمام الحسين، ص59.
[2] ابن نما، مثير الأحزان، ص20. العلّامة البحرانيّ، عوالم الإمام الحسين، ص159.
21
10
الموعظة الثانية: إحياء محرّم
الموعظة الثانية: إحياء محرّم
بيان أهمّيّة أيّام عاشوراء، وكيفيّة إحيائها، والحثّ على ذلك.
محاور الموعظة
أهميّة أيّام عاشوراء عند أهل البيت (عليهم السلام)
كيفيّة إحياء هذه المناسبة
آداب ومستحبّات ومراقبات
تصدير الموضوع
الإمام الصادق (عليه السلام) لفضيل بن يسار: «تجلسون وتحدّثون؟»، قال: نعم، جُعِلتُ فداك، قال: «إنّ تلك المجالس أحبّها، فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحم الله من أحيا أمرنا. يا فضيل، مَن ذَكَرَنا أو ذُكِرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر»[1].
[1] الحميريّ القمّيّ، قرب الإسناد، ص36.
22
11
الموعظة الثانية: إحياء محرّم
لا شكّ في أنّ لإحياء مراسم شهر محرّم الحرام أسبابه وأهدافه التي يرجع إليها، بحيث يؤدّي الإحياء وظيفته في تكريسها وتعزيزها، كإظهار المودّة والمحبّة لأهل البيت (عليهم السلام)، المنصوص عليها في الكتاب الكريم: ﴿قُل لَّا أَسَٔلُكُم عَلَيهِ أَجرًا إِلَّا ٱلمَوَدَّةَ فِي ٱلقُربَىٰ﴾[1]، وتعظيم شعائر الله، كما قال -تعالى-: ﴿وَمَن يُعَظِّم شَعَٰئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوَى ٱلقُلُوبِ﴾[2]، وإيصال صوت العدالة للإنسانيّة جمعاء، ومحاربة الظلم والفساد، وربط قلوب المحبّين والموالين بالنبيّ وأهل بيته (عليهم السلام)، إلى غير ذلك من غايات تهدف إليها هذا المراسم.
وفيما يلي الإشارة إلى بعض ما ورد في الروايات من أمور حثّ عليها الأئمّة (عليهم السلام) في هذا المجال:
1. حرارة الدم الحسينيّ: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنّ لقتل الحسين حرارةً في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدًا»[3].
وفي حديث للسيّدة زينب (عليها السلام) مع ابن أخيها الإمام زين العابدين (عليه السلام) تُسكّن فيه آلامه وأحزانه بمصيبة أبيه الإمام الحسين (عليه السلام) لمّا رآه على الثرى بلا مواراة، فاشتدّ الأمر عليه، وصار يجود بنفسه، فذكرت له (عليها السلام) أنّه سيُدفن وسيُعلي الله شأن قبره ومدفنه؛ وممّا قالته له: «... لا يُدرَس أثره، ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيّام، وليجتهدّن أئمّة الكفر وأشياع
[1] سورة الشورى، الآية 23.
[2] سورة الحجّ، الآية 32.
[3] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج10، ص318.
23
12
الموعظة الثانية: إحياء محرّم
الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلّا ظهورًا، وأمره إلّا علوًا»[1].
2. عاشوراء أيّام الحزن والبكاء: عن الإمام الرضا (عليه السلام): «إنّ المحرّم شهر كان أهل الجاهليّة يحرّمون فيه القتال، فاستُحلّت فيه دماؤنا، وهُتكت فيه حرمتنا، وسُبي فيه ذرارينا ونساؤنا، وأُضرمت النيران في مضاربنا، وانتُهب ما فيها من ثقلنا، ولم تُرعَ لرسول الله (صلى الله عليه وآله) حرمة في أمرنا. إنّ يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذلّ عزيزنا، بأرض كربٍ وبلاء، وأورثتنا الكرب والبلاء، إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكِ الباكون، فإنّ البكاء عليه يحطّ الذنوب العظام». ثمّ قال (عليه السلام): «كان أبي صلوات الله عليه إذا دخل شهر المحرّم لا يُرى ضاحكًا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتّى يمضي منه عشرة أيّام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين صلوات الله عليه»[2].
آداب ومستحبّات ومراقبات
1. البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام): عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «كلّ عين يوم القيامة باكية، وكلّ عين يوم القيامة ساهرة، إلّا عين مَن اختصّه الله بكرامته، وبكى على ما يُنتهك من الحسين وآل محمّد (عليهم السلام)»[3].
[1] ابن قولويه القمّيّ، كامل الزيارات، ص444 - 445.
[2] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص190.
[3] الشيخ الصدوق، الخصال، ص625، حديث الأربعمئة.
24
13
الموعظة الثانية: إحياء محرّم
وعن الإمام الرضا (عليه السلام) في حديثه للريّان بن شبيب: «يابن شبيب، إن كنت باكيًا لشيء فابكِ للحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، فإنّه ذُبح كما يُذبح الكبش، وقُتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلًا ما لهم في الأرض شبيه...
يابن شبيب، إن بكيت على الحسين (عليه السلام) حتّى تصير دموعك على خدّيك غفر الله لك كلّ ذنب أذنبته، صغيرًا كان أو كبيرًا، قليلًا كان أو كثيرًا»[1].
2. إنشاد الشعر: عن الإمام الصادق (عليه السلام): «مَن أنشد في الحسين بيتًا من شعر فبكى وأبكى عشرة فله ولهم الجنّة، ومن أنشد في الحسين بيتًا فبكى وأبكى تسعة فله ولهم الجنّة، فلم يزل حتّى قال: [و]مَن أنشد في الحسين بيتًا فبكى -وأظنّه قال: أو تباكى- فله الجنّة»[2].
3. لبس السواد وترك الزينة: وذلك من باب كونه شعارًا لأهل الحزن والعزاء. فعن عمر بن عليّ بن الحسين، قال: لمّا قتل الحسين بن عليّ (عليه السلام) لبسن نساء بني هاشم السواد والمسوح، وكنّ لا يشتكين من حرّ ولا برد، وكان عليّ بن الحسين (عليه السلام) يعمل لهن الطعام للمأتم[3].
وفي حديث للإمام الصادق (عليه السلام) مع زرارة: «... وما اختضبتْ
[1] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص192.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج44، ص289.
25
[3] الشيخ البرقيّ، المحاسن، ج2، ص420.
14
الموعظة الثانية: إحياء محرّم
منّا امرأة، ولا ادّهنت ولا اكتحلت ولا رجلت، حتّى أتانا رأس عبيد الله بن زياد، وما زلنا في عبرة بعده...»[1].
4. الإنفاق وبذل المال: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّ الله -تبارك وتعالى- اطّلع إلى الأرض فاختارنا، واختار لنا شيعة، ينصروننا و يفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، أولئك منّا وإلينا»[2].
وعن معاوية بن وهب، قال: استأذنت على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقيل لي: ادخل، فدخلت، فوجدته في مصلّاه في بيته، فجلست حتّى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربّه، وهو يقول: «اللهمّ! يا من خصّنا بالكرامة، ووعدنا بالشفاعة، وخصّنا بالوصيّة، وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني، وزوّار قبر أبي عبد الله الحسين، الذين أنفقوا أموالهم، وأشخصوا أبدانهم، رغبةً في برّنا، ورجاءً لما عندك في صلتنا، وسرورًا أدخلوه على نبيّك، وإجابةً منهم لأمرنا، وغيظًا أدخلوه على عدوّنا، أرادوا بذلك رضوانك؛ فكافهم عنّا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف...»[3].
5. إقامة العزاء والمشاركة فيه: عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث له: «... ثمّ ليندب الحسين (عليه السلام)، ويبكيه، ويأمر مَن في داره
[1] ابن قولويه القمّيّ، كامل الزيارات، ص167 - 168.
[2] الشيخ الصدوق، الخصال، ص635، حديث الأربعمئة.
[3] ابن قولويه القمّيّ، كامل الزيارات، ص228.
26
15
الموعظة الثانية: إحياء محرّم
بالبكاء عليه، ويقيم في داره مصيبته بإظهار الجزع عليه، ويتلاقون بالبكاء بعضهم بعضًا بمصاب الحسين (عليه السلام)...»[1].
وعن الإمام الرضا (عليه السلام): «مَن تذكر مصابنا وبكى لما ارتُكب منّا كان معنا في درجتنا يوم القيامة، ومَن ذكَّر بمصابنا فبكى وأبكى لم تبكِ عينُه يوم تبكي العيون، ومَن جلس مجلسًا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»[2].
6. التعزية بالإمام الحسين (عليه السلام): وفي الحديث المتقدّم عن الإمام الباقر (عليه السلام) لمّا سئل (عليه السلام): فكيف يعزّي بعضهم بعضًا؟ قال: «يقولون: عظّم الله أجورنا بمصابنا بالحسين (عليه السلام)، وجعلنا وإيّاكم من الطالبين بثاره مع وليّه الإمام المهديّ من آل محمّد (صلى الله عليه وآله)»[3].
7. زيارة الإمام الحسين (عليه السلام): عن الإمام الصادق (عليه السلام): «مَن زار الحسين يوم عاشوراء وجبت له الجنّة»[4].
8. ترك العمل يوم عاشوراء: وفي حديث الإمام الباقر (عليه السلام) المتقدّم: «... فإن استطعت أن لا تنتشر يومك في حاجة فافعل، فإنّه يوم نحس لا تقضى فيه حاجة، وإن قضيت لم يبارَك له فيها ولم يرَ رشدًا، ولا تدّخرن لمنزلك شيئًا، فإنّه من ادّخر لمنزله شيئًا في ذلك اليوم لم يبارَك له فيما يدّخره ولا يبارَك له في أهله...»[5].
[1] ابن قولويه القمّيّ، كامل الزيارات، ص326.
[2] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص131.
[3] ابن قولويه القمّيّ، كامل الزيارات، ص326.
[4] المصدر نفسه، ص324.
[5] المصدر نفسه، ص326 - 327.
27
16
الموعظة الثالثة: فلسفة البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام)
الموعظة الثالثة: فلسفة البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام)
إظهار البعد الروحيّ والولائيّ لقضيّة البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام)، وتأكيد مشروعيّتها وثوابها.
محاور الموعظة
مشروعيّة البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام)
ثواب البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام)
فلسفة البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام)
تصدير الموعظة
الإمام الصادق (عليه السلام): «ما من مؤمن ذَكَرَنا أو ذُكرنا عنده يخرج من عينَيه ماء ولو مثل جناح البعوضة، إلّا بنى الله له بيتًا في الجنّة، وجعل ذلك الدمع حجابًا بينه وبين النّار»[1].
[1] الشيخ الأمينيّ، الغدير، ج2، ص202.
28
17
الموعظة الثالثة: فلسفة البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام)
مشروعيّة البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام)
عن الإمام الرضا (عليه السلام): «يابن شبيب، إن كنت باكيًا لشيء فابكِ للحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، فإنّه ذُبح كما يُذبح الكبش، وقُتل معه من أهل بيته ثمانيةَ عشرَ رجلًا، ما لهم في الأرض شبيهون. ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله، ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره، فوجدوه قد قُتل، فهم عند قبره شعثٌ غبْرٌ إلى أن يقوم القائم، فيكونون من أنصاره، وشعارهم: يا لثارات الحسين.
يابن شبيب، لقد حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه: أنّه لما قُتل جدّي الحسين أمطرت السماء دمًا وترابًا أحمر»[1].
ثواب البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام)
عن الإمام الرضا (عليه السلام): «فعلى مثل الحسين فليبكِ الباكون، فإنّ البكاء عليه يحطّ الذنوب العظام»[2].
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «كلّ عين باكية يوم القيامة إلّا عين بكت على مصاب الحسين، فإنّها ضاحكة مستبشرة»[3].
عن الإمام الرضا (عليه السلام): «يابن شبيب، إن بكيتَ على الحسين حتّى تصير دموعك على خدّيك، غفر الله لك كلّ ذنب أذنبته صغيرًا كان أو كبيرًا، قليلًا كان أو كثيرًا»[4].
[1] الشيخ هادي النجفيّ، موسوعة أحاديث أهل البيت (عليهم السلام)، ج2، ص78.
[2] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص191.
[3] الشيخ البحرانيّ، عوالم الإمام الحسين (عليه السلام)، ص534.
[4] الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج2، ص268.
29
18
الموعظة الثالثة: فلسفة البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام)
وعن الإمام محمّد الباقر (عليه السلام): «كان أبي عليّ بن الحسين (عليه السلام) يقول: أيّما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين (عليه السلام) ومَن معه حتّى تسيل على خدّيه، بوّأه الله في الجنّة غرفًا، وأيّما مؤمن دمعت عيناه دمعًا حتّى يسيل على خدّيه لأذى مسّنا من عدّونا بوأه الله مبوّأ صدق، وأيّما مؤمن مسّه أذى فينا فدمعت عيناه حتّى يسيل على خدّيه من مضاضة ما أوذي فينا صرف الله عنه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه ومن النّار»[1].
كما ورد أيضًا الحثّ على التباكي، فروي أنّ أبا ذرّ حدّث عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «مَن استطاع أحدكم أن يبكي فليبكِ، ومن لم يستطع فليُشعر قلبه الحزن وليتباكَ، فإنّ القلب القاسي بعيد من الله –تعالى-»[2].
فلسفة البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام)
1. إظهار المحبّة والولاء: إنّ البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام) يعني أنّنا سِلمٌ لمَن سالمهم، وحربٌ لمَن حاربهم، وعدوٌّ لمَن عاداهم، فالحزن والبكاء عليه هو إعلان الولاء والانتماء والبيعة له ولأهل البيت (عليهم السلام).
2. الإجلال والتعظيم: إنّ البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام) هو تعظيم لقدره، وتجليل لمقامه، وتبيان لعظيم كرامته أمام جميع الناس. وبالتالي، فإنّ بكاءنا هنا هو إعطاء شخصيّة الإمام الحسين (عليه السلام) عظمتها ومكانتها في نفوسنا.
[1] الشيخ الحويزيّ، تفسير نور الثقلين، ج4، ص628.
[2] الفيض الكاشانيّ، الوافي، ج26، ص189.
30
19
الموعظة الثالثة: فلسفة البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام)
3. تعليم مبادىء ثورة الإمام الحسين (عليه السلام): إذ البكاء يستهدف التفاعل القلبيّ والروحيّ مع المبادئ التي طرحها الإمام الحسين (عليه السلام)، والانصهار بها؛ تلك المبادئ التي خلّدت الإسلام، كالمطالبة بالحقّ المغصوب، والرفض القاطع للظلم، والتفاني والإيثار، والجهاد بكلّ غالٍ ونفيس. لذلك، فإنّ البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام) وسيلة لتربية النفس البشريّة.
4. مواساة أهل بيت العصمة (عليهم السلام): إنّ البكاء وإقامة المآتم هما لونٌ من ألوان المواساة لأهل البيت (عليهم السلام). والشعائر الحسينيّة هي بمثابة تعزية للرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) بذبح سبطه وولده الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وسبي عياله؛ وهذه المواساة نتوسّم منها نيل الأجر وعظيم المثوبة، فإنّ من صفات شيعتهم وأتباعهم (عليهم السلام) أنّهم يفرحون لفرحهم ويحزنون لحزنهم.
5. إحياء الثورة في النفوس وتزكيتها: للبكاء على الإمام الحسين (عليه السلام) دلالات يعبّر الإمام الراحل (قدس سره) عن جانب منها بقوله: «البكاء على مصاب الإمام الحسين (عليه السلام) هو إحياء للثورة، وإحياء لفكرة وجوب وقوف الجمع القليل في وجه إمبراطوريّة كبيرة»[1].
[1] موقع: IMAM KHoMEINI على الرابط: /http://ar.imam-khomeini.ir/ar/n9367.
31
20
الموعظة الرابعة: من أسباب الثورة الحسينيّة
الموعظة الرابعة: من أسباب الثورة الحسينيّة
بيان أهمّ معالم السياسة الأمويّة وخطرها على الإسلام، ومسؤوليّة الأمّة تجاه ذلك.
محاور الموعظة
المسؤوليّة الدينيّة
المسؤوليّة الاجتماعيّة
المسؤوليّة السياسيّة
المسؤوليّة الاقتصاديّة والماليّة
تصدير الموعظة
الإمام الحسين (عليه السلام) لأخيه محمّد بن الحنفيّة: «يا أخي، والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية»[1].
[1] السيّد الأمين، أعيان الشيعة، ج4، ص186.
32
21
الموعظة الرابعة: من أسباب الثورة الحسينيّة
قام الأمويّون بالعديد من السياسات التي كان لها الخطر الكبير على رسالة الإسلام وتعاليمه، وبرزت في مقابل ذلك عدّة مسؤوليّات جسيمة، نذكر منها:
المسؤوليّة الدينيّة
تعني مواجهة القضايا الآتية:
1. حكومة السلطان الجائر: عن الإمام الحسين (عليه السلام): «أيّها الناس، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من رأى سلطانًا جائرًا مستحلًّا لحُرم الله، ناكثًا لعهد الله، مخالفًا لسنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يعمل في عباد الله بالإثمّ والعدوان، فلم يغيّر عليه بقول ولا فعل كان حقًّا على الله أن يدخله مدخله»[1].
2. محو ذكر أهل البيت (عليه السلام): وذلك من خلال افتعال الأخبار والحطّ من شأنهم، واستخدام أجهزة الدولة لتربية الناس على بغضهم، ومعاقبة من يذكر فضائلهم بأقصى العقوبات، وسبّهم على المنابر والمآذن وخطب الجمعة، ولعلّ ما قالته الحوراء زينب (عليها السلام) ليزيد أكبر شاهد على حجم الجريمة التي كان يستهدفها بنو أميّة: «فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا»[2].
3. تدمير القيم الإسلاميّة: يقول ابن أبي الحديد: «كان معاوية أيّام عثمان شديد التهتّك موسومًا بكلّ قبيح، وكان في أيّام عمر يستر نفسه قليلًا خوفًا منه»[3].
[1] أبو مخنف، وقعة الطفّ، ص172.
[2] السيّد الأمين، أعيان الشيعة، ج1، ص616.
[3] جمعية المعارف الإسلاميّة الثقافيّة، تاريخ النهضة الحسينيّة، ص17.
33
22
الموعظة الرابعة: من أسباب الثورة الحسينيّة
ونقل الناس عنه في كتب السيرة أنّه كان يشرب الخمر[1].
واستخفّ بالقيم الدينيّة كافّة، ولم يعن بجميع ما جاء به الإسلام من أحكام، فاستعمل أواني الذهب والفضّة وأباح الربا[2].
4. ظهور البدع: فقد ورد في رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) إلى أهل البصرة: «فإنّ السنّة قد أميتت، والبدعة قد أحييت»[3].
المسؤوليّة الاجتماعيّة
وذلك في مقابل:
1. المظالم الهائلة على الشيعة: حيث عانى الشيعة في عهد معاوية صنوف العذاب كإعدام أعلامهم، وصلبهم على جذوع النخل، ودفنهم أحياء، وهدم دورهم، وعدم قبول شهادتهم، وحرمانهم من العطاء، وترويع نسائهم، وإذاعة الذعر والخوف في أوساطهم.
2. تفكيك المجتمع: إذ عمد معاوية في سياسته إلى إثارة عناصر التفرقة والعصبيّات القبليّة، كالصراع الذي نشب بين قيس ومضر، وأهل اليمن والمدينة، وبين قبائل العراق فيما بينها، وإثارة العنصريّة عند العرب ضدّ المسلمين من غير العرب، أي الموالي، وأثار الأحقاد القديمة بين الأوس والخزرج[4].
[1] أحمد بن حنبل، المسند، ج5، ص347.
[2] النسائيّ، سنن النسّائي، ج7، ص279.
[3] الطبريّ، تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص565.
[4] ابن عبد ربّه، العقد الفريد، ج2، ص260.
34
23
الموعظة الرابعة: من أسباب الثورة الحسينيّة
المسؤوليّة السياسيّة
والتي تتمثّل -بشكل أساسيّ- بالقضيّة الآتية:
الدفاع عن أحقّيّته بالخلافة: كتب الإمام الحسين (عليه السلام) في أولى رسائله إلى أهل الكوفة: «فلعمري ما الإمام إلّا العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط، والدائن بالحقّ، والحابس نفسه على ذات الله»[1].
وفي المقابل، يقول (عليه السلام): «ويزيد رجلٌ فاسق، شارب للخمر، وقاتل النفس المحترمة، معلنٌ بالفسق»[2].
المسؤوليّة الاقتصاديّة والماليّة
ذلك لتصحيح المسارات الآتية:
1. التمييز في العطاء: فقد منح معاوية المال بناءً على الولاء السياسيّ، فأعطى الأموال الهائلة لأسرته ووهبهم الثراء العريض، وأغدق المال على المؤيّدين له فأعطى خراج مصر لابن العاص، وجعله طعمة له ما دام حيّا[3]. وكلّ هذا معتمدًا على سياسة عشوائيّة في جمع الضرائب والأموال من خلال إعفاء مؤيّديه وإرغام معارضيه من محبّي أمير المؤمنين (عليه السلام) على دفع مبالغ طائلة.
[1] الطبريّ، تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص561.
[2] القرشيّ، حياة الإمام الحسين (عليه السلام)، ج2، ص209.
[3] جمعيّة المعارف الإسلاميّة الثقافيّة، تاريخ النهضة الحسينيّة، ص15.
35
24
الموعظة الرابعة: من أسباب الثورة الحسينيّة
2. إشاعة الفقر بين معارضيه: حتّى يبقى أكبر همّهم رفع الجوع والحرمان، فقد أجبر أهل يثرب على بيع أملاكهم واشتراها منهم بأبخس الأثمان[1].
وقد قام بأعباء هذه المسؤوليّات على أنواعها أبو عبد الله الحسين (عليه السلام) الذي تكفّلت نهضته تصحيح المسار الذي انحرف عن التعاليم التي جاءت بها رسالة النبيّ (صلى الله عليه وآله) وصدقت معه الكلمة القائلة «إنّ الإسلام محمّديّ الوجود حسينيّ البقاء»، ولعلّ هذا يكون من أبعاد كلمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حقّ سبطه الحسين (عليه السلام): «حسين منّي وأنا من حسين»[2].
[1] جمعيّة المعارف الإسلاميّة الثقافيّة، تاريخ النهضة الحسينيّة، ص13.
[2] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص127.
36
25
الموعظة الخامسة: الإمام السجّاد (عليه السلام) قدوة وأسوة
الموعظة الخامسة: الإمام السجّاد (عليه السلام) قدوة وأسوة
تعرّف الجوانب التربويّة في حياة الإمام السجّاد (عليه السلام) للاقتداء والتأسّي بها.
محاور الموعظة
قدوة العابدين والساجدين
قبس من علمه وتعليمه
تعبيره عن حبّه لله
فلسفة الجهاد في دعاء أهل الثغور
تصدير الموعظة
قال الفَرَزدق في قصيدته المشهورة واصفًا الإمام زين العابدين (عليه السلام):
هَذا الذي تَعرفُ البطحاءُ وطأتَه
والبيتُ يَعرفُه والحِلُّ والحَرَمُ
هذا ابنُ خَيرِ عبادِ الله كُلِّهمُ
هَذا التَّقيُّ النَّقيُّ الطاهرُ العَلَمُ
37
26
الموعظة الخامسة: الإمام السجّاد (عليه السلام) قدوة وأسوة
كان لعليّ بن الحسين (عليه السلام) جلالة عجيبة، فقد كان أهلًا للإمامة العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه وتألّهه وكمال عقله[1]. ويتّفق المؤرّخون على أنّ الإمام (عليه السلام) انكبَّ على الشؤون الدينيّة، ورواية الحديث، والتعليم، وأنّه انصرف إلى بثّ العلوم، وتعليم الناس، وتربية المخلصين، وتخريج العلماء والفقهاء، والإشراف على بناء الكتلة الشيعية[2].
قدوة العابدين والساجدين
لقد سطعت عبادة الإمام عليّ بن الحسين (عليه السلام) في حياته لتبرز في ألقابه التي منها «السجّاد» لكثرة سجوده و«ذو الثفنات» التي برزت على جبهته الشريفة و«زين العابدين» لعبادته لله و«سيّد العابدين»، وهو اللقب الذي اختاره له جدّه النبيّ (صلى الله عليه وآله) كما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ: كنتُ جالسًا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) والحسين (عليه السلام) في حجره وهو يداعبه، فقال (صلى الله عليه وآله): «يا جابر يولد له مولود اسمه عليّ، إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ ليقم سيّد العابدين»[3].
وجاء في تسميته بذي الثفنات، أنّ الإمام الباقر (عليه السلام)، قال: «كان لأبي في موضع سجوده آثار ثابتة وكان يقطعها في كلِّ سنة من طول سجوده وكثرته...»[4] ، ويمكن أن نبيّن بعض مظاهر عبادته (عليه السلام)، ومنها:
[1] الذهبيّ، سير أعلام النبلاء، ج4، ص398.
[2] السيّد محمّد رضا الجلاليّ، جهاد الإمام السجّاد (عليه السلام)، ص17 - 18.
[3] الشيخ جعفر السبحانيّ، الأئمة الاثني عشر، ص104.
[4] ابن شهر آشوب، المناقب، ج4، ص180 - 181.
38
27
الموعظة الخامسة: الإمام السجّاد (عليه السلام) قدوة وأسوة
1. الخوف من الله -تعالى-: علّمنا الإمام السجّاد (عليه السلام) كيف نخاف الله في حواره مع طاووس اليمانيّ الذي رآه يطوف من وقت العشاء إلى السحر، ونظر طاووس إلى الإمام (عليه السلام) فرآه يرمق السماء بطرفه ويقول: «إلهي غارت نجوم سماواتك، وهجعت عيون أنامك، وأبوابك مفتّحات للسائلين، جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدّي محمد (صلى الله عليه وآله) في عرصات القيامة»، ثمّ بكى وأطال الدعاء والبكاء، فدنا منه طاووس، وقال له: «ما هذا الجزع والفزع؟! ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا، ونحن عاصون جانون، أبوك الحسين بن عليّ (عليه السلام) وأمّك فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وجدّك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فالتفت إليه الإمام (عليه السلام)، وقال: «هيهات يا طاووس! دع عنّي حديث أبي وأمي وجدّي، خلق الله الجنّة لمن أطاعه وأحسن، ولو كان عبدًا حبشيًّا وخلق النار لمن عصاه، ولو كان سيّدًا قرشيًا، أما سمعت قوله -تعالى-: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَينَهُم يَومَئِذٖ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾[1]، والله لا ينفعك غدًا إلاّ تقدمة تقدّمها من عمل صالح»[2].
2. حاله عند التهيّؤ للصلاة: جاء في مصادر عدّة أنّه (عليه السلام) كان إذا توضّأ للصلاة يصفرّ لونه، وكيف لا تبرز معالم العبادة في ألقابه وهو الذي كان إذا أراد الوضوء اصفرّ لونه، فيقال له: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيجيب (عليه السلام): «أتدرون بين يدي من أقوم!»[3].
[1] سورة المؤمنون، الآية 101.
[2] الإمام زين العابدين (عليه السلام)، الصحيفة السجّاديّة (أبطحي)، ص176.
[3] جعفر عبّاس الحائريّ، بلاغة الإمام عليّ بن الحسين (عليه السلام)، ص199.
39
28
الموعظة الخامسة: الإمام السجّاد (عليه السلام) قدوة وأسوة
وكان (عليه السلام) إذا قام في الصلاة غشي لونه لونٌ آخر وأخذته رعدة بين يدي الله -تعالى- لم يعد عندها يلتفت إلى ما حوله، لذا حينما وقع حريق في بيته وهو ساجد فرَّ مَن في البيت بينما بقي الإمام (عليه السلام) ساجدًا ولمّا سُئَل في ذلك كان جوابه (عليه السلام): «ألهتني عنها النار الكبرى»[1].
3. خشوعه: وعن خشوعه، قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كان أبي يقول: كان عليّ بن الحسين (عليهما السلام) إذا قام في الصلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرّك منه شيء إلّا ما حرّكه الريح منه»[2].
قال أبو حمزة الثماليّ: رأيت عليّ بن الحسين (عليه السلام) يصلّي فسقط رداؤه عن أحد منكبه، قال: فلم يُسوِّه حتّى فرغ من صلاته، قال: فسألته عن ذلك. فقال: «ويحك أتدري بين يدي من كنت؟ إنّ العبد لا يقبل من صلاته إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه»[3]. وعن الإمام الباقر (عليه السلام): «كان عليّ بن الحسين يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة، وكانت له خمسمئة نخلة وكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين، وكان إذا قام في صلاته غشي لونه لون آخر، وقيامه في صلاته قيام عبد ذليل بين يدي الملك الجليل، كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله، وكان يصلّي صلاة مودّع يرى أنّه لا يصلّي بعدها أبدًا»[4].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج46، ص80.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج3، ص300.
[3] الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ج1، ص231.
[4] ابن شهر آشوب، المناقب، ج4، ص150.
40
29
الموعظة الخامسة: الإمام السجّاد (عليه السلام) قدوة وأسوة
وقال الزهريّ: «كان عليّ بن الحسين (عليه السلام) إذا قرأ (ملك يوم الدين) يكرِّرها حتّى يكاد أن يموت»[1].
4. حجّه (عليه السلام): جاء في حياة الحيوان للدميريّ، قال: «إنّه لمّا حجّ وأراد أن يلبّي أرعد واصفرّ وخرّ مغشيًّا عليه، فلمّا أفاق سُئِل عن ذلك، فقال: إنّي لأخشى أن أقول: لبّيك، اللهمّ لبّيك، فيقول لي: لا لبّيك ولا سعديك، فشجّعوه، وقالوا: لا بدّ من التلبية، فلمّا لبّى غشي عليه حتّى سقط عن راحلته، وكان يصلّي في كلّ يوم وليلة ألف ركعة، كان كثير الصدقات وكان أكثر صدقته بالليل، وكان يقول: «صدقة الليل تطفئ غضب الربّ»[2].
قبس من علمه وتعليمه
كان (عليه السلام) يشجّع كلّ من يأتي إليه طالبًا لعلوم آل محمد، ويقول له: «مرحبًا بوجه رسول الله (صلى الله عليه وآله)»، ثمّ يقول: «إنّ طالب العلم إذا خرج من منزله لم يضع رجليه على رطب ولا يابس من الأرض إلّا سحبت له إلى الأرضين السابعة»[3]. ويقول ابن حجر في صواعقه: «زين العابدين هو الذي خلف أباه علمًا وزهدًا وعبادة»[4]. وقد تمكّن الإمام زين العابدين من بيان معالم فقه أهل البيت (عليهم السلام) وإغناء معارفه، حتّى أقرَّ كبار العلماء بأنّه الأفقه من الجميع، قال أبو حازم: «لم أرَ هاشميًّا
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج6، ص151.
[2] كمال الدين دميريّ، حياة الحيوان الكبرى، ج1، ص139.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج46، ص62.
[4] أحمد بن حجر الهيتميّ المكّيّ، الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة، ص200.
41
30
الموعظة الخامسة: الإمام السجّاد (عليه السلام) قدوة وأسوة
أفضل من عليّ بن الحسين(عليه السلام) وما رأيت أحدًا كان أفقه منه»[1]، وقال الشافعيّ: «إنّ عليّ بن الحسين أفقه أهل البيت»[2].
ويتّفق المؤرّخون على أنّ الإمام (عليه السلام) «انكبَّ على الشؤون الدينيّة، ورواية الحديث، والتعليم، وأنّه انصرف إلى بثّ العلوم، وتعليم الناس، وتربية المخلصين، وتخريج العلماء والفقهاء، والإشراف على بناء الكتلة الشيعيّة»[3]، ولكنّه لم يكن بعيدًا عن العمل السياسيّ وإدارة شؤون المجتمع وفق ما تسمح به الظروف المحيطة آنذاك.
تعبيره عن حبّه لله
مفهوم الحبّ يعبّر عن حالة تعلّق خاصّ بين المرء وكماله، والإنسان يعشق الأشياء لأنّه يرى فيها سعادته، عن الإمام الباقر(عليه السلام): «يا زياد... ويحك، وهل الدين إلّا الحبّ، ألا ترى إلى قول الله -تعالى-: «﴿قُل إِن كُنتُم تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحبِبكُمُ ٱللَّهُ﴾ الدين هو الحبّ، والحبّ هو الدين»[4].
وفي «مناجاة المحبين» يصف الإمام عليّ بن الحسين (عليه السلام) محبّته لله -تعالى- وإخلاصه له، فيقول: «إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبّتِك، فرامَ منك بدلًا، ومن ذا الذي أنس بقربك، فابتغى عنك حولًا... يا منى قلوب المشتاقين... ويا غاية آمال المحبّين...
[1] محمّد بن طلحة الشافعي، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص420.
[2] السيّد محمّد رضا الجلاليّ، جهاد الإمام السجّاد (عليه السلام)، ص114.
[3] المصدر نفسه، ص79، نقلًا عن معتزلة اليمن ص17-18.
[4] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج66، ص238.
42
31
الموعظة الخامسة: الإمام السجّاد (عليه السلام) قدوة وأسوة
أسألك حُبّك، وحبَّ من يُحبّك، وحبّ كلّ عمل يُوصلني إلى قُربك.. وأن تجعلَ حبّي إياك قائدًا إلى رضوانك، وشوقي إليك ذائدًا عن عصيانك... يا أرحم الراحمين»[1].
وللحبّ في القلوب درجات:
أ. الحبّ الضحل والضئيل، لا يكاد يشعر به صاحبه ولا ينفع لبناء علاقة بالله.
ب. الحبّ الذي يملأ القلب ولا يترك مجالًا لشيء آخر.
ج. الحبّ الذي لا يرتوي معه العبد من ذكر الله ومناجاته، كما مرّ في المناجاة.
فلسفة الجهاد في دعاء أهل الثغور
إنّ الإمام زين العابدين (عليه السلام) وإن لم تتوافر له إمكانات التضحية والقتال إلى حدّ الشهادة، كما فعل أبوه الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء. لكنّه لم يفقد فرصة المقاومة بالدعاء لأهل الثغور بغضّ النظر عن الدولة القائمة على الظلم، فهو ينظر إلى ثغور المسلمين التي يشكّل حفظها حفظًا للمسلمين وحماية لأنفسهم وأعراضهم، وأموالهم التي يعتقد الإمام أنّها تدخل ضمن واجبات الإمامة ومسؤوليّات الإمام (عليه السلام).
لهذا نراه يفتتح هذا الدعاء العظيم، بقوله: «اللهمّ صلّ على محمّد وآله، وحصّن ثغور المسلمين بعزّتك، وأيّد حماتها بقوّتك، وأسبغ عطاياهم من جِدَتك». ثمّ يدعو الله أن يمنحهم القوّة بزيادة
[1] الإمام زين العابدين (عليه السلام)، الصحيفة السجّاديّة، ص413.
43
32
الموعظة الخامسة: الإمام السجّاد (عليه السلام) قدوة وأسوة
العدد والعُدّة ما يؤدّي إلى نصرهم، بقوله (عليه السلام): «اللهمّ صلّ على محمّد وآله، وكثّر عِدّتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألّف جمعهم... واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر».
لينتقل بعد ذلك إلى الدعاء لهم بالمعرفة والبصيرة كأهمّ عنصرين يحتاج إليهما المجاهدون، فيقول: «اللهمّ صلّ على محمّد وآله، وعرّفهم ما يجهلون، وعلّمهم ما لا يعلمون، وبصّرهم ما لا يبصرون»[1].
لينتقل بعد ذلك إلى تحفيز كلّ أفراد المجتمع على مساعدة المجاهدين وتقديم العون لهم؛ لأنّ عدم قدرة الجميع على الحضور في الثغور لا يعفيهم من واجباتهم، في الدعم والعون والنصرة من بعيد، بالمال والعتاد ومختلف أنواع المساعدة، حتّى الدعاء. فقال (عليه السلام): «اللّهمّ وأيّما مسلم خَلَفَ غازيًا، أو مرابطًا، في داره، أو تعهّد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله أو أمدّه بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوةً، أو رعى له من ورائه حرمةً، فأجْرِ له مثل أجره، وزنًا بوزن، ومثلًا بمثل، وعوّضه من فعله عوضًا حاضرًا يتعجّل به نفع ما قدّم، وسرور ما أتى به...»[2].
[1] الصحيفة السجّاديّة، دعاء أهل الثغور.
[2] الصحيفة السجّاديّة، الدعاء السابع والعشرون.
44
33
الموعظة السادسة: العبّاس بن عليّ عطاء وإيثار
الموعظة السادسة: العبّاس بن عليّ عطاء وإيثار
بيان جوانب التضحية والفداء في سيرة أبي الفضل العبّاس، ومقامه عند أهل البيت (عليهم السلام).
محاور الموعظة
لمحة في سيرته العطرة
مكانته ورفعة مقامه
مواقف أبي الفضل العبّاس
تصدير الموعظة
أحقّ الناس أن يُبكَى عليه
فتى أبكى الحسين بكربلاء
أخوه وابن والده عليّ أبو
الفضل المضرّج بالدماء
ومن واساه لا يثنيه شيء
وجادله على عطش بماء[1]
[1] أبو الفرج الأصفهانيّ، مقاتل الطالبيّين، ص55.
45
34
الموعظة السادسة: العبّاس بن عليّ عطاء وإيثار
أبو الفضل العباس بن الإمام عليّ (عليه السلام) نموذج رائع وفريد من أبناء الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، ولقد حاز أبو الفضل العبّاس قصب السبق في الفضائل ومكارم الأخلاق، فضلًا عن الشجاعة والعلم والإخلاص.
لمحة في سيرته العطرة
1. نسبه
هو من صميم الأسرة العلويّة، والدوحة الهاشميّة، فقد أخذ أبو الفضل العباس بأطراف رداء المجد من أبيه الإمام عليّ بن أبي طالب، ومن جهة الأمّ فهي السيدة فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابيّة، وأبوها حزام من أعمدة الشرف عند العرب، في الجاهليّة والإسلام[1]، وكانت ولادته في سنة (26 هـ) في اليوم الرابع من شهر شعبان[2].
2. نشأته
نشأ أبو الفضل العباس (عليه السلام) في ظلال أبيه، فغذّاه بعلومه وتقواه، وأشاع في نفسه النزعات الشريفة، والعادات الطيّبة ليكون مثالًا عنه، وأنموذجًا لمثله، كما غرست أمّه السيّدة فاطمة في نفسه، جميع صفات الفضيلة والكمال، وغذّته بحبّ الخالق العظيم فجعلته في أيّام طفولته يتطلّع إلى مرضاته وطاعته، وظلّ ذلك ملازمًا له طوال حياته.
[1] أبو الفرج الأصفهانيّ، مقاتل الطالبيّين، ص56.
[2] الشيخ عليّ النمازيّ الشاهروديّ، مستدركات علم رجال الحديث، ج4، ص350.
46
35
الموعظة السادسة: العبّاس بن عليّ عطاء وإيثار
ولازم أبو الفضل أخويه السبطين الحسن والحسين (عليهما السلام)، فكان يتلقّى منهما قواعد الفضيلة، وأسس الآداب الرفيعة، وقد لازم بصورة خاصّة أخاه الإمام الحسين (عليه السلام)، فكان لا يفارقه في حلّه وترحاله، وقد تأثّر بسلوكه، وانطبعت في قرارة نفسه مثله الكريمة وسجاياه الحميدة، حتّى صار صورة صادقة عنه يحكيه في مثله واتّجاهاته، وقد أخلص له الإمام الحسين كأعظم ما يكون الإخلاص، وقدّمه على جميع أهل بيته لِمَا رأى منه من الودّ الصادق له حتّى فداه بنفسه.
3. ألقابه
إنّ الألقاب التي تضفى على الشخص تحكي صفاته النفسيّة الحسنة، وقد أُضفيت على أبي الفضل (عليه السلام) عدّة ألقاب رفيعة تنمّ عن نزعاته النفسيّة الطيّبة، وما اتّصف به من مكارم الأخلاق، منها:
أ.قمر بني هاشم
كان العباس (عليه السلام) في روعة بهائه، وجميل صورته آية من آيات الجمال، ولذلك لُقِّب بقمر بني هاشم[1].
ب.السقّاء
وهو من أجلّ ألقابه، وأحبّها إليه، أمّا السبب في إمضاء هذا اللقب الكريم عليه فهو لقيامه بسقاية الإمام الحسين(عليه السلام)، فإنّه لما عطش الإمام الحسين (عليه السلام)، وقد منعوه الماء، وأخذ العباس قربة ومضى
[1] أبو الفرج الأصفهانيّ، مقاتل الطالبيّين، ص56.
47
36
الموعظة السادسة: العبّاس بن عليّ عطاء وإيثار
نحو الماء، وجلب الماء للإمام (عليه السلام)[1]، وسمّي بذلك أيضًا لسقايته عطاشى أهل البيت (عليهم السلام) حينما فرض ابن مرجانة الحصار على الماء، وأقام جيوشه على الفرات لتموت عطشًا ذريّة النبيّ (صلى الله عليه وآله).
ج.بطل العلقميّ
أمّا العلقميّ فهو اسم للنهر الذي استشهد على ضفافه أبو الفضل العبّاس (عليه السلام)، وكان محاطًا بقوى مكثّفة من قبل ابن مرجانة لمنع ريحانة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسيّد شباب أهل الجنة، ومن كان معه من نساء وأطفال من شرب الماء، وقد استطاع أبو الفضل بعزمه الجبّار، وبطولته النادرة أن يجندل الأبطال، ويهزم أقزام ذلك الجيش المنحطّ، ويبلُغ ذلك النهر، وقد قام بذلك عدّة مرّات، وفي المرّة الأخيرة استشهد على ضفافه ومن ثمّ لقب ببطل العلقميّ، وهو القائل:
لا أرهب الموت إذ الموت رقى
حتى أواري في المصاليت لقا
نفسي لنفس المصطفى الطهر وقا
إني أنا العباس أغدو بالسقا[2].
د.حامل اللواء
ومن ألقابه المشهورة (حامل اللواء) لواء الإمام الحسين(عليه السلام)، وقد خصّه به من دون أهل بيته وأصحابه؛ وذلك لما تتوافر فيه من القابليّات العسكريّة، ويعتبر منح اللواء في ذلك العصر من أهمّ المناصب الحسّاسة في الجيش[3].
[1] القاضي النعمان المغربيّ، شرح الأخبار، ج3، ص182.
[2] ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج3، ص256.
[3] أبو الفرج الأصفهانيّ، مقاتل الطالبيّين، ص56.
48
37
الموعظة السادسة: العبّاس بن عليّ عطاء وإيثار
هـ .كبش الكتيبة
وهو من الألقاب الكريمة التي يختصّ بها القائد الأعلى في الجيش، الذي يقوم بحماية كتائب جيشه بحسن تدبيره، وقوّة بأسه، وقد أضفي هذا الوسام الرفيع على سيّدنا أبي الفضل؛ وذلك لما أبداه يوم الطفّ من الشجاعة والبسالة في الذبّ عن معسكر الإمام الحسين (عليه السلام)، فقد كان قوّة ضاربة في معسكر أخيه، وصاعقة مرعبة ومدمّرة لجيوش الباطل[1].
و.باب الحوائج
وهذا من أكثر ألقابه شيوعًا، وانتشارًا بين الناس، فقد آمنوا وأيقنوا أنّه ما قصده ذو حاجة بِنيّة خالصة إلّا قضى الله حاجته، وما قصده مكروب إلّا كشف الله ما ألمّ به من محن الأيّام، وكوارث الزمان.
مكانته ورفعة مقامه
إنّ لأبي الفضل العبّاس مكانة عظيمة عند أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، وقد أفصحوا عنها في العديد من الكلمات والزيارات المأثورة عنهم، وفيما يلي بعض هذه الكلمات المعبّرة عن تلك المكانة العظيمة، وهي:
1.الإمام زين العابدين
أمّا الإمام زين العابدين (عليه السلام) فهو من المؤسّسين للتقوى والفضيلة في الإسلام، وكان هذا الإمام العظيم يترحّم-دومًا- على عمّه العبّاس ويذكر بمزيد من الإجلال والإكبار تضحياته الهائلة لأخيه
[1] لجنة الحديث في معهد باقر العلوم (عليه السلام)، موسوعة كلمات الإمام الحسين (عليه السلام)، ص362.
49
38
الموعظة السادسة: العبّاس بن عليّ عطاء وإيثار
الحسين وكان ممّا قاله في حقّه هذه الكلمات القيّمة: «رحم الله العبّاس، فلقد آثر وأبلى، وفدى أخاه بنفسه حتّى قطعت يداه، فأبدله الله -عزّ وجلّ- بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنّة كما جعل لجعفر بن أبي طالب، وإن للعبّاس عند الله -تبارك وتعالى- منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة»[1].
2. الإمام الصادق
كان الإمام الصادق (عليه السلام) هو العقل المبدع والمفكّر في الإسلام فقد كان هذا العملاق العظيم يشيد دومًا بعمّه العبّاس، ويثني ثناء عاطرًا ونديًّا على مواقفه البطوليّة يوم الطفّ، وكان ممّا قاله في حقّه: «كان عمّنا العبّاس نافذ البصيرة صلب الإيمان جاهد مع أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) وأبلى بلاءً حسنا ومضى شهيدًا»[2]، وفي كلمات الإمام الصادق(عليه السلام) مقامات عظيمة لأبي الفضل العباس، وهي:
أ.نَفاذ البصيرة
أمّا نَفاذُ البصيرة، فإنّه مُنبعث من سداد الرأي، وأصالة الفكر، ولا يتّصف بها إلّا من صفت ذاته، وخلصت سريرته، ولم يكن لدواعي الهوى والغرور أيّ سلطان عليه، وكانت هذه الصفة الكريمة من أبرز صفات أبي الفضل. فقد كان من نفاذ بصيرته.
[1] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص548.
[2] أبو نصر البخاريّ، سرّ السلسلة العلويّة، ص89.
50
39
الموعظة السادسة: العبّاس بن عليّ عطاء وإيثار
ب.الصلابة في الإيمان
والظاهرة الأخرى من صفات أبي الفضل (عليه السلام) هي الصلابة في الإيمان، وكان من صلابة إيمانه انطلاقه في ساحات الجهاد بين يدي ريحانة رسول الله مبتغيًا في ذلك الأجر عند الله.
ج.الجهاد والشهادة مع الحسين
وثمّة مكرمة وفضيلة أخرى لبطل كربلاء العبّاس (عليه السلام) أشاد بها الإمام الصادق (عليه السلام) وهي جهاده المشرق بين يدي سبط رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وسيّد شباب أهل الجنّة، ويعتبر الجهاد في سبيله من أسمى مراتب الفضيلة التي انتهى إليها أبو الفضل، وقد أبلى بلاءً حسنًا يوم الطفّ لم يشاهد مثله في دنيا البطولات.
3. الإمام الحجّة
وأثنى الإمام المصلح العظيم بقية الله في الأرض قائم آل محمد (صلى الله عليه وآله) بكلمة رائعة في حقّ عمّه العبّاس (عليه السلام) جاء فيها: «السلام على أبي الفضل العبّاس بن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له، الواقي، الساعي إليه بمائه، المقطوعة يداه، لعن الله قاتليه يزيد بن الرقاد، وحكيم بن الطفيل الطائي...»[1].
وقد ضمّ ديوان بطولات العبّاس ومواقفه الكريمة الشجاعة في واقعة كربلاء صفحات كثيرة مضيئة لكنّ أكثرها إضاءة وشهرة مواساته
[1] السيّد ابن طاووس، الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرّة في السنة، ج3، ص74.
51
40
الموعظة السادسة: العبّاس بن عليّ عطاء وإيثار
لأخيه الحسين بنفسه. إذ أبى أن يذوق الماء، وقد كان واقفا في لجّته وكَبِدُه تتلظّى من العطش، لأنّ الإمام الحسين (عليه السلام) وعياله عطاشى لم يذوقوا قطرة منه منذ أيام.
مواقف أبي الفضل العبّاس
لقد كان لأبي الفضل العبّاس مواقف عديدة في كربلاء تكشف عن إيمانه وثباته، ورسوخ عقيدته، وهذه المواقف العديدة هي مبادئ أسياسيّة في حياة الإنسان الجهاديّة، إذا وقف بين يدي الأعداء واعظًا ومحاربًا، ومن جملة تلك المواقف:
1. الثبات حتّى الشهادة
ثبت أبو الفضل العبّاس وإخوته في ساحات الجهاد أيّما موقف مع الإمام الحسين(عليه السلام)، فهم من الذين جاءهم الأمان لترك الإمام الحسين (عليه السلام) وحده، وكان هذا من أساليب عمر بن سعد لتفتيت جيش الإمام الحسين (عليه السلام)، إلّا أنّه فشل في ذلك، فإيمان أصحاب الإمام وثباتهم يفوق تصوّر ابن سعد، وفي محاولة منه، فقد أرسل شمرًا لإعطاء الأمان للعبّاس وإخوته، حتّى وقف على أصحاب الحسين (عليه السلام)، فقال: أين بنو أختنا[1]؟ فخرج إليه العبّاس وجعفر وعثمان بنو عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام)، فقالوا: «ما تريد؟» فقال: أنتم يا بني أختي آمنون، فقالت له الفتية: «لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمّننا وابن رسول الله لا أمان له؟!»[2].
[1] وذلك لأنّ أمّ البنين بنت حزام أمّ عبّاس وعثمان وجعفر وعبد الله كانت كلابيّة وشمر ابن ذي الجوشن كلابيّ ولذا أخذ من ابن زياد أمانا لبنيها.
[2] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص89.
52
41
الموعظة الثامنة: الحوراء زينب (عليها السلام) بعد كربلاء إلى الشهادة
2. الطاعة والولاء لقيادة الإمام الحسين (عليه السلام)
ففي اليوم التاسع من المحرّم جاء رسول عمر بن سعد إلى الإمام الحسين (عليه السلام)، فنهض العبّاس، وقال: «يا أخي أتاك القوم»، فنهض الإمام الحسين (عليه السلام)، ثمّ قال: «يا عبّاس، اركب -بنفسي أنت يا أخي- حتّى تلقاهم وتقول لهم: ما لكم وما بدا لكم؟ وتسألهم عمّا جاء بهم». فأتاهم العبّاس، فقال لهم العبّاس: «ما بدا لكم وما تريدون؟».
قالوا: جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم، قال: فلا تعجلوا حتّى أرجع إلى أبي عبد الله فأعرض عليه ما ذكرتم، فوقفوا وقالوا: اِلقَه فأعلمه، ثمّ لقنا بما يقول لك. فانصرف العبّاس راجعًا يركض إلى الحسين (عليه السلام) يخبره الخبر.
فقال الإمام الحسين (عليه السلام): «ارجع إليهم فإن استطعت أن تؤخّرهم إلى الغدوة وتدفعهم عنّا العشيّة، لعلّنا نصلّي لربّنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أنّي قد أحبّ الصلاة له وتلاوة كتابه والدعاء والاستغفار».
فمضى العبّاس إلى القوم ورجع من عندهم ومعه رسول من قبل عمر بن سعد، يقول: إنّا قد أجّلناكم إلى غد، فإن استسلمتم سرّحناكم إلى أميرنا عبيد الله بن زياد، وإن أبيتم فلسنا تاركيكم، وانصرف[1].
[1] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص90.
53
42
الموعظة السادسة: العبّاس بن عليّ عطاء وإيثار
الموعظة السابعة: الإمام المهديّ(عجل الله تعالى فرجه) الثائر للحسين(عليه السلام)
تعريف الناس بالإمام الحُجّة (عجل الله تعالى فرجه)، وبيان صفات أنصاره الثائرين معه.
محاور الموعظة
التعريف بالإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
الثأر للإمام الحسين عنوان حركة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
صفات الآخذين بالثأر
تصدير الموعظة
﴿بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيرٞ لَّكُم إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيكُم بِحَفِيظٖ﴾[1].
[1] سورة هود، الآية 86.
54
43
الموعظة السابعة: الإمام المهديّ(عجل الله تعالى فرجه) الثائر للحسين(عليه السلام)
التعريف بالإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
عن النبي (صلى الله عليه وآله): «لمّا أُسرِيَ بي، أوحى إليَّ ربّي -جلَّ جلاله-... فرفعتُ رأسي، فإذا أنا بأنوار عَليّ، وفاطمة، والحسن، والحسين، وعليّ بن الحسين، ومحمّد بن عليّ، وجعفر بن محمّد، وموسى بن جعفر، وعليّ بن موسى، ومحمّد بن عليّ، وعليّ بن محمّد، والحسن بن عليّ، والحُجّة بن الحسن القائم في وسطهم كأنّه كوكب دُرّيّ، قلتُ: يا ربّ، مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأئمّة، وهذا القائم الذي يحلّ حلالي ويحرِّم حرامي، وبه أنتقم مِن أعدائي»[1].
الثأر للإمام الحسين عنوان حركة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
عن الإمام الصادق (عليه السلام) في قوله -تعالى- ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصرِهِم لَقَدِيرٌ﴾[2]: «إنّ العامّة يقولون نزلَتْ في رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله) لمّا أخرجَتْه قريش مِن مكّة، وإنّما هي للقائم (عليه السلام) إذا خرج يطلب بِدم الحسين (عليه السلام)...»[3].
وعنه (عليه السلام): «لمّا كان مِن أمرِ الحسين (عليه السلام) ما كان، ضجَّت الملائكة إلى اللَّه بالبكاء، وقالت: يُفعل هذا بالحسين صفيِّك وابن نبيِّك؟ فأقام اللّه لهم ظلّ القائم (عليه السلام)، وقال: بهذا أنتقم لهذا»[4].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج42، ص422.
[2] سورة الحج، الآية 39.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج42، ص422.
[4] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج42، ص422.
55
44
الموعظة السابعة: الإمام المهديّ(عجل الله تعالى فرجه) الثائر للحسين(عليه السلام)
والثأر لا يقتصر على مَن شارك في قتل الإمام (عليه السلام) في التاريخ، بل يشمل المشاركين لهم من أهل الباطل كلّهم.
صفات الآخذين بالثأر
1. مُخلصون: عن الإمام الرضا (عليه السلام): «... ينتظرُ خروجَه المخلصون»[1].
2. عابدون: في وصفهم وَرَدَ: «رجالٌ لا ينامون الليل، لهم دويٌّ كدويّ النحل»[2].
3. ثابتون: وصفَهُم أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله: «لا يخافون في اللَّه لومةَ لائم»[3].
4.5. متولّون أولياءه، متبرّئون من أعدائه: عن رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله): «طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي (عليه السلام) وهو مُقتدٍ به قبل قيامه، يتولّى وليَّه، ويتبرّأ مِن عدوّه»[4].
6. أقوياء: عن الإمام الصادق (عليه السلام): «ما يخرج إلّا في أُولي قوّة». وفي وصفهم قال: «إنّ قلبَ رجلٍ منهم أشدّ مِن زبر الحديد، لو مرّوا بالجبال الحديد لَتدكدكَتْ، لا يكفّون سيوفهم حتّى يرضى اللَّه -عزَّ وجلَّ-»[5].
7. مجهَّزون بالعتاد: عن الإمام الصادق (عليه السلام): «ليعدّنّ أحدكم لخروج القائم ولو سهمًا، فإنّ اللَّه -تعالى- إذا عَلِم ذلك مِن نيّته، رجوتُ
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج15، ص703.
[2] المصدر نفسه، ج25، ص703.
[3] القزوينيّ، سنن ابن ماجة، ج2، ص1371.
[4] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج25، ص921.
[5] القاضي النعمان المغربيّ، شرح الأخبار، ج3، ص569.
56
45
الموعظة السابعة: الإمام المهديّ(عجل الله تعالى فرجه) الثائر للحسين(عليه السلام)
أن ينسأ في عمره حتّى يُدركه، فيكون من أعوانه وأنصاره»[1].
8. غاضبون: ذُكر عند أمير المؤمنين (عليه السلام) «جيش الغضب»، فقال: «أولئك قومٌ يأتون في آخر الزمان... أما -واللَّه- إنّي لأعرف أميرهم واسمه... ذلك رجلٌ مِن ذرّيّتي...»[2].
9. موحَّدون: عنه أيضًا (عليه السلام): «يُؤلّف اللَّه بين قلوبهم»[3].
10. منظَّمون: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصفِهم: «الزيّ واحد، واللباس واحد، كأنّما آباؤهم أبٌ واحد»[4].
11. مُطيعون: يُكمل الإمام (عليه السلام) في وصفِهم بقوله: «يَكْفونه ما يريد منهم»[5].
12. مبتلون: عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ أصحاب طالوت ابتلوا بالنهر... وإنّ أصحاب القائم (عليه السلام) يُبتلون بمثل ذلك»[6].
13. فدائيّون: عنه أيضًا في وصفِه لهم: «يَقونه بأنفسهم في الحروب»[7].
14. طالبون للشهادة: عنه أيضًا (عليه السلام): «يَدعون بالشهادة، ويتمنّون أن يُقتلوا في سبيل اللَّه»[8].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج25، ص693.
[2] المصدر نفسه، ج25، ص742.
[3] الحاكم النيسابوريّ، المستدرك، ج4، ص554.
[4] المقدسيّ، عقد الدرر، ص95.
[5] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج25، ص703.
[6] النعمانيّ، الغيبة، ص331.
[7] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج52، ص308.
[8] المصدر نفسه، ج25، ص703.
57
46
الموعظة الثامنة: الحوراء زينب (عليها السلام) بعد كربلاء إلى الشهادة
الموعظة الثامنة: الحوراء زينب (عليها السلام) بعد كربلاء إلى الشهادة
تعرّف مواقف السيّدة زينب (عليها السلام) بعد كربلاء وقيادتها للثورة على الطغاة والظالمين.
محاور الموعظة
العقيلة زينب في سطور
عفّتها (عليها السلام)
عبادة زينب (عليها السلام)
القيادة الزينبيّة للثورة
تصدير الموعظة
السيّدة زينب (عليها السلام) ليزيد (لعنه الله): «فَكِدْ كَيْدَكَ، وَاسْعَ سَعْيَكَ، ونَاصِبْ جَهْدَكَ، فَوَاللهِ لاَ تَمْحُو ذِكْرَنَا، ولاَ تُمِيتُ وَحْيَنَا، وَلاَ تُدْركُ أَمَدَنَا، وَلاَ تَرْحَضُ عَنْكَ عَارَهَا...»[1].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج45، ص135.
58
47
الموعظة الثامنة: الحوراء زينب (عليها السلام) بعد كربلاء إلى الشهادة
من أعظم بطولات الحوراء زينب (عليها السلام) أنّ واقعة السبي والأسر لم تفرض عليها التكيّف مع الواقع كيفما كان، ولم يدفعها الخوف من إيثار السلامة والدّعة على المواجهة والتحدّي، ولم يمنعها انكسار السيف في كربلاء من مواجهة الانحراف بل بقي صوتها العالي شاهد صدق في محكمة التاريخ، على عظم الجريمة التي جرت في كربلاء، وعظيم المواجهة التي واجهت بها قوى الظلام، قائلة: فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا.
العقيلة زينب في سطور
ولدت السيّدة زينب (عليها السلام)، في الخامس من جمادى الأولى، في السنة الخامسة -أو السادسة- للهجرة، وقيل في غرّة شعبان في السنة السادسة. وتكنّى بأمّ كلثوم، وأمّ الحسن، وتلقّب: بالصدّيقة الصغرى، والعقيلة، وعقيلة بني هاشم، وعقيلة الطالبيّين.
عفّتها (عليها السلام)
حدّث يحيى المازنيّ، قال: كنت في جوار أمير المؤمنين في المدينة مدّة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته، فلا والله ما رأيت لها شخصًا ولا سمعت لها صوتًا، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدّها رسول الله (صلى الله عليه وآله) تخرج ليلًا والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين (عليه السلام) أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخمد ضوء القناديل، فسأله الحسن (عليه السلام) مرّة عن ذلك، فقال (عليه السلام): «أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب»[1].
[1] لجنة من علماء البحرين والقطيف، وفيّات الأئمّة(عليهم السلام)، ص436.
59
48
الموعظة الثامنة: الحوراء زينب (عليها السلام) بعد كربلاء إلى الشهادة
عبادة زينب (عليها السلام)
كانت تقضي لياليها عامّة بالتهجّد وتلاوة القرآن، قالت فاطمة بنت الحسين (عليها السلام): «وأمّا عمّتي زينب فإنّها لم تزل قائمة في تلك الليلة -أي العاشرة من المحرّم- في محرابها، تستغيث إلى ربّها، فما هدأت لنا عين ولا سكنت لنا رنّة. وفي رواية: أنّ الحسين (عليه السلام) لمّا ودّع أخته زينب وداعه الأخير، قال لها: يا أختاه لا تنسيني في نافلة الليل...»[1].
إيثارها (عليها السلام)
وروي عن الإمام زين العابدين (عليه السلام) أنّه قال: «إنّ عمّتي زينب كانت تؤدّي صلواتها من الفرائض والنوافل عند سير القوم بنا من الكوفة إلى الشام من قيام، وفي بعض المنازل كانت تصلّي من جلوس فسألتها عن سبب ذلك فقالت: أصلّي من جلوس لشدّة الجوع والضعف منذ ثلاث ليال، لأنّها كانت تقسّم ما يصيبها من الطعام على الأطفال لأنّ القوم كانوا يدفعون لكلّ واحد منّا رغيفًا واحدًا من الخبز في اليوم والليلة»[2].
القيادة الزينبيّة للثورة
تحرَّك موكب سبايا أهل البيت (عليهم السلام) من كربلاء المقدّسة نحو مدينة الكوفة وهو يقطع الصحاري، في الحادي عشر من المحرّم
[1] لجنة من علماء البحرين والقطيف، وفيّات الأئمّة(عليهم السلام)، ص441.
[2] المصدر نفسه.
60
49
الموعظة الثامنة: الحوراء زينب (عليها السلام) بعد كربلاء إلى الشهادة
سنة 61 هـ، وقد حمل جيش عمر بن سعد السبايا على أحلاس أقتاب الجمال بغير وطاء ولا غطاء، وساقوهم كما يساق سبي الترك والروم في أشدّ المصائب، وتتقدّمهم الرؤوس على الرماح، حتّى دخل الركب الكوفة في اليوم الثاني عشر من المحرَّم سنة 61 هـ، واقتسمت القبائل الرؤوس بينها...
عظمة الصبر وتحمّل المصيبة في عين الله: حينما حدثت الفاجعة الكبرى بمقتل أخيها الحسين (عليه السلام) خرجت السيّدة زينب تعدو نحو ساحة المعركة، تبحث عن جسد أخيها الحسين بين القتلى غير عابئة بالأعداء المدجّجين بالسلاح، فلمّا وقفت على جثمان أخيها الحسين وضعت يدها تحت جسده الطاهر المقطّع ورفعته نحو السماء وهي تدعو الله، قائلة: «اللهمّ تقبّل منّا هذا القربان»[1].
ويلكم يا أهل الكوفة: لمّا دخل موكب السبايا الكوفة، توجّه نحو قصر الإمارة، مُخترقًا جموع أهل الكوفة المحتشدين في الشوارع وهم يبكون لما حلَّ بالبيت النبويّ الكريم، قال بشير بن خزيم الأسدي: ونظرت إلى زينب بنت عليّ يومئذٍ، ولم أرَ خفرة والله أنطق منها، كأنّها تفرع من لسان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا، فارتدّت الأنفاس، وسكنت الأجراس، ثمّ قالت: «الْحَمْدُ للهِ، وَالصَّلاَةُ عَلىَ جَدِّي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الأَخْيَارِ، أمّا بَعْدُ: يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، يَا أَهْلَ الْخَتْلِ والْغَدْرِ، أَتَبْكُونَ؟! فَلَا رَقَأَتِ
[1] السيّد ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص84.
61
50
الموعظة الثامنة: الحوراء زينب (عليها السلام) بعد كربلاء إلى الشهادة
الدَّمْعَةُ، ولَا هَدَأَتِ الرَّنَّةُ، إِنَّمَا مَثَلُكُمْ كَمَثَلِ الَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ...َ أتَبْكُونَ وَتَنْتَحِبُونَ؟! إِيْ وَاللهِ فَابْكُوا كَثِيرًا، واضْحَكُوا قَلِيلًا، فَلَقَدْ ذَهَبْتُمْ بِعَارِهَا وَشَناَرِهَا... وَيْلَكُمْ يَا أَهلَ الْكُوفَةِ، أَتَدْرُونَ أَيَّ كَبِدٍ لِرَسُولِ اللهِ فَرَيْتُم؟! وَأيَّ كَرِيمَةٍ لَهُ أبْرَزتُمْ؟! وَأَيَّ دَم لَهُ سَفَكْتُمْ؟! وَأّيَّ حُرْمَةٍ لَهُ انتَهَكْتُمْ؟! لَقَدْ جِئْتُمْ بِهَا صَلعَاءَ عَنْقَاءَ سَوْدَاءَ فَقُمَاءَ... أَفَعَجِبْتُمْ أَنْ مَطَرَتِ السَّمَاءُ دَمًا، وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزىَ وَأَنْتُمْ لاَ تُنْصَرُونَ...»[1].
وخلاصة ما أرادت إيصاله إليهم:
إيضاح الصورة للرأي العامّ وإثارتهم على الأمويّين، وإظهار المصيبة الكبرى التي داهمت العالم الإسلاميّ بقتل ريحانة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتحميل الكوفيّين مسؤوليّة هذه الجريمة النكراء.
شجاعة عليّ وثبات الحسين في مواجهة ابن زياد: لمّا سأل ابن مرجانة عنها، فقال: مَن هذه التي انحازت ناحية ومعها نساؤها؟ أعرضت عنه احتقارًا واستهانة به، وكرّر السؤال فلم تجبه، فأجابته إحدى السيّدات: هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله). فقال لها: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم، وأبطل أحدوثتكم.
فأجابته (عليها السلام) بشجاعة أبيها محتقرة له، قائلة: «الحمْدُ للهِ الَّذي أَكْرَمَنَا بِنَبِيِّهِ، وَطَهَّرَنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيرًا، إِنَّمَا يَفْتَضِحُ الْفَاسِقُ وَيَكْذِبُ الْفَاجِرُ، وَهُوَ غَيْرُنَا يَابْنَ مَرْجَانَة»[2].
[1] السيّد محسن الأمين، لواعج الأشجان، ص201.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج45، ص116.
62
51
الموعظة الثامنة: الحوراء زينب (عليها السلام) بعد كربلاء إلى الشهادة
ما رأيت إلّا جميلًا: وكذلك عندما خاطبها مستهزئًا: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ فأجابته حفيدة الرسول بكلمات الظفر والنصر لها ولأخيها، قائلة: «ما رَأَيْتُ إِلّا جَمِيلًا، هؤُلاَءَ قَوْم كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْقَتَلَ، فَبَرَزُوا إِلى مَضَاجِعِهِمْ، وَسَيَجْمعُ اللهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، فَتُحَاجُّ وَتُخَاصَمُ، فَانْظُرْ لِمَنِ الْفَلَجُ يَومَئِذٍ، ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ يابْنَ مَرْجَانَةَ...»[1].
الدفاع عن الإمام والإمامة: وأدار ابن مرجانة بصره في بقيّة الأسرى من أهل البيت فوقع بصره على الإمام زين العابدين، وقد أنهكته العلّة، فسأله: مَن أنت؟ فقال (عليه السلام): عليّ بن الحسين... -بعد حوار مع الإمام- فالتفت إلى بعض جلّاديه، فقال له: خذ هذا الغلام واضرب عنقه، فانبرت العقيلة بشجاعة لا يرهبها سلطان، فاحتضنت ابن أخيها، وقالت لابن مرجانة: «يَابْنَ زِيَادٍ، إِنَّكَ لَمْ تُبْقِ مِنّا أَحَدًا، فَإنْ كنت عَزَمْتَ عَلى قَتْلِهِ فَاقْتُلْني مَعَهُ...»[2]. وبهر الطاغية وانخذل، وقال متعجّبًا: دعوه لها، عجبًا للرحم ودَّت أن تقتل معه.
أَمِنَ العدل يابن الطلقاء: (المواجهة مع رأس الظلم): لمّا وصلت قافلة السبايا إلى مجلس الطاغية يزيد بن معاوية في الشام... أظهر الطاغية فرحته الكبرى بإبادته لعترة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأخذ يهزّ أعطافه جذلان وراح يترنّم بالأبيات التي مطلعها:
لَيْتَ أَشْيَاخِي بِبَدرٍ شهدوا
جَزَعَ الْخَزْرَجِ مِـنْ وَقْعِ الأَسَلْ
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج45، ص116.
[2] أحمد بن أعثم الكوفي، كتاب الفتوح، ج5، ص123.
63
52
الموعظة الثامنة: الحوراء زينب (عليها السلام) بعد كربلاء إلى الشهادة
ولمّا سمعت العقيلة هذه الأبيات ألقت خطبتها الشهيرة بفصاحة أبيها عليّ (عليه السلام)وشجاعته وقد ضمّنتها أعنف المواقف لفرعون عصره يزيد، وممّا قالته (عليها السلام): «الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلىَ مُحَمّدَ وآلِهِ أَجْمَعِيَن، صَدَقَ اللهُ كَذَلكَ يَقُولُ: ﴿ثُمَّ كَانَ عَٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَٰـُٔواْ ٱلسُّوأَىٰ أَن كَذَّبُواْ بَِٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَستَهزِءُونَ﴾[1].
وَلَئِنْ جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِي مُخَاطَبَتَكَ، إِنِّي لأَسْتَصْغِرُ قَدْرَكَ، وَأَسْتَعْظِمُ تَقْرِيعَكَ، وَأَسْتَكْثِرُ تَوْبِيخَكَ، لَكِنِ الْعُيُونُ عَبْرىَ، وَالصُّدَورُ حَرّىَ. أَلاَ فَالعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِقَتْلِ حِزْبِ اللهِ النُّجبَاءِ بِحِزْبِ الشَّيْطَانِ الطُّلَقَاء.
أَمِنَ الْعَدْلِ يَابْنَ الطُّلَقَاءِ تَخْدِيرُكَ حَرَائِرَكَ وَإمَاءَكَ وَسوقَكَ بَنَاتِ رَسُولِ اللهِ سَبَايَا؟! قدْ هَتَكْتَ سُتورَهُنَّ، وَأَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ، تَحْدُو بِهِنَّ الأَعْدَاءُ مِنْ بَلَدِ إلى بلدٍ... وَيَتَصَفَّحُ وُجُوهَهُنَّ الْقَرِيبُ وَالبَعِيدُ...
اَللهُمَّ خُذْ بِحَقِّنَا، وَانتَقِمْ مِمَّنْ ظَلَمَنَا، وَاحْلُلْ غَضَبَكَ بِمَنْ سَفَكَ دِمَاءَنَا وَقَتَلَ حُمَاتَنَا. فَوَاللهِ مَا فَرَيْتَ إِلاَّ جِلْدَكَ، وَلا حَزَزْتَ إِلاَّ لَحْمَكَ، وَلَتَرِدَنَّ عَلى رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِمَا تَحَمَّلْتَ مِنْ سَفْكِ دِمَاءِ ذُرّيَّتِهِ، وَانْتَهكْتَ مِنْ حُرْمَتِهِ فِي عِتْرَتِهِ وَلُحْمَتِهِ...»[2].
[1] سورة الروم، الآية 10.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج45، ص134.
64
53
الموعظة التاسعة: مسلم بن عقيل سفير الحسين (عليه السلام)
الموعظة التاسعة: مسلم بن عقيل سفير الحسين (عليه السلام)
تعرّف شخصيّة مسلم بن عقيل، وأهمّ ما تمتاز به هذه الشخصيّة الفذّة من صفات قياديّة رائدة.
محاور الموعظة
نشأة مسلم
مسلم وأسرته
مسلم في حديث النبيّ (صلى الله عليه وآله)
مع عمّه أمير المؤمنين (عليه السلام)
مع سيّد الشهداء (عليه السلام)
من أهمّ مميّزات شخصيّته وموقفه
تصدير الموعظة
«سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصدّيقين، والزاكيات الطيّبات فيما تغتدي وتروح عليك يا مسلم بن عقيل»[1].
[1] الشيخ المفيد، المزار، ص177.
65
54
الموعظة التاسعة: مسلم بن عقيل سفير الحسين (عليه السلام)
من الشخصيّات البارزة في النهضة الحسينيّة والتي احتلّت مكانة خاصّة عند الإمام الحسين (عليه السلام) مبعوثه وسفيره لأهل الكوفة مسلم بن عقيل بن أبي طالب (رضوان الله عليه). وإنّ التعرّف على جوانب من حياة هذه الشخصيّة وأهمّ ما كانت تمتاز به من صفات وخصائص له الدور الكبير في استفادة الدروس والعبر سواء على مستوى الفرد، أو على مستوى الأمّة ومستقبلها.
نشأة مسلم
نشأ مسلم في بيت والده عقيل بن أبي طالب (رضوان الله عليه)، ذلك الرجل الذي كان يحبّه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقاتل معه وشاركه في حروبه ضدّ المشركين جنبًا إلى جنب أخيه عليّ بن أبي طالب (عليه السلام).
وبعد وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان قد كُفَّ بصره ومع ذلك كان صلبًا في مواجهة الأعداء فأرسل إلى أخيه الإمام عليّ (عليه السلام) يخبره باستعداده لتوجيهاته في مواجهة الأمويّين، فأجابه الإمام (عليه السلام) برسالة يعذره فيها ويطيّب خاطره.
وكان عقيل عالمًا بأنساب قريش وأيّامها، ومن الطبيعيّ أن يكون عالمًا حينئذٍ بصاحب النسب الصحيح من غيره، ومحاسن القوم ومساوئهم، لذا كان بعضهم يبغضه لأنّه كان يعدّ مساوئَهم.
وفي هذا البيت المحاط بالمجد من جنباته: جدّ كأبي طالب المدافع الأوّل عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)، وعمٌّ كأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، وأب صلب وحازم وشجاع كعقيل بن أبي طالب، نشأ مسلم
66
55
الموعظة التاسعة: مسلم بن عقيل سفير الحسين (عليه السلام)
نشأة الرجل الواعي، والعالم الخبير بأيّام العرب، والحروب والأجواء المحيطة في عصره.
مسلم وأسرته
اقترن مسلم برقيّة بنت الإمام عليّ (عليه السلام) وغيرها، وكان لديه أربعة أبناء أو خمسة على اختلاف بين المؤرّخين، قضى منهم اثنان بين يدي أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في كربلاء، كما قضى ثلاثة من إخوته وآخرين من بني عقيل.
وعندما أعذرهم الإمام الحسين (عليه السلام) وأحلَّهم من بيعته بعد شهادة مسلم، فقال لهم: «حسبكم من القتل بمسلم اذهبوا فقد أذنت لكم». أبوا ذلك، وقالوا له: إذًا ما يقول الناس وما نقول لهم؟ إنّا تركنا شيخنا وسيّدنا وبني عمومتنا خير الأعمام ولم نرمِ معهم بسهم ولم نطعن برمح ولم نضرب بسيف ولا ندري ما صنعوا؟ لا والله لا نفعل ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، نقاتل معك حتّى نرد موردك، فقبّح الله العيش بعدك!!
وكانت رقيّة زوجة مسلم مع أخيها الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء وقد شاهدت ما جرى على أخيها وأهل بيته وأصحابه وشاركتهم في تقديم التضحيات وسبيت فيمن سبي مع النساء.
ولوفاء هؤلاء فقد حفظ الإمام زين العابدين (عليه السلام) لهم ذلك، فكان يوليهم عناية خاصّة، ففي بعض الروايات أنّه (عليه السلام) كان يميل إلى ولد عقيل، فقيل له: ما بالك تميل إلى بني عمّك هؤلاء دون آل
67
56
الموعظة التاسعة: مسلم بن عقيل سفير الحسين (عليه السلام)
جعفر؟ فقال: «إنّي أذكر يومهم مع أبي عبد الله الحسين بن عليّ (عليهما السلام) فأرقّ لهم»[1].
مسلم في حديث النبيّ (صلى الله عليه وآله)
رُوي عن ابن عبّاس، أنّه قال: قال الإمام عليّ (عليه السلام) لرسول الله (صلى الله عليه وآله): «يا رسول الله، إنّك لتحبّ عقيلًا؟ قال: إي والله إنّي لأحبّه حبّين: حبًّا له، وحبًّا لحبّ أبي طالب له، وإنّ وَلَدَه لمقتول في محبّة ولدك، فتدمع عليه عيون المؤمنين، وتصلّي عليه الملائكة المقرّبون. ثمّ بكى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتّى جرت دموعه على صدره، ثمّ قال: إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي»[2].
مع عمّه أمير المؤمنين (عليه السلام)
في الفتوح لابن أعثم أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) جعل على ميمنته فيصفّين الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ومسلم بن عقيل، وعلى الميسرة محمّد بن الحنفيّة ومحمّد بن أبيّ وهاشم بن عتبة المرقال[3].
قال العلّامة السيّد عبد الرزّاق المقرّم M: إنّ رجلًا يراه عمّه أمير المؤمنين (عليه السلام) جديرًا بقيادة الجيش يوم صفّين فيجعله على الميمنة في صفّ ولديه الإمامين السبطين (عليهما السلام) وابن أخيه عبد الله بن جعفر، ويجده سيّد الشهداء (عليه السلام) قابلًا لأهليّة الولاية على أعظم
[1] ابن قولويه، كامل الزيارات، ص214.
[2] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص191.
[3] أحمد بن أعثم الكوفي، الفتوح، ج3، ص29.
68
57
الموعظة العاشرة: الإخلاص في نهضة كربلاء
حاضرة في العراق «الكوفة» فيحبوه بالنيابة الخاصّة في الدينيّات والمدنيّات، لا بدّ وأن يكون أعظم رجل في العقل والدين والأخلاق حتّى لا يقع الغمز والطعن فيمن يمثّل موقف الإمامة[1].
مع سيّد الشهداء (عليه السلام)
قال الشيخ المفيد في معرض ذكره لرسائل أهل الكوفة إلى الإمام الحسين (عليه السلام): وتلاقت الرسل كلّها عنده، فقرأ الكتب وسأل الرسل عن الناس، ثمّ كتب مع هانئ بن هانئ وسعيد بن عبد الله وكانا آخر الرسل: «بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن عليّ إلى الملأ من المسلمين والمؤمنين. أمّا بعد: فإنّ هانئًا وسعيدًا قدما عليّ بكتبكم، وكانا آخر من قدم عليّ من رسلكم، وقد فهمت كلّ الذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جلّكم: أنّه ليس علينا إمام فأقبل لعلّ الله أن يجمعنا بك على الهدى والحقّ. وإنّي باعث إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي، فإنّ كتب إليّ أنّه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجا والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم، أقدم عليكم وشيكًا إن شاء الله. فلعمري ما الإمام إلّا الحكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحقّ، الحابس نفسه على ذات الله، والسلام»[2].
بهذه الكلمات الصغيرة في حجمها، الكبيرة في معناها، أوضح الإمام الحسين (عليه السلام) مكانة مسلم عنده، فهو أخوه وابن عمّه وثقته من أهل بيته...
[1] المقرّم، الشهيد مسلم بن عقيل، ص41.
[2] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص38-39.
69
58
الموعظة التاسعة: مسلم بن عقيل سفير الحسين (عليه السلام)
من أهمّ مميّزات شخصيّته وموقفه
1. الجانب المعنويّ: جاء في زيارته: «السلام عليك أيها العبد الصالح».
2.الطاعة لله ورسوله والأئمّة (عليهم السلام): في زيارته أيضًا: «المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين (عليهم السلام)».
3. الشجاعة وتنفيذ المهمّة مع بقائه وحيدًا: وهذه صفة اكتسبها من عمّه أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي روي عنه قوله: «والله لو لقيتهم فردًا وهم ملأ الأرض ما باليت ولا استوحشت وإنّي من ضلالتهم التي هم فيها والهدى الذي نحن عليه لعلى ثقة وبيّنة ويقين وبصيرة وإنّي إلى لقاء ربّي لمشتاق ولحسن ثوابه لمنتظر»[1].
4. الصبر والثبات والتحمّل: حتّى النهاية والشهادة.
5. محبّته وعشقه ومواساته لسيّد الشهداء (عليه السلام): وهذا ما أشارت إليه الرواية عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) مخاطبًا لعقيل: «وإنّ ولده لمقتول في محبّة ولدك»[2]. وقد تجسّد هذا العشق والحبّ عندما دمعت عيناه وقد أخذ أسيرًا: فقيل له: إنّ من يطلب مثل الذي تطلب، إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبك. قال: إنّي والله ما لنفسي بكيت، ولا لها من القتل أرثي، وإن كنت لم أحبّ لها طرفة عين تلفًا، ولكن أبكي لأهلي المقبلين إليّ، أبكي للحسين (عليه السلام) وآل الحسين. وكذلك مواساته للحسين (عليه السلام) في القتل عطشًا، وحمل رأسه إلى يزيد في الشام.
[1] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص452.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج22، ص288.
70
59
الموعظة التاسعة: مسلم بن عقيل سفير الحسين (عليه السلام)
بكتك دمًا يابن عمّ الحسين
مدامع شيعتك السافحه
ولا برِحت هاطلات العيون
تُحييِّك غاديةً رائحه
لأنّك لم تُروَ من شَربةٍ
ثناياك فيها غدت طائحه
71
60
الموعظة العاشرة: الإخلاص في نهضة كربلاء
الموعظة العاشرة: الإخلاص في نهضة كربلاء
حثّ الناس على الإخلاص لله -تعالى-.
محاور الموعظة
قيمة العمل ببعده الباطنيّ
إخلاص الإمام الحسين (عليه السلام)
إخلاص أصحاب الإمام الحسين (عليه السلام)
تصدير الموعظة
﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلمَوتَ وَٱلحَيَوٰةَ لِيَبلُوَكُم أَيُّكُم أَحسَنُ عَمَلٗا﴾[1].
[1] سورة الملك، الآية 2.
72
61
الموعظة العاشرة: الإخلاص في نهضة كربلاء
قيمة العمل ببعده الباطنيّ
للعمل بعدان: ظاهريّ، وهو ما يظهر للناس من البناء والفخامة والكثرة، وباطنيّ، وهو الخلفيّة التي ينطلق منها العامل.
قيمة العمل عند الله -تعالى- تتحقّق بحسنه لا بشكله وكمّيّته ﴿ أَحسَنُ عَمَلٗا﴾ والعمل الحسن الذي ينطلق من الإخلاص لله -تعالى-.
فعن الإمام الصادق (عليه السلام): «ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله»[1].
قصّة وتعليق
دخل فقير إلى مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وطلب من المسلمين صدقة فلم يعطه أحد، فرفع يديه إلى السماء، وقال: اللهم إنّي دخلت مسجد نبيّك ولم يتصدّق عليّ أحد من المسلمين، وكان الإمام علي (عليه السلام) يصلّي، فأشار إلى الفقير بيده أثناء الصلاة وناوله الخاتم الذي كان يلبسه، فأنزل الله -تعالى- في هذه الأثناء على خاتم رسله (صلى الله عليه وآله): ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم رَٰكِعُونَ﴾[2].
وقد اعتبر بعض من قرأ هذه القصّة أنّ الإمام علي (عليه السلام) لم يتصدّق بخاتم عاديّ؛ لأنّه لا يعقل نزول هكذا آية عظيمة بخاتم لا قيمة كبيرة له، فقالوا: إنّ قيمة خاتم علي (عليه السلام) هذا تعادل خراج سوريا والشام.
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج1، ص166.
[2] سورة المائدة، الآية 55.
73
62
الموعظة العاشرة: الإخلاص في نهضة كربلاء
ويعلّق الشهيد المطهّري (يرحمه الله) بأنّ الإمام عليًا لم يكن ليلبس خاتمًا كهذا، وفي المدينة فقراء يئنّون، إنّ ما استنزل الآية ليس قيمة مادّيّة، بل هو الإخلاص الذي ملأ قلب أمير المؤمنين (عليه السلام).
إخلاص الإمام الحسين (عليه السلام)
لثورة كربلاء بعد ظاهريّ كبير، فهي التي «أولدت الإسلام ولادة ثانية» كما عبّر الإمام الخمينيّ (قدس سره).
«ولولا ثورة الحسين لم يبقَ للإسلام من أثر» كما عبّر عالم الأزهر الكبير الشيخ محمّد عبده.
لكن منطلق الإمام الحسين (عليه السلام) في ثورته كان حبّه للَّه -تعالى- وإخلاصه له. وهذه خصيصة مهمّة؛ فعندما يقول الإمام (عليه السلام): «إنّي لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا ظالمًا ولا مفسدًا»؛ فمعناه أنّ ثورتي لم تكن للرياء والغرور، وليست فيها ذرّة من الظلم والفساد، بل «إنّما خرجت لطب الإصلاح في أمّة جدّي»؛ أي إنّ هدفي هو الإصلاح فقط ولا غير.
إخلاص أصحاب الإمام الحسين (عليه السلام)
كان الإمام الحسين (عليه السلام) يعرف عدم إمكانيّة الانتصار العسكريّ، وكان يعلم أنّه يقوم مع أصحابه بعمليّة استشهاديّة كبرى، وقد جمعهم الإمام الحسين (عليه السلام) ليلة العاشر، وقال لهم: «... وقد نزل بي ما قد ترون، وأنتم في حل من بيعتي، ليست لي في أعناقكم بيعة، ولا لي عليكم ذمّة، وهذا الليل قد غشيكم، فاتّخذوه جملا»[1].
[1] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص220.
74
63
الموعظة العاشرة: الإخلاص في نهضة كربلاء
وعبَّرت مواقف الأصحاب عن ذلك الإخلاص الكبير:
-سعيد بن عبد اللَّه الحنفيّ: «واللَّه، لو علمت أنّي أقتل، ثمّ أحيا، ثمّ أحرق حيًّا، ثمّ أذرى، يفعل ذلك بي سبعين مرّة لما فارقتك حتّى ألقى حمامي دونك».
-زهير بن القين: «واللَّه وددت أنّي قتلت، ثمّ نشرت، ثمّ قتلت حتّى أُقتل كذا ألف مرّة، وإنّ اللَّه -عزَّ وجلّ- يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك».
إنّهم حقًّا كما عبّر أمير المؤمنين (عليه السلام): «عشّاق شهداء، لا يسبقهم من كان قبلهم، ولا يلحقهم من بعدهم»[1].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج41، ص295.
75
64
الموعظة الحادية عشرة: مظاهر العِزّة في مدرسة كربلاء
الموعظة الحادية عشرة: مظاهر العِزّة في مدرسة كربلاء
إبراز بعض نماذج العزّة في مواقف أهل بيت العصمة (عليهم السلام)، والتي تساهم في تعليم الأُمّة عدم الرضوخ والاستسلام.
محاور الموعظة
عزّة المؤمن
نماذج مِن مواقف العزّة
تصدير الموعظة
﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلعِزَّةُ جَمِيعًا﴾[1].
[1] سورة فاطر، الآية 10.
76
65
الموعظة الحادية عشرة: مظاهر العِزّة في مدرسة كربلاء
تتجلّى مَظاهر العِزّة يوم الطفّ -بِأبهى صُوَرِها- في خطابات الإمام الحسين (عليه السلام). ولعلّ أوّل تصريحٍ ظهر له -حين بدأ حركته المباركة- عندما عُرِضَتْ عليه بَيْعة يزيد بن معاوية، فَقال لِأمير المدينة: «يا أمير، إنّا أهل بيت النبوّة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، ويزيد رجلٌ فاسق، شاربٌ للخمر، قاتلٌ للنفْس المحترمة، ومِثلي لا يبايع مثله»[1]. ويكفي في قوله: مثلي ومثله أنّه (عليه السلام) قدّم نفْسه مَجمعًا للقيم والمبادئ ومعاني العزّة والإباء كلّها، وقدّم يزيد مَجمعًا للفساد والظلم والرذيلة.
عزّة المؤمن
وَرَدَ عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ الله فَوَّض إلى المؤمن أمرَه كلّه، ولم يفوّض له أن يكون ذليلًا... فالمؤمن يكون عزيزًا، ولا يكون ذليلًا، فإنّ المؤمن أعزّ مِن الجبل، يستقلّ منه بالمعاول، والمؤمن لا يستقلّ مِن دينه بِشيء»[2]؛ وفي هذا إشارة كافية إلى أنّ قضيّة العزّة والإباء والكرامة ليست أمرًا اختياريًّا، بل إنّها مسألة ينبغي الالتزام والتمسُّك بها، والثبات عليها، ولا يجوز -بِأيّة حالٍ- التفريط فيها أو تضييعها.
نماذج مِن مواقف العزّة
مِن المهمّ الإشارة -أوّلًا- إلى أنّ أيّة حالٍ يكون عليها الإنسان، لا ينبغي أن تؤثّر في مواقفه المبدئيّة -كما هو حال أغلب الناس-؛ فأهل بيت العصمةِ يَقِفون مواقف العزّة والإباء وَهُم في أقسى
[1] البحرانيّ، العوالم، ص174.
[2] الشيخ الطوسيّ، تهذيب الأحكام، ج6، ص179.
77
66
الموعظة الحادية عشرة: مظاهر العِزّة في مدرسة كربلاء
تتجلّى مَظاهر العِزّة يوم الطفّ -بِأبهى صُوَرِها- في خطابات الإمام الحسين (عليه السلام). ولعلّ أوّل تصريحٍ ظهر له -حين بدأ حركته المباركة- عندما عُرِضَتْ عليه بَيْعة يزيد بن معاوية، فَقال لِأمير المدينة: «يا أمير، إنّا أهل بيت النبوّة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، ويزيد رجلٌ فاسق، شاربٌ للخمر، قاتلٌ للنفْس المحترمة، ومِثلي لا يبايع مثله»[1]. ويكفي في قوله: مثلي ومثله أنّه (عليه السلام) قدّم نفْسه مَجمعًا للقيم والمبادئ ومعاني العزّة والإباء كلّها، وقدّم يزيد مَجمعًا للفساد والظلم والرذيلة.
عزّة المؤمن
وَرَدَ عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ الله فَوَّض إلى المؤمن أمرَه كلّه، ولم يفوّض له أن يكون ذليلًا... فالمؤمن يكون عزيزًا، ولا يكون ذليلًا، فإنّ المؤمن أعزّ مِن الجبل، يستقلّ منه بالمعاول، والمؤمن لا يستقلّ مِن دينه بِشيء»[2]؛ وفي هذا إشارة كافية إلى أنّ قضيّة العزّة والإباء والكرامة ليست أمرًا اختياريًّا، بل إنّها مسألة ينبغي الالتزام والتمسُّك بها، والثبات عليها، ولا يجوز -بِأيّة حالٍ- التفريط فيها أو تضييعها.
نماذج مِن مواقف العزّة
مِن المهمّ الإشارة -أوّلًا- إلى أنّ أيّة حالٍ يكون عليها الإنسان، لا ينبغي أن تؤثّر في مواقفه المبدئيّة -كما هو حال أغلب الناس-؛ فأهل بيت العصمةِ يَقِفون مواقف العزّة والإباء وَهُم في أقسى
[1] البحرانيّ، العوالم، ص174.
[2] الشيخ الطوسيّ، تهذيب الأحكام، ج6، ص179.
77
66
الموعظة الحادية عشرة: مظاهر العِزّة في مدرسة كربلاء
حالات الاضطهاد والضعف والتعذيب، التي تُضعف الآخرين ممّن قد يستسلمون فيها، ومِن هذه المواقف:
1. قول الحسين (عليه السلام) لِقادة معسكر الأعداء -حين هدّدوه بالقتل أو النزول على بَيْعة يزيد- إنّ هذه البَيْعة إنّما تنسجم مع أهل الذِلّة وحياة العبيد: «لا أعطيكم بِيَدي إعطاء الذليل، ولا أُقرّ لكم إقرار العبيد»[1].
فهذه هي العِزّة التي خَلَّدَتْ مفاهيم الإسلام، وخلَّدَتْ أحدَ أكبر المفاهيم السماويّة، وهو عدم الرضوخ للظالم -مهما كان عاتيًا-، وعدم الاستسلام له -مهما كانت القُوّة بسيطة-.
2. تحدّي الإمامُ زين العابدين (عليه السلام) -وهو مأسورٌ، مُكبّلٌ بالقيود، والحبل في عنقه-، لِيزيدَ بن معاوية، وإصراره على مبادئه، وتبيانه الحقائق للناس، غيرَ آبهٍ بِتهديد يزيد له بالقتل، قائلًا له: «أبِالموت تُهدّدني يابن الطُلَقَاء؟ إنّ القتْلَ لنا عادة، وكرامتنا مِن الله الشهادة»[2].
3. موقف سيّدتنا زينب (عليها السلام) في وجه الطاغية يزيد، إذ وقفَتْ -بكلّ جُرأة وعنفوان-، وقد أعيَتْها مسيرة السبْي وفَقْد الأحبّة والآل، وقالت له أمام الملأ مِن قومه: «فَكِدْ كيْدك، واسْعَ سَعْيَك، وناصِبْ جهدَك، فَوَالله، لا تمحو ذِكرنا، ولا تميت وَحْينا، ولا تَدحض عنك عارَها. وهل رأيكَ إلّا فَنَدَ، وأيّامُك إلّا عدد، وجَمْعك إلّا بَدَد؟»[3].
4. مِن مواقف العِزّة ما وردَ مِن أنّ معاوية بن أبي سفيان كَتَب إلى
[1] المقرّم، مقتل الحسين، ص280.
[2] البحرانيّ، العوالم، ص385.
[3] المصدر نفسه، ص435.
78
67
الموعظة الحادية عشرة: مظاهر العِزّة في مدرسة كربلاء
الإمام الحسن الزكيّ (عليه السلام): يا أبا محمّد، أنا خيرٌ مِنك؛ لأنّ الناس أجمعَتْ عَليَّ، ولم تُجمِع عليك. ويعني بذلك: أنّني، عندما أصبحَ الحُكم بِيَدي أذعنَت الناس كلّها، وأنتَ، عندما كان الحُكم بِيَدك حدثَتْ خلافات. فأجابه الإمام الحسن (عليه السلام): «هيهات! هيهات! لَشرّ ما عَلَوْتَ يابن آكلة الأكباد. المجتمعون عليك رجُلان: بين مطيعٍ ومُكرَه؛ فالطائع لكَ عاصٍ لله؛ ﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِن بَعدِ إِيمَٰنِهِ إِلَّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنُّ بِٱلإِيمَٰنِ﴾[1]، والمكرَهُ معذور بِكتاب الله. وحاشَ لله أن أقول: أنا خيرٌ مِنك، فلا خيرَ فيك. ولكنّ الله برّأني مِن الرذائل، كما برّأَك مِن الفضائل»[2].
5. مِن مواقف العزّة أيضًا قول الإمام الحسين (عليه السلام) يوم الطفّ لمعسكر الأعداء: «ألا وإنّ الدعيّ ابن الدعيّ قد ركَز بين اثنتيْن: بين السِلّة والذِلّة، وهيهات منّا الذلّة! يأبى اللهُ لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، وحجورٌ طابَتْ وطهُرَتْ، وأنوفٌ حَميّة، ونفوس أبيّة، مِن أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام»[3].
فقوله: هيهات منّا الذلّة موقفٌ خالدٌ وأبديّ، لا نزال نُردّده، وسنبقى؛ لأنّه شعارٌ مِن شأنه أن يطرد مظاهر الذلّة كافّة عن الأُمّة، ويُكسبها كلّ ما مِن شأنه أن يرفعها في معارج الرقيّ والمجد.
[1] سورة النحل، الآية 106.
[2] ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج4، ص22.
[3] السيّد المرعشيّ، شرح إحقاق الحقّ، ج11، ص639.
79
68
الموعظة الثانية عشرة: البصيرة عند الإمام الحسين (عليه السلام)
الموعظة الثانية عشرة: البصيرة عند الإمام الحسين (عليه السلام)
الحثّ على التبصّر في الأمور وإدراك خفاياها وعدم الاستعجال في اتّخاذ القرارات المبنيّة على النظرة السطحيّة.
محاور الموعظة
البصيرة وعوامل تنميتها
معنى البصير
الدعوة إلى التبصّر
بين البصر والبصيرة
عاقبة عدم التبصّر
أبصر الناس
تصدير الموعظة
﴿قُل هَٰذِهِۦ سَبِيلِي أَدعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلمُشرِكِينَ﴾[1].
[1] سورة يوسف، الآية 108.
80
69
الموعظة الثانية عشرة: البصيرة عند الإمام الحسين (عليه السلام)
البصيرة وعوامل تنميتها
البصيرة قوّة خفيّة أو ملكة وهبها الله للإنسان لإدراك حقائق الأشياء، أو إدراك الجوانب الخفيّة من الموضوعات، وقد ذكر العلماء عوامل عديدة تساعد في تنمية البصيرة عند الإنسان منها:
أوّلًا: دراسة الموضوعات دراسة شاملة حتّى يصل الفرد إلى إحاطة وإلمام بكلّ موضوع.
ثانيًا: النظر إلى الموضوعات نظرة تفصيليّة.
ثالثًا: معرفة الفوارق بين الموضوعات.
رابعًا: النظرة النقديّة للموضوع وهو السعي لمعرفة محاسنه ومعايبه.
خامسًا: التجارب والممارسة.
وإذا كان المراد تنمية البصيرة في الدين الإسلاميّ، فإنّ هذا الموضوع يحتاج إلى عامل آخر يزيد عن كلّ تلك العوامل في الأهمّيّة ألا وهو عامل الوجدان والحبّ لهذا الدين. فالإسلام دين الفطرة التي تنطبق تمام الانطباق مع الوجدان. والإسلام دين حيّ لا يمكن أن يعطي خفاياه وجوانب من حقيقته إلّا لمن أحبّه وأولاه ولاءً خاصًّا.
معنى البصير
والبصير هو الإنسان الذي يتأمّل في كلّ ما يدركه من حوله ليكتشف خفاياه وأسراره، ويعمل وفق ما وصل إليه، فعن الإمام عليّ (عليه السلام): «فإنّما البصير من سمع فتفكّر، ونظر فأبصر، وانتفع بالعبر، ثمّ سلك جددًا واضحًا يتجنّب فيه الصرعة في المهاوي»[1].
[1] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص213.
81
70
الموعظة الثانية عشرة: البصيرة عند الإمام الحسين (عليه السلام)
الدعوة إلى التبصّر
وشدّد القرآن الكريم على ضرورة التبصّر في الأمور معتبرًا أنّ العمى الحقيقيّ هو الناشئ من عدم التبصّر لا من عدم البصر، قال -تعالى-: ﴿أَفَلَم يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرضِ فَتَكُونَ لَهُم قُلُوبٞ يَعقِلُونَ بِهَا أَو ءَاذَانٞ يَسمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعمَى ٱلأَبصَٰرُ وَلَٰكِن تَعمَى ٱلقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ﴾[1].
وفي الرواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ليس الأعمى من يعمى بصره، إنّما الأعمى من تعمى بصيرته»[2].
عاقبة عدم التبصّر
وعدم التبصّر ليس أمرًا يمكن للمرء فعله أو تركه على حدٍّ سواء، بل إنّ عدم التبصّر من شأنه أن يوقع المرء في المهالك ويجعل مأواه النار في الآخرة، قال -تعالى-: ﴿وَلَقَد ذَرَأنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلجِنِّ وَٱلإِنسِ لَهُم قُلُوبٞ لَّا يَفقَهُونَ بِهَا وَلَهُم أَعيُنٞ لَّا يُبصِرُونَ بِهَا وَلَهُم ءَاذَانٞ لَّا يَسمَعُونَ بِهَا أُوْلَٰئِكَ كَٱلأَنعَٰمِ بَل هُم أَضَلُّ أُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلغَٰفِلُونَ﴾[3].
بين البصر والبصيرة
والبصيرة وإن كانت مشتقّةً من البصر لغةً إلّا أنّها أرقى مقامًا وأرفع شأنًا بل لعلّ إدراكات الإنسان كلّها وعلى رأسها البصر ليست بذي أهمّيّة ما لم تقترن بالبصيرة والوعي الذي يمكّن الإنسان من استخلاص العبر واتخاذ المواقف الحكيمة، فعن الإمام عليّ (عليه السلام):
[1] سورة الحجّ، الآية 46.
[2] المتّقي الهنديّ، كنز العمّال، ج1، ص243.
[3] سورة الأعراف، الآية 179.
82
71
الموعظة الثانية عشرة: البصيرة عند الإمام الحسين (عليه السلام)
«نظر البصر لا يجدي إذا عميت البصيرة»[1].
وعنه (عليه السلام): «لَيْسَتِ [الرُّؤْيَةُ] الرَّوِيَّةُ كَالْمُعَايَنَةِ مَعَ الْإِبْصَار، فَقَدْ تَكْذِبُ الْعُيُونُ أَهْلَهَا، وَلَا يَغُشُّ الْعَقْلُ مَنِ اسْتَنْصَحَه»[2].
وعنه (عليه السلام): «فقد البصر أهون من فقدان البصيرة»[3].
أبصر الناس
قد يخفى على الإنسان الكثير من أبعاد ما يجري حوله، لكن ما لا يمكن أن يخفى عنه نفسه التي بين جنبيه، وقد عبّر الله عن ذلك بقوله -تعالى-: ﴿بَلِ ٱلإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفسِهِ بَصِيرَةٞ ١٤ وَلَو أَلقَىٰ مَعَاذِيرَهُ﴾[4]، فالإنسان يعلم تمامًا أنّ كلّ ما يعزّي نفسه به من أعذار ليست سوى أوهام يقنع نفسه بها ليبرّر تقصيرها وأنّ عليه أن يتبصّر نفسه جيدًا ويتفحّصها ويكتشف عيوبها ويصلح ما فسد منها.
الإمام عليّ (عليه السلام): «أبصر الناس من أبصر عيوبه وأقلع عن ذنوبه»[5].
بصيرة الإمام الحسين (عليه السلام): ولعلّ أبرز تجلّيات البصيرة عند الإمام الحسين إدراكه خطورة ما آلت إليه الأمور على المستوى السياسيّ الذي أصاب الأمّة وأنّه لا يمكن الإصلاح إلّا بحركة استشهاديّة كبرى،
[1] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص497.
[2] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص525.
[3] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص266.
[4] سورة القيامة، الآيتان 14 - 15.
[5] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص120.
83
72
الموعظة الثانية عشرة: البصيرة عند الإمام الحسين (عليه السلام)
والأداء المتميّز الذي استطاع من خلاله إبراز وفضح حقيقة النظام الأمويّ ومدى إجرامه ودمويّته.
بصيرة الأصحاب: وتتجلّى بصيرتهم في إدراكهم البعد التاريخيّ الذي أراده الحسين (عليه السلام) من المواجهة وفي إصرارهم على البقاء مع إمامهم رغم عرضه عليهم بالتخلّي عن الركب وفي الكثير من أدائهم وسلوكهم خلال بقائهم في كربلاء.
ويصف الإمام الصادق (عليه السلام) العبّاس، بقوله: «كان عمّنا العبّاس نافذ البصيرة صلب الإيمان جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاءً حسنًا ومضى شهيدًا»[1].
[1] أبو مخنف الأزديّ، مقتل الحسين (عليه السلام)، ص176.
84
73
الموعظة الثالثة عشرة: تَجَلّي الإيثار في كربلاء
الموعظة الثالثة عشرة: تَجَلّي الإيثار في كربلاء
بيان مقام هذه الفضيلة السامية بين الفضائل، ودرجتها في الدنيا والآخرة، وحثّ الناس على التحلّي بها.
محاور الموعظة
مَنزلة الإيثار
فَضْل المُؤْثِرين
إيثار عليّ (عليه السلام)
الإيثار في كربلاء
تصدير الموعظة
﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلإِيمَٰنَ مِن قَبلِهِم يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيهِم وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِم حَاجَةٗ مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم وَلَو كَانَ بِهِم خَصَاصَةٞ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفسِهِۦ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلمُفلِحُونَ﴾[1].
[1] سورة الحشر، الآية 9.
85
74
الموعظة الثالثة عشرة: تَجَلّي الإيثار في كربلاء
تُعَدُّ فضيلة الإيثار -كما وَرَد في النصوص- أعلى المكارم، وشيمة الأخيار، وسجيّة الأبرار، وأحسن الإحسان، وأعلى مراتب الإيمان، وأعلى مراتب الكَرَم، وأفضل الشِيَم، وأفضل عبادة، وأَجَلّ سيادة، وزينة الزهد، وأفضل السخاء... وكَفى بالإيثار مَكرُمة أنّه غاية المكارم، وبهِ يُسترَقّ الأحرار وتُملك الرقاب؛ لذا كان مِن أفضل الاختيار التحلّي بالإيثار، وحَمْل النفوس عليه.
وقد وَرَد عن الإمام عليّ (عليه السلام): «عامِل سائِر الناس بالإنصاف، وعامِل المؤمنين بالإيثار»[1].
مَنزلة الإيثار
عن النبيّ موسى (عليه السلام): «يا ربّ، أَرِني درجات محمّد وأُمّته»، قال: «يا موسى، إنّك لن تطيق ذلك، ولكن أُريك مَنزلةً مِن منازله، جليلة عظيمة، فَضَّلْته بها عليكَ وعلى خلقي جميعهم...» فَكَشَفَ له عن مَلَكوت السماء، فَنَظَر إلى منزلةٍ كادَتْ تَتْلف نفْسه مِن أنوارها وقُرْبِها مِن الله -عزَّ وجلَّ-. قال: «يا ربّ، بماذا بلَّغتَه إلى هذه الكرامة؟» قال -عزّ وجلّ-: «بِخُلُق اختَصَصْته به مِن بَيْنهم، وهو الإيثار. يا موسى، لا يأتيني أحدٌ منهم قد عَمِل به وقتًا مِن عُمر، إلّا استحيَيْتُ مِن مُحاسبته، وبَوَّأْته مِن جَنّتي حيث يشاء»[2].
[1] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص16.
[2] المصدر نفسه.
86
75
الموعظة الثالثة عشرة: تَجَلّي الإيثار في كربلاء
وَرَوى أبو الطُفَيْل أنّ عليًّا (عليه السلام) اشترى ثَوْبًا، فأَعجَبَه، فتَصَدّق به، وقال: «سَمعتُ رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: مَن آثر على نفْسه، آثَرَه اللهُ يوم القيامة الجنّة»[1].
وعن الإمام الباقر (عليه السلام): «لله -عزَّ وجلَّ- جنّة لا يَدخلها إلّا ثلاثة:... ورَجُلٌ آثَر أخاه المؤمن في الله -عزَّ وجلَّ-»[2].
فَضْل المُؤْثِرين
1. صِفة أهل الكمال
عن الإمام الصادق (عليه السلام) -في وَصْف الكاملين مِن المؤمنين-: «هُم البَرَرة بالإخوان في حالِ العُسْر واليُسْر، المُؤْثِرون على أنفُسِهم في حالِ العُسْر، كذلك وَصَفَهم الله، فَقال: ﴿وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم﴾»[3].
2. أفضل الناس
عن الإمام عليّ (عليه السلام): «مَن آثَر على نفسِه، استحقَّ اسمَ الفضيلة»[4].
3. مُنتهى المروءة
عنه (عليه السلام): «مَن آثَر على نفْسه، بالَغَ في المروّة»[5].
[1] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج7، ص250.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص142.
[3] الميرزا محمد تقي الأصفهاني، مكيال المكارم، ج2، ص295.
[4] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص435.
[5] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص18.
87
76
الموعظة الثالثة عشرة: تَجَلّي الإيثار في كربلاء
وقد مَدَح الله -عزَّ وجلَّ- صاحبَ القليل، فقد رَوى أبو بصير عن أحدهما (الباقر أو الصادق (عليهما السلام))، حين سأَلَه: أيّ الصدقةِ أفضل؟ قال: «جُهْد المُقِلّ، أما سمعْتَ قَول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم﴾ ترى ها هُنا فضلًا؟»[1].
وعن الإمام الصادق (عليه السلام): «ليْس البِرّ بالكثرة، وذلك أنّ الله -عزَّ وجلَّ- يقول في كتابه: ﴿وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم﴾، ومَن عَرَفه الله -عزَّ وجلَّ- بِذلك أَحَبّه الله»[2].
وقد أُهْدِيَ رجلٌ مِن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأسَ شاة، فقال: إنّ أخي فلانًا وعياله أَحْوَج إلى هذا مِنّا. فَبَعَثَ به إليهم. فلمْ يَزَلْ يبْعث به واحدًا إلى آخر، حتّى تداوَلَها أهل سَبْعة أبيات، حتّى رَجعَتْ إلى الأوّل، فَنَزِلَتْ ﴿وَيُؤثِرُونَ﴾[3].
ورَوَتْ عائشة: «ما شَبِع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أيّام مُتوالية، حتّى فارق الدنيا. ولَوْ شاءَ لَشَبِع، ولكنّه كان يُؤْثِر على نفْسه»[4].
إيثار عليّ (عليه السلام)
بات عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) على فِراش رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فَأَوْحى الله إلى جبرئيل وميكائيل (عليهما السلام): «إنّي آخيتُ بَينكما، وجَعَلْتُ عُمر الواحد منكما أطول مِن عُمر الآخر، فأيّكما يُؤْثِر صاحبَه بالحياة؟» فاختار
[1] الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال، ص142.
[2] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص18.
[3] السيّد البروجرديّ، جامع أحاديث الشيعة، ج8، ص369.
[4] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص18.
88
77
الموعظة الثالثة عشرة: تَجَلّي الإيثار في كربلاء
كِلاهما الحياة. فَأوْحى الله -عزَّ وجلَّ- إليهما: «أفلا كُنتُما مِثل عليّ بن أبي طالب؟ آخيْتُ بينه وبين محمّد، فَباتَ على فِراشه يَفْديه بِنَفْسه، فيُؤْثِره بالحياة...»، فأنزل الله -تعالى-: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشرِي نَفسَهُ ٱبتِغَاءَ مَرضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلعِبَادِ﴾[1].
الإيثار في كربلاء
عند الإيثار على النفْس تَتَبيّن جواهر الكُرَماء ومَعادن الناس وحقائق النفوس؛ وهذا ما تجلّى -بِأبهى صُوَره- في كربلاء.
ويُمكِن استخلاص بَعض مشاهد الإيثار:
1. إيثار الأصحاب والآل للحسين (عليه السلام)
وذلك بِتَقَدُّمهم للشهادة بين يديْه، وإيثاره بالبقاء حيًّا -ولو لِوَقت قصير-؛ هذا الإيثار الذي كان خلاصة عشقهم للحسين (عليه السلام)، والذي لم يقووا معه على أنْ يَرَوا الحسين شهيدًا قَبلَهم.
2. إيثار الأصحاب للآل
في الرواية أنّ الآل كانوا يُنافسون الأصحاب على التقدُّم، والأصحاب يَمنعونهم، حتّى يُقدِموا قَبْلَهم، فاستُشهِدوا جميعًا.
3. إيثار العبّاس
مِن أروع مشاهد الإيثار وهو يرمي الماء مِن يديْه، مُؤْثرًا عطش الحسين على عطشه، فَحَمَل إليه الماء قَبل أن يَشْرَب منه.
[1] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص18.
89
78
الموعظة الرابعة عشرة: دروس من عاشوراء
الموعظة الرابعة عشرة: دروس من عاشوراء
بيان بعض المفاهيم العاشورائيّة التي يمكن استفادة الدروس والعبر المتعدّدة منها.
محاور الموعظة
المواجهة مع الطاغوت
إحياء سنّة النبيّ (صلى الله عليه وآله) وسيرته
إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
رفض الذلّ
خطر الخيانة والانكفاء السياسيّ
إنّ الحقّ هو المنتصر في النهاية
تصدير الموعظة
الإمام الخمينيّ (قدس سره): «إنّ كلّ ما لدينا من عاشوراء».
90
79
الموعظة الرابعة عشرة: دروس من عاشوراء
تطفح كربلاء بالكثير من المفاهيم والمعاني السامية التي يمكن الوقوف عندها واستخراج مجموعة من الدروس التي تصلح أن تكون منهاجًا يُتّبع في الحياة، واستخلاص العبر التي تسلّط الضوء على بعض السلبيّات التي يمكن من خلالها التنبّه لمواضع الخلل وإصلاحها لتكون لنا عبرة وموعظة.
وسنحاول أن نقف على مجموعة من هذه المفاهيم دون أن نحصيها بأجمعها:
المواجهة مع الطاغوت
وهذه من وظائف الأنبياء (عليهم السلام)، قال -تعالى- مخاطبًا نبيّه موسى (عليه السلام): ﴿ٱذهَب إِلَىٰ فِرعَونَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾[1]. وجعلها -تعالى- من صفات المؤمنين: ﴿فَمَن يَكفُر بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱستَمسَكَ
بِٱلعُروَةِ ٱلوُثقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[2].
وعن الإمام الحسين (عليه السلام) في بعض خطبه: «أيّها الناس إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من رأى سلطانًا جائرًا مستحلًّا لحرم الله ناكثًا لعهد الله مخالفًا لسنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغيَّر عليه بفعل ولا قول كان حقًّا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطّلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله وأنا أحقّ من غيَّر»[3].
[1] سورة طه، الآية 24.
[2] سورة البقرة، الآية 256.
[3] الطبريّ، تاريخ الطبريّ، ج4، ص304.
91
80
الموعظة الرابعة عشرة: دروس من عاشوراء
إحياء سنّة النبيّ (صلى الله عليه وآله) وسيرته
«وإنّي لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا مفسدًا ولا ظالمًا وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي (صلى الله عليه وآله) أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) فمن قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ، ومن ردّ عليّ هذا أصبر حتّى يقضي الله بيني وبين القوم بالحقّ وهو خير الحاكمين»[1].
وهذا ما نجده في سيرة الأئمّة (عليهم السلام) جميعًا، فعندما طلب المأمون من الإمام الرضا (عليه السلام)أن يصلّي صلاة العيد وكان الإمام (عليه السلام) يأبى، فلمّا ألحَّ عليه المأمون أرسل إليه الإمام (عليه السلام): «إن أعفيتني فهو أحبّ إليّ، وإن لم تُعفني خرجت كما خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)»، فقال له المأمون: أخرج كيف شئت... فخرج الإمام (عليه السلام) ذلك الخروج المهيب الذي اضطرّ معه المأمون إلى إرجاع الإمام (عليه السلام) قبل وصوله إلى الصلاة[2].
وكذلك صاحب الزمان(عجل الله تعالى فرجه) عندما يظهر كما جاء في دعاء العهد المرويّ عن الإمام الصادق (عليه السلام): «... واجعله اللهمّ مفزعًا لمظلوم عبادك، وناصرًا لمن لا يجد له ناصرًا غيرك، ومجدّدًا لما عطّل من أحكام كتابك ومشيّدًا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيّك (صلى الله عليه وآله)...»[3].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج44، ص329.
[2] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص264.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج53، ص96.
92
81
الموعظة الرابعة عشرة: دروس من عاشوراء
إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وقد تكرّر ذلك في كلام الإمام الحسين (عليه السلام)، كقوله: «أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر»[1].
وعنه (عليه السلام): «ألا ترون أنّ الحقّ لا يعمل به وأنّ الباطل لا يُتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقًّا فإنّي لا أرى الموت إلّا شهادة ولا الحياة مع الظالمين إلّا برمًا»[2].
وقد أعطى في ذلك درسًا عمليًّا، مفاده: أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بدّ من القيام به لإصلاح المجتمع حتّى لو أدّى إلى القتل أحيانًا.
رفض الذلّ
إنّ الله -تعالى- لا يرضى للمؤمن أن يكون ذليلًا، قال -سبحانه-: ﴿وَلِلَّهِ ٱلعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلمُؤمِنِينَ﴾[3]، وعن الإمام الحسين (عليه السلام): «ألا وإنّ الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين اثنتين السلّة والذلّة، وهيهات منّا الذلّة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وحجور طهرت ونفوس أبيّة وأنوف حميّة من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإنّي زاحف بهذه الأسرة مع قلّة العدد وكثرة العدوّ وخذلة الناصر»[4].
وقوله (عليه السلام): «هيهات منّا الذلّة»، صار شعارًا لجميع أحرار العالم.
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج44، ص329.
[2] الطبريّ، تاريخ الطبريّ، ج4، ص305.
[3] سورة المنافقين، الآية 8.
[4] ابن نما الحليّ، مثير الأحزان، ص40.
93
82
الموعظة الرابعة عشرة: دروس من عاشوراء
عدم الخضوع أمام الحصار العسكريّ والاقتصاديّ
أمّا الحصار العسكريّ فتمثّل في المواجهة بين العديد القليل -73 شخصًا- على المشهور-مقابل ثلاثين ألفًا- كما في الروايات.
وأمّا الحصار الاقتصاديّ فقد تمثّل في منع إيصال الطعام والشراب إلى المخيّم حتّى أدّى ذلك إلى عطش حتّى الأطفال الصغار وقتلهم عطاشى.
كلّ ذلك لم يخضع معسكر الإمام الحسين (عليه السلام)، ما أدّى إلى انتصارهم بتحقيق أهدافهم التي خرجوا لأجلها.
تحقيق مقولة انتصار الدم على السيف
حيث تجلّت بأعلى معانيها حتّى استفاد منها كلّ أحرار العالم، وبتنا نسمع مثل المصلح الهنديّ الشهير غاندي، يقول: «تعلّمت من الحسين كيف أكون مظلومًا فأنتصر».
قبول الدعوة وإتمام الحجّة
فمع علم الإمام الحسين (عليه السلام) بغدر أهل الكوفة، ولكنّه لمّا دعوه أجابهم من باب إتمام الحجّة عليهم؛ لأنّه هناك قيمة في نفس إجابة الدعوة، ولا بدّ من إتمام الحجّة عليهم.
إنّ الدين أغلى من كلّ شيء
إنّ الدين له هذه القيمة التي يقدّم له شخص كأبي عبد الله الحسين (عليه السلام) نفسه فداءً وفي سبيل الله، ولذا يقال: إنّ زينب (عليها السلام) خرجت عصر يوم العاشر من المحرّم تشقّ صفوف الجيش
94
83
الموعظة الرابعة عشرة: دروس من عاشوراء
الأمويّ، إلى أن انتهت إلى جسد أخيها الحسين (عليه السلام)، وقالت: «اللهمّ تقبّل منّا هذا القربان».
ورحم الله الشاعر يقول عن لسان الحسين (عليه السلام):
إن كان دين محمّد لم يستقم
إلّا بقتلي يا سيوف خذيني
حفظ حقوق الناس
نزل الإمام الحسين (عليه السلام) أرض كربلاء في اليوم الثاني من المحرّم، وروي أنّه (عليه السلام) اشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى والغاضريّة بستّين ألف درهم، وتصدّق بها عليهم، وشرط عليهم أن يرشدوا إلى قبره ويضيفوا من زاره ثلاثة أيّام[1].
كما لم يقبل أن يكون معه ومن أصحابه أحد ممّن عليه دين.
خطر الخيانة والانكفاء السياسيّ
خرج لقتال الإمام الحسين (عليه السلام) ثلاثون ألفًا، بعض هؤلاء كان ممّن عزلهم أمير المؤمنين (عليه السلام) وجاؤوا لقتال ولده الإمام الحسين (عليه السلام).
وبعض هؤلاء كانوا ممّن بايع الإمام (عليه السلام) ونكث، فعن سيّد الشهداء (عليه السلام) يوم العاشر من المحرّم أنّه نادى: «يا شبث بن ربعيّ، ويا حجّار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا يزيد بن الحارث، ألم تكتبوا إليّ أن قد أينعت الثمار وأخضرّ الجناب وطمّت الجمام وإنّما تقدم على جند لك مجند فأقبل»؟ قالوا له: لم نفعل، فقال: «سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم»[2].
[1] الطريحيّ، مجمع البحرين، مادّة «كربل»، ج5، ص461.
[2] الطبريّ، تاريخ الطبريّ، ج4، ص323.
95
84
الموعظة الرابعة عشرة: دروس من عاشوراء
باب التوبة مفتوح حتّى آخر الطريق
الحرّ بن يزيد الرياحيّ مثال واضح لذلك حيث قبل الإمام (عليه السلام) توبته. وهناك مجموعة من أصحاب عمر بن سعد تحوّلت إلى أصحاب الحسين (عليه السلام) حين رأوهم متبتّلين متهجّدين عليهم سيماء الطاعة والخضوع لله -تعالى-[1].
وهناك من مال يوم العاشر من المحرّم إلى معسكر الحسين (عليه السلام) وقاتل معه واستشهد بين يديه.
وهنا لا بدّ من التنبيه إلى ما جاء في كلمات الإمام (عليه السلام) أنّه كان مانعًا من سماعهم لمواعظه وهو المال الحرام، حيث جاء في كلماته (عليه السلام) لهم: «وكلّكم عاص لأمري غير مستمع قولي فقد ملئت بطونكم من الحرام، وطبع على قلوبكم»[2].
المهمّ هو المبدأ والخطّ وليس الشخص والفرد
عن الإمام الحسين (عليه السلام)، أنّه قال عن يزيد: «إنّا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، وبنا فتح الله، وبنا ختم الله، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر، قاتل النفس المحرّمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله...»[3].
فمن كان يحمل صفات كالإمام (عليه السلام) لا يبايع من يحمل صفات كيزيد.
[1] المقرّم، مقتل الحسين (عليه السلام)، ص217.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج45، ص8.
[3] المصدر نفسه، ج44، ص325.
96
85
الموعظة الرابعة عشرة: دروس من عاشوراء
كونوا أحرارًا
«إن لم يكن لكم دين، وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحرارًا في دنياكم»[1].
ولذا امتدح الحرّ بن يزيد الرياحيّ بهذا الأمر، فقال له: «أنت الحرّ كما سمّتك أمّك، وأنت الحرّ في الدنيا، وأنت الحرّ في الآخرة»[2].
الدفاع عن الدين ولو لوقت قليل
لو كان الإمام الحسين (عليه السلام) وحيدًا لقتل صبيحة يوم العاشر من المحرّم، ولكنّ أصحاب الإمام (عليه السلام) وأهل بيته وإن لم يستطيعوا دفع القتل عنه ولكنّهم أخّروا ذلك إلى عصر ذلك اليوم، فحفظوا حياة الإمام ولو لساعات، وهذا درس لنا أن نحفظ الحقّ ونؤخّر الفساد ونقلّل من وجوده ولو لساعات.
عدم ترك الدعوة والتبليغ مهما كان
خطب الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه من الصباح إلى العصر حوالي عشر خطب، قصيرة وطويلة، بعض منها للإمام (عليه السلام)، وواحدة للحرّ وأخرى لزهير وثالثة لأبي الفضل العبّاس (عليه السلام) وغيرهم.
إنّ الحقّ هو المنتصر في النهاية
قال -تعالى-: ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلعَاجِلَةَ عَجَّلنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصلَىٰهَا مَذمُومٗا مَّدحُورٗا﴾[3].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج45، ص51.
[2] المصدر نفسه، ص14.
[3] سورة الإسراء، الآية 18.
97
86
الموعظة الثالثة عشرة: تَجَلّي الإيثار في كربلاء
هناك الكثير من الناس يسعون إلى أهدافهم من خلال الذهاب إلى العدوّ والتعامل معه، وكان عاقبة أمرهم هو الهلاك والخسران، فهذا عمر بن سعد كان يريد ملك الريّ، وقد سعى للوصول إليه من خلال الخروج إلى حرب الحسين (عليه السلام) وقتله مع عبيد الله بن زياد ويزيد، فماذا كانت النتيجة؟! الخسران في الدنيا والهلاك في الآخرة، ﴿وَٱلعَٰقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ﴾[1].
النسب ليس على حساب المبدأ
لمّا كان اليوم التاسع من المحرّم جاء شمر حتّى وقف على أصحاب الحسين (عليه السلام) فقال أين بنو أختنا - يعني العبّاس وجعفرًا وعبد الله وعثمان أبناء عليّ (عليه السلام)- فقال الحسين (عليه السلام): «أجيبوه وإن كان فاسقًا فإنّه بعض أخوالكم» (وذلك أنّ أمّهم أمّ البنين كانت من بني كلاب والشمر من بني كلاب)، فقالوا له: «ما تريد»؟ فقال لهم: أنتم يا بني أختي آمنون فلا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين والزموا طاعة يزيد؟ فقالوا له: «لعنك الله ولعن أمانك أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له»[2].
[1] سورة الأعراف، الآية 128.
[2] السيّد الأمين، أعيان الشيعة، ج4، ص129.
98
87
الموعظة الخامسة عشرة: الصلاة في عاشوراء
الموعظة الخامسة عشرة: الصلاة في عاشوراء
بيان أهمّيّة الصلاة في الإسلام، والحثّ على الالتزام بها.
محاور الموعظة
الصلاة عنوان بارز في عاشوراء
منزلة الصلاة في الإسلام
ثواب الصلاة
عقاب تارك الصلاة
تصدير الموعظة
ورد في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام): «وأشهد أنّك قد أقمت الصلاة»[1].
[1] الشيخ الطوسيّ، مصباح المتهجّد، ص720.
99
88
الموعظة الخامسة عشرة: الصلاة في عاشوراء
الصلاة عنوان بارز في عاشوراء
قال الحسين (عليه السلام) لأخيه العبّاس في ليلة العاشر: «ارجع إليهم واستمهلهم هذه العشيّة إلى غد، لعلّنا نصلّي لربّنا الليلة، وندعوه، ونستغفره، فهو يعلم أنّي أحبّ الصلاة له، وتلاوة القرآن، وكثرة الدعاء، والاستغفار».
نظر الصائديّ في السماء، وأخذ يقلِّبُ وجهه فيها، ثم توجَّه نحو الحسين، (عليه السلام) وقال: نفسي لنفسك الفداء، أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، واللَّه لا تقتل حتّى أقتل معك، وأحبّ أن ألقى ربّي وقد صلّيت هذه الصلاة التي دان وقتها.
فأجابه (عليه السلام): «ذكرت الصلاة جعلك اللَّه من المصلّين الذاكرين وأقاموا الصلاة».
سعيد بن عبد اللَّه الحنفيّ بعد تعهّده ليلة العاشر بالدفاع عن الإمام (عليه السلام) حتّى الشهادة يرتفع شهيدًا وهو يدافع عن الإمام الحسين أثناء إقامته الصلاة يتلقّى السهام بجسده حتّى وقع على الأرض، قائلًا لإمامه: أَوَفيت يابن رسول اللَّه؟ فأجابه (عليه السلام): «نعم أنت أمامي في الجنّة».
منزلة الصلاة في الإسلام
عن النبيّ (صلى الله عليه وآله): «ليكن أكثر همّك الصلاة فإنّها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين»[1].
[1] الشيخ ابن شعبة الحرّانيّ، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص26.
100
89
الموعظة الخامسة عشرة: الصلاة في عاشوراء
عن النبيّ (صلى الله عليه وآله): «لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة فلا يشيننّ أحدهم وجه دينه»[1].
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «أحبّ الأعمال إلى اللَّه -عزّ وجلّ- الصلاة وهي آخر وصايا الأنبياء»[2].
ثواب الصلاة
عن سلمان المحمّديّ: كنت مع رسول اللَّه في ظلّ شجرة، فأخذ غصنًا منها، فنفضه فتساقط ورقه، فقال: «ألا تسألوني عن ما صنعت؟!» قلنا أخبرنا يا رسول اللَّه، فقال (صلى الله عليه وآله): «إنّ العبد إذا قام إلى الصلاة تحاتت عنه خطاياه كما تحاتّ ورق هذه الشجرة»[3].
عن الإمام علي (عليه السلام): «لو يعلم المصلّي ما يغشاه من جلال اللَّه ما سرَّه أن يرفع رأسه من السجود»[4].
عن الإمام علي (عليه السلام): «إنّ الإنسان إذا كان في الصلاة فإنّ جسده وثيابه وكلّ شيء حوله يسبح»[5].
عقاب تارك الصلاة
قال -تعالى-: ﴿مَا سَلَكَكُم فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُواْ لَم نَكُ مِنَ ٱلمُصَلِّينَ﴾[6].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج3، ص270.
[2] الشيخ المفيد، المقنعة، ص267.
[3] الشيخ الطوسيّ، الأمالي، ص168.
[4] الشيخ الصدوق، الخصال، ص632.
[5] الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ج2، ص336.
[6] سورة المدّثّر، الآيتان 42 - 43.
101
90
الموعظة الخامسة عشرة: الصلاة في عاشوراء
الإمام الصادق (عليه السلام) حين حضرته الوفاة: «لا تنال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة»[1].
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قُبلت قُبل سائر الأعمال، وإن رُدَّت ردّ سائر الأعمال»[2].
دعوة الإمام الخامنئيّ (دام ظله)
الصلاة في اليوم العاشر إعلان عن التمسّك بخطّ اللَّه -تعالى- المتمثّل بالنهج العباديّ الجهاديّ للإمام الحسين (عليه السلام).
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج3، ص270.
[2] المصدر نفسه، ص268.
102
91
الموعظة السادسة عشرة: نساء عاشوراء قدوة وأسوة
الموعظة السادسة عشرة: نساء عاشوراء قدوة وأسوة
تعرّف دور النساء في كربلاء وبعض المواقف الولائيّة من جهادهنّ.
محاور الموعظة
الحضور العامّ للمرأة في النزاعات
حضور المرأة في كربلاء
مواقف بطوليّة للمرأة في كربلاء
تصدير الموعظة
﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمرَأَتَ فِرعَونَ إِذ قَالَت رَبِّ ٱبنِ لِي عِندَكَ بَيتٗا فِي ٱلجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرعَونَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلقَومِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾[1].
[1] سورة التحريم، الآية 11.
103
92
الموعظة السادسة عشرة: نساء عاشوراء قدوة وأسوة
إنّ الإمام الحسين (عليه السلام) أخذ النساء معه كي يؤدّين أدوارًا مهمّة لنصرة الثورة أو إنّ أدوار النساء كانت ضمن البرنامج التخطيطيّ لقائد الثورة الذي لم يكن يفكّر بأنّه سينُهي المواجهة بعدم مبايعته ليزيد، من ثمّ باستشهاده، بل لا بدّ من توجيه الأمّة إلى قيم جديدة وتربويّات مطلوبة.
ولم يكن لهذه المهمّة الصعبة من يؤدّيها سوى هؤلاء النساء وعلى رأسهنّ السيدة زينب (عليها السلام). وهذا يشير إلى ثقته الكاملة بأُخته وبأنّ هؤلاء النساء هنّ ممّن يُعتمَد عليهنّ وهنّ قادرات على أداء التكاليف المطلوبة.
وسيبقى هؤلاء النساء رمزًا للبشريّة جمعاء، وخصوصًا للمرأة التي تبحث في كلّ عصر عن نماذج يُقتدى بها، وتسير في هداها.
الحضور العامّ للمرأة في النزاعات
إنّ وجود المرأة في مناطق النـزاعات غالبًا ما يكون عامل تحريك للرأي العامّ وعامل تعريف بجرائم العدوّ، ولهذا نجد أنّ الإعلام إذا ما أراد أن يظهر بطش الحاكم وطغيانه فإنّه يعرض صورًا لنساء معذّبات أو مقتولات أو أطفالًا يبكون ويستصرخون ويصرخون... هي صورٌ من الممكن أن تهزّ الضمير الاجتماعيّ وتحدث فيه حركة باتجاه المطلوب، بمعنى أنّ وجود المرأة في النـزاعات المسلّحة والحروب غالبًا ما يكون عاملًا لكشف وحشيّة العدوّ ومجازره وبشاعته ولنا أن نستعرض في ذاكرتنا ما كان يُبَثّ من صور عن المعارك التي شهدها القرن
104
93
الموعظة السادسة عشرة: نساء عاشوراء قدوة وأسوة
المنصرم وبداياته والتي يستعمل فيها »مونتاجًا» خاصًّا لعرض بكاء الأمّهات وذهول الزوجات وأنين البنات. ولهذا اهتزّت الكوفة لمّا جاء ركب الحسين (عليه السلام) وارتجّت لمرأى الأطفال الذين ترتعد فرائصهم واصفرّت وجوههم، وماجت للحرائر المُخدَّرات اللواتي ارتسم الحزن على وجوههنّ وبان ثقل الدموع في مآقيهنّ وازداد الألم حينما جادت عليهنّ الكوفيّات بالإزر والمقانع وضجّ الناس بالبكاء والعويل حينما أزيح الستار عن القناع الأمويّ، فهؤلاء لسن سبايا الخوارج والديلم كما قال ابن زياد إنّما هنّ سبايا آل البيت (عليهم السلام)!
حضور المرأة في كربلاء
إنّ واقعة الطفوف كانت بحاجة إلى حضور المرأة كي تنجح الثورة، وبحاجة إلى حضور نسائيّ متميّز لا يجزي عنه الرجل أبدًا. فمن المعلوم أنّ الإمام لو اصطحب الكثير من الرجال فلن يقوموا بالدور الذي ستقوم به النساء، وبهذا جاء حمل النساء كدلالة على تخطيط مستقبليّ للثورة فيما يمكن أن تؤدّيه النساء من أدوار تدور ضمن مصلحة الإسلام الكبرى والإيمان بمبادئ الإمام في الإصلاح والتغيير، فهو إذًا اجتياز للدائرة المحدّدة التي تشمل حياة المرأة الخاصّة، ولكنّها لا تلغي شخصيّة المرأة نفسها أو أهدافها الممتدّة في الحياة أو مسؤوليّاتها العديدة.
وكان الحضور النسائيّ متميّزًا في نساء عرفن بالعلم والمعرفة والبلاغة والفصاحة والصبر الجميل إلى غير ذلك، وبذلك نجح الإمام
105
94
الموعظة السادسة عشرة: نساء عاشوراء قدوة وأسوة
وأنصاره في تضحيته كما نجحت المرأة -زينب (عليها السلام)- في التبليغ والإعلام الموجّه، ولم تكن الأدوار التقليديّة للنساء كالأمومة والزوجيّة عائقًا أمام تحقيق نجاح أوسع ضمن دائرة الأهداف العامّة بل كانت هذه الأدوار سببًا لإضفاء مزيد من الحزن والتفجّع على ما جرى في الطفوف، فهؤلاء النساء قدّمنَ الغالي والنفيس بل ضحّين بالولد والأخ والزوج لنصرة الثورة في زمن تقاعس فيه الأشاوس من الرجال عن نصرة الإمام الذي كانوا يسمعون استغاثته!. وبهذا تحوّلت الأدوار التقليديّة التي تضجر منها المرأة المعاصرة إلى أدوار رساليّة ومحطّات انطلاق لرسم هُويّة ثائرة للمرأة المسلمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكان مجموع هؤلاء النساء إضافة إلى الأطفال يؤلّف قافلة سبايا أهل البيت، الذين فرّوا بعد مقتل الحسين وهجوم الأعداء على الخيام، ثمّ قبض عليهم وسيقوا في قافلة السبايا إلى الكوفة ومنها إلى الشام.
وإذا نظرنا إلى خلفيّة أولئك الطاهرات اللاتي جئن إلى أرض المعركة نلاحظ أنّ فيهنّ الأمّ والجدّة، والأخت والشقيقة، والعمّة والخالة، والابنة والحفيدة، والزوجة، ويجب التمعّن بأنّ لكلّ منهنّ مهمّة ربّما تختلف تمامًا عن مهمّة ألأخرى، ولكنْ يجمعهنّ الإيمان بأرقى مفاهيمه الإنسانيّة التي جاء بها الإسلام ولخّصها في شخص الإمام الحسين (عليه السلام) وأهدافه.
106
95
الموعظة الخامسة عشرة: الصلاة في عاشوراء
مواقف بطوليّة للمرأة في كربلاء
1.السيّدة زينب بنت عليّ بن أبي طالب (عليهما السلام) والمواقف الصُلبة
المرأة التي أبت إلّا المشاركة في النهضة، تلك الزوجة الوفيّة، والأمّ الحنون، والعمّة العطوف، والخالة الرؤوف، والأخت المسؤولة التي كانت قدوة لا للنساء فحسب بل للرجال أيضًا، أخذت على عاتقها أدوارًا مختلفة يصعب على المرء حصرها، ولكن سنشير إلى جانبٍ منها ألا وهو تفعيل الأهداف التي من أجلها نهض الإمام الحسين (عليه السلام) وتكريسها وذلك بعد شهادته (عليه السلام)، وإن شئت فقل تكميل ذلك الدور واستمراريّته فقد وقع على عاتقها، ولا يمكن نسيان هذا الدور الفاعل، ولولا جهودها لما أثمرت تلك النهضة المباركة بهذا الشكل الذي أثمر، وقد أبت السيّدة زينب إلّا أن تشارك شقيقها الحسين (عليه السلام)، فقد ذكر المؤرّخون أنّ ابن عباس جاء إلى الحسين (عليه السلام) ناصحًا ومودّعًا وهو بأرض الحجاز ليثنيه عن السفر إلى العراق، ولكنّه وجد نفسه أمام إصرار الإمام (عليه السلام) الذي لا محيص عنه فطلب منه (عليه السلام) أن لا يأخذ معه النساء، قائلًا: جعلت فداك يا حسين، إن كان لا بدّ من السير إلى الكوفة فلا تسِرْ بأهلك ونسائك، فسمعته السيّدة زينب (عليها السلام)، فانبرت تخاطبه: يابن عباس تشير على سيّدنا وشيخنا أن يخلّفنا ها هنا ويمضي وحده؟ لا والله بل نحيا معه ونموت معه وهل أبقى الزمان لنا غيره[1].
[1] راجع: السيّد هاشم الحسينيّ البحرانيّ، مدينة المعاجز، ج3، ص485.
107
96
الموعظة السادسة عشرة: نساء عاشوراء قدوة وأسوة
2.بحرية بنت مسعود الخزرجيّة وتجهيز ابنها للشهادة
المرأة التي تجهّز ابنها للشهادة، كانت بحرية وهي ممّن حضرن كربلاء مع زوجها جنادة بن كعب الخزرجيّ فخرج الزوج وقاتل قتال الأبطال بين يدي أبي عبد الله الحسين (عليه السلام)، ولمّا لم تمتلك بحرية وسيلة أخرى للدفاع عن الحقّ المتمثّل بالحسين (عليه السلام) جاءت إلى ابنها عمر، الذي لم يتجاوز العقد الأوّل من عمره، فألبسته لامة الحرب وقلّدته السيف، وتحدّثت معه بأمر القتال بين يدي أبي عبد الله، والنواميس التي يدافع عنها، وحثّته على ذلك، وقالت فيما قالته: أُخرج يا بني وانصر الحسين (عليه السلام) وقاتل بين يدي ابن رسول الله فلمّا جهّزته خرج ووقف أمام الحسين (عليه السلام) يستأذنه للقتال، فلم يأذن له فأعاد عليه الاستئذان، فقال الحسين (عليه السلام): «إنّ هذا غلام قتل أبوه في المعركة، ولعلّ أمّه تكره ذلك»، فقال عمر: «يابن رسول الله، إنّ أمّي هي التي أمرتني وقد قلّدتني هذا السيف وألبستني لامة الحرب»، وعندها سمح له الحسين (عليه السلام) فذهب إلى ميدان القتال وهو ينشد ما يختلج بقلبه، قائلًا من المتقارب:
أميري حسينٌ ونعم الأمير
عليٌّ وفاطمةُ والداهُ
له طلعةٌ مثلُ شمس الضحى
سرورُ فؤاد البشير النذير
فهل تعلمون له من نظير؟
له غرّةٌ مثلُ بدر منير
فقاتل حتّى قتل وقطع رأسه فرُمي به إلى جهة الحسين (عليه السلام)، فأخذته أمّه وضربت به رجلًا أو رجلين فقتلتهما، وخفّ إليها الحسين (عليه السلام) فأرجعها إلى الخيمة[1].
[1] راجع: ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج3، ص253.
108
97
الموعظة السادسة عشرة: نساء عاشوراء قدوة وأسوة
3. دلهم بنت عمرو الكوفيّة والتشجيع على الولاء والقتال
المرأة التي وضعت زوجها على الطريق، لم يكن زوجها زهير بن القين البجليّ من الموالين لأهل البيت (عليهم السلام)، بل كان على الخطّ النقيض لخطّ أهل البيت (عليهم السلام)، ولكنّ الطريق جمع بينه وبين الإمام الحسين (عليه السلام) وهما في طريقهما إلى الكوفة، وما كانت إلّا ساعة فإذا برسول الحسين (عليه السلام) على باب خيمة زهير، يقول: إنّ أبا عبد الله بعثني إليك لتأتيه فساد صمت رهيب في مجلس زهير، حيث كان يكره زهير وقومه مسايرة الحسين (عليه السلام) وهو في الطريق فكيف بهم ورسول الحسين يدعوهم للقياه، وفي هذه اللحظة مزّقت دلهم تلك المرأة الحكيمة والمؤمنة، أجواء الصمت والذهول، والتفتت إلى زوجها مفجّرة بكلماتها بركانًا من الدرن الذي خيّم على القلوب، وقالت: يا زهير أيبعث إليك ابن رسول الله ثمّ لا تأتيه، سبحان الله، لو تأتيه فسمعت كلامه، ثمّ انصرفت، فما كان من زهير إلّا أن قرّر الذهاب إلى أبي عبدالله (عليه السلام) والاستماع إليه، وفجأة وجد زهير نفسه في مجلس الحسين (عليه السلام) حيث حملته رجلاه إليه، ولمّا حاوره الحسين (عليه السلام) وبيّن أهداف نهضته، انقلب زهير واتّخذ قرارًا حاسمًا، وصمّم على الالتحاق بركب ريحانة الرسول (صلى الله عليه وآله)، فعاد إلى قومه مستبشرًا قد أسفر وجهه والتفت إلى زوجته ليطلّقها ويلحقها بأهلها، لا كرهًا بها، بل حبًّا لها، مُوطّنًا نفسه على الشهادة، فبشّرها بقراره الشجاع، والتحاقه بركب الحقّ، فقامت إليه زوجته تودّعه باكية، لتقول له بكلّ
109
98
الموعظة السادسة عشرة: نساء عاشوراء قدوة وأسوة
ثبات: خار الله لك، أسألك أن تذكرني في القيامة عند جدّ الحسين[1]. وهكذا ودّع زهير متاع الدنيا كلّها، ليقول للحسين (عليه السلام): والله، لو كانت الدنيا لنا باقية وكنّا مخلّدين إلّا أنّ فراقها في نصرتك ومواساتك لآثرنا الخروج معك على الإقامة فيها... أما والله، لوددت أنّي قتلت ثمّ نشرت ثمّ قتلت حتّى أقتل هكذا ألف قتلة وأنّ الله يدفع بذاك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك... طلّق زهير زوجته والدنيا، وطلّقت زوجته حلاوة الدنيا وبهجتها وأذعنت لقرار زوجها خوفًا من أن يتردّد عن الشهادة، فمن يا ترى كان وراء تحوّل زهير![2].
4. نوار بنت مالك الحضرميّة وإنكار الظلمة
المرأة التي رفضت بعلها، فقد انتُدِبَ الخوليّ بن يزيد الأصبحيّ ليحمل رأس الحسين (عليه السلام) إلى الطاغية عبيد الله بن زياد، وكان عَجِلًا من أمره للوصول إلى دار الإمارة لينال الجائزة إلّا أنّه وصلها متأخّرًا حيث خيّم الظلام وأغلقت الكوفة أبوابها فاضطرّ إلى المضيّ إلى داره ليستريح ليلته ويعود في الصباح الباكر، ولمّا دخل بيته سألته زوجته نوار عمّا يخبّئه في التنور، فقال لها بعد حوار طويل: جئتك بغنى الدهر، هذا رأس الحسين (عليه السلام) معك في الدار. فقالت: ويلك جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول الله، لا والله لا يجمع رأسي ورأسك في بيت أبدًا، ثمّ أضافت قائلة: اِرجع، وأخذت عمودًا
[1] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص73.
[2] البلاذريّ، أنساب الأشراف، ج3، ص167.
110
99
الموعظة السادسة عشرة: نساء عاشوراء قدوة وأسوة
وأوجعته ضربًا، وقالت: والله ما أنا لك بزوجة، ولا أنت لي ببعل[1].
وهكذا فارقته لتُعلّم الآخرين درسًا في التعامل مع الظالمين وإن كان الظالم وليَّ نعمتهم، وفعلًا اتّبعتها ضرّتها عيوف الأسديّة حيث هي الأخرى رفضت الخوليّ فبات بلا مأوى، فمن يا تُرى استنكر فَعلة الظالمين!.
5.مارية بنت منقذ العبديّ وحماية المجاهدين
المرأة التي موّلت الثائرين، كانت مارية أرملة استشهد زوجها في معركة الجمل نصرةً لأمير المؤمنين (عليه السلام) ومع هذا فقد كانت موالية للحقّ دون أيّ ملل أو تعب، وكانت تحوز مكانة مرموقة في المجتمع البصريّ وتمتلك أموالًا طائلة، ولمّا بدأ الصراع العلويّ الأمويّ وأصبح على أشدّه فتحت بيتها للزعماء الموالين للبيت العلويّ ليكون ناديًا فكريًّا يناقش فيه الزعماء قضايا الأمّة، ومركز اتّصال وتواصل لدعم المعارضة، فقد قال الطبريّ:
«اجتمع ناس من الشيعة بالبصرة في منزل امرأة من عبد القيس يُقال لها مارية ابنة سعد أو منقذ أيّامًا، وكانت تشيّع، وكان منزلها لهم مألفًا يتحدّثون فيه»[2].
[1] البلاذري، أنساب الأشراف، ج3، ص206.
[2] المصدر نفسه.
111
100
الموعظة السابعة عشرة: خلود النهضة الحسينيّة
الموعظة السابعة عشرة: خلود النهضة الحسينيّة
بيان عوامل بقاء مؤثّرية النهضة الحسينيّة وأسبابه، ودور الإخلاص في خلود الأثر والعمل.
محاور الموعظة
الخلود من معالم النهضة الحسينيّة
أسباب البقاء والخلود
من آثار الإخلاص في النيّة
تصدير الموعظة
النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «إنّ لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدًا»[1].
[1] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج10، ص318.
112
101
الموعظة السابعة عشرة: خلود النهضة الحسينيّة
الخلود من معالم النهضة الحسينيّة
إنّنا وكلّ ما ومن في الوجود إلّا ما ومن استثنى إليه آيل إلى الفناء والاندثار، أو لا أقلّ أنّ بنفسه لا يملك عناصر الخلود والبقاء إلّا أن يفاض علينا ما به بقاؤه وخلوده ممّن له الخلود والبقاء ومن يملك الموت والحياة.
ولو أردنا أنّ البقاء بدوام الذكر في الدنيا وعلى مرّ الأجيال فما الضامن لذلك؛ إذ كم من أمّة مرّت على هذه الدنيا وكان لها ما كان لا تجد لها ذكرًا حتّى كأنّها لم تكن.
ومثلها الكثير من الأفراد، إلّا أنّ ثمّة أمرًا ملفتًا في القرآن الكريم، وهو أنّه -تعالى- جعل بعض الثواب لبعض الأنبياء دوام الذكر في الدنيا من خلال إيراد ذكره والتنويه بجهده وجهاده في القرآن الكريم، بل أمر بذكرهم بقول ﴿وَٱذكُر فِي ٱلكِتَٰبِ﴾[1]، ﴿وَٱذكُر عِبَٰدَنَا﴾[2] تنفيذًا لسنّته ووعده: ﴿كَذَٰلِكَ نَجزِي ٱلمُحسِنِينَ﴾[3]، بل ليكون ذكرهم مقرونًا بالسلام عليهم ﴿سَلَٰمٌ عَلَىٰ نُوحٖ فِي ٱلعَٰلَمِينَ﴾[4]، ﴿سَلَٰمٌ إِل يَاسِينَ﴾[5] وغير هؤلاء.
[1] راجع: سورة مريم، الآيات 16 - 41 - 51 - 54 - 56.
[2] سورة ص، الآية 45.
[3] راجع على سبيل المثال: سورة الصافّات، الآيات 80 - 105 - 110 - 121 - 131.
[4] سورة الصافّات، الآية 29.
[5] سورة الصافّات، الآية 130.
113
102
الموعظة السابعة عشرة: خلود النهضة الحسينيّة
ومن أبرز من خلّد ذكرهم في الدنيا بذكرهم في كتابه الكريم من خلال التنويه بأعمالهم آل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومنهم الحسين (عليه السلام)، فالحسين (عليه السلام) باقٍ ذكره مع القرآن وفيه حتّى قبل حصول ما حصل في كربلاء وعاشوراء فضلًا عن الزخم الذي أحدث به عاشوراء ذكر الحسين من أسباب بقاء وخلود، فالبقاء والأبديّة والخلود من أبرز معالم الحسين والنهضة الحسينيّة ومزاياهما، لا من حيث الذكر فقط، بل من حيث المؤثّريّة والفاعليّة على مرّ الأزمنة وتعاقب الأجيال، وهذا ما أنبأ به الصادق الأمين (صلى الله عليه وآله): «إنّ لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدًا»[1].
أسباب البقاء والخلود
كلّنا وبفطرتنا وما جبلنا عليه نحبّ البقاء ونحبّ أن يبقى لنا الأثر الحسن والذكر الحسن في الحياة بعد رحيلنا عن هذه الدنيا، فهل ثمّة من سبيل إلى ذلك؟
وبجواب مباشر، نقول: نعم، هناك أمور يمكن أن نحفظ بها جهودنا، ولنقف على شيء منها، نقف على ما جاء في القرآن الكريم، ومنها قوله -تعالى-: ﴿مَا عِندَكُم يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٖ وَلَنَجزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجرَهُم
بِأَحسَنِ مَا كَانُواْ يَعمَلُونَ ٩٦ مَن عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَو أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤمِنٞ فَلَنُحيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗ وَلَنَجزِيَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ مَا كَانُواْ يَعمَلُونَ﴾[2].
[1] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج10، ص318.
[2] سورة النحل، الآيتان 96 - 97.
114
103
الموعظة السابعة عشرة: خلود النهضة الحسينيّة
ولنا أن نستخرج من هاتين الآيتين ما يلي:
1. إنّ الصبر والثبات في طرق طاعة الله من أفضل أعمال الإنسان.
2. إذا كان العمل من ثمار وجود الإنسان، فإن كان المقصود به الناس فإنّه يذهب بذهاب الناس ﴿مَا عِندَكُم يَنفَدُ﴾[1] ولا مادّة له تحدّه بأسباب الدوام والبقاء.
3. من أراد لعمله البركة ودوام النفع، وأراد إنقاذ عمله من الفناء والاندثار عليه أن يقرنه بالدائم الباقي، وممّا لا شكّ فيه أنّ من له البقاء والدوام هو الله.
وبتعبير آخر: إنّ كلّ ما هو لنا من وجودنا في هذه الدنيا هو عملنا فلا مال يبقى ولا بنون، ولا عزّ ولا جاه، فكنزنا الذي نحصل عليه من حياتنا في هذه الدنيا هو عملنا، وحتّى يبقى لنا هذا العمل ويسلم ويرافقنا إلى الحياة الآخرة لا بدّ من أن يكون عملًا صالحًا، يعني أن يكون مفيدًا وبنّاءً من جهة، ومن جهة لا بدّ من وجود الداعي والباعث الإيمانيّ، وإلّا فإنّ الأعمال حتّى لو كانت صالحة فهي لا تملك أسباب بقائها لترافقنا في الموت وما بعده ما لم يحدّها الإيمان بالحياة.
فالأعمال كلّ الأعمال عبادات كانت أو أعمال خير من صدقات وأعمال برّ وصلة رحم وقضاء حوائج وتعلّم وتعليم وحتّى الجهاد علينا أن نعتبرها كنوزًا نخشى عليها الضياع فعلينا أن نودعها عند من لا تضيع عنده الودائع ألا وهو الله -تعالى-، وبطريقة مباشرة نقول
[1] سورة النحل، الآية 96.
115
104
الموعظة السابعة عشرة: خلود النهضة الحسينيّة
معنى كون العمل عند الله هو أن نخلص النيّة لله قبلة قلوبنا فحينها سيكون لأصغر عمل أكبر الأثر، وهذه ضربة عليّ (عليه السلام) إنّما كانت تعدل عمل الثقلين؛ لأنّها صدرت عن نفس عليّ (عليه السلام) بصورة خالصة لم تشبها شائبة.
من آثار الإخلاص في النيّة
عندما سُئِل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن قوله -تعالى-: ﴿فَلَنُحيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗ﴾، قال: «هي القناعة»[1].
وممّا يستفاد من ذلك: أنّ العمل الصالح الصادر عن باعث هو الإيمان بالله -تعالى- له أثر في الدنيا على نفس العامل وعلى نفسه بالخصوص؛ إذ يزيل أسباب القلق والاضطراب ليحلّ محلّها الطمأنينة والسكينة.
فكلّما كان العمل بنّاءً ومفيدًا وكانت النيّة خالصة فيه لله كلّما اطمأنّت النفوس وسكنت وصارت حياتها طيّبة هانئة سعيدة.
وكذلك، فإنّ المجتمع الذي يتنافس فيه أبناؤه في الأعمال الصالحة وبدواعٍ متجرّدة عن الأنانيّات والمصلحيّات تسود هذا المجتمع الطمأنينة والهناء.
خاتمة
من يرد الخلود والبقاء عليه أن يتأسّى بالصالحين، من أمثال: إبراهيم (عليه السلام)؛ حيث جعل الله ذكره مقرونًا بعبادة من أعظم
[1] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص509.
116
105
الموعظة السابعة عشرة: خلود النهضة الحسينيّة
العبادات وهي الحجّ، وبأمكنة هي من أقدس الأمكنة وهي البيت الحرام، فكان مقام إبراهيم وحجر إسماعيل وقصّة حربه للشيطان عند الجمرات وكذلك في منى والخيف وعرفات وغيرها.
بل إنّ نداءه بأمر الله للحجّ كان له أثر اخترق الأمكنة والأزمنة والأجيال وأخبر -تعالى- عن ذلك، بقوله: ﴿يَأتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ﴾[1].
وكذلك، فإنّ الإمام الحسين (عليه السلام) أطاع الله -تعالى- في أغلى الأشياء عنده، فقدّم ما قدّم، وهو يقول: عند الله أحتسب.
بل يقول ورضيعه بين يديه: «هوّن ما نزل بي أنّه بعينك يا ربّ».
لتكون نداءات الحسين (عليه السلام) وشعاراته بعد هذه الأضاحي «هل من ناصر ينصرني؟!» و«هيهات منّا الذّلّة»، كأنّها نداء جدّه إبراهيم (عليه السلام) لتحجّ الأرواح والنفوس والقلوب إلى الحسين (عليه السلام) شخصًا، ومقامًا، ومبادئ، وأهدافًا.
بعض الناس يعمد إلى حفر اسمه على جذع شجرة أو على صخرة ما ليبقى اسمه وذكره.
لكن الحسين (عليه السلام) كتب بدمه اسمه على جبين الزمان فحفرت حروفه في القلوب حرارة لا ولن تبرد أبدًا.
[1] سورة الحجّ، الآية 27.
117
106
الموعظة الثامنة عشرة: مسيرة السبايا والقيادة الزينبيّة للثورة
الموعظة الثامنة عشرة: مسيرة السبايا والقيادة الزينبيّة للثورة
الحثّ على الاقتداء بالسيّدة زينب (عليها السلام) في مواجهة الباطل من خلال بيان مواقفها في مواجهة الظالمين.
محاور الموعظة
مواقف السيّدة زينب (عليها السلام) في كربلاء
خطبة السيّدة زينب(عليها السلام) في الكوفة
الحجّة والمنطق في مواجهة ابن زياد
السيّدة زينب في مواجهة الطاغية يزيد
بعض ما يستنتج من خطبة زينب (عليها السلام)
تصدير الموعظة
السيّدة زينب (عليها السلام) ليزيد (لعنه الله): «وَلَئِنْ جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِي مُخَاطَبَتَكَ، إِنِّي لأَسْتَصْغِرُ قَدْرَكَ، وَأَسْتَعْظِمُ تَقْرِيعَكَ، وَأَسْتَكْثِرُ تَوْبِيخَكَ، لَكِنِ الْعُيُونُ عَبْرىَ، وَالصُّدَورُ حَرّىَ. أَلاَ فَالعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِقَتْلِ حِزْبِ اللهِ النُّجبَاءِ بِحِزْبِ الشَّيْطَانِ الطُّلَقَاءِ»[1].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج45، ص135.
118
107
الموعظة الثامنة عشرة: مسيرة السبايا والقيادة الزينبيّة للثورة
تحرَّك موكب سبايا أهل البيت (عليهم السلام) من كربلاء المقدّسة نحو مدينة الكوفة وهو يقطع الصحاري، حاملًا الذكريات الموحشة والمؤلمة لليلة الفراق والوحشة، التي قضوها على مقربة من مصارع الشهداء، في الحادي عشر من المحرّم 61 هـ. وقد حمل جيش عمر بن سعد السبايا على أحلاس أقتاب الجمال بغير وطاء ولا غطاء، وساقوهم كما يساق سبي الترك والروم في أشدّ المصائب، وتتقدّمهم الرؤوس على الرماح، حتّى دخل الركب الكوفة في اليوم الثاني عشر من المحرَّم 61هـ[1].
مواقف السيّدة زينب (عليها السلام) في كربلاء
تعتبر واقعة كربلاء من أهمّ الأحداث التي عصفت بالأمّة الإسلاميّة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكان للسيّدة زينب (عليها السلام) دور أساسيّ ورئيس في هذه الثورة العظيمة، فهي الشخصيّة الثانية على مسرح الثورة بعد أخيها الحسين (عليه السلام)، كما أنّها قادت مسيرة الثورة بعد استشهاد أخيها الحسين (عليه السلام) وأكملت ذلك الدور بكلّ حكمة و جدارة.
وحينما حدثت الفاجعة الكبرى بمقتل أخيها الحسين (عليه السلام) بعد قتل كلّ رجالات بيتها وأنصارهم خرجت السيّدة زينب تعدو نحو ساحة المعركة، تبحث عن جسد أخيها الحسين بين القتلى غير عابئة بالأعداء المدجّجين بالسلاح، فلمّا وقفت على جثمان أخيها الحسين (عليه السلام)، فالكلّ كان يتصوّر أنّها سوف تموت أو تنهار وتبكي وتصرخ أو
[1] السيّد ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص84.
119
108
الموعظة الثامنة عشرة: مسيرة السبايا والقيادة الزينبيّة للثورة
يغمى عليها، لكن ما حدث هزّ أعماق الناظرين، فوضعت يدها تحت جسده الطاهر المقطّع وترفعه نحو السماء وهي تدعو بمرارة قائلة: اللهمّ تقبَّلْ مِنّا هذا القربان.
خطبة السيّدة زينب (عليها السلام) في الكوفة
لمّا دخل موكب السبايا الكوفة، خرج الناس إلى الشوارع، بين مُتسائل لا يدري لمن السبايا، وبين عارف يُكفكف أدمعًا ويُضمر ندمًا.
ثمَّ اتَّجه موكب السبايا نحو قصر الإمارة، مُخترقًا جموع أهل الكوفة، وهم يبكون لما حلَّ بالبيت النبويّ الكريم، قال بشير بن خزيم الأسديّ: ونظرت إلى زينب بنت عليّ يومئذ، ولم أر خفرة والله أنطق منها، كأنّها تفرع من لسان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا، فارتدّت الأنفاس، وسكنت الأجراس، ثمّ قالت: «الْحَمْدُ للهِ، وَالصَّلاَةُ عَلىَ جَدِّي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الأَخْيَارِ، اَمَّا بَعْدُ: يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، يَا أَهْلَ الْخَتْلِ والْغَدْرِ، أَتَبْكُونَ؟! فَلَا رَقَأَتِ الدَّمْعَةُ، ولَا هَدَأَتِ الرَّنَّةُ، إِنَّمَا مَثَلُكُمْ كَمَثَلِ الَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ...َ أتَبْكُونَ وَتَنْتَحِبُونَ؟! إِيْ وَاللهِ فَابْكُوا كَثِيرًا، واضْحَكُوا قَلِيلًا، فَلَقَدْ ذَهَبْتُمْ بِعَارِهَا وَشَناَرِهَا...وَيْلَكُمْ يَا أَهلَ الْكُوفَةِ، أَتَدْرُونَ أَيَّ كَبِدٍ لِرَسُولِ اللهِ فَرَيْتُم؟! وَأيَّ كَرِيمَةٍ لَهُ أبْرَرْتُمْ؟! وَأَيَّ دَمٍ لَهُ سَفَكْتُمْ؟! وَأّيَّ حُرْمَةٍ لَهُ انتَهَكْتُمْ؟! لَقَدْ جِئْتُمْ بِهَا صَلعَاءَ عَنْقَاءَ سَوْدَاءَ فَقُمَاءَ... أَفَعَجِبْتُمْ أَنْ مَطَرَتِ السَّمَاءُ دَمًا، وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزىَ وَأَنْتُمْ لاَ تُنْصَرُونَ...»[1].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج45، ص109.
120
109
الموعظة الثامنة عشرة: مسيرة السبايا والقيادة الزينبيّة للثورة
الحجّة والمنطق في مواجهة ابن زياد
ولمّا روى المجرم الخبيث ابن مرجانة أحقاده من رأس ريحانة رسول الله (صلى الله عليه وآله) التفت إلى عائلة الإمام الحسين فرأى سيّدة منحازة في ناحية من مجلسه، وقد حفّت بها المهابة والجلال، فانبرى ابن مرجانة سائلًا عنها، فقال: مَن هذه التي انحازت ناحية ومعها نساؤها؟ فأعرضت عنه احتقارًا واستهانة به، وكرّر السؤال فلم تجبه فانبرت إحدى السيّدات فأجابته: هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله).
فقال لها: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم، وأبطل أحدوثتكم.
فثارت حفيدة الرسول (صلى الله عليه وآله) وأجابته بشجاعة أبيها محتقرة له، قائلة: «الحمْدُ للهِ الَّذي أَكْرَمَنَا بِنَبِيِّهِ محمد (صلى الله عليه وآله)، وَطَهَّرَنــــَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيرًا، إِنَّمَا يَفْتَضِحُ الْفَاسِقُ وَيَكْذِبُ الْفَـــاجِرُ، وَهُوَ غَيْـــرُنَا يَابْنَ مَرْجَانَة»[1].
وكذلك عندما خاطبها مستهزئًا: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟
فأجابته حفيدة الرسول (صلى الله عليه وآله) بكلمات الظفر والنصر لها ولأخيها، قائلة: «ما رَأَيْتُ إِلاّ جَمِيلًا، هؤُلاَءَ قَوْمُ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْقَتَلَ، فَبَرَزُوا إِلى مَضَاجِعِهِمْ، وَسَيَجْمعُ اللهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، فَتُحَاجُّ وَتُخَاصَمُ، فَانْظُرْ لِمَنِ الْفَلَجُ يَومَئِذٍ، ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يابْنَ مَرْجَانَةَ...»[2].
[1] راجع: العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج45، ص117.
[2] المصدر نفسه، ج45، ص116.
121
110
الموعظة الثامنة عشرة: مسيرة السبايا والقيادة الزينبيّة للثورة
ولمّا أدار ابن مرجانة بصره في بقيّة الأسرى من أهل البيت (عليهم السلام) فوقع بصره على الإمام زين العابدين (عليه السلام)، وقد أنهكته العلّة فسأله: من أنت؟ فقال (عليه السلام): «عليّ بن الحسين» -بعد حوار مع الإمام- فالتفت إلى بعض جلّاديه فقال له: خذ هذا الغلام واضرب عنقه. فانبرت العقيلة (عليها السلام) بشجاعة لا يرهبها سلطان، فاحتضنت ابن أخيها، وقالت لابن مرجانة: «حسبك يَابْنَ زِيَادٍ مَا سَفَكْتَ مِن دِمَائِنَا، إِنَّكَ لَمْ تُبْقِ مِنّا أَحَدًا، فَإنْ كُنْتَ عَزَمْتَ عَلى قَتْلِهِ فَاقْتُلْني مَعَهُ...»[1]. ودَهِش الطاغية وانخذل، وقال متعجّبًا: دعوه لها، عجبًا للرَحِم ودَّت أن تُقتَل معه.
ولمّا أمر ابن مرجانة بحبس مُخدَّرات الرسالة وعقائل الوحي، فأُدخلْنَ في سجن، وقد ضُيِّقَ عليهنّ أشدَّ التضييق، فكان يجري على كلّ واحدة في اليوم رغيفًا واحدًا من الخبز، وكانت العقيلة تُؤثِر أطفال أخيها برغيفها وتبقى ممسِكة حتّى بان عليها الضعف، فلم تتمكّن من النهوض وكانت تصلّي من جلوس، وفزع الإمام زين العابدين (عليه السلام) من حالتها فأخبرته بالأمر.
السيّدة زينب في مواجهة الطاغية يزيد
وفي اليوم التالي أمر ابن زياد جنده بالتوجّه بسبايا آل البيت (عليهم السلام) إلى الشام، إلى الطاغية يزيد بن معاوية، وأمر أن يكبّل الإمام زين العابدين (عليه السلام) بالقيود، وأركب بنات الرسالة الإبل الهزّل تنكيلًا بهنّ، وهناك كان للسيّدة زينب (عليها السلام) العديد من المواقف منها:
[1] راجع: العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج45، ص117.
122
111
الموعظة الثامنة عشرة: مسيرة السبايا والقيادة الزينبيّة للثورة
1. أمن العدل يابن الطلقاء
لمّا وصلت القافلة إلى الشام في مجلس يزيد وأظهر الطاغية فرحته الكبرى بإبادته لعترة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأخذ يهزّ أعطافه جذلًا متمنّيًا حضور القتلى من أهل بيته ببدر ليريهم كيف أخذ بثأرهم من ذرّيّة النبيّ (صلى الله عليه وآله)، وراح يترنّم هذه الأبيات التي مطلعها:
لَيْـتَ أَشـْيَاخِي بِبَدرٍ شَـهِدُوا
جَزَعَ الْخَزْرَجِ مِـنْ وَقْعِ الأَسَـلْ
ولمّا سمعت العقيلة هذه الأبيات ألقت خطبتها الشهيرة بفصاحة أبيها عليّ (عليه السلام) وشجاعته وقد ضمّنتها أعنف المواقف لفرعون عصره يزيد، وممّا قالته (عليها السلام):
«أَمِنَ الْعَدْلِ يَابْنَ الطُّلَقَاءِ تَخْدِيرُكَ حَرَائِرَكَ وَإمَاءَكَ وَسُوقُكَ بَنَاتِ رَسُولِ اللهِ سَبَايَا؟! قدْ هَتَكْتَ سُتورَهُنَّ، وَأَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ، تَحْدُو بِهِنَّ الأَعْدَاءُ مِنْ بَلَدِ إلى بلدٍ... وَيَتَصَفَّحُ وُجُوهَهُنَّ الْقَرِيبُ وَالبَعِيدُ».
2. الدعاء على الظالم في محضره
فقالت (عليها السلام): «فَكِدْ كَيْدَكَ، وَاسْعَ سَعْيَكَ، ونَاصِبْ جَهْدَكَ، فَوَاللهِ لاَ تَمْحُوَ ذِكْرَنَا، ولاَ تُمِيتُ وَحْيَنَا، وَلاَ تُدْركُ أَمَدَنَا، وَلاَ تَرْحَضُ عَنْكَ عَارَهَا»[1].
3. اليقين والتسليم بالحقّ
فقالت (عليها السلام) مخاطبة يزيد -مؤكّدة أنّ نهج محمّد لن يمحوه
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج45، ص134.
123
112
الموعظة الثامنة عشرة: مسيرة السبايا والقيادة الزينبيّة للثورة
أحد مهما عظمت التضحيات-: «كِدْ كَيْدَكَ، وَاسْعَ سَعْيَكَ، ونَاصِبْ جَهْدَكَ، فَوَاللهِ لاَ تَمْحُوَ ذِكْرَنَا، ولاَ تُمِيتُ وَحْيَنَا، وَلاَ تُدْركُ أَمَدَنَا، وَلاَ تَرْحَضُ عَنْكَ عَارَهَا».
4. توبيخ يزيد الظالم في مجلسه
حيث قالت (عليها السلام): «وَلَئِنْ جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِي مُخَاطَبَتَكَ، إِنِّي لأَسْتَصْغِرُ قَدْرَكَ، وَأَسْتَعْظِمُ تَقْرِيعَكَ، وَأَسْتَكْثِرُ تَوْبِيخَكَ، لَكِنِ الْعُيُونُ عَبْرىَ، وَالصُّدَورُ حَرّى»[1].
5. الظالم من حزب الشيطان
فصرّحت (عليها السلام) قائلة: «أَلاَ فَالعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِقَتْلِ حِزْبِ اللهِ النُّجبَاءِ بِحِزْبِ الشَّيْطَانِ الطُّلَقَاءِ...»[2].
بعض ما يستنتج من خطبة زينب (عليها السلام)
1. لقد كشفت الظنّ الزائف ليزيد، بل لجميع الطغاة على مرّ التاريخ الذين يحسبون أنّ ما حقّقوه من غلبة على أعدائهم بالظلم والعدوان كرامة وقوّة وعظمة، وهو في الحقيقة ضعف وخسارة؛ لأنّه تجاوز لحدود العقل والشرع والمنطق السليم، واستَشهدَتْ بقوله -تعالى-: ﴿وَلَا يَحسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُملِي لَهُم خَيرٞ لِّأَنفُسِهِم إِنَّمَا نُملِي لَهُم لِيَزدَادُواْ إِثمٗا وَلَهُم عَذَابٞ مُّهِينٞ﴾[3].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج45، ص134.
[2] المصدر نفسه، ص135.
[3] سورة آل عمران، الآية 178.
124
113
الموعظة الثامنة عشرة: مسيرة السبايا والقيادة الزينبيّة للثورة
2. كشف عمق الجريمة الأمويّة في هتك حرمات العائلة النبويّة من خلال الاستعراض العامّ لحرائر آل محمّد من بلد إلى بلد وهي جريمة لا تدانيها جريمة أخرى وهي سبي بنات رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهذا ما لا تعرف له الإنسانيّة مثلًا في سابق عهدها.
3. أعادت إلى الأذهان أنّ ما أقدم عليه يزيد امتداد لما أقدمت عليه جدّته هند وجدّه أبو سفيان في حرب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنّ هذه الجريمة هي امتداد لتلك الجريمة التي أقدمت عليها جدّته حين مضغت كبد حمزة عمّ الرسول (صلى الله عليه وآله).
4. أوضحت حقيقة إلهيّة أنَّ كلَّ جريمة أو فعل قبيح يقدم عليه الإنسان إنّما يضُرّ نفسه، ويحرق بها مستقبله، ولهذا خاطبت يزيد قائلة (عليها السلام): «فوالله ما فَريتَ إلّا جلدَك، ولا حززت إلّا لحمك»[1]، وإنّ الموت الحقيقيّ قد حلّ بك وبأضرابك وأسلافك، وإنّ الحياة الخالدة قد منحت للذين قتلتهم ومثّلت بأجسادهم ورفعت رؤوسهم على الرماح، وأكّدت ذلك باستشهادها بقوله -تعالى-: ﴿وَلَا تَحسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَموَٰتَۢا بَل أَحيَاءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقُونَ﴾[2].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج45، ص134.
[2] سورة آل عمران، الآية 169.
125
114
الموعظة التاسعة عشرة: أساليب العدوّ في القضاء على ثورة الإمام الحسين (عليه السلام)
الموعظة التاسعة عشرة: أساليب العدوّ في القضاء على ثورة الإمام الحسين (عليه السلام)
بيان أبرز أساليب النظام الأمويّ التي مارسها للقضاء على ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) ومنعها من تحقيق أهدافها.
محاور الموعظة
طلب البيعة منه
محاولة قتل الإمام في مكّة
منعه من دخول الكوفة
قتله باسم الدين
التشهير بهم أثناء السبي
تصدير الموعظة
السيّدة زينب (عليها السلام): «فوالله، لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا»[1].
[1] ابن نما الحلّيّ، مثير الأحزان، ص81.
126
115
الموعظة التاسعة عشرة: أساليب العدوّ في القضاء على ثورة الإمام الحسين (عليه السلام)
في عمليّة الصراع بين الحقّ والباطل لم يألُ أعداء الإسلام جهدًا في سبيل إسكات صوت الحقّ وإخماده بالتضييق والتعذيب والسجن وصولًا إلى القتل، وهذا ما تشهد به حقائق التاريخ، والمتتبّع لأحداث كربلاء يجد أنّ أعداء الإسلام لم يوفّروا أيّ طريقة من أجل خنق الثورة في مهدها أو مصادرة شعاراتها أو تضييع أهدافها.
طلب البيعة منه
واستهدف هذا الإجراء -من حكومة يزيد فور موت معاوية- عدم توفير الوقت الكافي للإمام الحسين (عليه السلام) بإعداد العدّة واستنصار الناس لمواجهة النظام الحاكم، وكان قرار الحكومة واضحًا بأخذ البيعة منه أو قتله كما ورد في رسالة يزيد إلى الوليد بن عتبة واليه على المدينة، وهذا ما عبّر عنه الحسين (عليه السلام) بقوله: «ألا وإنّ الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين اثنتين بين السلّة والذلّة وهيهات منّا الذلّة»[1].
محاولة قتل الإمام في مكّة
فقد كان واضحًا أنّ خروج الإمام المفاجىء من المدينة إلى مكّة يستهدف الخروج على النظام الحاكم وإعلان الثورة والعصيان على حكومة يزيد، فأرسل يزيد إلى واليه على المدينة بالحؤول دون ذلك وأمره بقتله ولو وجد معلّقًا بأستار الكعبة[2].
[1] ابن نما الحلّي، مثير الأحزان، ص40.
[2] السيّد محمّد رضا الجلاليّ، الإمام الحسين سماته وسيرته، ص92.
127
116
الموعظة التاسعة عشرة: أساليب العدوّ في القضاء على ثورة الإمام الحسين (عليه السلام)
منعه من دخول الكوفة
واتخذت حكومة يزيد جملة من الإجراءات لمنع الإمام من دخول الكوفة واستنصار أهلها:
أوّلًا: قتل مسلم بن عقيل، وكانت هذه رسالة واضحة للإمام الحسين (عليه السلام) ولأهل الكوفة باتخاذ حكومة يزيد قرار المواجهة والحرب والتصدّي لمجيء الحسين بأيّ وسيلة.
ثانيًا: إرسال الحرّ على رأس كتيبة من الجيش تجعجع بالحسين (عليه السلام) وتمنعه من دخول الكوفة، وأن تنزله في أرضٍ جدباء لا يقوى فيها على شيء.
ثالثًا: عزل النعمان بن بشير وتعيين عبيد الله بن زياد المعروف بقسوته وبطشه بشيعة عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) واليًا للكوفة.
قتله باسم الدين
قول ابن زياد للسيّدة زينب (عليها السلام): كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ فأجابته: «ما رأيت إلّا جميلًا، قومٌ كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاجّ وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذٍ، ثكلتك أمّك يابن مرجانة»[1].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج45، ص116.
128
117
الموعظة العشرون: بَرَكات التقوى في القرآن الكريم
الموعظة العشرون: بَرَكات التقوى في القرآن الكريم
الحثّ على التحلّي بِصِفة التقوى التي يُرشدنا القرآن الكريم إليها.
محاور الموعظة
تفسير التقوى
خصائِص المُتّقين
تصدير الموعظة
﴿يَٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلنَٰكُم شُعُوبٗا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ ٱللَّهِ أَتقَىٰكُم إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ﴾[1].
[1] سورة الحجرات، الآية 13.
132
118
الموعظة العشرون: بَرَكات التقوى في القرآن الكريم
إنّ تقوى الله -تعالى- حقّ تُقاته، التي أمر بها الله -تعالى- في قوله: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسلِمُونَ﴾[1]، بيّنها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بقوله: «اتّقوا الله حَقّ تُقاته؛ أن يُطاع فلا يُعصى، ويُذْكر فلا يُنسى»[2]. ولا بدّ مِن أن يُقدِّم المرء التقوى على ما سِواها، مِن اللون أو الشكل أو اللُغة أو التاريخ أو الجغرافيا، فَعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنّ ربّكم واحد، وإنّ أباكم واحد، ودينكم واحد، ونبيّكم واحد، ولا فضلَ لِعربيّ على عَجَميّ، ولا عَجَميّ على عربيّ، ولا أحمر على أسوَد، ولا أسودَ على أحمر، إلّا بالتقوى»[3].
تفسير التقوى
عن الإمام الصادق (عليه السلام) -لَمّا سُئِل عن تفسير التقوى-: «ألّا يَفقِدَك الله حيثُ أَمَرَك، ولا يَراك حيث نَهاك»[4].
ويقول -تعالى-: ﴿وَلِبَاسُ ٱلتَّقوَىٰ ذَٰلِكَ خَيرٞ﴾.
وعن الإمام عليّ (عليه السلام): «ثَوْب التُقى أشرفُ الملابس»[5].
بَرَكات التقوى
1. نزول البَرَكات
قال -تعالى-: ﴿وَلَو أَنَّ أَهلَ ٱلقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَفَتَحنَا عَلَيهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكسِبُونَ﴾[6].
[1] سورة آل عمران، الآية 102.
[2] الشيخ الصدوق، معاني الأخبار، ص240.
[3] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج4، ص3629.
[4] المولى المازندرانيّ، شرح أصول الكافي، ج1، ص118.
[5] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج4، ص3626.
[6] سورة الأعراف، الآية 96.
133
119
الموعظة العشرون: بَرَكات التقوى في القرآن الكريم
2. المغفرة والفرقان
قال -تعالى-: ﴿إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجعَل لَّكُم فُرقَانٗا وَيُكَفِّر عَنكُم سَئَِّاتِكُم وَيَغفِر لَكُم وَٱللَّهُ ذُو ٱلفَضلِ ٱلعَظِيمِ﴾[1].
3. تكفير الذنوب
قال -تعالى-: ﴿ذَٰلِكَ أَمرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥ إِلَيكُم وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّر عَنهُ سَئَِّاتِهِۦ وَيُعظِم لَهُۥ أَجرًا﴾[2].
4. قبول الأعمال
قال -تعالى-: ﴿وَٱتلُ عَلَيهِم نَبَأَ ٱبنَي ءَادَمَ بِٱلحَقِّ إِذ قَرَّبَا قُربَانٗا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَم يُتَقَبَّل مِنَ ٱلأخَرِ قَالَ لَأَقتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلمُتَّقِينَ﴾[3].
وعن الإمام عليّ (عليه السلام): «صِفَتان لا يَقبل الله -سبحانه- الأعمال إلّا بِهما: التُقى والإخلاص»[4].
5. الفَرَج والرِزق
قال -تعالى-: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجعَل لَّهُۥ مَخرَجٗا ٢ وَيَرزُقهُ مِن حَيثُ لَا يَحتَسِبُ﴾[5].
وقال -تعالى-: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجعَل لَّهُۥ مِن أَمرِهِۦ يُسرٗا﴾[6].
[1] سورة الأنفال، الآية 29.
[2] سورة الطلاق، الآية 5.
[3] سورة المائدة، الآية 27.
[4] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص304.
[5] سورة الطلاق، الآية 3.
[6] سورة نفسها، الآية 4.
134
120
الموعظة العشرون: بَرَكات التقوى في القرآن الكريم
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لَو أنّ السماوات والأرض كانَتا رَتْقًا على عبدٍ، ثمّ اتّقى الله، لَجَعَل اللهُ له مِنهما فَرَجًا ومَخرَجًا»[1].
وعنه (صلى الله عليه وآله) -لَمّا قرأ ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجعَل لَّهُ مَخرَجٗا﴾: «مِن شُبهات الدنيا، ومِن غَمَرات الموت، وشدائد يوم القيامة»[2].
6. المقام الرفيع في الآخرة
قال -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٖ﴾[3].
وقال -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَنَهَرٖ ٥٤ فِي مَقعَدِ صِدقٍ عِندَ مَلِيكٖ مُّقتَدِرِ﴾[4].
وقال أيضًا: ﴿وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ رَبَّهُم إِلَى ٱلجَنَّةِ زُمَرًا﴾[5].
7. العاقبة للمُتّقين
قال -تعالى-: ﴿وَأمُر أَهلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصطَبِر عَلَيهَا لَا نَسَٔلُكَ رِزقٗا نَّحنُ نَرزُقُكَ وَٱلعَٰقِبَةُ لِلتَّقوَىٰ﴾[6].
وقال -تعالى-: ﴿تِلكَ ٱلدَّارُ ٱلأخِرَةُ نَجعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّٗا فِي ٱلأَرضِ وَلَا فَسَادٗا وَٱلعَٰقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ﴾[7].
[1] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج4، ص3632.
[2] المصدر نفسه.
[3] سورة الدخان، الآية 51.
[4] سورة القمر، الآيتان 54 - 55.
[5] سورة الزمر، الآية 73.
[6] سورة طه، الآية 132.
[7] سورة القصص، الآية 83.
135
121
الموعظة العشرون: بَرَكات التقوى في القرآن الكريم
وقال أيضًا: ﴿تِلكَ مِن أَنبَاءِ ٱلغَيبِ نُوحِيهَا إِلَيكَ مَا كُنتَ تَعلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَومُكَ مِن قَبلِ هَٰذَا فَٱصبِر إِنَّ ٱلعَٰقِبَةَ لِلمُتَّقِينَ﴾[1].
8. مفتاح الصلاح
قال -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُم طَٰئِفٞ مِّنَ ٱلشَّيطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبصِرُونَ﴾[2].
وعن الإمام الصادق (عليه السلام) -لَمّا سُئِل عن قوله -تعالى- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُم﴾-: «هُو الذَنْب، يَهمّ بِه العبد، فيتذكّر، فَيَدَعه»[3].
خصائِص المُتّقين
1. التصديق بالرسالة
قال -تعالى-: ﴿وَٱلَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدقِ وَصَدَّقَ بِهِۦ أُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلمُتَّقُونَ﴾[4].
2. فِعل الخيرات
قال -تعالى-: ﴿لَّيسَ ٱلبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُم قِبَلَ ٱلمَشرِقِ وَٱلمَغرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلبِرَّ مَن ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱليَومِ ٱلأخِرِ وَٱلمَلَٰئِكَةِ وَٱلكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۧنَ وَءَاتَى ٱلمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلقُربَىٰ وَٱليَتَٰمَىٰ وَٱلمَسَٰكِينَ وَٱبنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّائِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلمُوفُونَ بِعَهدِهِم إِذَا عَٰهَدُواْ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلبَأسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلبَأسِ أُوْلَٰئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلمُتَّقُونَ﴾[5].
[1] سورة هود، الآية 49.
[2] سورة الأعراف، الآية 201.
[3] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج4، ص3628.
[4] سورة الزمر، الآية 33.
[5] سورة البقرة، الآية 177.
136
122
الموعظة العشرون: بَرَكات التقوى في القرآن الكريم
3. إحياء الليل
قال -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٍ ١٥ ءَاخِذِينَ مَا ءَاتَىٰهُم رَبُّهُم إِنَّهُم كَانُواْ قَبلَ ذَٰلِكَ مُحسِنِينَ ١٦ كَانُواْ قَلِيلٗا مِّنَ ٱلَّيلِ مَا يَهجَعُونَ ١٧ وَبِٱلأَسحَارِ هُم يَستَغفِرُونَ ١٨ وَفِي أَموَٰلِهِم حَقّٞ لِّلسَّائِلِ وَٱلمَحرُومِ﴾[1].
4. أهل العَفْو والتسامح
قال -تعالى-: ﴿وَأَن تَعفُواْ أَقرَبُ لِلتَّقوَىٰ﴾[2].
5. أهل العَدْل والقِسْط
قال -تعالى-: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلقِسطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَو عَلَىٰ أَنفُسِكُم أَوِ ٱلوَٰلِدَينِ وَٱلأَقرَبِينَ إِن يَكُن غَنِيًّا أَو فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلهَوَىٰ أَن تَعدِلُواْ وَإِن تَلوُۥاْ أَو تُعرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعمَلُونَ خَبِيرٗا﴾[3].
وقال -تعالى-: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُستَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِۦ ذَٰلِكُم وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ﴾[4].
6. أهل الهداية بالقرآن
قال -تعالى-: ﴿ذَٰلِكَ ٱلكِتَٰبُ لَا رَيبَ فِيهِ هُدٗى لِّلمُتَّقِينَ... أُوْلَٰئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِم وَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلمُفلِحُونَ﴾[5].
[1] سورة الذاريات، الآية 15.
[2] سورة البقرة، الآية 237.
[3] سورة النساء، الآية 135.
[4] سورة الأنعام، الآية 153.
[5] سورة البقرة، الآيات 2 - 5.
137
123
الموعظة العشرون: بَرَكات التقوى في القرآن الكريم
وأهل البيت (عليهم السلام) هُم أَهل التقوى -كما في بعض زيارات أئمّة البقيع (عليهما السلام)-: «السلام عليكم أئمّة الهُدى، السلام عليكم أهلَ التَقوى»[1].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج4، ص559.
138
124
الموعظة الحادية والعشرون: الإعراضُ عن ذِكر الله
الموعظة الحادية والعشرون: الإعراضُ عن ذِكر الله
بيان خطورة الإعراض عن ذِكر الله -تعالى-، والحثّ على بناء علاقة جيّدة مع الله وأوليائه وكِتابه.
محاور الموعظة
آيات الله ونِعَمُه لا تُحصى
معنى الإعراض عن ذِكر الله، ومصاديقه
أسباب الإعراض
عاقبة الإعراض عن ذِكر الله في الدنيا
عمر الآخرة عقوبة الإعراض
تصدير الموعظة
﴿وَمَن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فَإِنَّ لَه مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُرُهُ يَومَ ٱلقِيَٰمَةِ أَعمَىٰ ١٢٤ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرتَنِي أَعمَىٰ وَقَد كُنتُ بَصِيرٗا ١٢٥ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ ٱليَومَ تُنسَىٰ ١٢٦ وَكَذَٰلِكَ نَجزِي مَن أَسرَفَ وَلَم يُؤمِن بَِٔايَٰتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلأخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبقَىٰ﴾[1].
[1] سورة طه، الآيات 124 - 127.
139
125
الموعظة الحادية والعشرون: الإعراضُ عن ذِكر الله
آيات الله ونِعَمُه لا تُحصى
إنّ آيات الله وتجلّياتها في هذا الوجود لا تنفكّ ولا تنقطع بُرهة مِن الزمن، فأين صرفْتَ بصيرتك وبَصرك، وأعملْتَ عقلك وقلبك، وَجَدْتَ آيات الله، كأنّ الله يُخاطبك، في عقلك وإحساسك وعواطفك ومشاعرك، بأنّه هنا وهناك وهنالك، ومعك وفيك.
قال -تعالى-: ﴿فَأَينَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجهُ ٱللَّهِ﴾[1].
فالله يتجلّى لنا، ويتراءى لِبصائرنا، لِيُذكّرنا به، بأسمائه، بأفعاله، بصفاته، وبآلائه، ولكنْ نحن الذين نُعرِض ونغرق في ظُلماتٍ بعضها فوق بعضٍ، مِن الغفلة والجهل والشهوات والميول والرغبات، مُضافًا إلى ما يغشى أعيُن قلوبنا مِن غشاوة الأنا وحُبّ الذات، وما يستعمرها مِن القسوة والأمراض، لِتغدوَ مَقرًّا لِعدوّ الله وطريدِه الرجيم.
وإذا راجعنا مسلسل حياتنا، لَوجدناه مليئًا بالألطاف الإلهيّة والعنايات الربّانيّة. فتارةً تتلقّانا يَدُ الرحمة قبل السقوط في وديان المعصية، وأخرى تحجز عنّا البلاءات والمصائب، وثالثةً تُخوِّلنا نِعمةً نذوق حلاوتها، ورابعةً تدفع عدُوًّا جبّارًا أو مَرضًا قاتلًا. فحقيقٌ على أن نقول مع القرآن الكريم: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحصُوهَا﴾[2].
نعم، إنّ النِعَم الإلهيّة لا قدرة لنا على أن نحصيها، ومع ذلك فإنّ الكثير منّا لا يراها، ولا يشعر بها، ولا يتفاعل معها، وغالبًا ما يستفيد
[1] سورة البقرة، الآية 115.
[2] سورة إبراهيم، الآية 34.
140
126
الموعظة الحادية والعشرون: الإعراضُ عن ذِكر الله
منها. والأَوْلى ألّا يشكر الله عليها حينها، فكيف يشكر على النِعمة مَن لا يراها نِعمة، أو مَن لا يراها أبدًا؟ وأنّى له حينها أن يغتنمها ويستفيد منها؟
معنى الإعراض عن ذِكر الله، ومصاديقه
الإعراض عن ذِكر الله هو إشاحة الوجه عنه، أو إغفاله وإهماله، وبالمعنى القرآنيّ: نسيانه. فَمِن مصاديق ذِكر الله الالتفات إلى ألطافه ونِعَمه، ومنها الرزق، كالمال والذرّيّة والأَمْن، ومِنها ما هو معنويٌّ، كالهداية والإيمان، ومِنها وسائل الهداية، كالآيات الأنفُسيّة والآفاقيّة، ومِنها -وهو أجلاها- احترام الله وعدم الإقدام على عصيانه -إذ إنّ العالم مَحضر الله، ومع ذلك نعصيه، وهو يشهد علينا-، ومِنها الذِكر اللسانيّ، كالتسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك.
ومِن ذِكر الله القرآنُ الكريم، فإنّ عدم العناية به، وإهمال قراءته وعدم التدبُّر فيها، هو إعراض عنه ونسيان له. ومنه النبيّ (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام)، فإنّه الذِكر والمُذكِّر بالله، وهُم أهل الذِكر، وإنّ نِسيانه ونسيانهم، وإهماله وإهمالهم، وعدم الإقرار بفضلهم، وعدم التأسّي بهم والاقتداء بِسلوكهم وسِيَرِهم، هو إعراض.
فقد أمَرَنا الله بِعدم نسيان ذوي الفضل علينا، وقَرَن الشهادة له بِالوحدة بالشهادة للنبيّ (صلى الله عليه وآله)، وجعلها جزءًا مِن الأذان والإقامة، وجزءًا مِن الصلاة، بل صار أبخل الناس مَن سَمِع اسم النبيّ (صلى الله عليه وآله) ولم
141
127
الموعظة الحادية والعشرون: الإعراضُ عن ذِكر الله
يُصَلِّ عليه، وكذلك تَرْك ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) -في إجابة الإمام الصادق (عليه السلام) مَن سأله عن الآية-.
ومن الإعراض -أيضًا- نسيان الآخرة والموت ولقاء الله -تعالى-، وعدم الاستعداد لهم. وفي الآية التي سبقت موضوعنا، قال -تعالى-: ﴿فَإِمَّا يَأتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدٗى﴾[1]، فعدم اتّباع الهدى الإلهيّ -مُطلقًا- هو إعراض عن ذِكر الله أيضًا.
أسباب الإعراض
إنّ أسباب إعراض الإنسان عن ذِكر الله كثيرة، منها العامّ ومنها الخاصّ؛ يأتي بالدرجة الأولى ضعف الإيمان، وضعف العقيدة، ثمّ الانكباب المفرط على الدنيا والعلاقة بالمادّيّات، وتغييب المعنويّات والعلاقة بالغَيْب والغيبيّات؛ أي الضعف الروحيّ، بل الفقر المعنويّ والروحيّ، وطغيان الشهوات وانغماس الإنسان بها، والغفلة وقسوة القلب نتيجة الذنوب التي يتراكم أثرها على صفحة القلب، فتضعف البصيرة، وتتدرّج في الضعف إلى العمر الكامل؛ ﴿كَلَّا بَل رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكسِبُونَ﴾[2].
عاقبة الإعراض عن ذِكر الله في الدنيا
ذَكَر الله -تعالى- في القرآن الكريم عقوبتيْن لمن يُعرِض عن ذِكره ولا يهتدي بِهَدْيِه وهَدْيِ أوليائه؛ ﴿وَمَن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ
[1] سورة البقرة، الآية 38.
[2] سورة المطفّفين، الآية 14.
142
128
الموعظة الحادية والعشرون: الإعراضُ عن ذِكر الله
ضَنكٗا وَنَحشُرُهُۥ يَومَ ٱلقِيَٰمَةِ أَعمَىٰ﴾[1]. فالعقوبة الأولى هي المعيشة الضنك؛ أي ضيق العيش الذي قد يكون بالفقر والعَوَز والحاجة -كما فسّره بعضهم لغويًّا-، ولكن قد يكون عكسُها، مع الاضطراب وفقدان الطمأنينة والخوف والقلق. فإن كان ذِكر الله بِقَيْدِ الإيمان يورث الطمأنينة والسكينة؛ ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكرِ ٱللَّهِ تَطمَئِنُّ ٱلقُلُوبُ﴾[2]، فإنّ العكس يَنتج عنه الضِدّ؛ أي إنّ عدم الإيمان، والإعراض عن ذِكر الله يورث الاضطراب والقلق والخوف والحزن. وهذا هو العيش الضيّق والمعيشة الضنك، فضيق الحياة -غالبًا- يتولّد مِن الفقر المعنويّ والنقائص الدنيويّة وانعدام الغِنى الروحيّ.
فَمَن لا يؤمن بالله والغَيْب، ولا بالحياة بعد الموت، ومَن لا يعدّ لِذلك عُدّته، سيكون في حالةٍ مِن عدم الطمأنينة إلى المستقبل، وسيحكمه الخوف مِن ذهاب قدراته البدنيّة والماليّة وغيرها. وهذه العقوبة قد تكون في البرزخ، لا في الدنيا فقط.
عمر الآخرة عقوبة الإعراض
أمّا العقوبة الثانية، وهي عقوبة أُخرويّة، فهي أن يَحشر الله -تعالى- المُعرِض عن ذِكره أعمى. فَعالَم الآخرة عالمُ ظهور الحقائق، تتجسّم فيه الأعمال والأخلاق. والحقيقة أنّ المُعرِض عن ذِكر الله -تعالى- أغمضَ عينَيْ قلبه عن رؤية آيات الله وآلائه، وأهمل استخدام بصيرته. فإن كانت الدنيا بالبصر، فالآخرة بالبصيرة، وإن كانت العقوبة
[1] سورة طه، الآية 124.
[2] سورة الرعد، الآية 28.
143
129
الموعظة الحادية والعشرون: الإعراضُ عن ذِكر الله
﴿جَزَاءٗ وِفَاقًا﴾[1] -أي مِن سِنخ الذنب-، فإنّ أعمى البصيرة في الدنيا أعمى البصيرة في الآخرة. ومِن ناحية أُخرى، فإنّ المُعرِض عن ذِكر الله يكون قد أهمل كلّ ما عرضَ الله له مِن آيات لِيراها ويراه بها، فتكون العقوبة الإهمال المعبَّر عنه بالنسيان؛ ﴿قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ ٱليَومَ تُنسَىٰ﴾[2].
ولَيْتَ العقوبة تتوقّف عند ذلك! فإنّ الأمر أشدّ؛ قال -تعالى-: ﴿وَكَذَٰلِكَ نَجزِي مَن أَسرَفَ وَلَم يُؤمِنۢ بَِٔايَٰتِ رَبِّهِۦ وَلَعَذَابُ ٱلأخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبقَىٰ﴾[3].
خاتمة
إنّ الإعراض عن ذِكر الله عملٌ مُهلِك يجب أن نحذر منه، فَعَلينا أن نوقظ قلوبنا مِن الغفلة بألّا نترك الدعاء والتأمّل في الكون والأنفُس، وأن نحرص على أفضل العلاقة بالله -أوّلًا- ونبيّه -ثانيًا- وأولياء الله وكِتابه وبيوته، وأن نجعل ألسنتنا رطبة بِذِكر الله، وأن نتذكّر الله عندما نُرزق نِعمة أو تُدفع عنّا نقمة، أو -خاصّةً- عندما نهمُّ بِمعصية.
[1] سورة النبأ، الآية 26.
[2] سورة طه، الآية 126.
[3] سورة طه، الآية 127.
144
130
الموعظة الثانية والعشرون: الإخلاص في العمل
الموعظة الثانية والعشرون: الإخلاص في العمل
بيان أنّ قيمة أيّ عملٍ مرهونة بالنيّة والدافع الذي ينبغي أن يكون التقرُّب إلى الله.
محاور الموعظة
تعريف الإخلاص
الإخلاص في القرآن
أهمّيّة الإخلاص وفضله
موانع الإخلاص
تصدير الموعظة
﴿فَمَن كَانَ يَرجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشرِك بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا﴾[1].
[1] سورة الكهف، الآية 110.
145
131
الموعظة الثانية والعشرون: الإخلاص في العمل
الإخلاص في العمل مِن أهمّ الأمور القلبيّة التي تحتاج رقابةً شديدة مِن الإنسان، لِكَوْنها أوّل الأهداف التي يحاول الشيطان الولوج فيها، بعد عَجْزِه عن ثَنْيِ الإنسان عن القيام بِعَمل الخير، فَيُزيّن له أمر الإشراك في نيّته، لِيُحبِط له أجْرَه، بعد أن عَجِز عن أن يُحبِط له عمله.
تعريف الإخلاص
تطهير القلب مِن مُلاحظة غيرِ وجه الله -تعالى- وَرِضاه -حتّى في الرجاء بالثواب والخوف مِن العقاب-، ومِن الرِياء والسُمعة وحُبّ الجاه وأمثال ذلك، فإنّ ذلك شِرْكٌ خَفِيّ؛ لذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «دبيب الشِرْكِ في أُمّتي أَخفى مِن دبيب النملة السوداء على الصخرة الصَمّاء في الليلة الظَلْماء»[1].
والإخلاص يُناقِض الرياء. وحقيقة الرياء إرادةُ مَدح الناس على العمل، والسرور به، والتقرُّب إليهم بِإظهار الطاعة وطَلَب المنزلة في قلوبهم، والميل إلى إعظامهم له وتوقيرهم إيّاه، واستِجلاب تسخيرهم لِقضاء حوائجه وقيامهم بمهمّاته؛ وهو شِرْكٌ بالله العظيم.
الإخلاص في القرآن
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله -عزَّ وجلَّ- ﴿حَنِيفٗا مُّسلِمٗا﴾[2]: «خالصًا مُخلصًا، لَيس فيه شيءٌ مِن عِبادة الأوثان»[3].
[1] المولى المازندرانيّ، شرح أصول الكافي، ج8، ص49.
[2] سورة آل عمران، الآية 67.
[3] المولى المازندرانيّ، شرح أصول الكافي، ج8، ص49.
146
132
الموعظة الثانية والعشرون: الإخلاص في العمل
وليس المقصود الأوثان المعروفة، بل يتعدّى ذلك إلى عبادة الشياطين في إغوائها، وعبادة النفْس في أهوائها، وقد نهى -جلّ شأنه- عن عبادتهما، فقال: ﴿أَلَم أَعهَد إِلَيكُم يَٰبَنِي ءَادَمَ أَن لَّا تَعبُدُواْ ٱلشَّيطَٰنَ﴾[1]، وقال -تعالى-: ﴿أَفَرَءَيتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ﴾[2].
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله -تعالى- ﴿لِيَبلُوَكُم أَيُّكُم أَحسَنُ عَمَلٗا﴾[3]: «ليس يعني: أكثر عملًا، ولكن أَصوبكم عملًا. وإنّما الإصابة: خَشية الله، والنيّة الصادقة والحَسَنة»[4].
أهمّيّة الإخلاص وفضله
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «مَن تَرَك معصيةً مَخافة الله -عزَّ وجلَّ-، أرضاه يوم القيامة»[5].
وعن الإمام عليّ (عليه السلام): «أفضل الأعمال أَحمزها»[6]؛ يفيد أنّ النيّة أحمزها، وهو كذلك؛ لأنّ النيّة الخالصة تتوقّف على إقلاع القلب عن حُبّ الدنيا، ونَزْعِه عن الميل إلى ما سوى الله -تعالى-، وهذا أشقّ الأشياء على النفْس.
ولِهذا قال (صلى الله عليه وآله) بعد رجوعه مِن إحدى المعارك: «رجعنا مِن الجهاد
[1] سورة يس، الآية 60.
[2] سورة الجاثية، الآية 23.
[3] سورة هود، الآية 7.
[4] الشيخ هادي النجفيّ، موسوعة أحاديث أهل البيت، ج1، ص127.
[5] المولى المازندرانيّ، شرح أصول الكافي، ج8، ص53.
[6] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج3، ص2126.
147
133
الموعظة الثانية والعشرون: الإخلاص في العمل
الأصغر إلى الجهاد الأكبر»[1]. فقد عدَّ الجهاد -الذي هو أشقّ الأعمال البدنيّة- أصغر مِن جهاد النفْس وصَرْفِ وَجْهها عن غير الله؛ لأنّه أشقّ، والأشقّ أفضل -لِما مرّ-.
وفي روايةٍ أنّ رجلًا سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن قَوْل الله -عزَّ وجلَّ: ﴿إِلَّا مَن أَتَى ٱللَّهَ بِقَلبٖ سَلِيمٖ﴾[2]، فقال (صلى الله عليه وآله): «القلب السليم الذي يَلقى ربّه ولَيْس فيه أحدٌ سِواه... وكلّ قلبٍ فيه شِرْكٌ أو شَكّ فَهو ساقِط، وإنّما أراد بالزُهد في الدنيا، لِتَفرغ قلوبهم للآخرة»[3].
وقد جاء السؤال عن القلب السليم في الآية، لِأنّ القرآن جَعله النافع الوحيد للإنسان يوم القيامة.
موانع الإخلاص
1. الأموال والأولاد: فلا يجعلهما مصدر غفلةٍ ولَهْوٍ عن الصراط السَوِيّ، فقد حذّر الله -تعالى- مِن ذلك بِقوله: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلهِكُم أَموَٰلُكُم وَلَا أَولَٰدُكُم عَن ذِكرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفعَل ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلخَٰسِرُونَ﴾[4].
2. مَدّ النظر إلى دنيا الآخرين: فالمطلوب أن يقنَع المرء بِما قَسَم اللهُ له، وأنّ في ذلك صَلاحه وهُداه، فعن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: «طوبى لِمَن أخلصَ لله العبادة
[1] المولى المازندرانيّ، شرح أصول الكافي، ج8، ص53.
[2] سورة الشعراء، الآية 89.
[3] المولى المازندرانيّ، شرح أصول الكافي، ج8، ص54.
[4] سورة المنافقون، الآية 9.
148
134
الموعظة الثالثة والعشرون: التسليم
الموعظة الثالثة والعشرون: التسليم
بيان مكانة التسليم للّه -تعالى- وبَواعثه، والحثّ عليه وعلى الاقتداء بِأهله.
محاور الموعظة
معنى التسليم
مكانة التسليم مِن الإيمان
مِن صِفات أهل التسليم
مَنشأ التسليم
نماذج مِن أهل التسليم
تصدير الموعظة
﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِم حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسلِيمٗا﴾[1].
[1] سورة النساء، الآية 65.
150
135
الموعظة الثالثة والعشرون: التسليم
معنى التسليم
1. قال العلّامة الطباطبائيّ: التسليم مِن العبد مُطاوعته المحضة لِما يريده الله -سبحانه- فيه ومِنه، مِن غيرِ نَظَرٍ إلى انتساب أمرٍ إليه. فهي مقاماتٌ ثلاثةٌ مِن مقامات العبوديّة: التوكُّل، ثمّ التفويض -وهو أدقّ مِن التوكُّل-، ثمّ التسليم -وهو أدقّ منهما-.
2. قال الإمام الخمينيّ (قدس سره): التسليم عبارة عن الانقياد الباطنيّ، والاعتقاد والإيمان القلبيَّيْن بالحقّ -تعالى-، بعد سلامة النفْس مِن العيوب، وخُلوّها مِن المَلَكات الخبيثة. فإذا كان القلب سالمًا، فإنّه يُسلِّم للحقّ؛ يقول بعض المحقّقين: إنّما جُعِل الشكّ مُقابل التسليم، لا الجحود والإنكار... إذ إنّ المُراد مِن التسليم التصديق في الأشياء جميعها.
مكانة التسليم مِن الإيمان
عن الإمام الصادق (عليه السلام) -لَمّا سُئِل: بِأيّ شيءٍ عَلِم المؤمن أنّه مؤمن؟ قال: «بالتسليم لله، والرضى بِما وَرَد عليه مِن سُرورٍ وسَخَط»[1].
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الايمان أربعة أركان: الرضا بقضاء الله والتوكل على الله، وتفويض الامر إلى الله، والتسليم لأمر الله»[2].
[1] الشيخ البرقيّ، المحاسن، ج2، ص329.
[2] الشيخ الحرّ العامليّ، ج15، ص199.
151
136
الموعظة الثالثة والعشرون: التسليم
مِن صِفات أهل التسليم
1. نُجَباء
عن الإمام أبي جعفر (عليه السلام): «﴿قَد أَفلَحَ ٱلمُؤمِنُونَ﴾[1]، أتَدري مَن هُم؟» قال: أنت أعلم. قال (عليه السلام): «قد أفلح المؤمنون المُسلِّمون. إنّ المُسلِّمين هُم النُجَباء»[2].
2. مخبتون
عن محمّد بن يحيى، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قلتُ له إنّ عندنا رجلًا يُقال له كُلَيْب، فلا يجيء عنكم شيءٌ إلّا قال: أنا أُسلِّم، فَسَمّيناه: كُليْب تسليمٍ. فَتَرَحَّم عليه، ثمّ قال (عليه السلام): «أتدرون ما التسليم؟» فَسَكَتْنا. فقال (عليه السلام): «هو -والله- الإخبات». ثمّ تَلا الآية الكريمة: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَخبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِم﴾[3][4].
(الإخبات: هو الخشوع في الظاهر والباطن، والتواضع بالقلب والجوارح، والطاعة في السرّ والعَلَن).
مَنشأ التسليم
عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «أوحى الله -عزَّ وجلَّ- إلى داوود (عليه السلام): يا داوود، تُريد وأُريد، ولا يكون إلّا ما أُريد. فإنْ أسلمْتَ لِما
[1] سورة المؤمنون، الآية 1.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج1، ص391.
[3] سورة هود، الآية 23.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج1، ص391.
152
137
الموعظة الثالثة والعشرون: التسليم
أُريد أَعطيْتُك ما تريد، وإنْ لَمْ تُسلِّم لِما أُريد أتعبْتُك في ما تُريد، ثمّ لا يكون إلّا ما أُريد»[1].
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «يا عباد الله أنتم كالمرضى ورب العالمين كالطبيب فصلاح المرضى فيما يعمله الطبيب ويدبره لا فيما يشتهيه ويقترحه ألا فسلموا الله أموركم تكونوا من الفائزين»[2].
وقال الإمام الخمينيّ (قدس سره): لا بُدّ للإنسان مِن أن يسعى في سَيْرِه الملكوتيّ إلى أن يَجِدَ هاديًا إلى الطريق. فإذا وَجَد الهادي، فلا بُدّ مِن أن يستسلم له، ويتابعه في السير والسلوك، ويضع قَدَمه مكان قدمه. ونحنُ -إذ وَجَدنا النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) هاديًا إلى الطريق، وعَرَفْنا أنّه واصلٌ إلى المعارف جميعها- فلا بُدّ مِن أن نَتْبعه في السيْر الملكوتيّ، مِن دون (كيف؟) و(لِمَ؟)... فالمريض الذي يُريد أن يَطّلع على سرّ وَصْفة الطبيب، ثمّ يَستفيد مِن الدواء، يكون قد مضى وقت العلاج، وَجَرَّ بِنفسه إلى الهلاك.
نماذج مِن أهل التسليم
1. نبيّ الله إبراهيم (عليه السلام) سلَّم أمرَه لله في وَضْع زوجته ووَلده في وادٍ غيرِ ذي زَرْعٍ وماءٍ وبَشَر، وسَلَّمَ أمرَه لله في قصّة ذبْحِ وَلَده إسماعيل (عليه السلام).
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج5، ص104.
[2] الديلميّ، إرشاد القلوب، ج1، ص153.
153
138
الموعظة الثالثة والعشرون: التسليم
2. سلَّم إسماعيل (عليه السلام) لِأبيه إبراهيم (عليه السلام)؛ ﴿يَٰأَبَتِ ٱفعَل مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾[1].
3. سلَّم الإمام الحسين (عليه السلام) بِقوله: «الحمد لله، وما شاء الله، ولا قوّة إلّا بالله، وصلّى الله على رسوله. خُطَّ الموتُ على ولد آدمَ مَخَطّ القلادة على جيد الفتاة، وما أولَهَني إلى أسلافي اشتياق يَعقوب إلى يوسف! وَخِير لي مَصرعٌ أنا لاقيه؛ كأنّي بِأوصالي تُقطّعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فَيَملأنّ مِنّي أكراشًا جوفًا وأجربة سغبًا. لا محيص عن يومٍ خُطّ بالقلم. رضى الله رضانا أهل البيت؛ نَصبر على بلائه، ويوفّينا أجور الصابرين»[2].
4. وَرَد عن عبد الله بن أبي يعفور: قلتُ لِأبي عبد الله: والله، لو فلقْتَ رمّانةً بِنِصْفيْن، فقلتَ: هذا حرامٌ وهذا حلالٌ، شَهِدْتُ أنّ الذي قلتَ حلالٌ حلال، وأنّ الذي قلتَ حرامٌ حرام. قال (عليه السلام): «رَحِمَك الله، رَحِمَك الله».
5. سلَّمَ المجاهدون في المقاومة الإسلاميّة لله -تعالى- في تكليفهم المحدّد مِن الوليّ الفقيه.
[1] سورة الصافات، الآية 102.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج44، ص367.
154
139
الموعظة الرابعة والعشرون: الثبات وحسن العاقبة
الموعظة الرابعة والعشرون: الثبات وحسن العاقبة
الحثّ على المراقبة الدائمة للإيمان، كي يبقى ثابتًا مهما بلغت التحدّيات.
محاور الموعظة
الثبات وحسن العاقبة في الدعاء
الثبات في البعد الثقافيّ
من شواهد التاريخ على الثبات وحسن العاقبة
تصدير الموعظة
الإمام الحسين (عليه السلام): «الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معايشهم، فإذا مُحّصوا بالبلاء قلّ الديّانون»[1].
[1] الشيخ ابن شعبة الحرّانيّ، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص245.
155
140
الموعظة الرابعة والعشرون: الثبات وحسن العاقبة
إنّ مسألة الثبات تتلازم تلازمًا أكيدًا مع الأخطار والتحديّات التي تواجهها الأمّة، وكلّما اشتدّت هذه التحديّات كلّما احتاجت الأمّة إلى الرجال الأشدّاء الثابتين في إيمانهم والراسخين على مواقفهم، وبالتالي كلّما خلّد التاريخ هؤلاء الصفوة القادة، وهذا من أبرز العبر في كربلاء الحسين (عليه السلام).
الثبات وحسن العاقبة في الدعاء
ممّا ورد في دعاء أبي حمزة الثماليّ: «وأعنّي على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنّة برحمتك»[1].
ولا يخفى أنّ من آثار سوء العاقبة حبط الأعمال، كما ورد في القرآن الكريم: ﴿وَمَن يَرتَدِد مِنكُم عَن دِينِهِۦ فَيَمُت وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰئِكَ حَبِطَت أَعمَٰلُهُم فِي ٱلدُّنيَا وَٱلأخِرَةِ﴾[2].
وفي الدعاء أيضًا: «يا مثبّت القلوب، ثبّت قلوبنا على دينك»[3].
وورد في دعاء يوم الجمعة: «إلهي، ثبّتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني»[4].
[1] السيّد ابن طاووس، إقبال الأعمال، ج1، ص173.
[2] سورة البقرة، الآية 217.
[3] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج2، ص955.
[4] الشيخ الكفعميّ، البلد الأمين والدرع الحصين، ص87.
156
141
الموعظة الرابعة والعشرون: الثبات وحسن العاقبة
الثبات في البعد الثقافيّ
يرتبط مفهوم الثبات وحسن العاقبة ارتباطًا وثيقًا بفهم أمرين أساسيّين:
أوّلًا: مفهوم الابتلاء: وأنّ ساحة الحياة الدنيا هي في حقيقتها وجوهرها ساحة ابتلاء وامتحان للإنسان، بل إنّ الابتلاء أمر طبيعيّ وضروريّ لتكامل الفرد والأمّة وجعلهما على مستوى التحديّات مهما تعاظمت.
قال -تعالى-: ﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلمَوتَ وَٱلحَيَوٰةَ لِيَبلُوَكُم أَيُّكُم أَحسَنُ عَمَلٗا﴾[1].
وقال -تعالى-:﴿وَلَنَبلُوَنَّكُم بِشَيءٖ مِّنَ ٱلخَوفِ وَٱلجُوعِ وَنَقصٖ مِّنَ ٱلأَموَٰلِ وَٱلأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾[2].
وقال -تعالى-:﴿أَم حَسِبتُم أَن تَدخُلُواْ ٱلجَنَّةَ وَلَمَّا يَأتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبلِكُم مَّسَّتهُمُ ٱلبَأسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصرَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ﴾[3].
ثانيًا: وضوح التكليف والالتزام به: فمن أكبر الأمراض التي تصيب الإنسان أن يضعف أو يتهاون أو يعتبر أنّه تكليف بما لا يطاق أو رضوخه للمغريات الدنيويّة وسوى ذلك، بل ينبغي أن يبقى واعيًا لحركة الابتلاء في حياته مشخّصًا تشخيصًا دقيقًا لتكليفه وملتزم به التزامًا حقيقيًّا.
[1] سورة الملك، الآية 2.
[2] سورة البقرة، الآية 155.
[3] سورة البقرة، الآية 214.
157
142
الموعظة الرابعة والعشرون: الثبات وحسن العاقبة
من شواهد التاريخ على الثبات وحسن العاقبة
ثبات رسول الله (صلى الله عليه وآله): وهو يجيب قريش التي أرسلت له مع عمّه أبي طالب تعرض عليه مالًا وجاهًا ونساءً مقابل تركه الدعوة قائلًا: «والله يا عمّ لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتّى يظهره الله أو أهلك دونه»[1].
ويؤكّد أمير المؤمنين أنّ عدم الثبات على الهدى والإيمان سيفتح على الإنسان أبوابًا أخرى من البلاء أشدّ وأصعب عليه من موضوع الثبات نفسه، فيقول (عليه السلام): «لا يترك الناس شيئًا من دينهم لإصلاح دنياهم إلّا فتح الله عليهم ما هو أضرّ منه»[2].
ثبات أصحاب الحسين (عليه السلام): رغم قلّة الصديق والناصر وكثرة العدوّ ويقينهم بالشهادة بقوا على موقفهم وثباتهم فلم يتراجعوا أو يجبنوا أو يستسلموا أو يتنازلوا عن أيّ شيء.
ومن أكبر الشواهد على حسن العاقبة في كربلاء الحرّ بن يزيد الرياحيّ الذي التحق بمعسكر الحسين (عليه السلام) قبل نشوب القتال وأعلن توبته بين يدي الإمام، ثمّ كان أوّل من قاتل واستشهد من أصحاب الحسين (عليه السلام).
[1] الشيخ الأمينيّ، الغدير، ج7، ص356.
[2] السيّد الرضيّ، خصائص الأئمّة(عليهم السلام)، ص97.
158
143
الموعظة الخامسة والعشرون: الثقة بالله وحُسن الظنّ به
الموعظة الخامسة والعشرون: الثقة بالله وحُسن الظنّ به
تعرُّف مفهوم حسن الظنّ بالله -تعالى- وآثاره الإيجابيّة.
محاور الموعظة
حُسن الظنّ بالله
سوء الظنّ بالله
الآثار السلبيّة لسوء الظنّ بالله
الإنسان بين الثقة والأمل
آثار الثقة بالله
الثقة والأمل في كربلاء
الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) الأمل الموعود للبشريّة
تصدير الموعظة
﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَواْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُواْ خَيرٗا﴾[1].
[1] سورة النحل، الآية 30.
159
144
الموعظة الخامسة والعشرون: الثقة بالله وحُسن الظنّ به
حُسن الظنّ بالله
إنّ فهم المقصود من حُسن الظنّ بالله يكون بالعودة إلى ما أُثِر عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام)، فقد ورد الكثير من الروايات الصادرة عنهم (عليهم السلام)، والتي تحدّثَت بوضوح عن حُسن الظنّ بالله، منها:
عن الإمام الرضا (عليه السلام): «أَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ بِي؛ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا وَإِنْ شَرًّا فَشَرًّا»[1].
أي إن كان ظنّه بي خيرًا، فجزاؤه خير؛ وإن كان ظنّه بي شرًّا، فجزاؤه شرّ. وهذا الحديث يؤكّد وجود الارتباط بين الظنّ الذي يختاره العبد بالله، مع الجزاء، وإنّ الأمر لا يتعدّى الاختيار القلبيّ الذي يظهر أثره على المرء في عمله.
عن الإمام الباقر (عليه السلام): «أَحْسِنُوا الظَّنَّ بِاللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ، عَرْضُ كُلِّ بَابٍ مِنْهَا مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً»[2].
يٌقرِن الإمام (عليه السلام) في هذا الحديث، بين حُسن الظنّ ودخول الجنّة، فسعة رحمة الله -عزّ وجلّ- والتعلّق بها يفتحان للإنسان أبواب الجنّة على سعتها، فلا ينبغي -والحال هذه- أن يكون الإنسان سلبيًّا بالإعراض عنها.
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص72.
[2] الشيخ الصدوق، الخصال، ص408.
160
145
الموعظة الخامسة والعشرون: الثقة بالله وحُسن الظنّ به
عن الإمام الباقر (عليه السلام)، قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله): قَالَ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: لَا يَتَّكِلِ الْعَامِلُونَ عَلَى أَعْمَالِهِمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا لِثَوَابِي؛ فَإِنَّهُمْ لَوِ اجْتَهَدُوا وَأَتْعَبُوا أَنْفُسَهُمْ أَعْمَارَهُمْ فِي عِبَادَتِي، كَانُوا مُقَصِّرِينَ غَيْرَ بَالِغِينَ فِي عِبَادَتِهِمْ كُنْهَ عِبَادَتِي فِيمَا يَطْلُبُونَ عِنْدِي مِنْ كَرَامَتِي وَالنَّعِيمِ فِي جَنَّاتِي وَرَفِيعِ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى فِي جِوَارِي، وَلَكِنْ بِرَحْمَتِي فَلْيَثِقُوا، وَفَضْلِي فَلْيَرْجُوا، وَإِلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِي فَلْيَطْمَئِنُّوا؛ فَإِنَّ رَحْمَتِي عِنْدَ ذَلِكَ تُدْرِكُهُمْ، وَمَنِّي يُبَلِّغُهُمْ رِضْوَانِي، وَمَغْفِرَتِي تُلْبِسُهُمْ عَفْوِي، فَإِنِّي أَنَا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، وَبِذَلِكَ تَسَمَّيْتُ»[1].
وهذا الحديث يوضّح نقطة مهمّة في مسألة حسن الظنّ بالله، وهي أنّ حُسن الظنّ لا يعني ترك العمل، بل عدم الاتّكال على العمل، واعتبار العمل وحده المنجي للإنسان والبالغ به عبادة الله ورضوانه، فحاجة الإنسان إلى رحمة الله وحُسن ظنّه بها أكثر من حاجته إلى عمله.
عن بعض أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام) أنّه قال: كُنْتُ وَرَاءَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَلَى الصَّفَا أَوْ عَلَى الْمَرْوَةِ، وَهُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى حَرْفَيْنِ: «اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ فِي كُلِّ حَالٍ، وَصِدْقَ النِّيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْك»[2].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص71.
[2] المصدر نفسه، ج4، ص433.
161
146
الموعظة الخامسة والعشرون: الثقة بالله وحُسن الظنّ به
وفي هذا الحديث، تأكيد على أنّ المؤمن لا يستغني عن حُسن الظنّ بالله -تبارك وتعالى- في جميع حالاته، سواء عند نزول النعمة بأن يرجو استمرارها والمزيد منها، أو عند نزول المصيبة بأن يرجو زوالها وعدم حدوثها ثانية، وسواء عند ارتكاب الطاعة بأن يرجو من الله قبولها، أو عند ارتكاب المعصية بأن يستغفر الله ويرجو قَبول توبته.
عن الإمام الباقر (عليه السلام): «وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) قَالَ وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِهِ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا أُعْطِيَ مُؤْمِنٌ قَطُّ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا بِحُسْنِ ظَنِّهِ بِاللَّهِ، وَرَجَائِهِ لَهُ، وَحُسْنِ خُلُقِهِ، وَالْكَفِّ عَنِ اغْتِيَابِ الْمُؤْمِنِينَ. وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ مُؤْمِنًا بَعْدَ التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ، إِلَّا بِسُوءِ ظَنِّهِ بِاللَّهِ، وَتَقْصِيرِهِ مِنْ رَجَائِهِ، وَسُوءِ خُلُقِهِ، وَاغْتِيَابِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَا يَحْسُنُ ظَنُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ، إِلَّا كَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ بِيَدِهِ الْخَيْرَاتُ، يَسْتَحْيِي أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ قَدْ أَحْسَنَ بِهِ الظَّنَّ ثُمَّ يُخْلِفَ ظَنَّهُ وَرَجَاءَهُ؛ فَأَحْسِنُوا بِاللَّهِ الظَّنَّ وَارْغَبُوا إِلَيْهِ»[1].
يقول العلّامة المجلسيّ، تعليقًا على هذا الحديث: «قولُه (عليه السلام): «إلَّا بِحُسْنِ ظَنِّهِ»، قيل: معناه حُسن ظنّه بالغفران إذا ظنّه حين يستغفر، وبالقبول إذا ظنّه حين يتوب، وبالإجابة إذا ظنّها حين يدعو،
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص71-72.
162
147
الموعظة الخامسة والعشرون: الثقة بالله وحُسن الظنّ به
وبالكفاية إذا ظنّها حين يستكفي؛ لأنّ هذه الصفات لا تظهر إلّا إذا حسن ظنّه بالله -تعالى-، وكذلك تحسين الظنّ بقبول العمل عند فعله إيّاه، فينبغي للمستغفر والتائب والداعي والعامل أن يأتوا بذلك، موقنين بالإجابة بوعد الله الصادق، فإنّ الله -تعالى- وعد بقبول التوبة الصادقة والأعمال الصالحة؛ وأمّا لو فعل هذه الأشياء وهو يظنّ أن لا يقبل ولا ينفعه، فذلك قنوط من رحمة الله -تعالى-، والقنوط كبيرة مهلكة»[1].
سوء الظنّ بالله
يقابل حُسن الظنّ بالله سوء الظنّ به، قال -تعالى-: ﴿وَيُعَذِّبَ ٱلمُنَٰفِقِينَ وَٱلمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلمُشرِكِينَ وَٱلمُشرِكَٰتِ ٱلظَّانِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوءِ عَلَيهِم دَائِرَةُ ٱلسَّوءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيهِم وَلَعَنَهُم وَأَعَدَّ لَهُم جَهَنَّمَ وَسَاءَت مَصِيرٗا﴾[2].
تتحدّث هذه الآية عن سوء الظنّ بالساحة الربوبيّة والحقيقة المقدّسة الإلهيّة، فتقول: إنّ سوء الظنّ بالله -تعالى- من جانب هؤلاء، هو لأنّهم كانوا يتصوّرون أنّ الوعود الإلهيّة للنبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) لن تتحقّق أبدًا، وأنّ المسلمين، مضافًا إلى عدم انتصارهم على العدوّ، فإنّهم لن يعودوا إلى المدينة إطلاقًا، كما كان في ظنّ المشركين أيضًا، حيث توهّموا أنّهم سوف يهزمون رسول الله وأصحابه؛ لقلّة عددهم وعدم توافر الأسلحة الكافية في أيديهم، وأنّ نجم الإسلام منذر بالزوال والأفول، في حين أنّ الله -تعالى- وعد المسلمين بالنصر
[1] العلّامة المجلسيّ، مرآة العقول، ج8، ص44.
[2] سورة الفتح، الآية 6.
163
148
الموعظة الخامسة والعشرون: الثقة بالله وحُسن الظنّ به
الأكيد، وتحقّق لهم ذلك، بحيث إنّ المشركين لم يجرُؤوا أبدًا على الهجوم على المسلمين.
واللافت في هذه الآية، أنّ مسألة سوء الظنّ بالله -تعالى- كانت بمثابة القدر المشترك بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وبيّنَت هذه الآية أنّ جميع هذه الفئات والطوائف شركاء في هذا الأمر، بخلاف المؤمنين الذين يحسنون الظنّ بالله -تعالى- وبوعده وبرسوله الكريم، ويعلمون أنّ هذه الوعود سوف تتحقّق قطعًا، ولعلّ تحقُّقَها قد يتأخّر فترة من الوقت لمصالح معيّنة، ولكنّها أمرٌ حتميّ في حركة عالم الوجود؛ لأنّ الله -تعالى- العالِم بكلّ شيء، والقادر على كلّ شيء، لا يمكن مع هذا العلم المطلق والقدرة اللامتناهية، أن يتخلّف عن وعده.
الآثار السلبيّة لسوء الظنّ بالله
إنّ سوء الظنّ بالله -تعالى- وعدم الثقة بالوعود الإلهيّة:
1. عنصرٌ هدّامٌ لإيمان الشخص، يُبعِده عن الله -تعالى-، وقد جاء في مناجاة النبيّ داود (عليه السلام): «يا رَبِّ، ما آمَنَ بِكَ مَنْ عَرَفَكَ فَلَم يُحسِنِ الظنّ بِكَ»[1].
2. يتسبّب في فساد العبادة وحبط العمل؛ لأنّه يقتل في الإنسان روح الإخلاص وصفاء القلب، وقد ورد: «إِيِّاكَ أَنْ تُسِيءَ الظنّ؛ فَإِنَّ سُوءَ الظنّ يُفسِدُ العِبادَةَ وَيُعَظِّمُ الوِزرَ»[2].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج67، ص394.
[2] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص99.
164
149
الموعظة الخامسة والعشرون: الثقة بالله وحُسن الظنّ به
الإنسان بين الثقة والأمل
إنّ طول الأَمَلِ من الرذائل الأخلاقيّة التي تجرّ الإنسان إلى ارتكاب أنواع الذنوب والخطايا، وتُبعِده عن الله -تعالى-. وهذا لا يعني أنّ الأمل رذيلة بالمطلق، فإنّ أصل الأمل له دور مهمّ في إدامة حركة الحياة والتطوّر البشريّ في الأبعاد المادّيّة والمعنويّة. فإذا سُلِب الأملُ -مثلًا- من قلب الأمّ، فإنّها لا تجد دافعًا إلى إرضاع طفلها، وتحمُّل أنواع المشقّة والألم بتربيته وتنشئته، ففي الحديث النبويّ الشريف: «الأَمَلُ رَحْمَةٌ لأُمَّتِي، وَلَوْلاَ الأَمَلُ، مَا رَضَعَتْ وَالِدَةٌ وَلَدَهَا، وَلاَ غَرَسَ غَارِسٌ شَجَرًا»[1].
ورد عن المسيح (عليه السلام) أنّه كان جالسًا يومًا في مكان، وشاهد شيخًا كبيرًا يحرث الأرض بمسحاته، ويعمل على سقيها وزراعتها، فطلب المسيح (عليه السلام) من الله -تعالى- أن يسلب منه الأمل في الحياة: «اللَّهُمَّ، انْزِعْ مِنْهُ الْأَمَلَ» فَوَضَعَ الشَّيْخُ الْمِسْحَاةَ وَاضْطَجَعَ، فَلَبِثَ سَاعَةً، فَقَالَ عِيسَى: «اللَّهُمَّ ارْدُدْ إِلَيْهِ الْأَمَلَ»، فَقَامَ فَجَعَلَ يَعْمَلُ، فَسَأَلَهُ عِيسَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَعْمَلُ، إِذْ قَالَتْ لِي نَفْسِي: إِلَى مَتَى تَعْمَلُ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ؟ فَأَلْقَيْتُ الْمِسْحَاةَ وَاضْطَجَعْتُ، ثُمَّ قَالَتْ لِي نَفْسِي: وَاللَّهِ، لَا بُدَّ لَكَ مِنْ عَيْشٍ مَا بَقِيتَ، فَقُمْتُ إِلَى مِسْحَاتِي[2].
[1] الديلميّ، أعلام الدين في صفات المؤمنين، ص295.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج14، ص329.
165
150
الموعظة السادسة والعشرون: الحبّ والبغض في الله
والثقة بالله -تعالى- تُحيي الأملَ في النفوس، وتمنع عنها تسلُّل اليأس والإحباط، وهي باعثة على التغلُّب على الأفكار والوساوس الشيطانيّة التي تُسقِط الإنسان في وحول الرذيلة والمعصية. فأحيانًا، يُغلِق الله -سبحانه وتعالى- أمامنا بابًا، لكي يفتح لنا بابًا آخر أفضل منه، ولكنّ الناس الفاقدين للثقة بالله يضيع تركيزهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أُغلِق، بدلًا من باب الأمل الذي انفتح أمامه على مصراعَيه.
آثار الثقة بالله
نتائج الثقة بالله وحُسن الظنّ به -تعالى- وآثارها كثيرة، وتنعكس على حياة الإنسان وسلوكه الفرديّ والاجتماعيّ، نذكر منها بالاستناد إلى الروايات، الآتي:
1. رجاء الله فقط
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ أَنْ لَا تَرْجُوَ إِلَّا اللَّهَ، وَلَا تَخَافَ إِلَّا ذَنْبَك»[1].
وعنه (عليه السلام): «مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ، فَقَدْ أَسَاءَ بِاللَّهِ الظَّنَّ»[2].
وذلك أنّ ترك التزويج هو أثرٌ عمليٌّ مترتّب على خوف الفقر، وهو يفصح عن توقُّع التارك عدمَ نزول رحمة الله عليه، ولا يُراد من سوء الظنّ سوى هذا المعنى.
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص72.
[2] المصدر نفسه، ج5، ص330.
166
151
الموعظة الخامسة والعشرون: الثقة بالله وحُسن الظنّ به
والثقة بالله -تعالى- تُحيي الأملَ في النفوس، وتمنع عنها تسلُّل اليأس والإحباط، وهي باعثة على التغلُّب على الأفكار والوساوس الشيطانيّة التي تُسقِط الإنسان في وحول الرذيلة والمعصية. فأحيانًا، يُغلِق الله -سبحانه وتعالى- أمامنا بابًا، لكي يفتح لنا بابًا آخر أفضل منه، ولكنّ الناس الفاقدين للثقة بالله يضيع تركيزهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أُغلِق، بدلًا من باب الأمل الذي انفتح أمامه على مصراعَيه.
آثار الثقة بالله
نتائج الثقة بالله وحُسن الظنّ به -تعالى- وآثارها كثيرة، وتنعكس على حياة الإنسان وسلوكه الفرديّ والاجتماعيّ، نذكر منها بالاستناد إلى الروايات، الآتي:
1. رجاء الله فقط
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ أَنْ لَا تَرْجُوَ إِلَّا اللَّهَ، وَلَا تَخَافَ إِلَّا ذَنْبَك»[1].
وعنه (عليه السلام): «مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ، فَقَدْ أَسَاءَ بِاللَّهِ الظَّنَّ»[2].
وذلك أنّ ترك التزويج هو أثرٌ عمليٌّ مترتّب على خوف الفقر، وهو يفصح عن توقُّع التارك عدمَ نزول رحمة الله عليه، ولا يُراد من سوء الظنّ سوى هذا المعنى.
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص72.
[2] المصدر نفسه، ج5، ص330.
166
152
الموعظة الخامسة والعشرون: الثقة بالله وحُسن الظنّ به
2. أثره على الصراط
عن النبيّ (صلى الله عليه وآله): «رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى الصِّرَاطِ، يَرْتَعِدُ كَمَا تَرْتَعِدُ السَّعَفَةُ فِي يَوْمِ رِيحٍ عَاصِفٍ، فَجَاءَهُ حُسْنُ ظَنِّهِ بِاللَّهِ، فَمَسَكَتْ رَعْدَتُهُ»[1].
3. الله عند ظنّ عبده المؤمن
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَا يَحْسُنُ ظَنُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ، إِلَّا كَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ بِيَدِهِ الْخَيْرَاتُ، يَسْتَحْيِي أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ قَدْ أَحْسَنَ بِهِ الظَّنَّ ثُمَّ يُخْلِفَ ظَنَّهُ وَرَجَاءَهُ؛ فَأَحْسِنُوا بِاللَّهِ الظَّنَّ وَارْغَبُوا إِلَيْهِ»[2].
4. ثمن الجنّة
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-؛ فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ ثَمَنُ الْجَنَّةِ»[3].
الثقة والأمل في كربلاء
حينما نظر الإمام الحسين (عليه السلام) إلى جمع بني أميّة في كربلاء كأنّه السيل، وقد حاصره الأعداء يوم عاشوراء، رفع يده بالدعاء، وقال: «اللّهُمَّ، أَنْتَ ثِقَتي في كُلِّ كَرْبٍ، وَرَجائِي في كُلِّ شِدَّة، وَأَنْتَ لي في كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بي ثِقَةٌ وَعُدَّة...»[4].
[1] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج11، ص250.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص72.
[3] الشيخ الطوسيّ، الأمالي، ص379.
[4] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص96.
167
153
الموعظة الخامسة والعشرون: الثقة بالله وحُسن الظنّ به
هذه الفقرة الأولى من الدعاء، التي دعا بها (عليه السلام)، تعكس محبّة الله، وثقته به -تعالى- التي غمرَت قلبَه المقدّس، فكان الرضا بقضاء الله، والثقة بعنايته، فقدّم (عليه السلام) الخوف والرجاء في دعائه هذا، كمنهجٍ اتّبعَه، والذي يميّزه عن بقيّة أدعيته في ليلة عاشوراء ويومها، ومن شأنه أن يكون منهجًا جديدًا لتجاوُز الأزمات التي تمرّ بها النفس الإنسانيّة، وهو منهج تفريج الهموم وكشف الكروب.
الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) الأمل الموعود للبشريّة
إنّ الظنّ الحسن بالله -تعالى- يدفعنا إلى الإيمان والاعتقاد بأنّه سوف ينقذ هذه البشريّة من الظلم الذي ألحقَه بها جنود الشيطان، وهذا ما تمّ التأكيد عليه في القرآن والروايات، ولا شكّ أنّه سوف يتحقّق هذا الوعد، فتخضرّ آمال المؤمنين، وتنتعش قلوبهم المهمومة، وتقبض أكفَّهم على الراية، وإن عتَتَ العواصف وطال الطريق، فعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «فَانْظُرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ، فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فَانْصُرُوهُمْ، فَلَيُفَرِّجَنَّ اللَّهُ [الْفِتْنَةَ] بِرَجُلٍ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْت»[1].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج34، ص118.
168
154
الموعظة السادسة والعشرون: الحبّ والبغض في الله
الموعظة السادسة والعشرون: الحبّ والبغض في الله
تعرُّف الحبّ في الله والبغض في الله، باعتبارهما الركيزة الأساسيّة للإيمان.
محاور الموعظة
فضل الحبّ والبغض في الله
فضل المتحابّين في الله
عبادة الحبّ
مسؤوليّة الحبّ في الله
حُشِرَ الإنسانُ مع من أَحَبَّ
حبّ النبيّ وأهل بيته (عليهم السلام)
ثواب من دمعَت عينُه في آل محمّد(صلى الله عليه وآله)
تصدير الموعظة
﴿قُل إِن كُنتُم تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحبِبكُمُ ٱللَّهُ وَيَغفِر لَكُم ذُنُوبَكُم وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾[1].
[1] سورة آل عمران، الآية 31.
169
155
الموعظة السادسة والعشرون: الحبّ والبغض في الله
ذكرت الروايات أهمّيّة خاصّة للحبّ والبغض، حيث عدّته من أوثق عرى الإيمان، فإنّ الذي يجعل ميزان ميوله وتعلّقاته واختياره لأفعاله، هو ما يحبّه الله -تعالى-، ويترك ما يبغضه، سوف تتمايز الأشياء أمامه إلى نوعَين: نوع له علاقة بالله -تعالى- وأحبّائه، ونوع له علاقة بما يبغضه الله -تعالى- وبأعدائه.
فضل الحبّ والبغض في الله
1. كمال الإيمان عن أبي عبد الله (عليه السلام): «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ، فَهُوَ مِمَّنْ كَمَلَ إِيمَانُهُ»[1].
وعن أبي عبد الله (عليه السلام): «لَا يُمَحِّضُ رَجُلٌ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَوُلْدِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَمِنَ النَّاسِ كُلِّهِم»[2].
2. أوثَقُ عرى الإيمان: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) لِأَصْحَابِهِ: أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ؟ فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الصَّلَاةُ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الزَّكَاةُ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الصِّيَامُ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْجِهَادُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله): لِكُلِّ مَا قُلْتُمْ فَضْلٌ وَلَيْسَ بِهِ، وَلَكِنْ أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ، وَتَوَالِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَالتَّبَرِّي مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ»[3].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص124 - 125.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج67، ص25.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص125.
170
156
الموعظة السادسة والعشرون: الحبّ والبغض في الله
3. هل الدّين إلّا الحبّ: وعن الفضيل بن يسار قال سألتُ أبا عبدِ اللهِ (عليه السلام) عن الحبِّ والبُغضِ، أَمِنَ الإيمانِ هُوَ؟ فقالَ (عليه السلام): «وَهَل الإيمانُ إلَّا الحبُّ والبُغضُ؟» ثمَّ تَلا هذهِ الآيةَ: ﴿حَبَّبَ إِلَيكُمُ ٱلإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُم وَكَرَّهَ إِلَيكُمُ ٱلكُفرَ وَٱلفُسُوقَ وَٱلعِصيَانَ أُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ﴾[1] [2].
عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث له قال: «يَا زِيَادُ، وَيْحَكَ! وَهَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ؟ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ اللَّهِ: ﴿إِن كُنتُم تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحبِبكُمُ ٱللَّهُ وَيَغفِر لَكُم ذُنُوبَكُم﴾؟ أَوَلَا تَرَى قَوْلَ اللَّهِ لِمُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله): ﴿حَبَّبَ إِلَيكُمُ ٱلإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُم﴾؟ وَقَالَ: يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: الدِّينُ هُوَ الْحُبُّ، وَالْحُبُّ هُوَ الدِّينُ»[3].
ونحن نقرأ في زيارتهم (عليهم السلام): «بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَنَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي»[4].
فضل المتحابّين في الله
عن الإمام عليّ بن الحسين (عليهما السلام) قال: «إِذَا جَمَعَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، قَامَ مُنَادٍ فَنَادَى يُسْمِعُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ؟ قَالَ: فَيَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمُ: اذْهَبُوا إِلَى الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ. قَالَ: فَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فَيَقُولُونَ: إِلَى أَيْنَ؟
[1] سورة الحجرات، الآية 7.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص125.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج66، ص238.
[4] الشيخ عباس القمّي، مفاتيح الجنان، الزيارة الجامعة الكبيرة، ص623.
171
157
الموعظة السادسة والعشرون: الحبّ والبغض في الله
فَيَقُولُونَ: إِلَى الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ. قَالَ: فَيَقُولُونَ: فَأَيُّ ضَرْبٍ أَنْتُمْ مِنَ النَّاسِ؟ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ. قَالَ: فَيَقُولُونَ: وَأَيَّ شَيْءٍ كَانَتْ أَعْمَالُكُمْ؟ قَالُوا:كُنَّا نُحِبُّ فِي اللَّهِ وَنُبْغِضُ فِي اللَّهِ. قَالَ: فَيَقُولُونَ: ﴿نِعمَ أَجرُ ٱلعَٰمِلِينَ﴾[1]»[2].
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: «إِنَّ الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، قَدْ أَضَاءَ نُورُ وُجُوهِهِمْ، وَنُورُ أَجْسَادِهِمْ، وَنُورُ مَنَابِرِهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى يُعْرَفُوا بِهِ، فَيُقَالُ: هَؤُلَاءِ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّه»[3].
وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ رَجُلًا لِلَّهِ، لَأَثَابَهُ اللَّهُ عَلَى حُبِّهِ إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ الْمَحْبُوبُ فِي عِلْمِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَبْغَضَ رَجُلًا لِلَّهِ، لَأَثَابَهُ اللَّهُ عَلَى بُغْضِهِ إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُبْغَضُ فِي عِلْمِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»[4].
عبادة الحبّ
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إِنَّ الْعُبَّادَ ثَلَاثَةٌ: قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- خَوْفًا، فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، وَقَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- طَلَبَ الثَّوَابِ، فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأُجَرَاءِ، وَقَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- حُبًّا، لَهُ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ»[5].
[1] سورة العنكبوت، الآية 58.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص126.
[3] المصدر نفسه، ص125.
[4] المصدر نفسه، ص127.
[5] المصدر نفسه، ص84.
172
158
الموعظة السادسة والعشرون: الحبّ والبغض في الله
مسؤوليّة الحبّ في الله
وقال رجلٌ للإمام زين العابدين (عليه السلام): إنّي لأحبُّكَ في اللهِ حُبًّا شديدًا، فنكَّس (عليه السلام) رأسَهُ، ثمّ قال: «اللَّهُمَّ، إنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُحِبَّ فِيكَ وَأَنْتَ لِي مُبْغِضٌ»، ثمَّ قال له: «أُحِبُّكَ لِلَّذِي تُحِبُّنِي فِيهِ»[1].
حُشِرَ الإنسانُ مع من أَحَبَّ
عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إيَّاكَ أنْ تُحِبَّ أَعْدَاءَ اللهِ وَتُصْفِي وُدَّكَ لِغَيْرِ أَوْلِيَاءِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا حُشِرَ مَعَهُمْ»[2].
وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ فِيكَ خَيْرًا، فَانْظُرْ إِلَى قَلْبِكَ؛ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَيُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، فَفِيكَ خَيْرٌ، وَاللَّهُ يُحِبُّكَ، وَإِنْ كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَيُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، فَلَيْسَ فِيكَ خَيْرٌ، وَاللَّهُ يُبْغِضُكَ، وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»[3].
عن أنس بن مالك قال: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَسْأَلُ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وآله)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ؟ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟» قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: وَاللَّهِ، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ لَا صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وآله): «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ»َ.
[1] الشيخ ابن شعبة الحرّانيّ، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص282.
[2] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص497.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص126 - 127.
173
159
الموعظة السادسة والعشرون: الحبّ والبغض في الله
قَالَ أَنَسٌ: فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بَعْدَ الْإِسْلَامِ، بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْ فَرَحِهِمْ بِهَذَا»[1].
حبّ النبيّ وأهل بيته (عليهم السلام)
وفي خبر آخر: «جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ(صلى الله عليه وآله)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَسْتَطِيعُ فِرَاقَكَ، وَإِنِّي لَأَدْخُلُ مَنْزِلِي فَأَذْكُرُكَ، فَأَتْرُكُ صَنِيعَتِي وَأُقْبِلُ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْكَ حُبًّا لَكَ، فَذَكَرْتُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَأُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ، فَرُفِعْتَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، فَكَيْفَ لِي بِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ فَنَزَلَ ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَٰئِكَ رَفِيقٗا﴾[2]، فَدَعَا النَّبِيُّ الرَّجُلَ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ وَبَشَّرَهُ بِذَلِك»[3].
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «اِلْزَمُوا مَوَدَّتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَنْتَفِعُ عَبْدٌ بِعَمَلِهِ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ حَقِّنَا»[4].
وعنه (صلى الله عليه وآله) أيضًا: «مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ حُبَّ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَقَدْ أَصَابَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَلَا يَشُكَّنَّ أَحَدٌ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ، فَإِنَّ فِي حُبِّ أَهْلِ بَيْتِي عِشْرِينَ خَصْلَةً؛ عَشْرٌ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا، وَعَشْرٌ مِنْهَا فِي الْآخِرَةِ: أَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا، فَالزُّهْدُ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعَمَلِ، وَالْوَرَعُ فِي الدِّينِ،
[1] الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ج1، ص139.
[2] سورة النساء، الآية 69.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج65، ص70.
[4] الشيخ البرقيّ، المحاسن، ج1، ص61.
174
160
الموعظة السادسة والعشرون: الحبّ والبغض في الله
وَالرَّغْبَةُ فِي الْعِبَادَةِ، وَالتَّوْبَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ، وَالنَّشَاطُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ، وَالْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَالْحِفْظُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَالتَّاسِعَةُ بُغْضُ الدُّنْيَا، وَالْعَاشِرَةُ السَّخَاءُ. وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ، فَلَا يُنْشَرُ لَهُ دِيوَانٌ، وَلَا يُنْصَبُ لَهُ مِيزَانٌ، وَيُعْطَى كِتابَهُ بِيَمِينِهِ، وَيُكْتَبُ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَيَبْيَضُّ وَجْهُهُ، وَيُكْسَى مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، وَيَشْفَعُ فِي مِئَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَيَنْظُرُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ، وَيُتَوَّجُ مِنْ تِيجَانِ الْجَنَّةِ، وَالْعَاشِرَةُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ؛ فَطُوبَى لِمُحِبِّي أَهْلِ بَيْتِي»[1].
ثواب من دمعَت عينُه في آل محمّد(صلى الله عليه وآله)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «مَنْ ذُكِرْنَا عِنْدَهُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَلَوْ مِثْلَ جَنَاحِ الذُّبَابِ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر»[2].
[1] الشيخ الصدوق، الخصال، ص515.
[2] الشيخ البرقيّ، المحاسن، ج1، ص63.
175
161
الموعظة السابعة والعشرون: الإيمان بالغيب
الموعظة السابعة والعشرون: الإيمان بالغيب
تعزيز الروح الإيمانيّة وعلاقة العبد بربّه وإمام زمانه (عجل الله تعالى فرجه).
محاور الموعظة
معنى الغيب
أبرز مصاديق الغيب
النموذج الكربلائيّ
تصدير الموعظة
﴿ذَٰلِكَ ٱلكِتَٰبُ لَا رَيبَ فِيهِ هُدٗى لِّلمُتَّقِينَ ٢ ٱلَّذِينَ يُؤمِنُونَ بِٱلغَيبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقنَٰهُم يُنفِقُونَ﴾[1].
[1] سورة البقرة، الآيتان 2 - 3.
176
162
الموعظة السادسة والعشرون: الحبّ والبغض في الله
معنى الغيب
ما كان غير معلوم، وهو قسمان:
أ. إمّا لعدم الحضور في زمان وقوع الحدث كالإخبارات عن قضايا الأنبياء والأولياء(عليهم السلام)، ﴿ذَٰلِكَ مِن أَنۢبَاءِ ٱلغَيبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيهِم إِذ يُلقُونَ أَقلَٰمَهُم أَيُّهُم يَكفُلُ مَريَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيهِم إِذ يَختَصِمُونَ﴾[1].
ب. وإمّا لما سيكون عليه المستقبل، المجهول كإخبار القرآن عن انتصار الروم المستقبليّ: ﴿غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢ فِي أَدنَى ٱلأَرضِ وَهُم مِّن بَعدِ غَلَبِهِم سَيَغلِبُونَ ٣ فِي بِضعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلأَمرُ مِن قَبلُ وَمِن بَعدُ وَيَومَئِذٖ يَفرَحُ ٱلمُؤمِنُونَ﴾[2].
أبرز مصاديق الغيب
1. ما غاب عن سلطان الحواس المادّيّة.
2. اخباراته -تعالى- عن حوادث القيامة والآخرة والجنّة والنار.
3. الإحاطة الغيبيّة لله -تعالى-:
﴿لَّا تُدرِكُهُ ٱلأَبصَٰرُ وَهُوَ يُدرِكُ ٱلأَبصَٰرَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلخَبِيرُ﴾[3].
اللَّه القريب
﴿وَهُوَ مَعَكُم أَينَ مَا كُنتُم وَٱللَّهُ بِمَا تَعمَلُونَ بَصِيرٞ﴾[4].
[1] سورة آل عمران، الآية 44.
[2] سورة الروم، الآيات 2 - 4.
[3] سورة الأنعام، الآية 103.
[4] سورة الحديد، الآية 4.
177
163
الموعظة السابعة والعشرون: الإيمان بالغيب
﴿وَلَقَد خَلَقنَا ٱلإِنسَٰنَ وَنَعلَمُ مَا تُوَسوِسُ بِهِۦ نَفسُهُۥ وَنَحنُ أَقرَبُ إِلَيهِ مِن حَبلِ ٱلوَرِيدِ﴾[1].
﴿وَٱعلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَينَ ٱلمَرءِ وَقَلبِهِۦ وَأَنَّهُۥ إِلَيهِ تُحشَرُونَ﴾[2].
الله الرقيب
ومن خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) في النهج: «الحمد لله... الْبَاطِنُ لِكُلِّ خَفِيَّةٍ وَالْحَاضِرُ لِكُلِّ سَرِيرَةٍ الْعَالِمُ بِمَا تُكِنُّ الصُّدُورُ وَمَا تَخُونُ الْعُيُونُ»[3].
عودة إلى الآية (في التصدير)
الآية توضّح أنّ هناك هداية خاصّة لمن كان من المتّقين الذين من صفاتهم:
1. إيمانهم بالغيب: ويظهر من الروايات أنّ الغيب هو الإمام الحجّة (عجل الله تعالى فرجه) والإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان ويظهر من الآية أنّه بشرط اقترانه بالعمل.
2. إقامتهم الصلاة وإنفاقهم: وهنا الفات إلى أنّ الهداية الخاصّة إلى الإمام الحجّة (عجل الله تعالى فرجه) تحتاج إلى عمل وتأهيل للنفس.
النموذج الكربلائيّ
شدّة الشعور بحضور الله -تعالى- يؤدّي إلى الطمأنينة أمام الأهوال:
[1] سورة ق، الآية 16.
[2] سورة الأنفال، الآية 24.
[3] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج8، ص268.
178
164
الموعظة السابعة والعشرون: الإيمان بالغيب
قال عبد الله البارقيّ، وهو ممّن حضر المعركة: فوالله، ما رأيتُ مكثورًا -قطّ- قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشًا ولا أجرأ مقدمًا منه، ولقد كانت الرجال لتشدّ عليه فيشدّ عليها، فتنكشف بين يديه إذا شدّ عليها[1].
عن أبي جعفر الثاني عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام): «لما اشتدّ الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب نظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم؛ لأنّهم كلّما اشتدّ الأمر تغيّرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم ووجلت قلوبهم وكان الحسين (عليه السلام) وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا لا يبالي بالموت، فقال لهم الحسين (عليه السلام): صبرا بني الكرام فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة فأيّكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر وما هو لأعدائكم إلّا كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب، إنّ أبي حدّثني عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّ الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم ما كذبت ولا كُذِّبت»[2].
قال أبو عبد الله (عليه السلام): «اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنّها سورة الحسين بن عليّ(عليه السلام) وارغبوا فيها رحمكم الله -تعالى-فقال له أبو أسامة -وكان حاضر المجلس-: وكيف صارت هذه
[1] معهد سيّد الشهداء (عليه السلام)، المصيبة الراتبة، ص154.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج44، ص297.
179
165
الموعظة السابعة والعشرون: الإيمان بالغيب
السورة للحسين (عليه السلام) خاصة؟ فقال: ألا تسمع إلى قوله -تعالى-: ﴿يَٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفسُ ٱلمُطمَئِنَّةُ ٢٧ ٱرجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٗ مَّرضِيَّةٗ ٢٨ فَٱدخُلِي فِي عِبَٰدِي ٢٩ وَٱدخُلِي جَنَّتِي﴾[1]إنّما يعني الحسين بن عليّ (عليه السلام) فهو ذو النفس المطمئنّة الراضية المرضيّة وأصحابه من آل محمد هم الراضون عن الله يوم القيامة وهو راضٍ عنهم وهذه السورة في الحسين بن عليّ (عليه السلام) وشيعته وشيعة آل محمّد خاصّة من أدمن قراءة والفجر كان مع الحسين بن عليّ (عليه السلام) في درجته في الجنّة إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»[2].
[1] سورة الفجر، الآيات 27 - 30.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج44، ص219.
180
166
الموعظة الثامنة والعشرون: السعادة والشقاء في الإسلام
الموعظة الثامنة والعشرون: السعادة والشقاء في الإسلام
إيضاح المراد من مفهومي السعادة والشقاء من وجهة نظر إسلاميّة.
محاور الموعظة
حقيقة السعادة والشقاء
علامات السعادة
الشقاء وأشقى الناس
علامات الشقاء
تصدير الموعظة
﴿يَومَ يَأتِ لَا تَكَلَّمُ نَفسٌ إِلَّا بِإِذنِهِۦ فَمِنهُم شَقِيّٞ وَسَعِيدٞ ١٠٥ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُم فِيهَا زَفِيرٞ وَشَهِيقٌ ١٠٦ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلأَرضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٞ لِّمَا يُرِيدُ ١٠٧ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلأَرضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيرَ مَجذُوذٖ﴾[1].
[1] سورة هود، الآيات 105 - 108.
181
167
الموعظة الثامنة والعشرون: السعادة والشقاء في الإسلام
يرتبط مفهوم الشقاء ومفهوم السعادة ارتباطًا أكيدًا بمصير الإنسان في الآخرة وكونه من أهل النعيم أو من أهل العذاب، بل لا يمكن أن تكون الدنيا ساحة سعادة أو شقاء لأحد؛ لأنّها مخلوقة على كون سعادتها مشوبة بالشقاء وشقائها ممزوج بالسعادة بخلاف الآخرة التي هي إمّا شقاء محض أو سعادة محضة.
حقيقة السعادة والشقاء
وإذا كان مفهوم كلّ من السعادة والشقاء له علاقة وثيقة بآخرة المرء فمن الطبيعي أن تكون الطاعة وتزكية النفس سبيل السعادة كما أنّ المعصية سبيل الشقاء.
عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من أجهد نفسه في إصلاحها سعد، من أهمل نفسه في لذّاتها شقي وبعد»[1].
وعنه (عليه السلام): «لا يسعد امرؤٌ إلّا بطاعة الله -سبحانه-، ولا يشقى امرؤٌ إلّا بمعصية الله»[2].
وعن الإمام الحسين (عليه السلام) -في دعاء يوم عرفة-: «اللهمّ اجعلني أخشاك كأنّي أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك»[3].
وفي هذا السياق، يتّضح أنّ السعادة والشقاء لا يرتبطان بالموت والحياة كما قد يتوهّم أهل الدنيا بل يرتبطان بأداء المرء لتكليفه في هذه الحياة.
[1] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج2، ص1303.
[2] المصدر نفسه.
[3] الشيخ الطوسيّ، مصباح المتهجّد، ص270.
182
168
الموعظة الثامنة والعشرون: السعادة والشقاء في الإسلام
قال الإمام الحسين (عليه السلام): «إنّي لا أرى الموت إلّا سعادة والحياة مع الظالمين إلّا برم»[1].
وعن الإمام عليّ (عليه السلام): «فالموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين»[2].
علامات السعادة
1. حبّ الإمام عليّ (عليه السلام): أي مودّته وطاعته والولاء له، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) -لأمير المؤمنين (عليه السلام) -: «إنّ السعيد حقّ السعيد من أحبّك وأطاعك»[3].
محبّة أهل البيت (عليهم السلام): عن الإمام عليّ (عليه السلام): «أسعد الناس من عرف فضلنا، وتقرّب إلى الله بنا، وأخلص حبّنا، وعمل بما إليه ندبنا، وانتهى عمّا عنه نهينا، فذاك منّا وهو في دار المقامة معن»[4].
2. إخلاص العمل: فإنّ صفاء النيّة وعدم الشرك فيها ممّا يضفي على المرء سعادة خاصّة ببلوغه هذا المقام الرفيع، فعن الإمام عليّ (عليه السلام): «إمارات السعادة إخلاص العمل»[5].
3. هداية الآخرين: وإعانتهم على تجاوز مشكلاتهم ولا سيّما الثقافيّة والفكريّة، فعن الإمام عليّ (عليه السلام): «من كمال السعادة السعي في صلاح الجمهور»[6].
[1] الشيخ عبد الله البحرانيّ، العوالم، ص67.
[2] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص88.
[3] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص466.
[4] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج2، ص1305.
[5] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص70.
[6] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج2، ص1306.
183
169
الموعظة الثامنة والعشرون: السعادة والشقاء في الإسلام
4. زيارة الإمام الحسين (عليه السلام): حيث ورد في الروايات «أنّ من زار الحسين (عليه السلام) عارفًا بحقّه-: وإن كان شقيًّا كتب سعيدًا، ولم يزل يخوض في رحمة الله -عزَّ وجلَّ-»[1].
5. الزوجة والولد والرزق: عن الإمام الصادق (عليه السلام): «ثلاثة من السعادة: الزوجة المؤاتية، والولد البارّ، والرزق يرزق معيشة يغدو على صلاحها ويروح على عياله»[2].
6. السعي لنيل الآخرة: عن الإمام عليّ (عليه السلام): «سعادة الرجل في إحراز دينه والعمل لآخرته»[3].
الشقاء وأشقى الناس
عن الإمام الصادق (عليه السلام) في قول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَت عَلَينَا شِقوَتُنَا وَكُنَّا قَومٗا ضَالِّينَ﴾[4]: «بأعمالهم شقوا»[5].
فالشقاء نتيجة طبيعيّة للأعمال السيّئة والمصير الحتميّ لأهل المعاصي على ما اقترفت أيديهم وجوارحهم.
الإمام عليّ (عليه السلام) -وقد سئل عن أشقى الناس-: «من باع دينه بدنيا غيره»[6].
لأنّه بذلك يكون قد اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة.
[1] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج10، ص310.
[2] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج2، ص1304.
[3] المصدر نفسه، ص1305.
[4] سورة المؤمنون، الآية 106.
[5] الشيخ الصدوق، التوحيد، ص356.
[6] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص478.
184
170
الموعظة الثامنة والعشرون: السعادة والشقاء في الإسلام
4. زيارة الإمام الحسين (عليه السلام): حيث ورد في الروايات «أنّ من زار الحسين (عليه السلام) عارفًا بحقّه-: وإن كان شقيًّا كتب سعيدًا، ولم يزل يخوض في رحمة الله -عزَّ وجلَّ-»[1].
5. الزوجة والولد والرزق: عن الإمام الصادق (عليه السلام): «ثلاثة من السعادة: الزوجة المؤاتية، والولد البارّ، والرزق يرزق معيشة يغدو على صلاحها ويروح على عياله»[2].
6. السعي لنيل الآخرة: عن الإمام عليّ (عليه السلام): «سعادة الرجل في إحراز دينه والعمل لآخرته»[3].
الشقاء وأشقى الناس
عن الإمام الصادق (عليه السلام) في قول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَت عَلَينَا شِقوَتُنَا وَكُنَّا قَومٗا ضَالِّينَ﴾[4]: «بأعمالهم شقوا»[5].
فالشقاء نتيجة طبيعيّة للأعمال السيّئة والمصير الحتميّ لأهل المعاصي على ما اقترفت أيديهم وجوارحهم.
الإمام عليّ (عليه السلام) -وقد سئل عن أشقى الناس-: «من باع دينه بدنيا غيره»[6].
لأنّه بذلك يكون قد اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة.
[1] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج10، ص310.
[2] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج2، ص1304.
[3] المصدر نفسه، ص1305.
[4] سورة المؤمنون، الآية 106.
[5] الشيخ الصدوق، التوحيد، ص356.
[6] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص478.
184
171
الموعظة الثامنة والعشرون: السعادة والشقاء في الإسلام
علامات الشقاء
وكما بيّنت النصوص علامات السعادة حتّى يختبر المرء نفسه بها بيّنت كذلك علامات الشقاء حتّى لا تتسلّل إلى قلب المسلم من دون أن يشعر بها.
فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من علامات الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وشدّة الحرص في طلب الرزق، والإصرار على الذنب»[1].
وعن الإمام عليّ (عليه السلام): «من علامات الشقاء الإساءة إلى الأخيار»[2].
أيّ شقاء أكبر من أولئك الذين أقدموا على قتل سبط رسول الله ورائد الأخيار الحسين بن عليّ (عليه السلام) وسبوا نساءه وحرمه وأنزلوا بهم شتّى صروف العذاب والمآسي.
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص290.
[2] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص468.
185
172
الموعظة التاسعة والعشرون: مكانة البصيرة عند المؤمن
الموعظة التاسعة والعشرون: مكانة البصيرة عند المؤمن
حثّ الناس على التحلّي بهذه الصفة الجليلة، لما لها من المكانة في المنظومة الإسلاميّة.
محاور الموعظة
من هو البصير؟
مسبّبات البصيرة
ما يفقد البصيرة
الأعمى أعمى البصيرة لا البصر
البصيرة من مكارم الأخلاق
البصيرة في كربلاء
تصدير الموعظة
﴿قَد جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُم فَمَن أَبصَرَ فَلِنَفسِهِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيهَا وَمَا أَنَا عَلَيكُم بِحَفِيظٖ﴾[1].
[1] سورة الأنعام، الآية 104.
186
173
الموعظة التاسعة والعشرون: مكانة البصيرة عند المؤمن
البصيرة هي البيّنة، والدلالة التي يبصر بها الشيء على ما هو به[1]. وقيل إنّ البصيرة للقلب بمنزلة البصر للعين. فالبصيرة هي الإدراك والفهم، هي الرؤية الذهنيّة والعقليّة.
فالبصيرة هي قوّة ونور يدرك الإنسان من خلالها الحقائق والدلائل، ويهتدي بهذا النور إلى الحقّ -تعالى-، وهذا المعنى نجده في جواب أمير المؤمنين (عليه السلام) للحبر عندما سأله: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربّك حين عبدته؟ فقال: «ويلك، ما كنت أعبد ربًّا لم أره!»، قال: وكيف رأيته؟ قال: «ويلك، لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان»[2].
وأعمى القلب هو من فقد بصيرته، وغلب الوهم عنده على العقل، فمهما كثر عمله وفعله، فإنّه كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءً، فالوعي والبصيرة من صفات المؤمن الأساسيّة.
من هو البصير؟
عن الإمام عليّ (عليه السلام): «فَإِنَّمَا الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ، وَنَظَرَ فَأَبْصَرَ، وَانْتَفَعَ بِالْعِبَر،ِ ثُمَّ سَلَكَ جَدَدًا وَاضِحًا، يَتَجَنَّبُ فِيهِ الصَّرْعَةَ فِي الْمَهَاوِي، وَالضَّلَالَ فِي الْمَغَاوِي، وَلَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ الْغُوَاة،َ بِتَعَسُّفٍ فِي حَقٍّ، أَوْ تَحْرِيفٍ فِي نُطْقٍ، أَوْ تَخَوُّفٍ مِنْ صِدْقٍ»[3].
[1] الشيخ الطبرسيّ، المجمع البيان، ج4، ص129.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج1، ص98.
[3] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص213.
187
174
الموعظة التاسعة والعشرون: مكانة البصيرة عند المؤمن
مسبّبات البصيرة
1. التفقّه في الدّين: عن الإمام الكاظم (عليه السلام): «تفقّهوا في دين الله، فإنّ الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدّين والدنيا»[1].
2. القرآن الكريم: ﴿قَد جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُم فَمَن أَبصَرَ فَلِنَفسِهِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيهَا وَمَا أَنَا عَلَيكُم بِحَفِيظٖ﴾[2].
ما يفقد البصيرة
1. عشق الشهوات: عن الإمام عليّ (عليه السلام): «وَمَنْ عَشِقَ شَيْئًا أَعْشَى بَصَرَهُ، وَأَمْرَضَ قَلْبَهُ، فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ غَيْرِ صَحِيحَةٍ، وَيَسْمَعُ بِأُذُنٍ غَيْرِ سَمِيعَةٍ، قَدْ خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ، وَأَمَاتَتِ الدُّنْيَا قَلْبَهُ وَوَلِهَتْ عَلَيْهَا نَفْسُهُ»[3].
2. حبّ الدنيا: عن الإمام عليّ (عليه السلام): «لحبّ الدنيا صمّت الأسماع عن سماع الحكمة، وعميت القلوب عن نور البصيرة»[4].
الأعمى أعمى البصيرة لا البصر
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ليس الأعمى من يعمى بصره، إنّما الأعمى من تعمى بصيرته»[5].
[1] الشيخ ابن شعبة الحرّانيّ، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص410.
[2] سورة الأنعام، الآية 104.
[3] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص160.
[4] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج2، ص898.
[5] المصدر نفسه، ج1، ص266.
188
175
الموعظة التاسعة والعشرون: مكانة البصيرة عند المؤمن
البصيرة من مكارم الأخلاق
عن الإمام الكاظم (عليه السلام): «إنّ الله جلّ جلاله خصّ رسله بمكارم الأخلاق، فامتحنوا أنفسكم، فإنْ كانت فيكم فاحمدوا الله، وإلاّ فاسألوه وارغبوا إليه فيها». قال: وذكرها عشرة: «اليقين والقناعة والبصيرة والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والمروة»[1].
شيعتنا أصحاب بصيرة
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّما شيعتنا أصحاب الأربعة الأعين: عينان في الرأس، وعينان في القلب، ألا والخلائق كلّهم كذلك، إلّا أنّ الله عزَّ وجلّ فتح أبصاركم وأعمى أبصارهم»[2].
العمل القليل أفضل من العمل الكثير
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «واعلم أنّ العمل الدائم القليل على اليقين والبصيرة، أفضل عند الله من العمل الكثير على غير اليقين والجهل»[3].
عمل بلا بصيرة بُعْدٌ عن الطريق
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، ولا يزيده سرعة السير من الطريق إلّا بعدا»[4].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج8، ص215.
[2] الشيخ الصدوق، فقه الرضا (عليه السلام)، ص356.
[3] الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص57.
[4] المصدر نفسه، ج1، ص43.
189
176
الموعظة التاسعة والعشرون: مكانة البصيرة عند المؤمن
قصّة وعبرة
من أبرز مصاديق فقدان البصيرة والوعي هم الخوراج، الذين خرجوا على أمير المؤمنين (عليه السلام)، ورفعوا شعار: «لا حكم إلّا لله». وفيما يأتي حادثة لنموذج من هؤلاء:
خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) ذات ليلة من مسجد الكوفة متوجّهًا إلى داره، وقد مضى ربع من الليل، ومعه كميل بن زياد، وكان من خيار شيعته ومحبّيه، فوصل في الطريق إلى باب رجل يتلو القرآن في ذلك الوقت، ويقرأ قوله -تعالى-: ﴿أَمَّن هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَاءَ ٱلَّيلِ سَاجِدٗا وَقَائِمٗا يَحذَرُ ٱلأخِرَةَ وَيَرجُواْ رَحمَةَ رَبِّهِۦ قُل هَل يَستَوِي ٱلَّذِينَ يَعلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلأَلبَٰبِ﴾[1]، بصوت شجي حزين، فاستحسن ذلك كميل في باطنه وأعجبه حال الرجل، من غير أن يقول شيئًا، فالتفت إليه (عليه السلام)، وقال: «يا كميل، لا تعجبك طنطنة الرجل، إنّه من أهل النار، وسأنبّئك فيما بعد»، فتحيّر كميل لمشافهته له على ما في باطنه وشهادته للرجل بالنار، مع كونه في هذا الأمر وفي تلك الحالة الحسنة ظاهرًا في ذلك الوقت، فسكت كميل متعجّبًا متفكّرًا في ذلك الأمر، ومضى مدّة متطاولة إلى أن آل حال الخوارج إلى ما آل، وقاتلهم أمير المؤمنين (عليه السلام)، وكانوا يحفظون القرآن كما أنزل، والتفت أمير المؤمنين إلى كميل بن زياد وهو واقف بين يديه، والسيف في يده يقطر دمًا، ورؤوس أولئك الكفرة الفجرة محلّقة على
[1] سورة الزمر، الآية 9.
190
177
الموعظة التاسعة والعشرون: مكانة البصيرة عند المؤمن
الأرض، فوضع رأس السيف من رأس تلك الرؤوس، وقال: يا كميل، ﴿ أَمَّن هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَاءَ ٱلَّيلِ سَاجِدٗا وَقَائِمٗا﴾، أي هو ذلك الشخص الذي كان يقرأ في تلك الليلة، فأعجبك حاله، فقبّل كميل مقدّم قدميه، واستغفر الله[1].
البصيرة في كربلاء
ورد في الرواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حقّ عمّه العبّاس (عليه السلام)، قال: «كان عمّنا العبّاس بن عليّ نافذ البصيرة، صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله (عليه السلام)، وأبلى بلاءً حسنًا ومضى شهيدا»[2].
وقد تجسّد نفاذ هذه البصيرة في مواقف عديدة في كربلاء مع العبّاس (عليه السلام)، فقد ورد أنّ الشمر قدِم حتّى وقف على أصحاب الحسين (عليه السلام)، فقال: أين بنو أختنا؟ فخرج إليه العبّاس وجعفر وعثمان بنو عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام)، «فقالوا: ما تريد؟ فقال: أنتم يا بني أختي آمنون، فقالت له الفتية: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا، وابن رسول الله لا أمان له»[3]؟!
[1] الديلميّ، إرشاد القلوب، ج2، ص226.
[2] أبو مخنف الأزديّ، مقتل الحسين (عليه السلام)، ص176.
[3] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج3، ص89.
191
178
الموعظة الثلاثون: مِن آداب التَوْبة
الموعظة الثلاثون: مِن آداب التَوْبة
بيان بعض آداب التوبة ومُقدّماتها في دعاء التوبة للإمام السجّاد (عليه السلام)، مع الترغيب بِها والحثّ عليها.
محاور الموعظة
التوبة لُجوءٌ إلى رَحمة الله
آداب التوبة ومُقدّماتها
له الفضْل في التوبة والتوفيق إليها
تصدير الموعظة
﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوبَةٗ نَّصُوحًا﴾[1].
[1] سورة التحريم، الآية 8.
192
179
الموعظة الثلاثون: مِن آداب التَوْبة
التوبة لُجوءٌ إلى رَحمة الله
قال الله -تعالى- في كتابه الكريم: ﴿نَبِّئ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾[1].
هذه الآية خِطاب للنبيّ (صلى الله عليه وآله) بِعنوان نُبُوّته ورَسوليّته، ومِنه إلى كلِّ حاملٍ للإسلام، لكي يُعلِّم الناس -الناس كلّهم- أنّ الله غَفورٌ يَغفر الذنوب جميعًا، ورحيمٌ في مُعامَلتهم في كِلا الدارَيْن. وقد أشارَتْ إلى أنّه -تبارك وتعالى- يُعاهِد الناس، بل المخلوقات كلّها، بِأن يُعاملهم بالرحمة، قائلًا: ﴿كَتَبَ رَبُّكُم عَلَىٰ نَفسِهِ ٱلرَّحمَةَ﴾[2].
وزِيادةً في بثّ روح الأمل في نُفوس البشر -خاصّةً المذنبين منهم-، قال لهم: ﴿قُل يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِم لَا تَقنَطُواْ مِن رَّحمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾[3].
ولأنّ المُذنِبين يشعرون أنّهم بَعيدون عن ساحة رَحمة الله، ومُستحقّون لِعُقوباته الآجِلة والعاجِلة، فقد يَظُنّون -وَهُمْ على هذه الحال- أنّهم ممنوعون مِن مُخاطبته -تعالى- وطَلَبِ العفْوِ والمغفرة منه -وهذه مِن حِيَل إبليس وتلبيساته-، فجاء الخطاب الإلهيّ: ﴿قُل يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِم لَا تَقنَطُواْ مِن رَّحمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾[4].
[1] سورة الحجر، الآية 49.
[2] سورة الأنعام، الآية 54.
[3] سورة الزمر، الآية 53.
[4] سورة الزمر، الآية 53.
193
180
الموعظة الثلاثون: مِن آداب التَوْبة
وحتّى لا يَستبدّ المرض الخطير، وهو اليأس مِن رَحمة الله بِالعباد، فلا بُدّ مِن بابٍ يَلجأ منه الإنسان إلى كنف مَغفرة الله -هَرَبًا مِن سَطوات جَبروته وقاهريّته-، بابٍ يُفضي إلى دار أمْنِه وأمانه مِن خَوف عِقابه وانتقامه، فكان الباب هو التوبة التي اقتَضَتْها رَحمته -تعالى-؛ فبالتوبة يَلجأ العبدُ إلى رحمة الله، لِيُعالِج أمراض الذنوب، ولِيَتحوّل مِن مَبغوضه إلى محبوبه -تعالى-.
آداب التوبة ومُقدّماتها
كما أنّ للتوبة أركانها -وهي الندم والعزم على تَرْكِ الذنوب-، وشرائط لِقَبولها -وهي جُبران التقصير في حقّه -تعالى- والخروج مِن مَظالم العباد بِرَدِّها وطلَب المسامحة منهم-، فإنّ لها كذلك آدابًا ذَكَرَتْها الأدعية المنقولة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) -ولا سيّما الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) في دعائه الموسوم بدعاء التوبة-، مِنها:
1. الإقرار بالذنوب بين يديْه -تعالى-
يُعلِّمنا هذا الأدبَ، قائلًا: «هذا مَقام مَن تَداوَلَتْه أيْدي الذنوب، وقادَتْه أَزِمّة الخطايا، واستَحْوَذ عليه الشيطان، فقَصَّرَ عمّا أمَرْتَ به تفريطًا، وتَعاطى ما نَهَيْتَ عنه تَعزيرًا، كالجاهل بِقُدْرَتِك عليه، أو كالمُنْكِر فضلَ إحسانِك إليه»[1].
[1] الإمام السجّاد (عليه السلام)، الصحيفة السجّادّية، ص140.
194
181
الموعظة الثلاثون: مِن آداب التَوْبة
ومضمون الإقرار والاعتراف بالذنوب أنْ يَقِفَ موقف الذليل، كاسِرًا كبرياء نفْسه التي بها أقدَمَ على ذنْبه؛ فكما أقدَم على الذنْب باعتزازٍ، أو بِلا مبالاة -كما تفيد عبارة «كالجاهل بِقُدرتِك عليه»-، أو بِنُكران الجميل -كما تشير عبارة «أو كالمُنكِر فضل إحسانك إليه»-، فإنّ عليه أن يتأدّب بين يدَيْه -تعالى-، ويُؤدّب نفْسه بِإيقافِها هذا الموقِف؛ أي بإقدامه على الإقرار ذليلًا مُنكسِرًا. ولا بُدّ مِن الإشارة إلى أنّ الإقرار والاعتراف مِن تَرَشُّحات الندم القلبيّ على اللسان، فلْيتأمّل قليلًا -بالاعتراف- في أنّه عندما انساقَ إلى الحرام، كان قائده إلى ذلك شَهوته وهَواه ورغباته، فأسقَطَه ذلك في قَبْضة الشيطان، كأنّه أصبح مُهَيْمنًا عليه.
2. الاستيقاظ مِن الغَفْلة
هي مُقدِّمة لِسُلوك الطريق الموصلة إلى التوبة، إذ كيف يتوب الإنسان بِلا يَقَظةٍ وانتباهٍ جَدِّيَّيْن؟ لذا، عَدّها عُلماء السلوك أُولى خُطوات السالكين إلى الله، وعنها قال الإمام زين العابدين (عليه السلام): «حتّى إذا انْفَتَح له بَصَرُ الهُدى، وتَقَشَّعَتْ عنه سَحائِبُ العَمى...». لكنّ هذه اليقظة مُقدّمتها الاعتراف والإقرار، اللذانِ يُشكّلان مُحفِّزًا لِليقظة، كَوَخْزِ الإِبَر لِلنائم. ولكي تنفع اليَقظة، فلا يعود المُذنب إلى غَفْلَته وسُباته في قَبضة الشيطان، لا بُدّ مِن أن تَتْبعها خُطواتٌ هي مِحَكّ جِدّيّة التوبة ومُؤثّريّة اليَقظة، وهي:
أ. إحصاء الذنوب
وفيه قال (عليه السلام): «أحصى ما ظَلَمَ به نفْسه»؛ لأنّ مَن يريد إصلاح
195
182
الموعظة الثلاثون: مِن آداب التَوْبة
ما أفْسَد، عليه أنْ يُحصي أخطاءَه، لِيَخرج منها جميعًا، فالتوبة يجب أن تكون شاملة للذنوب كلّها، وإلّا فإنّها لَيْسَت جِدّيّة تَمام الجِدّيّة.
ب. التفكّر في الحال التي هو عليها، والذنوب التي اقترَفَها
إحصاء الذنوب ليس عَدّها، بل إنّ المقصود أنْ يَعرِف الإنسان -أوّلًا- سوءَ الحال التي هُوَ عليها، تمامًا كما يَحصُل لِمَن قَضى لَيْلَه سكرانَ؛ فإنّه بعد إفاقته مِن سُكْرِه، سَيَرى ما فَعَله بِنَفْسه وبِمَن وما حَوله، وبالتالي، فإنّ النتيجة المَرْجُوّة مِن التفكُّر ستكون انْكِشاف سوءِ حالِه وقُبْح واقعه؛ «فَرَأى كَبيرَ عِصيانه كبيرًا، وجَليل مُخالَفَتِه جَليلًا».
3. اللجوء إلى الله -تعالى-
فَبَعد اليَقَظة وانْكِشافِ الواقع المُزري، لا بُدّ مِن البحث تِلقائيًّا عن المَأمَن مِن العواقب، والمُعين على الخلاص، والمُساعد في الإصلاح. ولأنّه -بالتفكُّر- يَعرف أنَ جُرْحَه وخَطَأَه مُخالفةٌ لله، ومُجانبةٌ لِشَرْعِه، وخُروجٌ عن طاعته، ولأنّه الله الواحد الأحد الذي كَتَب على نفسه الرحمة، فلا بُدّ مِن اللُجوء إليه؛ «فأقْبَلَ نَحوَك». لكنْ لَمّا كان على هذه الحال المبغوضة لله -تعالى-، فإنّ هذا اللجوء لا بُدّ مِن أن يكون مصحوبًا بِجُملةٍ مِن الأمور والآداب، مِنها:
أ. الحياء؛ «مُستَحْيِيًا مِنك»، وهو أَحَد موانع الذنوب، فاستِحْضارُه هُنا استِجلابًا لِعَطفِه -تعالى-.
ب. الرغبة والثقة به -تعالى-؛ «ووَجَّهَ رغبته إليك، ثِقةً بك».
ج. الخوف والرجاء؛ «فأَمَّكَ بِطَمَعه يقينًا، وقَصَدك بِخَوفه إخلاصًا».
196
183
الموعظة الثلاثون: مِن آداب التَوْبة
وفي هذا إشارة إلى توحيده -تعالى- في الخوف والرجاء. وعلى هذا النوع مِن التوحيد أكّد بِقوله (عليه السلام): «قد خَلا طَمَعه مِن كلّ مَطموع فيه غيرك، وأفرَخَ رَوْعه مِن كلِّ مَحذور مِنه سِواك».
4. الدعاء
يُشير إليه قوله (عليه السلام): «فَمَثَل بَيْن يَدَيْكَ مُتضرّعًا». ولِدعاء طالبِ التوبة مِن الله آدابٌ، مِنها:
أ. أن يَعكِس الداعي بِظاهر جَسَده حالةَ الحَياء والمَذلّة؛ لأنّه يتوجّه مِن ذُلِّ مَسكنته -كَمُذْنبٍ- إلى رحمة الباري، فلا بُدّ مِن أن يكون على هَيْئةٍ يَستعطِفه فيها؛ «وغَمَّض بَصَرَه إلى الأرض مُتخشّعًا، وطَأْطَأَ رأسَه لِعِزّتِك مُتذلِّلًا».
ب. تضمين الدعاء جُملةً مِن الأمور:
- الإفصاح عن الذنوب وتَعدادها سرًّا وعلانيةً؛ ورَدَ في الدعاء: «وأبثّك مِن سِرّه ما أنت أَعلم بِه منه خضوعًا، وعدّد مِن ذنوبه ما أنت أَحصى لها خُشوعًا»، تمامًا كالمريض الذي يَصِفُ لِطَبيبه المُداوي عِلَلَه وعوارضها، لِيَترفَّقَ به، ويتَحنّن عليه بالمداواة وتخفيف الآلام، بل إزالتها.
- الاستقامة، فَعلى الداعي ألّا يكتفي بِتَعداد الذنوب، بل إنّ عليه أنْ يَطلب الغَوث، مُسترحِمًا ومُستعطِفًا مَن بِيَدِه الإنجاء مِن التَبِعات والعواقب، وفي ذلك قوله (عليه السلام): «واستَغاث بك مِن عَظيم ما وَقَع به في عِلمِك، وقبيح ما فَضَحَه في حُكْمك، مِن ذنوبٍ أدبَرَتْ لَذّاتها فَذَهَبَتْ، وأقامَتْ تَبِعاتها فَلَزِمَت».
197
184
الموعظة الثلاثون: مِن آداب التَوْبة
- اليقين بِإجابته -تعالى- بَعد عَدم استِعْظام عَدْله إنْ عاقَب، ورَحْمَتِه إنْ عَفا؛ لأنّ مِن صِفاته الكريم؛ «لأنّك الربّ الكريم الذي لا يتعاظمه غُفران الذنْب العظيم».
له الفضْل في التوبة والتوفيق إليها
هذا نَزَرٌ يسير مِن آداب التوبة ومُقدّماتها التي لَفَتَ إليها دعاء التوبة للإمام زين العابدين (عليه السلام)، وقد بَقِيَتْ مَضامين كثيرة، مِنها إسناد الفضْل إليه في اللجوء إلى التوبة، والذي يُشير إليه قوله (عليه السلام): «فها أنا ذا قد جِئْتُك مُطيعًا لِأَمْرك في ما أمَرْتَ به مِن الدعاء، مُتنجّزًا وعْدَك في ما وَعَدْتَ به مِن الإجابة، إذ تقول: ﴿ٱدعُونِي أَستَجِب لَكُم﴾[1]».
ولا بُدّ مِن تأكيد العَزم على التوبة، وهذا ما لَفَتَ إليه (عليه السلام) بِقوله: «اللهمّ إنّي أتوب إليك... تَوبةَ مَن لا يُحدِّث نفْسه بِمعصية، ولا يُضمِرُ أن يعود في خطيئة...».
[1] سورة غافر، الآية 60.
198
185
الموعظة الحادية والثلاثون: قَسْوةُ القُلوب
الموعظة الحادية والثلاثون: قَسْوةُ القُلوب
بيان خُطورة قَسْوة القلب وأسبابها وطُرق علاجها.
محاور الموعظة
مُحرّم، ومَطرُ الرحمة لِلقلوب
معنى قسوة القلوب
أسباب قسوة القلوب
علاج قسوة القلب
تصدير الموعظة
وَرَد في الحديث القُدسيّ: «يا موسى، لا تُطَوِّل في الدنيا أَمَلك فَيَقسو قلبُك، والقاسي القلب مِنّي بعيد»[1].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص329.
199
186
الموعظة الحادية والثلاثون: قَسْوةُ القُلوب
الموعظة الحادية والثلاثون: قَسْوةُ القُلوب
بيان خُطورة قَسْوة القلب وأسبابها وطُرق علاجها.
محاور الموعظة
مُحرّم، ومَطرُ الرحمة لِلقلوب
معنى قسوة القلوب
أسباب قسوة القلوب
علاج قسوة القلب
تصدير الموعظة
وَرَد في الحديث القُدسيّ: «يا موسى، لا تُطَوِّل في الدنيا أَمَلك فَيَقسو قلبُك، والقاسي القلب مِنّي بعيد»[1].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص329.
199
187
الموعظة الحادية والثلاثون: قَسْوةُ القُلوب
مُحرّم، ومَطرُ الرحمة لِلقلوب
إنّ الله -تعالى- قد أَوْدَعَ في الإنسان جَوهرةً جَعَلَها بيته الحقيقيّ؛ «لا يَسَعني أرضي ولا سمائي، ولكن يَسَعني قلب عَبدي المؤمن»[1]، وأَمَرَنا بِعمارة هذا البيت، وتطهيره مِن رِجْس الشيطان، لِيَكون لائقًا بِصاحبه وسَيِّده؛ عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «ألا وإنّ لله أواني في أرضه، وهي القلوب. وأَحَبّ الأواني إلى الله أَصفاها وأصلَبها وأرَقّها...»[2].
وثمّة صِفات أرشَدَنا إليها دليلُ الخير النبيُّ (صلى الله عليه وآله)، لِيَكون القلب مَحبوبًا لله، وهي: الصافية مِن الذنوب، والصَلبة في الدين، والرقيقة على الإخوان.
فالرِقّة -وهي مُقابل الغِلظة والقَسوة- تَجعل القلب مَحلّ عناية خالقِه، لِصَيرورته بِها مَحبوبًا عنده -تعالى-؛ عن باقر العلوم (عليه السلام): «إنّ لله عقوبات في القلوب والأبدان: ضَنْك في المعيشة، وَوَهن في العبادة، وما ضُرِبَ عبدٌ بِعُقوبةٍ أعظم مِن قَسوةِ القلب»[3]. ولأنّ الله لطيف بِعباده، ومِن موقع رُبوبيّته للنُفوس والقلوب، مُتدارِكًا ما يوجب قسوَتَها والمعبّر عنه بطول الأمد: ﴿فَطَالَ عَلَيهِمُ ٱلأَمَدُ فَقَسَت قُلُوبُهُم﴾[4]؛ إذ إنّ انقطاع القلوب عن مصدر الرحمة يُؤدّي إلى قَسوتها وجفافها، تلطف بحسن التدبير، وجَعَلَ مواسم لِمَطر الرحمة الإلهيّة
[1] ابن أبي جمهور الإحسائيّ، عوالي اللئاليّ، ج4، ص7.
[2] الفيض الكاشانيّ، المحجّة البيضاء، ج3، ص322.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج75، ص176.
[4] سورة الحديد، الآية 16.
200
188
الموعظة الحادية والثلاثون: قَسْوةُ القُلوب
ينزلها على القلوب لتلين وتهتزّ وتنبت وتزهر وتثمر. ومُحرّم -كما أشهر النور- موسم ينبغي اغتنامه في التعرّض لِهذه الرحمة والنِعمة الإلهيّة العُظمى.
معنى قسوة القلوب
قبل الحديث عن أسباب قَسوة القلوب لا بُدّ مِن القول إنّ معنى كَوْن قلب الإنسان قاسيًا هو كَوْنه صلبًا لا يتفاعل مع ما يوجب الرقّة واللين، فلا يخشع بين يَدَي الله -تعالى-، ولا يَعطف على أصحاب الآلام، ولا يَحِنّ على الفقراء، ولا يرأف بِأحوال الضُعَفاء، ولا يَرِقّ لِمُصاب ذوي المصائب؛ فالقاسي مِن القلوب هو ما لا يخشع لِحَقٍّ ولا يتأثّر بِرحمة، ومِن أبرز ذلك -ونحن في عاشوراء الحسين (عليه السلام)- عدم تفاعُله وتأثّره بِمصائب أهل بيت النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله).
ولنا أن نُعبِّر بطريقة أخرى؛ فالقلب كالأرض، كلّما قلّ الماء فيها وجَفّ، ولم تَتَلَقَّ مَطر السماء، صَلبَتْ وقَسَتْ. والماء الذي يُليِّن القلوب، ويجعلها قابلةً للإنبات والصلاح لِلزرع، هو الرحمة. فالقلب القاسي هو القلب الذي جَفَّتْ فيه ونَضبَتْ ينابيع الرحمة، ولمْ يَتَلَقَّ مَطر الرحمة النازل مِن الله -تعالى- في مواسم الرحمة ومجالسها ومواطنها -ومنها مجالس عاشوراء-؛ وَرَد في الحديث القدسيّ: «القاسي القلب مِنّي بعيد»[1].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص329.
201
189
الموعظة الحادية والثلاثون: قَسْوةُ القُلوب
أسباب قسوة القلوب
ثمّة أسباب كثيرة لِقَسوة القلب، وقد ذُكِرَت في القرآن الكريم وأحاديث النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام)، ومِنها:
1. تَرْك العبادة
إنّ مُراودة العبادة مراودةٌ لِباب الرحمن الرحيم، ومِن جُملة آثارها أن يُكسى الإنسان مِن حلَل الله -تعالى-. فالعبادة بابٌ لِتَلَقّي العناية الإلهيّة. وكما أنّ زائر العطّار يعود مِن عنده برائحة عَطِرة يَجِدها هو ومَن يمرّ به، فإنّ المُقبِل على الله بِالعبادة كذلك، لا بُدّ مِن أن يعود مِن عنده -وهو الرحمن الرحيم- بِشيء مِن الرحمة.
مُضافًا إلى أنّ مِن آثار العبادة التواضع؛ لأنّها تَذَلُّلٌ بين يَدَي الله -تعالى-، والتذلّل يُفضي إلى إيقاظ الرحمة في القلب. وفي أثر تَرْك العبادة على القلب قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «تَرْك العبادة يُقسّي القلب، وتَرْك الذِكر يُميت النفْس»[1].
2. طول الأمل ونسيان الآخرة
عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «مَن يأمل أن يعيش غَدًا فإنّه يأمل أن يعيش أبدًا، ومَن يأمل أن يعيش أبدًا يَقسو قلبه، ويَرغب في الدنيا، ويزهد في الذي وَعَدَه ربّه -تبارك وتعالى-»[2].
[1] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج3، ص2612.
[2] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ص156.
202
190
الموعظة الحادية والثلاثون: قَسْوةُ القُلوب
ويمكن أن يستفاد، مُضافًا إلى طول الأمل، أنّ نسيان الإنسان الموتَ والقبرَ والآخرةَ مِن موجبات قَسوة القلب.
3. كَثرة الذنوب
عن الإمام عليّ (عليه السلام): «ما جَفَّت الدموع إلّا لِقَسوة القلوب، وما قَسَت القلوب إلّا لِكَثرة الذنوب»[1].
وآثار الذنوب التي ذُكِرَت بِأنّها تَترك على صفحة القلب آثارًا سَمّاها القرآن الرَيْن؛ ﴿كَلَّا بَل رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكسِبُونَ﴾[2]. فإذا تَراكَم الرَيْن نتيجة الإكثار مِن الذنوب وعَدَم مُعالجته بالتوبة والاستغفار، أدّى إلى قَسوة القلوب. ومِن أهمّ ما يؤدّي إلى قَسوة القلب مِن الذنوب استماع الغناء والموسيقى المحرّمة.
4. الثرثرة وكثرة الكلام بِغير ذِكر الله
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا تُكثِروا الكلام بِغير ذِكر الله، فإنّ كثرة الكلام بِغير ذِكر الله قَسوة القلب. إنّ أبعد النّاس مِن الله القلب القاسي»[3].
فقد ذَكَرت بعض الروايات خريطةً عجيبة تُؤدّي إلى الهلاك الأبديّ، وأوّلها كَثرة الكلام. فإنّها توصل إلى محطّة الهاوية في الطريق بِكَثرة الخطأ، التي -بِدَورها- توصل إلى قَسوة القلب، وقسوة القلب تُؤدّي
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج16، ص25.
[2] سورة المطفّفين، الآية 14.
[3] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج8، ص536.
203
191
الموعظة الحادية والثلاثون: قَسْوةُ القُلوب
ويمكن أن يستفاد، مُضافًا إلى طول الأمل، أنّ نسيان الإنسان الموتَ والقبرَ والآخرةَ مِن موجبات قَسوة القلب.
3. كَثرة الذنوب
عن الإمام عليّ (عليه السلام): «ما جَفَّت الدموع إلّا لِقَسوة القلوب، وما قَسَت القلوب إلّا لِكَثرة الذنوب»[1].
وآثار الذنوب التي ذُكِرَت بِأنّها تَترك على صفحة القلب آثارًا سَمّاها القرآن الرَيْن؛ ﴿كَلَّا بَل رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكسِبُونَ﴾[2]. فإذا تَراكَم الرَيْن نتيجة الإكثار مِن الذنوب وعَدَم مُعالجته بالتوبة والاستغفار، أدّى إلى قَسوة القلوب. ومِن أهمّ ما يؤدّي إلى قَسوة القلب مِن الذنوب استماع الغناء والموسيقى المحرّمة.
4. الثرثرة وكثرة الكلام بِغير ذِكر الله
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا تُكثِروا الكلام بِغير ذِكر الله، فإنّ كثرة الكلام بِغير ذِكر الله قَسوة القلب. إنّ أبعد النّاس مِن الله القلب القاسي»[3].
فقد ذَكَرت بعض الروايات خريطةً عجيبة تُؤدّي إلى الهلاك الأبديّ، وأوّلها كَثرة الكلام. فإنّها توصل إلى محطّة الهاوية في الطريق بِكَثرة الخطأ، التي -بِدَورها- توصل إلى قَسوة القلب، وقسوة القلب تُؤدّي
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج16، ص25.
[2] سورة المطفّفين، الآية 14.
[3] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج8، ص536.
203
191
الموعظة الحادية والثلاثون: قَسْوةُ القُلوب
إلى الهلاك الأعظم، وهو مَوت القلب؛ لأنّ الثرثار يَصِل إلى درجة اللامبالاة بما يقول وما يمكن أن يؤدّي إليه قوله، فلا يعبأ بِعرضٍ ولا بِكلام. ومِن حصائد إبليس -في هذا الزمن- ومصاديق الثرثرة ما يحصل على وسائل الاتّصال الحديثة. فَحَذار ثمّ حَذار!
5. أكْل المال الحرام
إنّ لِأَكْل المال الحرام آثارًا خطيرة جدًّا في الدنيا والآخرة، فيكون هذا المال نفسه النار التي محلّها بطن الإنسان. وقد قال -تعالى- عن أكْلِ مال اليتامى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموَٰلَ ٱليَتَٰمَىٰ ظُلمًا إِنَّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَارٗا وَسَيَصلَونَ سَعِيرٗا﴾[1].
ومِن مصاديق المال الحرام في زماننا ما يُؤكل بالرِبا والتجارة المحرّمة والاحتيال والتجارة بالمحرّمات.
أمّا في الدنيا، فإنّ أكل المال الحرام كان سببًا لِقَسوة قلوب جُنود ابن زياد وابن سعد، إلى درجة أنّهم ارتكبوا أفظع ما ارتُكب مِن جرائم في تاريخ البشريّة. ولِشِدّة قَسوة هذه القلوب، لم تتأثّر بِخطابات وليّ الله المعصوم الإمام الحسين (عليه السلام) حين قال لهم: «كلّكم عاصٍ لِأمري، غير مُستَمِع قولي، فقد مُلِئَتْ بُطونكم مِن الحرام، وطُبِع على قلوبكم. وَيْلكم! ألا تُنصِتون؟ ألا تَسمعون؟»[2].
[1] سورة النساء، الآية 10.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج54، ص8.
204
192
الموعظة الحادية والثلاثون: قَسْوةُ القُلوب
علاج قسوة القلب
ذَكَرت الروايات مجموعة مِن علاجات قسوة القلب، مِنها:
1. ذِكر الله في الخَلَوات
عن الإمام الباقر (عليه السلام): «تَعَرَّضْ لِرِقّة القلب بِكَثرة الذِكر في الخَلَوات»[1].
2. التفكُّر والبكاء مِن خشية الله
عن الرسول (صلى الله عليه وآله): «عَوِّدوا قلوبكم الرِقّة، وأكثِروا مِن التفكُّر والبكاء مِن خشية الله»[2].
3. الرِقّة الإنسانيّة
عن النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) -لَمّا شكا إليه رجل قَساوة قلبه-: «إذا أردْتَ أن يَلين قلبك، فَأَطْعِم المسكين، وامسَحْ رأس اليتيم»[3].
الْجَأ إلى طبيب القلوب
وَرَد في دعاء الجوشن الكبير: «يا مُقلِّب القلوب، يا طبيب القلوب، يا مُنوِّر القلوب، يا أنيس القلوب...»[4].
فالله هو طبيب القلوب، وعليك أن تَلجأ إلى طبيبك الذي بِيَدِه طِبُّك وشفاؤك، ومِن ثمّ عليك أن تشكو إليه آلامك -كما علَّمَنا الإمام
[1] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج3، ص2615.
[2] المصدر نفسه.
[3] المصدر نفسه.
[4] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج91، ص385.
205
193
الموعظة الحادية والثلاثون: قَسْوةُ القُلوب
السجّاد (عليه السلام) في مناجاة الشاكين: «إلهي، إليك أشكو قلبًا قاسيًا، مع الوسواس مُتقلّبًا، وبالرَيْن والطَبْع مُتلبّسًا، وعينًا عن البكاء مِن خوفك جامدة، وإلى ما يَسرّها طامحة»[1].
ووَرد في مناجاة التائبين: «إلهي، ألبَسَتْني الخطايا ثوبَ مَذلّتي، وجَلّلني التباعُد مِنك لباسَ مسكنتي، وأماتَ قلبي عظيمُ جِنايتي، فأَحْيِه بِتوبة مِنك يا أملي وبُغيتي، ويا سُؤلي ومُنيتي. فوَعِزّتك، لا أجِدُ لِذنوبي سِواك غافرًا، ولا أرى لِكَسري غيرك جابرًا...»[2].
[1] الإمام زين العابدين(عليه السلام)، الصحيفة السجّاديّة (تحقيق الأبطحي)، مناجاة الشاكين، ص403.
[2] المصدر نفسه، مناجاة التائبين، ص401.
206
194
الموعظة الثانية والثلاثون: محمّد المصطفى (صلى الله عليه وآله) رحمة للعالمين
الموعظة الثانية والثلاثون: محمّد المصطفى (صلى الله عليه وآله) رحمة للعالمين
تعرُّف عظمةِ نبيّ الإسلام محمّد (صلى الله عليه وآله)، وقبسٍ من سلوكه الشخصيّ؛ للاقتداء به.
محاور الموعظة
ولادته وتسميته (صلى الله عليه وآله)
طهارة النسب
الله -تعالى- يصف النبيَّ محمّدًا ونبوّتَه (صلى الله عليه وآله)
قبسٌ من سلوكه وصفاته الشخصيّة
تصدير الموعظة
الإمام الصادق (عليه السلام): «لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله)، انْتَهَى بِهِ جَبْرَئِيلُ إِلَى مَكَانٍ، فَخَلَّى عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا جَبْرَئِيلُ، تُخَلِّينِي عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ؟! فَقَالَ: امْضِهْ، فَوَاللَّهِ، لَقَدْ وَطِئْتَ مَكَانًا مَا وَطِئَهُ بَشَرٌ، وَمَا مَشَى فِيهِ بَشَرٌ قَبْلَك»[1].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج1، ص442.
207
195
الموعظة الثانية والثلاثون: محمّد المصطفى (صلى الله عليه وآله) رحمة للعالمين
ولادته وتسميته (صلى الله عليه وآله)
تتحدّث جملة من المصادر التاريخيّة والحديثيّة عن وقوع حوادث عجيبة يوم ولادته (صلى الله عليه وآله)، مثل: انطفاء نار فارس، وزلزال أصاب الناس حتّى تهدّمت الكنائس والبيَع، وزال كلُّ شيء يُعبَد من دون الله -عزَّ وجلّ- عن موضعه، وتساقُط الأصنام المنصوبة في الكعبة على وجوهها، حتّى عُمِّيَت على السحَرَة والكهّان أُمورُهم، وطلوع نجوم لم تُرَ من قبل هذا. وقد وُلِد (صلى الله عليه وآله) وهو يقول: «اللهُ أَكْبَرُ، وَالحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا»[1]. وأمّا عن يوم ميلاده (صلى الله عليه وآله)، فقد حدّده أهل بيته (عليهم السلام) -وهم أدرى بما في البيت- فقالوا: «هو يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأوّل، بعد طلوع الفجر، كما هو المشهور بين الإماميّة، وعند غيرهم أنّه وُلِد في يوم الاثنين الثاني عشر من الشهر نفسه».
واشتهر النبيّ (صلى الله عليه وآله) بـاسمين: «محمّد» و«أحمد»، وقد ذكرهما القرآن الكريم، وروى المؤرّخون أنّ جدّه عبد المطلب قد سمّاه محمّدًا، وأجاب مَن سأله عن سبب التسمية قائلًا: «أردْتُ أنْ يُحْمَدَ فِي السمَاءِ وَالأرضِ»[2]. كما أنّ أُمّه آمنة سمّته قبل جدّه بـ: أحمد. وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنِي وَعَلِيًّا مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ، وَشَقَّ لَنَا اسْمَيْنِ مِنْ أَسْمَائِهِ؛ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَأَنَا مُحَمَّدٌ، وَاللَّهُ الْأَعْلَى وَهَذَا عَلِيٌّ»[3].
[1] اليعقوبيّ، تاريخ اليعقوبيّ، ج2، ص8.
[2] الحلبيّ، السيرة الحلبيّة، ج1، ص128.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج16، ص97.
208
196
الموعظة الثانية والثلاثون: محمّد المصطفى (صلى الله عليه وآله) رحمة للعالمين
طهارة النسب
قال الطبرسيّ في تفسير قوله -تعالى-: ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّٰجِدِينَ﴾[1]: ومعناه: وتقلبّك في أصلاب الموحّدين من نبيٍّ إلى نبيٍّ، حتّى أَخرَجَك نبيًّا... وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، قالا: «في أصلاب النبيّين، نبيٍّ بعد نبيٍّ، حتّى أَخرجَه من صلب أبيه، من نكاحٍ غير سفاح من لدن آدم (عليه السلام)»[2].
الله -تعالى- يصف النبيَّ محمّدًا ونبوّتَه (صلى الله عليه وآله)
يمكن الإشارة إلى بعض ما ورد في القرآن الكريم حول شخصيّة رسول الله، وعظمة نبوّته ورسالته، وموقع النبيّ محمّد في السماء والأرض:
هدف بعثتِه ورسالتِه
الرحمة بالبشر، والتزكية والتربية لهم، قال -تعالى-: ﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلأُمِّيِّنَ رَسُولٗا مِّنهُم يَتلُواْ عَلَيهِم ءَايَٰتِهِ وَيُزَكِّيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلكِتَٰبَ وَٱلحِكمَةَ﴾[3]، وقال -تعالى-: ﴿وَمَا أَرسَلنَٰكَ إِلَّا رَحمَةٗ لِّلعَٰلَمِينَ﴾[4].
الأسوة الحسنة وصاحب الخُلُق العظيم
قال الله -تعالى-: ﴿لَّقَد كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٞ﴾[5]، ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ﴾[6].
[1] سورة الشعراء، الآية 219.
[2] الشيخ الطبرسيّ، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج19، ص189.
[3] سورة الجمعة، الآية 2.
[4] سورة الأنبياء، الآية 107.
[5] سورة الأحزاب، الآية 21.
[6] سورة القلم، الآية 4.
209
197
الموعظة الثانية والثلاثون: محمّد المصطفى (صلى الله عليه وآله) رحمة للعالمين
سيّد الرسل وأعظمهم وخاتمهم
قال -تعالى-: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُم وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّۧنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٗا﴾[1]، وقال النبيّ (صلى الله عليه وآله) لعليٍّ (عليه السلام): «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»[2].
تخصيصه بالإسراء والمعراج
﴿سُبحَٰنَ ٱلَّذِي أَسرَىٰ بِعَبدِهِۦ لَيلٗا مِّنَ ٱلمَسجِدِ ٱلحَرَامِ إِلَى ٱلمَسجِدِ ٱلأَقصَا﴾[3].
الأمر الإلهيّ بوجوب طاعته واحترامه
قال -تعالى-: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفشَلُواْ وَتَذهَبَ رِيحُكُم﴾[4].
بشارات الأنبياء برسالة محمّد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله)
لقد نصّ القرآن الكريم على بشارة إبراهيم الخليل (عليه السلام) برسالة خاتم النبيّين (صلى الله عليه وآله)، بأسلوب الدعاء، قائلًا -بعد الكلام عن بيت الله الحرام في مكّة المكرّمة، ورفع القواعد من البيت، والدعاء بقبول عمله وعمل إسماعيل (عليه السلام): ﴿رَبَّنَا وَٱبعَث فِيهِم رَسُولٗا مِّنهُم يَتلُواْ عَلَيهِم ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلكِتَٰبَ وَٱلحِكمَةَ وَيُزَكِّيهِم إِنَّكَ أَنتَ ٱلعَزِيزُ ٱلحَكِيمُ﴾[5].
[1] سورة الأحزاب، الآية 40.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج8، ص107.
[3] سورة الإسراء، الآية 1.
[4] سورة الأنفال، الآية 46.
[5] سورة البقرة، الآية 129.
210
198
الموعظة الثانية والثلاثون: محمّد المصطفى (صلى الله عليه وآله) رحمة للعالمين
وصرّح القرآن الكريم بأنّ البشارة بنبوّة محمّد (صلى الله عليه وآله) الأمّيّ كانت موجودة في العهدَين القديم (التوراة) والجديد (الإنجيل)، قال -تعالى-: ﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكتُوبًا عِندَهُم فِي ٱلتَّورَىٰةِ وَٱلإِنجِيلِ يَأمُرُهُم بِٱلمَعرُوفِ وَيَنهَىٰهُم عَنِ ٱلمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ ٱلخَبَٰئِثَ وَيَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَٱلأَغلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَت عَلَيهِم﴾[1].
وقد بشّر به الإنجيل على لسان عيسى (عليه السلام) -كما أخبر القرآن الكريم بذلك، وصدّقه علماء أهل الكتاب- وقد حكاه قوله -تعالى-: ﴿وَمُبَشِّرَا بِرَسُولٖ يَأتِي مِن بَعدِي ٱسمُهُ أَحمَدُ﴾[2]. ولا مانع من أن يُعرَف الشخص باسمَين ولقبَين وكنيتَين في عُرفِ الجزيرة العربيّة وغيرها.
قبسٌ من سلوكه وصفاته الشخصيّة
محمّد (صلى الله عليه وآله) العبد الذي يخاف ربّه
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) يَقُومُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿طه ١ مَا أَنزَلنَا عَلَيكَ ٱلقُرءَانَ لِتَشقَىٰ﴾[3]»[4].
[1] سورة الأعراف، الآية 157.
[2] سورة الصف، الآية 6.
[3] سورة طه، الآيات 1 - 2.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص95.
211
199
الموعظة الثانية والثلاثون: محمّد المصطفى (صلى الله عليه وآله) رحمة للعالمين
وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «مَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) مِنْ أَنْ يَظَلَّ جَائِعًا خَائِفًا فِي اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-»[1]. وقد تجلَّت عبوديّتُه في قولِه وسلوكِه، حتّى قال: «قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»[2].
وكان ينتظر وقت الصلاة، ويشتدُّ شوقُه للوقوف بين يدَي الله -تعالى-.
وكان كثير الدعاء، حتّى قال: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ»[3]. وعن أبي جعفر (عليه السلام): «كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) عِنْدَ عَائِشَة لَيْلَتَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تُتْعِبْ نَفْسَكَ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَة، أَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟»[4].
وفي الخبر عنه (عليه السلام): «وَلَقَدْ قُبِضَ (صلى الله عليه وآله) وَإِنَّ دِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ مِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، اِسْتَلَفَهَا [اسْتَسْلَفَهَا] نَفَقَةً لِأَهْلِه»[5].
جلوسُه وأكلُه
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ، وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ»[6].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج8، ص129.
[2] المصدر نفسه، ج5، ص321.
[3] الرواندي، الدعوات (سلوة الحزين)، ص18.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص95.
[5] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج16، ص219.
[6] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج6، ص271.
212
200
الموعظة الثانية والثلاثون: محمّد المصطفى (صلى الله عليه وآله) رحمة للعالمين
علاقتُه بأصحابه
قال -تعالى-: ﴿حَرِيصٌ عَلَيكُم بِٱلمُؤمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ﴾[1]. وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) يَقْسِمُ لَحَظَاتِهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ؛ فَيَنْظُرُ إِلَى ذَا وَيَنْظُرُ إِلَى ذَا بِالسَّوِيَّةِ. قَالَ: وَلَمْ يَبْسُطْ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) رِجْلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ قَطُّ، وَإِنْ كَانَ لَيُصَافِحُهُ الرَّجُلُ، فَمَا يَتْرُكُ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) يَدَهُ مِنْ يَدِهِ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ التَّارِك»[2].
الجود والحِلم
قال -تعالى-: ﴿لَقَد جَاءَكُم رَسُولٞ مِّن أَنفُسِكُم عَزِيزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُّم حَرِيصٌ عَلَيكُم بِٱلمُؤمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ﴾[3]. وقد رُوِيَ أنّه: ما سُئِل النبيُّ (صلى الله عليه وآله) شيئًا قطّ، فقال: «لا»، وأنّه عَفَا عنْ قُرَيْشٍ التي عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَحَارَبَتْهُ بِكُلِّ مَا لَدَيْها، وَهُوَ فِي ذُرْوَةِ القُدْرَةِ، قَائِلًا لَهُمْ: «اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»[4]، وقال: «اِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ»[5].
ورُوي: أنّ رَجُلًا كَلَّمَ النبيَّ (صلى الله عليه وآله)، فَأَرْعَدَ، فَقَالَ: «هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ؛ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ القَدِيدَ»[6].
[1] سورة التوبة، الآية 128.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص671.
[3] سورة التوبة، الآية 128.
[4] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج21، ص119.
[5] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج3، ص513.
[6] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج4، ص3226.
213
201
الموعظة الثانية والثلاثون: محمّد المصطفى (صلى الله عليه وآله) رحمة للعالمين
شجاعته
قال الله -تعالى-: ﴿ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخشَونَهُۥ وَلَا يَخشَونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا﴾[1].
زهده
عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، قُلْتُ: لَا يَا رَبِّ، وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا؛ فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ»[2]. ويذكر المؤرِّخون أنّه كان (صلى الله عليه وآله) يرقّع ثوبه، ويخصف نعله، ويحلب شاته، ويأكل مع العبد، ويجلس على الأرض، ولا يمنعه الحياء أن يحمل حاجته من السوق إلى أهله، ويصافح الغنيّ والفقير.
[1] سورة الأحزاب، الآية 39.
[2] الترمذيّ، سنن الترمذيّ، ج4، ص6.
214
202
الموعظة الثالثة والثلاثون: آية المودّة
الموعظة الثالثة والثلاثون: آية المودّة
تعظيم حبّ أهل البيت (عليهم السلام) ومودّتهم في القلب والسلوك.
محاور الموعظة
المودّة في القربى
وجوب المودّة
حقيقة الحبّ
حبّ أهل البيت (عليهم السلام)
بين الحبّ والمودّة
آثار حبّ أهل البيت (عليهم السلام)
حبّ الإمام الحسين (عليه السلام)
تصدير الموعظة
﴿قُل لَّا أَسَٔلُكُم عَلَيهِ أَجرًا إِلَّا ٱلمَوَدَّةَ فِي ٱلقُربَىٰ﴾[1].
[1] سورة الشورى، الآية 23.
215
203
الموعظة الثالثة والثلاثون: آية المودّة
من القيم الجماليّة التي تمثّلَت في مدرسة كربلاء، «قيمة الحبّ». هذه القيمة التي عبّر عنها عابس بن أبي شبيب الشاكريّ، أحد أنصار الإمام الحسين (عليه السلام)، عندما قال: «حبُّ الحسينِ أجنَّني». حديثنا في هذه الليلة، عن قيمة الحبّ، وذلك عبر عناوين عدّة.
المودّة في القربى
المراد بالمودّة في القربى، مودّة قرابة النبيّ (صلى الله عليه وآله)، وهم عترته من أهل بيته (صلى الله عليه وآله). وقد وردَت روايات من طرق أهل السنّة، وتكاثرَت الأخبار من طرق الشيعة، على تفسير الآية بمودّتهم وموالاتهم (عليهم السلام)، ويؤيّده الأخبار المتواترة من طرق الفريقَين، على وجوب موالاة أهل البيت (عليهم السلام) ومحبّتهم[1].
روى السيوطيّ وغيره -في تفسير هذه الآية- بالإسناد إلى ابن عبّاس، قال: لمّا نزلت هذه الآية: ﴿قُل لَّا أَسَٔلُكُم عَلَيهِ أَجرًا إِلَّا ٱلمَوَدَّةَ فِي ٱلقُربَىٰ﴾، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أُمِرْنَا بِمَوَدَّتِهِمْ؟ قَالَ: «عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَوُلْدُهُمَا»[2].
وعن أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام): «فِينَا فِي آلِ حم، آيَةٌ لَا يَحْفَظُ مَوَدَّتَنَا إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ» ثمّ قرأ: ﴿قُل لَّا أَسَٔلُكُم عَلَيهِ أَجرًا إِلَّا ٱلمَوَدَّةَ فِي ٱلقُربَىٰ﴾[3].
[1] العلّامة الطباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج18، ص46.
[2] السيوطيّ، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، ج6، ص7.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج23، ص230.
216
204
الموعظة الثالثة والثلاثون: آية المودّة
وإلى هذا أشار الكُمَيْت الأسديّ بقوله:
وَجَدْنَا لَكُمْ في آلِ حم آيةً
تَأوَّلَهَا منَّا تَقِيٌّ ومُعْرِب[1]
وجوب المودّة
استدلّ الفخر الرازيّ على ذلك بثلاثة أوجه، فبعد أن روى الحديث عن الزمخشريّ، قال: «فثبت أنّ هؤلاء الأربعة أقارب النبيّ (صلى الله عليه وآله)؛ وإذا ثبت هذا، وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيدٍ من التعظيم، ويدلّ عليه أوجه:
الأوّل: قوله -تعالى-: ﴿إِلَّا ٱلمَوَدَّةَ فِي ٱلقُربَىٰ﴾.
الثاني: لا شكّ في أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) يحبّ فاطمة (عليها السلام)؛ إذ قال (صلى الله عليه وآله): «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُؤذِينِي مَا يُؤْذِيهَا»[2]. وثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه كان يحبّ عليًّا والحسن والحسين؛ وإذا ثبت ذلك، وجب على الأمّة كلّها مثله؛ لقوله -تعالى-: ﴿وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُم تَهتَدُونَ﴾[3]، ولقوله -تعالى-: ﴿فَليَحذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمرِهِ﴾[4].
الثالث: إنّ الدعاء للآل منصب عظيم؛ ولذلك جُعِل هذا الدعاء خاتمة التشهّد في الصلاة، وهو قوله: «اللَّهُمَّ، صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَآلِ
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج23، ص231.
[2] المصدر نفسه، ص234.
[3] سورة الأعراف، الآية 158.
[4] سورة النور، الآية 63.
217
205
الموعظة الثالثة والثلاثون: آية المودّة
مُحَمَّد»، وهذا التعظيم لم يوجد في حقّ غير الآل؛ فذلك كلّه يدلّ على أنّ حبّ محمّد وآل محمّد واجب[1].
وأشار الشافعيّ إلى نزول آية المودّة في أهل البيت (عليهم السلام)، بقوله:
يا آلَ بيتِ رسولِ اللهِ حبُّكُمُ فرضٌ مِنَ اللهِ في القرآنِ أنزلَهُ[2]
حقيقة الحبّ
الحبّ هو الانجذاب نحو الكمال، فمن يحبّ شخصًا مثلًا، فإنّه يرى فيه كمالًا من جمال أو قوّة أو علم.
والإنسان خُلِق مفطورًا على حبّ الكمال والسعي لاكتسابه، وإنّ هذا الحبّ يمثّل درجةً شديدةً في وجوده، فهو أمرٌ وجوديّ ذاتيّ شديد، فلا يحتاج إلى تعليل.
وفي ضوء ذلك، يتبيّن لنا أنّ الموارد والمواطن الكماليّة جميعها تقع هدفًا أمام سير الإنسان التكامليّ، يتزوّد بحسب مراتبها للوصول إلى الغاية العُليا، وهي الكمال المطلق، إذا أضفنا إلى ذلك أنّ الإنسان بذاته هو مظهر من مظاهر أسماء الله الحُسنى، حيث تجلّت فيه القدرة الإلهيّة والعلم والحياة والإبداع وغير ذلك.
ولاشكّ في أنّ الإنسان كلّما حاز كمالاتٍ أكثر، ومراتبَ أعلى وأشدّ وأكبر، فإنّ مظهريّة الأسماء الحسنى فيه تشتدّ، والعكس بالعكس.
[1] الفخر الرازيّ، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (تفسير الرازيّ)، ج27، ص166.
[2] ابن حجر، الصواعق المحرقة، ص148.
218
206
الموعظة الثالثة والثلاثون: آية المودّة
ولاشكّ في أنّ كلّ إنسان حائز كمالات يكون محلّ جذبِ واستقطاب الآخرين له، هذا فضلًا عمّن حاز كمالات أكثر وأشدّ وأكبر، فكيف بمن خلَتْ ساحتُه من أيّ قصور أو نقص سوى الفقر إلى الله -تعالى-؟ فلا ريب أنّه سوف يكون قطب الرحى، والنقطة الفريدة في مركز دائرة عالم الإمكان!
حبّ أهل البيت (عليهم السلام)
إذا تبيّن لنا، كما ثبت في الذكر الحكيم والسيرة الشريفة، أنّ أهل البيت (عليهم السلام) هم المصداق الأوّل والأشدّ لِمَا تقدّم كلّه، وأنّهم حازوا الكمالات الوجوديّة السامية كلّها، وأنّهم الأقرب إلى الكمال المطلق، والفاقدون لكلّ مفقودٍ سوى الفقر للغنيّ المطلق، عُلِمَ أنّ متابعة أهل البيت (عليهم السلام) ومحبّتهم قضيّة فُطِرَ الناس عليها؛ فالمتمسّك بهم، والداعي لهم يكون عاملًا في ضوء فطرته الأولى.
وهكذا، يتّضح لنا سبب حبّ أهل البيت (عليهم السلام)، وأنّه أمرٌ وجوديّ فينا، تِبْعًا لحبّ الكمال المتّصل بهم؛ وعندئذٍ، ينقطع السؤال عن سبب هذه المحبّة، كانقطاعه عن أصل طلب الكمال وحبّه.
وسيتّضح لنا اشتراط الإقرار بالنبوّة للنبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله)، والإمامة لعليّ وأهل بيته (عليهم السلام) على سائر الأنبياء السابقين، والالتزام بولايتهم، كما جاء في الأخبار المستفيضة[1].
[1] قال الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) يوم أُسرِيَ به: «أتاني ملك، فقال لي: يا محمّد، سَلْ مَن أرسَلْنا من قبلك مِن رُسُلنا، علامَ بُعِثُوا؟ قلتُ: علامَ بُعِثوا؟ قال: على ولايتك وولاية عليّ بن أبي طالب». انظر: الحاكم النيسابوريّ، معرفة علوم الحديث، ص96.وغيره الكثير.
219
207
الموعظة الثالثة والثلاثون: آية المودّة
ففي الحديث النبويّ المعتبَر: «يَا عَلِيُّ، أَنْتَ قَسِيمُ النَّارِ، تَقُولُ هَذَا لِي وَهَذَا لَك»[1]، وفي رواية أخرى: «أَنْتَ قَسِيمُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ فِي يَوْمِ القِيَامَةِ، تَقُولُ لِلنَّارِ: هَذَا لِي وَهَذَا لَك»[2].
فهو الكمال المأمول؛ من بَلَغَهُ كان نصيبه الجنّة، فطوبى لِمَن تمسّك بركبه وسار على نهجه! وذلك هو الفوز العظيم.
بين الحبّ والمودّة
الفرق بين المحبّة والمودّة هو كالفرق بين المؤثِّر وأثره؛ فالمحبّة صفة نفسيّة، والمودّة صفة عمليّة؛ فالحبّ هو المؤثّر، والمودّةهي الأثر؛ فالمحبّة تستتبع من ورائها المودّة، التي هي علامة عليه. إذًا، الحبّ صفة نفسيّة وعاطفة قلبيّة، وأمّا المودّة فهي أثر سلوكيّ وعمليّ متفرِّع على الحبّ.
عبَّر القرآنُ عن علاقة المسلم بأهل البيت بالمودّة، ولم يعبّر بالمحبّة، قال الله -تعالى-: ﴿قُل لَّا أَسَٔلُكُم عَلَيهِ أَجرًا إِلَّا ٱلمَوَدَّةَ فِي ٱلقُربَىٰ﴾[3]، فليس المطلوب من المسلم تُجاه أهل البيت مجرّد حرارة عاطفيّة وإقبال قلبيّ، بل المطلوب منه سلوك عمليّ، أي المودّة، وليس مجرّد المحبّة.
فالمودّة تكون بإحياء أمرهم، ونشر علومهم وحديثهم، وذكر فضائلهم، وإقامة عزائهم، وزيارة مراقدهم الشريفة...
[1] عليّ بن إبراهيم القمّيّ، تفسير القمّيّ، ج2، ص389.
[2] ابن حجر، الصواعق المحرقة، ص126.
[3] سورة الشورى، الآية 23.
220
208
الموعظة الثالثة والثلاثون: آية المودّة
فالله -جلّ وعلا- فرض حبّهم بنحوَين:
الأوّل: لأنّ في آل البيت (عليهم السلام) مجموعة من الفضائل والقيم، فيكون حبّهم حبًّا للفضائل والقيم. فأمرُ القرآن بحبّهم أمرٌ بالاستقامة على الفطرة، والمشي على الفطرة من حبّ الفضائل والقيم.
الثاني: إنّ حبّهم طريق لمرجعيّتهم التشريعيّة؛ فالله -سبحانه- يريد من المسلمين أن يرجعوا إلى أهل البيت في تفسير القرآن، وفي الفقه، وفي الحكم، هذه المرجعيّة التي أكّدها النبيّ (صلى الله عليه وآله) في حديث الثقلين: «وَإِنِّي أَوْشَكَ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبَ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلّ- وعِتْرَتِي؛ كِتَاب اللهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، وَعِتْرَتِي أَهْل بَيْتِي. وَإِنَّ اللَّطِيفَ الخَبِيرَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الحَوْضَ، فَانْظرُونِي بِمَ تُخْلِفُونِي فِيهِمَا»[1].
آثار حبّ أهل البيت (عليهم السلام)
1. الطاعة والورع
عن الإمام الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): «مَنْ أَحَبَّنَا، فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِنَا، وَلْيَسْتَعِنْ بِالْوَرَعِ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»[2].
وعنه (عليه السلام): «إِنَّمَا شِيعَةُ جَعْفَرٍ مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ، وَاشْتَدَّ جِهَادُهُ، وَعَمِلَ لِخَالِقِهِ، وَرَجَا ثَوَابَهُ، وَخَافَ عِقَابَهُ»[3].
[1] أحمد بن حنبل، المسند (مسند أحمد)، ج3، ص17. والحديث متواتر.
[2] الشيخ الصدوق، الخصال، ص614.
[3] المصدر نفسه، ص296.
221
209
الموعظة الثالثة والثلاثون: آية المودّة
2. استكمال الدين
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «حُبُّ أَهْلِ بَيْتِي وَذُرِّيَّتِي اسْتِكْمَالُ الدِّينِ»[1].
3. التمسّك بالعروة الوثقى
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مخاطِبًا أمير المؤمنين عليًّا (عليه السلام): «يَا عَلِيُّ، مَنْ أَحَبَّكُمْ وَتَمَسَّكَ بِكُمْ، فَقَدْ تَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى»[2].
4. الشفاعة يوم القيامة
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الْزَمُوا مَوَدَّتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا»[3].
5. منزلة الشهداء
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا، أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورًا لَهُ، أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ تَائِبًا، أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا مُسْتَكْمِلَ الْإِيمَان»[4].
حبّ الإمام الحسين (عليه السلام)
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديثٍ صحيحٍ مستفيضٍ عند المسلمين كلّهم: «حُسَيْنٌ مِنِّي، وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ»[5].
[1] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص259.
[2] الخزاز القمّيّ، كفاية الأثر، ص71.
[3] الشيخ البرقيّ، المحاسن، ج1، ص61.
[4] الثعلبيّ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبيّ)، ج8، ص314.
[5] الإمام أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج4، ص172. ومصادر كثيرة.
222
210
الموعظة الثالثة والثلاثون: آية المودّة
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ، قَذَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) وَحُبَّ زِيَارَتِهِ؛ وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ السُّوءَ، قَذَفَ فِي قَلْبِهِ بُغْضَ الْحُسَيْنِ وَبُغْضَ زِيَارَتِهِ»[1].
[1] ابن قولويه، كامل الزيارات، ص269.
223
211
الموعظة الرابعة والثلاثون: علاقة المنتظرين بالإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
الموعظة الرابعة والثلاثون: علاقة المنتظرين بالإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
تعزيز علاقة المنتظِرين بإمامهم الغائب (عجل الله تعالى فرجه).
محاور الموعظة
أهمّيّة معرفة الحجّة (عجل الله تعالى فرجه)
آداب العلاقة مع الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
توسُّل الإمام الخامنئيّ (دام ظله) بِصاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه)
روح العلاقة مع الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
تصدير الموعظة
دعاء الندبة: «هل إليك يابن أحمد سبيل فتُلقى»[1].
[1] المشهديّ، المزار، ص582.
224
212
الموعظة الثالثة والثلاثون: آية المودّة
أهمّيّة معرفة الحجّة (عجل الله تعالى فرجه)
عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله لِزرارة: «للقائم غَيبة قبل أن يقوم... وهو المنتظر، غيرَ أن اللّه يمتحن قلوب الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطِلون».
قال زرارة: جُعلت فداك، إن أدركتُ ذلك الزمان، أيّ شيء أعمل؟
قال (عليه السلام): «يا زرارة، متى أدركتَ ذلك الزمان، فلْتَدعُ بهذا الدعاء: (اللهمّ عرِّفني نفسك، فإنّك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف نبيّك. اللهمّ عرّفني رسولك، فإنّك إن لم تعرّفني رسولك لم أعرف حجّتك. اللهمّ عرّفني حجّتك، فإنّك إن لم تعرّفني حجّتك ضللتُ عن ديني»[1].
وفي الحديث المشهور: «مَن لم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهليّة»[2].
آداب العلاقة مع الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
1. مواساته في غَيبته تألُّمًا وبكاءً، والتشوّق لرؤيته
وردَ في دعاء النُدبة: «هل مِن مُعين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل مِن جَزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قذيَتْ عَيْنٌ فساعدَتْها عَيني على القذى؟»[3].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج1، ص337.
[2] الشيخ الصدوق، كمال الدين، ص409.
[3] المشهديّ، المزار، ص582.
225
213
الموعظة الرابعة والثلاثون: علاقة المنتظرين بالإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
وعن الإمام الصادق (عليه السلام): «سيّدي، غَيبتك نفَتْ رُقادي، وضيّقَت عليّ مِهادي، وابتزَّت منّي راحة فؤادي. سيّدي، غَيبتك أوصلَتْ مصابي بفجائع الأبد...»[1].
2. الصلاة عليه (عليه السلام)
جاء في دعاء الافتتاح: «اللهمّ وصَلِّ على وليّ أمرك القائم المؤمّل، والعدل المنتظر »[2].
3. التشوّق للتشرُّف بخدمته
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «لو أدركتُه لخَدمتُه مُدّة حياتي»[3].
4. التوسُّل به في المهمّات
عن الإمام الرضا (عليه السلام): «إذا نزلَت بكم شديدة، فاستعينوا بِنا على الله -عزّ وجلّ-»[4].
وعن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) وَرَد: «اللهمّ إنّي أسألكَ بحقّ وليّك وحجّتك صاحب الزمان، إلّا أعَنتَني به على جميع أُموري»[5]
[1] الشيخ الطوسيّ، الغيبة، ص168.
[2] الشيخ الطوسيّ، مصباح المتهجّد، ص580.
[3] النعمانيّ، الغيبة، ص252.
[4] الشيخ المفيد، الاختصاص، ص252.
[5] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج8، ص134.
226
214
الموعظة الثالثة والثلاثون: آية المودّة
توسُّل الإمام الخامنئيّ (دام ظله) بِصاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه)
أثناء حرب (عناقيد الغضب) التي شنّها الصهاينة على المقاومة الإسلاميّة، وبعد تفاقُم الأمور واشتدادها، وشعور الإمام الخامنئيّ (دام ظله) بالخطر، قام -حفظه المولى- بالانتقال مِن مقرّ إقامته في طهران إلى مسجد جمكران -بالقرب مِن مدينة قمّ المشرّفة- ليُصلّي فيه، ويتوسّل إلى الله بالإمام الحجّة لِينصر المقاومة الإسلاميّة في لبنان.
روح العلاقة مع الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
إنّ ما ورَدَ في آداب العلاقة مع الإمام صاحب الزمان (عليه السلام) يدعو إلى تأسيس علاقة مع شخصه المبارك، لا مع فكرة أو مشروع، بل مع إنسان معصوم وُلد مِن الإمام الحسن العسكريّ (عليه السلام). وهو -في غَيبته- حياة يعيشها المؤمن بتفاصيلها، فيقول في زيارته (زيارة آل ياسين): «السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ، السلام عليك حين تُبيّن...»[1].
ويقول له كما وَرَد في دعاء الندبة: «بنفسي أنت مِن مُغيّب لم يخلُ منّا، بنفسي أنت مِن نازحٍ ما نزح عنّا»[2].
[1] الشيخ الطوسيّ، مصباح المتهجّد، ص580.
[2] المشهديّ، المزار، ص582.
227
215
الموعظة الرابعة والثلاثون: علاقة المنتظرين بالإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
توسُّل الإمام الخامنئيّ (دام ظله) بِصاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه)
أثناء حرب (عناقيد الغضب) التي شنّها الصهاينة على المقاومة الإسلاميّة، وبعد تفاقُم الأمور واشتدادها، وشعور الإمام الخامنئيّ (دام ظله) بالخطر، قام -حفظه المولى- بالانتقال مِن مقرّ إقامته في طهران إلى مسجد جمكران -بالقرب مِن مدينة قمّ المشرّفة- ليُصلّي فيه، ويتوسّل إلى الله بالإمام الحجّة لِينصر المقاومة الإسلاميّة في لبنان.
روح العلاقة مع الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
إنّ ما ورَدَ في آداب العلاقة مع الإمام صاحب الزمان (عليه السلام) يدعو إلى تأسيس علاقة مع شخصه المبارك، لا مع فكرة أو مشروع، بل مع إنسان معصوم وُلد مِن الإمام الحسن العسكريّ (عليه السلام). وهو -في غَيبته- حياة يعيشها المؤمن بتفاصيلها، فيقول في زيارته (زيارة آل ياسين): «السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ، السلام عليك حين تُبيّن...»[1].
ويقول له كما وَرَد في دعاء الندبة: «بنفسي أنت مِن مُغيّب لم يخلُ منّا، بنفسي أنت مِن نازحٍ ما نزح عنّا»[2].
[1] الشيخ الطوسيّ، مصباح المتهجّد، ص580.
[2] المشهديّ، المزار، ص582.
227
216
الموعظة الخامسة والثلاثون: علامات الظهور بين التطبيق والتحليل
الموعظة الخامسة والثلاثون: علامات الظهور بين التطبيق والتحليل
تعرّف أهمّ الخطوط العامّة التي رسمها أهل البيت (عليهم السلام) في معرفة علامات الظهور وتحديدها وتطبيقها.
محاور الموعظة
علامات الظهور
الآثار السلبيّة للتطبيق والفهم الخاطئ لعلامات الظهور
توصيات الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) بشأن علامات الظهور
قصّة وعِبرة
تصدير الموعظة
﴿بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيرٞ لَّكُم إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيكُم بِحَفِيظٖ﴾[1].
[1] سورة هود، الآية 86.
228
217
الموعظة الخامسة والثلاثون: علامات الظهور بين التطبيق والتحليل
علامات الظهور
إنّ علامات ظهور الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) تُشكّل في منظومتها الفكريّة -بصنفَيْها المحتوم وغير المحتوم- فِكرًا عقائديًّا عمِل الأئمّة المعصومون على ترسيخه في أذهان الناس، وهذا لا يختلف كثيرًا عن باقي العقائد الإسلاميّة، بل لا يختلف عن عقيدة الشيعة بأئمّة أهل البيت (عليهم السلام).
غير أنّ فكرة علامات الظهور تخطّتْ كونها مسألة عقائديّة يُؤمن بها المسلم، فقد كان لها تأثيرها العمليّ في سلوكه الفرديّ الشخصيّ والاجتماعيّ. فبدلًا مِن أن يكون مؤمنًا بالمهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، صار لزامًا عليه أن ينتظر ظهوره ويُمهّد الأرضيّة المناسبة لذلك الظهور؛ لذا حدّد أهل البيت (عليهم السلام) الخطوط العامّة التي ينبغي على المسلم أن يتعامل بها مع أحداث ما قبل الظهور، وكيف يمكن له أن يتصرّف حِيال تلك العلامات الحتميّة وغير الحتميّة التي تحصل في زمانه.
الآثار السلبيّة للتطبيق والفهم الخاطئ لعلامات الظهور
1. توجيه الكذب للمعصوم
إنّ تطبيق علامات الظهور، وسرعة الاعتماد عليها، قد يؤدّي إلى توجيه تُهمة الكذب إلى المعصومين (عليهم السلام)؛ لأنّ المعصوم قد حدّد العلامات، وبيّن أسبابها وظروفها، وأماكن حدوثها، فلو حدث في مكان ما علامات خالفَت قول المعصوم، أو تقدّمت علامة على أخرى، فإنّ ذلك يكون مُخالفًا لكلام المعصوم (عليه السلام)؛ فإمّا أن تكون المشكلة في تحقّق العلامة، وإمّا أن تكون المشكلة في نصّ كلام المعصوم.
229
218
الموعظة الخامسة والثلاثون: علامات الظهور بين التطبيق والتحليل
2. إبطال فكرة الانتظار
لقد أُمرنا بانتظار الفرج المحتوم، ولكن لو اعتمدنا على علامات غير دقيقة، أو خُيِّل إلينا -ولو عن الطريق التحليل- أنّها هي العلامة المقصودة في الرواية، ثمّ تبيّن خلاف ما حلّلناه، فإنّ ذلك سوف ينعكس سلبًا على انتظارنا للإمام (عليه السلام). إذ إنّ الإنسان يصبح غير مكترث بما سوف يحصل، ولن يعدّ نفسه للظهور، بل قد يصل به الأمر إلى مرحلة أنّ العلامة تكون فعلًا قد تحقّقت، إلّا أنّه -لكثرة الخطأ الحاصل في فهم وتحليل علامات الظهور- ترَكَ الاستعداد، فلا يُؤمن بتلك العلامة، وإن كانت صحيحة.
3. تشويش أفكار الناس
إنّ الإسراع في عمليّة تطبيق علامات الظهور يؤدّي إلى آثار سلبيّة على نفوس الناس، فإنّه ينعكس سلبًا على ضِعاف الإيمان بالخصوص، وقد تصل المسألة إلى مرحلة الشكّ، وعند البعض الآخر إلى مرحلة اليأس.
4. فتح الباب أمام الكثير من العابثين بالعقيدة المهدويّة
عن طريق تشويه صورتها، والقول إنّ هذه الفكرة غير صحيحة، إذ يكثر فيها الكذب والافتراء؛ لأنّ ما يُقال بأنّه من علامات المهديّ لم يتحقّق، وأنّ تلك الأخرى لم تتحقّق. فينعكس ذلك على أصل العقيدة، ويتمسّك به المنكرون للإمامة ولقضيّة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)؛ وهذا ما نلاحظه في مجتمعاتنا المعاصرة، فإنّ كثيرًا مِن الأشخاص
230
219
الموعظة الخامسة والثلاثون: علامات الظهور بين التطبيق والتحليل
المنكرين لقضيّة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) يتمسّكون بهذه الأمور، ويقولون إنّ ما تدّعونه من علامات لم يحصل، وما مِن علامات طُبّقت إلّا وبانَ فسادها بعد مُدّة، وهذا دليل على بطلان أصل العقيدة المهدويّة.
5. إحداث خلل في المسار العامّ لحركة الظهور
إذ إنّ تطبيق كثير من العلامات، أو التسرّع في تلقّفها، سببه عدم الفهم والوضوح لتسلسل علامات الظهور. فقد يؤدّي ذلك إلى تقديم علامات، وتأخير أخرى، ما يُحدث خللًا في المنظومة العامّة لِسَير علامات الظهور.
توصيات الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) بشأن علامات الظهور
1. انتظار الفرج
عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «انتظروا الفرج، ولا تيأسوا مِن رَوح الله، فإنّ أحبّ الأعمال إلى الله -عزَّ وجلّ- انتظار الفرج ما دام عليه العبد المؤمن...»[1].
2. عدم التوقيت
نهى أهل البيت (عليهم السلام) عن التوقيت في ظهور المهديّ (عجل الله تعالى فرجه). والتوقيت يتضمّن تطبيق العلامات على أشخاص قد يُظَنّ أنّهم هم الذين تحدّثت عنهم الروايات.
[1] الشيخ الصدوق، الخصال ص616.
231
220
الموعظة الخامسة والثلاثون: علامات الظهور بين التطبيق والتحليل
لم ينقص أجله»، ثمّ قال: «إنّ فلان بن فلان حتّى بلغ السابع من ولد فلان»، قلت: فما العلامة في ما بيننا وبينك -جُعلت فِداك-؟ قال: «لا تبرح الأرض يا فضل حتّى يخرج السفيانيّ، فإذا خرج السفيانيّ فأجيبوا إلينا -يقولها ثلاثًا-، وهو من المحتوم»[1].
5. معرفة العلامة؛ أي معرفة الإمام المهديّ(عجل الله تعالى فرجه)
عن عمر بن أبان قال: سمعتُ أبا عبد الله الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) يقول: «اعرف العلامة، فإذا عرفته لم يضرّك تقدّمَ هذا الأمرُ أو تأخّر؛ إنَّ الله -عزَّ وجلّ- يقول: ﴿يَومَ نَدعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَٰمِهِم﴾[2]، فمَن عرف إمامه كان كمن كان في فسطاط المُنتَظَر (عليه السلام)»[3].
6. التحذير من الخفّة والانزلاق وراء أدعياء الإصلاح المواكبين للإصلاح الشامل
جابر الجعفيّ، عن أبي جعفر (عليه السلام)، يقول: «الزم الأرض، لا تحرّكنّ يدك ولا رجلك أبدًا، حتّى ترى علامات أذكرها لك في سنة» -ثمّ ذكر العلامات المحتومة مع تفاصيل كلّ منها-، وقال: «وإيّاك وشذّاذ من آل محمّد (عليهم السلام)، ولا تتّبع منهم رجلًا أبدًا، حتّى ترى رجلًا مِن ولد الحسين، معه عهد نبيّ الله ورايته وسلاحه...»[4].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج8، ص274.
[2] سورة الإسراء، الآية 71.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج1، ص372.
[4] العيّاشيّ، تفسير العيّاشيّ، ج1، ص64.
233
221
الموعظة الخامسة والثلاثون: علامات الظهور بين التطبيق والتحليل
7. التريُّث والانتظار لمعرفة مآل المدّعي أو الشخصيّة التي تظهر عليها تلك العلامة
عن الإمام عليّ بن الحسين (عليهما السلام): «والله، لا يخرج واحد منّا قبل خروج القائم (عليه السلام)، إلّا كان مثله مثل فرخ طار مِن وكره قبل أن يستوي جناحاه، فأخذه الصبيان فعبثوا به»[1].
8. التحذير مِن ظهور رايات تدّعي الدعوة للمهديّ(عجل الله تعالى فرجه)
عن المفضّل بن عمر الجعفيّ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إيّاكم والتنويه، أما -والله- لَيغيبنّ إمامكم سنين مِن دهركم، ولَيمحّص حتّى يُقال مات أو هلك، بأيّ وادٍ سلك، ولَتدمعنّ عليه عيون المؤمنين، ولَتكفأنّ كما تكفأ السفن في أمواج البحر، فلا ينجو إلّا مَن أخذ الله ميثاقه، وكتب في قلبه الإيمان، وأيدّه بروح منه، ولَترفعنّ اثنتا عشرة راية مشتبهة، لا يُدرى أيّ مِن أيّ». قال: فبكيت، فقال لي: «ما يُبكيك يا أبا عبد الله؟» فقلتُ: وكيف لا أبكي وأنت تقول: «تُرفع اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يُدرى أيّ مِن أي»، فكيف نصنع؟
قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصُفّة، فقال: «يا أبا عبد الله، ترى هذه الشمس؟»، قلت: نعم، قال: «والله! لَأمرُنا أبيَن مِن هذه الشمس»[2].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج8، ص274.
[2] الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ص347.
234
222
الموعظة الخامسة والثلاثون: علامات الظهور بين التطبيق والتحليل
9. رواية المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) واضحة المعالم
كما جاء في الرواية السابقة عن المفضّل بن عمر الجعفيّ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال جابر: وأنت تقول: «ترفع اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يُدرى أيّ مِن أيّ»، فكيف نصنع؟ قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصُفّة، فقال: «يا أبا عبد الله، ترى هذه الشمس؟»، قلت: نعم، قال: «والله! لَأمرنا أبيَن مِن هذه الشمس».
10. عدم الاستعجال
قال إبراهيم بن خليل: قلتُ لأبي الحسن (عليه السلام): جُعلت فِداك، مات أبي على هذا الأمر، وقد بلغتُ مِن السنين ما قد ترى، أموت ولا تُخبرني بشيء؟ فقال (عليه السلام): «يا أبا إسحاق، أنت تعجل»، فقلت: إي -والله- أعجل، وما لي لا أعجل، وقد بلغتُ مِن السنّ ما ترى؟! فقال (عليه السلام): «أما والله -يا أبا إسحاق- ما يكون ذلك حتّى تميّزوا وتمحّصوا، وحتّى لا يبقى منكم إلّا الأقلّ...»[1].
11. إنّ الأمر بيد الله -سبحانه وتعالى-
عن أبي جعفر (عليه السلام): «ما لكم لا تملكون أنفسكم وتصبرون حتّى يجيء الله -تبارك وتعالى- بالذي تريدون؟ إنّ هذا الأمر ليس يجيء على ما تريد الناس، إنّما هو أمر الله -تبارك وتعالى- وقضاؤه والصبر، وإنّما يعجل مَن يخاف الفَوت»[2].
[1] النعمانيّ، الغيبة، ص111.
[2] الحميريّ، قرب الإسناد، ص381.
234
223
الموعظة الخامسة والثلاثون: علامات الظهور بين التطبيق والتحليل
12. إنّ أمر الظهور له غايته ووقته المحدّد الذي لا يمكن أن يتخلّف عنه
عن الإمام الصادق (عليه السلام) عند ذكر ملوك بني العبّاس، قال: «إنّما هلك الناس مِن استعجالهم لهذا الأمر. إنّ الله لا يعجل لِعجَلَة العباد. إنّ لهذا الأمر غاية يُنتهى إليها، فلو قد بلغوها، لم يستقدموا ساعةً ولم يستأخروا»[1].
13. عدم إذاعة وقت الظهور
عن إسحاق بن عمّار، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «يا أبا إسحاق، إنّ هذا الأمر قد أخّر مرّتين»[2].
قصّة وعِبرة
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «وأمّا إبطاء نوح (عليه السلام)، فإنّه لمّا استنزلَت العقوبة على قومه من السماء، بعث الله -عزَّ وجلّ- الروح الأمين (عليه السلام) بِسبع نويّات، فقال: يا نبيّ الله، إنّ الله -تبارك وتعالى- يقول لك: إنّ هؤلاء خلائقي وعبادي، ولستُ أُبيدهم بصاعقة مِن صواعقي إلّا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجّة، فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك، فإنّي مُثيبك عليه. واغرس هذه النوى، فإنّ لك في نباتها وبلوغها وإدراكها -إذا أثمرَت- الفرج والخلاص، فبشّر بذلك مَن تَبِعك مِن المؤمنين. فلمّا نبتت الأشجار وتأزّرَت وتسوّقَت وتغصّنَت
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج1، ص369.
[2] النعمانيّ، الغيبة، ص303.
236
224
الموعظة الخامسة والثلاثون: علامات الظهور بين التطبيق والتحليل
وأثمرَت وَزَهَا الثمر عليها بعد زمان طويل، استنجز مِن الله -سبحانه وتعالى- العِدَة، فأمره الله -تبارك وتعالى- أن يغرس مِن نوى تلك الأشجار، ويُعاود الصبر والاجتهاد، ويؤكّد الحجّة على قومه.
فأخبر بذلك الطوائف التي آمنَت به، فارتدّ منهم ثلاثمئة رجل، وقالوا: لو كان ما يدّعيه نوح حقًّا، لَما وقع في وعد ربّه خُلف.
ثمّ إنّ الله -تبارك وتعالى- لم يزَلْ يأمره عندَ كلّ مرّة بأن يغرسها مرّة بعد أخرى، إلى أن غرسَها سبع مرّات، فما زالت تلك الطوائف مِن المؤمنين ترتدّ منه، طائفة بعد طائفة، إلى أن عاد إلى نيّف وسبعين رجلًا، فأوحى الله -تبارك وتعالى- عند ذلك إليه، وقال: يا نوح، الآن أسفر الصبح عن الليل لِعينك حين صرّح الحقّ عن محضِه، وصُفِّي مِن الكدر بارتداد كلّ مَن كانت طينته خبيثة، فلو أنّي أهلكتُ الكفّار وأبقيتُ مَن قد ارتدّ مِن الطوائف التي كانت آمنَت بك، لَما كنتُ صدقتُ وعدي السابق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد مِن قومك، واعتَصَموا بِحبل نبوّتك بأن أستخلِفهم في الأرض وأُمكّن لهم دينهم وأبدّل خوفهم بالأمن، لكي تَخْلُص العبادة لي بذهاب الشكّ مِن قلوبهم. وكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالأمن منّي لهم، مع ما كنت أعلم مِن ضعف يقين الذين ارتدّوا، وخُبث طينهم، وسوء سرائرهم التي كانت نتائج النفاق وسنوح الضلالة؟ فلو أنّهم تسنّموا منّي الملك الذي أوتي المؤمنين وقت الاستخلاف إذا أهلكتُ أعداءهم، لَنشقُوا روائح صفاته، ولاستحكمَتْ سرائر نفاقهم، وتأبّدَتْ
237
225
الموعظة الخامسة والثلاثون: علامات الظهور بين التطبيق والتحليل
حِبال ضلالة قلوبهم، ولَكاشَفوا إخوانهم بالعداوة، وحاربوهم على طلب الرئاسة، والتفرّد بالأمر والنهي. وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب؛ ﴿وَٱصنَعِ ٱلفُلكَ بِأَعيُنِنَا وَوَحيِنَا﴾[1]؟
قال الصادق (عليه السلام): «وكذلك القائم، فإنّه تمتدّ أيّام غَيبته لِيصرّح الحقّ عن محضه، ويصفو الإيمان مِن الكدر بارتداد كلّ مَن كانت طينته خبيثة مِن الشيعة الذين يُخشى عليهم النفاق إذا أحسّوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم (عجل الله تعالى فرجه)»[2].
[1] سورة هود، الآية 37.
[2] الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ص355.
238
226
الموعظة السادسة والثلاثون: دور الابتلاء في صناعة الإنسان
الموعظة السادسة والثلاثون: دور الابتلاء في صناعة الإنسان
التنبيه على أنّ الابتلاء إنّما يكون لمن يريد الله تكريمهم وصقل نفوسهم في الدنيا ورفع مكانتهم في الآخرة.
محاور الموعظة
أنواع الابتلاء
دور الأعمال السيّئة في وقوع البلاء
نعمة البلاء
تمحيص البلاء للذنوب
ضرورة الابتلاء
تصدير الموعظة
﴿مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلمُؤمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُم عَلَيهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ﴾[1].
[1] سورة آل عمران، الآية 179.
239
227
الموعظة السادسة والثلاثون: دور الابتلاء في صناعة الإنسان
إنّ سنّةَ الله في خلقه إذا أراد بعبدٍ خيرًا، قائمةٌ على موضوع الابتلاء، وأنّ الله إنّما يصنع من هذا الإنسان إنسانًا كاملًا عبر الابتلاءات والتحدّيات التي يجعلها في طريقه. فالله -تعالى- إذا أراد أن يمنح عبدَه القوّة ابتلاه بعدوٍّ قويّ، وإن أراد أن يجعل منه حكيمًا ابتلاه بفتنةٍ عمياء، وإن أراد أن يكون مشهورًا حبّب إليه الفقراء والمساكين، وإن أراد أن يخفّف عنه حسابه ابتلاه بالفقر والعوز؛ وهكذا فإنّ كلَّ ابتلاء من الله له هدفه الذي يريده الله للإنسان في الدنيا، وله مقامه الذي يريد الله أن يرفعه إليه في الآخرة.
أنواع الابتلاء
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «مَا مِنْ قَبْضٍ وَلَا بَسْطٍ إِلَّا وَللهِ فِيهِ المَنُّ وَالاِبْتِلَاءِ»[1]. وقد ذكرت النصوص بعض عناوين هذه الابتلاءات:
الخوف والجوع: قال -تعالى-: ﴿وَلَنَبلُوَنَّكُم بِشَيءٖ مِّنَ ٱلخَوفِ وَٱلجُوعِ وَنَقصٖ مِّنَ ٱلأَموَٰلِ وَٱلأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾[2].
الخير والشرّ: قال -تعالى-: ﴿وَنَبلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلخَيرِ فِتنَةٗ﴾[3].
المال والولد: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله -تعالى-: ﴿أَنَّمَا أَموَٰلُكُم وَأَولَٰدُكُم فِتنَةٞ﴾[4]: ومعنى ذلك أنّه -سبحانه- يختبر عباده بالأموال والأولاد؛ ليتبيَّن الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان
[1] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج3، ص2364.
[2] سورة البقرة، الآية 155.
[3] سورة الأنبياء، الآية 35.
[4] سورة الأنفال، الآية 28.
240
228
الموعظة السادسة والثلاثون: دور الابتلاء في صناعة الإنسان
-سبحانه- أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحقّ الثواب والعقاب.
الفاقة والمرض: عن الإمام عليّ (عليه السلام): «إِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةَ، وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ مَرَضُ الْبَدَنِ، وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ مَرَضُ الْقَلْبِ»[1].
ولعلّ ما رُوِيَ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يبيّن أنّ كلّ ما يحيط بالمرء يستبطن نوع ابتلاء، إذ قال: «الْمُؤْمِنُ بَيْنَ خَمْسِ شَدَائِدَ: مُؤْمِنٍ يَحْسُدُهُ، وَمُنَافِقٍ يُبْغِضُهُ، وَكَافِرٍ يُقَاتِلُهُ، وَنَفْسٍ تُنَازِعُهُ، وَشَيْطَانٍ يُضِلُّهُ»[2].
علّة الابتلاء اختيار العمل الأحسن: عن الإمام الرضا (عليه السلام) في قوله -تعالى-: ﴿لِيَبلُوَكُم أَيُّكُم أَحسَنُ عَمَلٗا﴾[3]: «إِنَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- خَلَقَ خَلْقَهُ لِيَبْلُوَهُمْ بِتَكْلِيفِ طَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الِامْتِحَانِ وَالتَّجْرِبَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَلِيمًا بِكُلِّ شَيْءٍ»[4].
تصحيح الإيمان: وفي روايةٍ عن الإمام الصادق (عليه السلام) يبيّن فيها أنّ البلاء له علاقة بتصحيح مسار الإيمان عند الإنسان، فيقول: «الْبَلَاءُ زَيْنُ الْمُؤْمِنِ، وَكَرَامَةٌ لِمَنْ عَقَلَ؛ لِأَنَّ فِي مُبَاشَرَتِهِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ وَالثَّبَاتِ عِنْدَهُ تَصْحِيحَ نِسْبَةِ الْإِيمَان»[5].
التذكير: والتذكير يكون للمؤمن والكافر على حدٍّ سواء؛ أمّا الكافر
[1] الشيخ الطوسيّ، الأمالي، ص146.
[2] المتّقي الهنديّ، كنز العمّال، ج1، ص161.
[3] سورة هود، الآية 7.
[4] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص301.
[5] المصدر نفسه، ص305.
241
229
الموعظة السادسة والثلاثون: دور الابتلاء في صناعة الإنسان
فلردعه عن كفره، وأمّا المؤمن لتذكيره بعبوديّته لله، قال -تعالى-: ﴿وَلَقَد أَخَذنَا ءَالَ فِرعَونَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقصٖ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُم يَذَّكَّرُونَ﴾[1].
وقال -تعالى-: ﴿أَوَلَا يَرَونَ أَنَّهُم يُفتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٖ مَّرَّةً أَو مَرَّتَينِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُم يَذَّكَّرُونَ﴾[2].
وعن الإمام الصادق (عليه السلام): «الْمُؤْمِنُ لَا يَمْضِي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً، إِلَّا عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ يَحْزُنُهُ يُذَكَّرُ بِه»[3].
عنه (عليه السلام): «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَهُوَ يُذَكَّرُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا بِبَلَاءٍ، إِمَّا فِي مَالِهِ، أَوْ فِي وَلَدِهِ، أَوْ فِي نَفْسِهِ؛ فَيُؤْجَرُ عَلَيْهِ...»[4].
الخضوع لله: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لَوْلَا ثَلَاثَةٌ فِي ابْنِ آدَم مَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ شَيْءٌ: المَرَضُ، وَالمَوْتُ، وَالفَقْرُ...»[5].
دور الأعمال السيّئة في وقوع البلاء
قال -تعالى-: ﴿وَمَا أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَت أَيدِيكُم وَيَعفُواْ عَن كَثِيرٖ﴾[6].
ومعنى أنّ الله يبتلي الإنسان بما كسبت يدَيه، لا ينافي كون البلاء نعمة له؛ وذلك لأنّ الله يريد للإنسان أن يرى أثر الأفعال السيّئة عليه، فيعمل على التخلّص منها.
[1] سورة الأعراف، الآية 130.
[2] سورة التوبة، الآية 126.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص254.
[4] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص305.
[5] المصدر نفسه، ص306.
[6] سورة الشورى، الآية 30.
242
230
الموعظة السادسة والثلاثون: دور الابتلاء في صناعة الإنسان
قال -تعالى-: ﴿أَوَلَمَّا أَصَٰبَتكُم مُّصِيبَةٞ قَد أَصَبتُم مِّثلَيهَا قُلتُم أَنَّىٰ هَٰذَا قُل هُوَ مِن عِندِ أَنفُسِكُم إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٖ قَدِيرٞ﴾[1].
قال -تعالى-: ﴿ظَهَرَ ٱلفَسَادُ فِي ٱلبَرِّ وَٱلبَحرِ بِمَا كَسَبَت أَيدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُم يَرجِعُونَ﴾[2]. وفي قوله: ﴿لَعَلَّهُم يَرجِعُونَ﴾ إشارة واضحة إلى النعمة المحيطة بالبلاء.
وعن الإمام عليّ (عليه السلام) -وقد خرج للاستسقاء-: «إِنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي عِبَادَهُ عِنْدَ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ بِنَقْصِ الثَّمَرَاتِ، وَحَبْسِ الْبَرَكَاتِ، وَإِغْلَاقِ خَزَائِنِ الْخَيْرَاتِ؛ لِيَتُوبَ تَائِبٌ، وَيُقْلِعَ مُقْلِعٌ، وَيَتَذَكَّرَ مُتَذَكِّرٌ، وَيَزْدَجِرَ مُزْدَجِر»[3].
نعمة البلاء
إنّ القاعدة الواردة عن الإمام العسكريّ (عليه السلام): «مَا مِنْ بَلِيَّةٍ إِلَّا وَللهِ فِيهَا نِعْمَةٌ تُحِيطُ بِهَا»[4]، تكشف أنّ الإنسان المؤمن ينبغي أن ينظر إلى أيّ ابتلاء على أنّه نعمة.
بل عدّ الإمام الكاظم (عليه السلام) ذلك شرطًا من شرائط الإيمان، فقال: «لَنْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ حَتَّى تَعُدُّوا الْبَلَاءَ نِعْمَةً وَالرَّخَاءَ مُصِيبَةً؛ وَذَلِكَ أَنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ الْبَلَاءِ أَعْظَمُ مِنَ الْغَفْلَةِ عِنْدَ الرَّخَاءِ»[5].
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لَا تَكُونُ مُؤْمِنًا حَتَّى تَعُدَّ الْبَلَاءَ نِعْمَةً
[1] سورة آل عمران، الآية 165.
[2] سورة الروم، الآية 41.
[3] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص306.
[4] الشيخ ابن شعبة الحرّانيّ، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص489.
[5] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج64، ص237.
243
231
الموعظة السادسة والثلاثون: دور الابتلاء في صناعة الإنسان
وَالرَّخَاءَ مِحْنَةً؛ لِأَنَّ بَلَاءَ الدُّنْيَا نِعْمَةٌ فِي الْآخِرَةِ وَرَخَاءَ الدُّنْيَا مِحْنَةٌ فِي الْآخِرَة»[1].
عن الإمام عليّ (عليه السلام): «إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُوَالِي عَلَيْكَ الْبَلَاءَ فَاشْكُرْه»[2] وعنه (عليه السلام): «إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُتَابِعُ عَلَيْكَ النِّعَمَ فَاحْذَرْهُ»[3]. وَمقتضى الشكر أنّ المؤمن ينظر إلى البلاء كنعمة من الله.
تمحيص البلاء للذنوب
عن الإمام عليّ (عليه السلام): «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ تَمْحِيصَ ذُنُوبِ شِيعَتِنَا فِي الدُّنْيَا بِمِحْنَتِهِمْ، لِتَسْلَمَ بِهَا طَاعَاتُهُمْ، وَيَسْتَحِقُّوا عَلَيْهَا ثَوَابَهَا»[4].
ومعنى ذلك أنّ الله يكفّر ذنوب عباده بهذه الإبتلاءات، فيقتصر عقابه لهم في الدنيا بما ينفعهم على تصويب إيمانهم، فعن الإمام عليّ (عليه السلام): «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-؟ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله): ﴿وَمَا أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَت أَيدِيكُم﴾[5]، وَاللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَمَا عُفِيَ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا، فَاللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- أَحْلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي عَفْوِهِ»[6].
وعنه (عليه السلام): «مَا عَاقَبَ اللَّهُ عَبْدًا مُؤْمِنًا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، إِلَّا كَانَ أَجْوَدَ وَأَمْجَدَ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي عِقَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[7].
[1] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص304.
[2] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص136.
[3] المصدر نفسه.
[4] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص306.
[5] سورة الشورى، الآية 30.
[6] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج78، ص188.
[7] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص306.
244
232
الموعظة السادسة والثلاثون: دور الابتلاء في صناعة الإنسان
ضرورة الابتلاء
وضرورته قائمة على كونه العلّة الأساسيّة في تصنيف الناس، عبر كيفيّة انفعالهم مع هذه الابتلاءات. قال -تعالى: ﴿أَم حَسِبتُم أَن تُترَكُواْ وَلَمَّا يَعلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُم وَلَم يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلمُؤمِنِينَ وَلِيجَةٗ وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعمَلُونَ﴾[1].
قال -تعالى-: ﴿وَلَنَبلُوَنَّكُم حَتَّىٰ نَعلَمَ ٱلمُجَٰهِدِينَ مِنكُم وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبلُوَاْ أَخبَارَكُم﴾[2].
بل أكثر من ذلك، فإنّ عدم الابتلاء يعني عدم اكتراث الله بهذا الإنسان، وعدم رهانه عليه في أيّ أمرٍ من أمور الدين، فعن الإمام عليّ (عليه السلام): «لَا حَاجَةَ للهِ فِيمَنْ لَيْسَ للهِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ نَصِيبٌ»[3].
عن الإمام زين العابدين (عليه السلام): «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يُعَافَى الرَّجُلُ فِي الدُّنْيَا، وَلَا يُصِيبَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَصَائِبِ»[4].
وهذا ما رمى إليه الإمام الحسين (عليه السلام) بقوله: «إِنَّ النَّاسَ عَبِيدُ الدُّنْيَا، وَالدِّينُ لَعْقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ، يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ؛ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ، قَلَّ الدَّيَّانُونَ»[5]. فالتمحيص بالبلاء وحده يميّز الديّانين من غيرهم.
[1] سورة التوبة، الآية 16.
[2] سورة محّمد، الآية 31.
[3] الشيخ الطبرسي، مشكاة الانوار في غرر الأخبار، ص505.
[4] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص304.
[5] لجنة الحديث في معهد باقر العلوم (عليه السلام)، موسوعة كلمات الامام الحسين (عليهم السلام)، ص432.
245
233
الموعظة السابعة والثلاثون: الحجاب عفّة وصلاح
الموعظة السابعة والثلاثون: الحجاب عفّة وصلاح
بيان فلسفة الحجاب وآثاره الفرديّة والاجتماعيّة على المرأة والمجتمع.
محاور الموعظة
معنى الحجاب
أدلّة الحجاب والستر
شروط الحجاب والستر الشرعيّ
فلسفة الحجاب في الإسلام
تصدير الموعظة
﴿يَٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ ٱلمُؤمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدنَىٰ أَن يُعرَفنَ فَلَا يُؤذَينَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾[1].
[1] سورة الأحزاب، الآية 59.
246
234
الموعظة السابعة والثلاثون: الحجاب عفّة وصلاح
إنّ الإسلام هو الدين الوحيد الذي أعطى المرأة حقوقًا ومزايا تنسجم مع دورها كأنثى (ابنة، أخت، زوجة) لم يعطها من قبله ولا من بعده تشريع أو نظام أيًّا كان هذا التشريع أو النظام. فمهما بلغت معرفة المخلوق فهي ناقصة أمام علم الخالق الذي جعل الرجل والمرأة من نفس واحدة وميّزهما بخصائص -لا تُعدّ نقصًا في جانب دون جانب- يترتّب عليها واجبات والتزامات ليست من باب المفاضلة ولكنّها من قبيل الشيء يتممّ بعضه ويحتاج إليه، وفي ذلك حكمة من الله -سبحانه وتعالى- لإعمار هذا الكون، وإذا كان هناك مجال للتفضيل فقد بيّنه الإسلام في القرآن الكريم في كثير من آياته.
معنى الحجاب
لغةً: حجب: الحِجابُ: السِّتْرُ. وامرأَة مَحْجُوبةٌ: قد سُتِرَتْ بِسِترٍ[1].
الحجاب في الإسلام: حجاب المرأة في الإسلام يعني أنّه يجب على المرأة أن تستر بدنها عدا (الوجه والكفّين) عند وجود رجل أجنبيّ ينظر إليها، وتلحق به أن لا تظهر زينتها أمام الرجال الأجانب.
أدلّة الحجاب والستر
يجب على المرأة أن تمنع نظر الأجنبيّ إلى كلّ ما عدا الوجه والكفّين من بدنها. وهناك أدلّة من الآيات الشريفة وأحاديث المعصومين (عليهم السلام) تدلّ على ذلك:
1. قوله-تعالى-: ﴿قُل لِّلمُؤمِنِينَ يَغُضُّواْ مِن أَبصَٰرِهِم وَيَحفَظُواْ فُرُوجَهُم
[1] ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص298، مادة حجب.
247
235
الموعظة السابعة والثلاثون: الحجاب عفّة وصلاح
ذَٰلِكَ أَزكَىٰ لَهُم إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا يَصنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلمُؤمِنَٰتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَٰرِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنهَا وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَو ءَابَائِهِنَّ أَو ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو أَبنَائِهِنَّ أَو أَبنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو إِخوَٰنِهِنَّ أَو بَنِي إِخوَٰنِهِنَّ أَو بَنِي أَخَوَٰتِهِنَّ أَو نِسَائِهِنَّ أَو مَا مَلَكَت أَيمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيرِ أُوْلِي ٱلإِربَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفلِ ٱلَّذِينَ لَم يَظهَرُواْ عَلَىٰ عَورَٰتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضرِبنَ بِأَرجُلِهِنَّ لِيُعلَمَ مَا يُخفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلمُؤمِنُونَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ﴾[1].
إنّ كلمة «يغضّوا» مشتقّة من «غض» من باب «ردّ»، وتعني في الأصل التنقيص، وتطلق غالبًا على تخفيض الصوت وتقليل النظر؛ لهذا لم تأمر الآية أن يغمض المؤمنون عيونهم، بل أمرت أن يغضّوا من نظرهم. وهذا التعبير الرائع جاء لينفي غلق العيون بشكل تامّ بحيث لا يعرف الإنسان طريقه بمجرّد مشاهدته امرأة ليست من محارمه، فالواجب عليه أن لا يحدّق فيها، بل أن يرمي ببصره إلى الأرض، ويصدق فيه القول إنّه غضّ من نظره وأبعد ذلك المنظر من مخيّلته.
وممّا يلفت النظر أنّ القرآن الكريم لم يحدّد الشيء الذي يستوجب غضّ النظر عنه. (أي إنّه حذف متعلّق الفعل) ليكون دليلًا على عموميّته. أي غضّ النظر عن جميع الأشياء التي حرّم الله النظر إليها. ولكنّ سياق الكلام في هذه الآيات، وخاصّة في الآية الآتية التي
[1] سورة النور، الآيتان 30 - 31.
248
236
الموعظة السابعة والثلاثون: الحجاب عفّة وصلاح
تتحدّث عن قضية الحجاب، يوضّح لنا جيّدًا أنّها تقصد النظر إلى النساء غير المحارم، ويؤكّد هذا المعنى سبب النزول الذي ذكرناه سابقًا.
ويتّضح لنا ممّا سبق، أنّ مفهوم الآية ليس هو حرمة النظر الحادّ إلى النساء غير المحارم، ليتصوّر بعض الناس أنّ النظر الطبيعيّ إلى غير المحارم مسموح به، بل إنّ نظر الإنسان يمتّد إلى حيّز واسع ويشمل دائرة واسعة، فإذا وجد امرأة من غير المحارم عليه أن يخرجها عن دائرة نظره، وألّا ينظر إليها، ويواصل السير بعين مفتوحة، وهذا هو مفهوم غضّ النظر[1].
وهذه الآية الكريمة تتناول عدّةَ أمور:
أ-ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يغضّوا من أبصارهم، ومعنى الغضّ في اللغة: الخفض والنقصان من الطرف، وغضّ البصر يعني عدم التحديق والإمعان في الشيء.
ب-يجب على الرجال والنساء حفظ الفروج، فالمطلوب الاجتهاد في حفظ العفاف والطهر.
ج-يجب ستر الزينة، وهناك نوعان من الزينة، خفيّة وظاهرة، والخفيّة هي ما تكون مخفيّة تحت الثياب مستورة عن نظر الناظرين، كالعقد والقراط (الحلق) ولون الشعر والثياب المستورة التي فيها زينة. والظاهرة هي الوجه والكفّان، حيث سُئل الإمام الصادق (عليه السلام)
[1] الشيخ الشيرازيّ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج11، ص75.
249
237
الموعظة السابعة والثلاثون: الحجاب عفّة وصلاح
عمّا تُظهرْ المرأة من زينتها؟ فقال (عليه السلام): «الوجه والكفّين»[1]. وهذا يعني وجوب ستر البدن كلّه باستثناء الوجه والكفّين.
ثم يعقّب -تعالى- بعد ذلك بقوله: ﴿وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾. والخُمر: جمع خمار، وهو ثوب تُغطّي به المرأة رأسها ورقبتها، والجيوب جمع جيب وهو من القميص موضع الشقّ الذي ينفتح على المنحر والصدر، ويقال: إنّ النساء في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله) كنّ يلبسن ثيابًا مفتوحة الجيب، وكنّ يلقين الخُمر ويسدلنها خلف رؤوسهنّ فتظهر آذانهنّ وأقراطهنّ ورقابهنّ وشيء من نحورهنّ للناظرين، فأمرت الآية بضرب خمرهنّ على جيوبهنّ، أي يُلقين بما زاد من غطاء الرأس على صدورهنّ حتّى يسترن بذلك آذانهنّ وأقراطهنّ وصدورهنّ.
2. ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ ٱلمُؤمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدنَىٰ أَن يُعرَفنَ فَلَا يُؤذَينَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾.[2]
وفي هذه الآية أمر واضح بضرورة إسدال الجلابيب، فما معنى الجلابيب، وكيف يكون الإسدال؟
الجلباب: هو ثوب تشتمل به المرأة فيغطّي جميع بدنها، ويطلق أيضًا على الخمار، والظاهر أنّه استعمل هنا بمعنى الخمار، فإسدالها: ستر الجيوب بها، فهي تشير إلى ما هو مذكور في الآية السابقة. وأضيف إليها هنا: ﴿ذَٰلِكَ أَدنَىٰ أَن يُعرَفنَ فَلَا يُؤذَينَ﴾.
[1] الحميريّ القمّيّ، قرب الإسناد، ص82.
[2] سورة الأحزاب، الآية 59.
250
238
الموعظة السابعة والثلاثون: الحجاب عفّة وصلاح
والمقصود: أن يعرفن بالستر والصلاح، فلا يتعرّض لهنَّ؛ لأنَّ الفاسق إذا عرف امرأة بالستر والصلاح لم يتعرّض لها[1].
شروط الحجاب والستر الشرعيّ
أ. أن يكون اللباس واسعًا فضفاضًا: أي غير ضيّق حتّى لا يصف شيئًا من جسمها أو يظهر أماكن الفتنة من الجسم.
ب. أن يكون مستوعبًا لجميع البدن باستثناء الوجه والكفّين. قال -تعالى-: ﴿وَلَا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنهَا﴾، ألّا يكون الحجاب زينة في نفسه لقوله -تعالى- ﴿وَلَا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنهَا﴾.
ج. أن لا يترتّب على اللباس بعض العناوين الفاسدة: كالتشبّه بالكفّار، فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) -عن آبائه (عليهم السلام)-: «أوحى الله إلى نبيّ من الأنّبياء أنْ قُل لقومك: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تشاكلوا بما شاكل أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي»[2].
ويظهر من الرواية أنّ من تشبّه بقوم وتأثّر بهم بالقليللم يأمن على نفسه الزيادة في هذا الأمر حتّى يكون منقادًا لكلّ ما يفعلونه أو يأتون به.
تشبّه الرجال بالنساء وبالعكس، عن الإمام الصادق (عليه السلام) -عن آبائه (عليهم السلام)-:«كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء، وينهى المرأة عن أن تتشبّه بالرجال في لباسها»[3].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج22، ص186.
[2] الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ج2، ص348.
[3] الشيخ الطبرسيّ، مكارم الأخلاق، ص118.
251
239
الموعظة السابعة والثلاثون: الحجاب عفّة وصلاح
د. ألّا يكون لباس شهرة: وهو اللباس الذي لا يتوقّع من الشخص أن يرتديه من أجل لونه أو كيفيّة خياطته أو من أجل كونه خلِقا أو غير ذلك، بحيث لو ارتداه على مرأًى من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم إلى نفسه وأشير إليه بالبنان[1].
ولباس الشهرة في المصطلح الفقهيّ هو اللباس الذي يثير الاستهجان والاستقباح عند عامّة الناس في البلد وبتعبير آخر هو اللباس الذي يعرّض صاحبه للتشهير والتشنيع وحديث الناس.
هـ. ويشمل اللباس الذي يتزيّا فيه الرجل بزيّ المرأة أو العكس، بحيث يصدق عليه تأنُّث الرجل واسترجال المرأة.
وهو محرّم حيث يعرّض صاحبه إلى الهتك والإذلال، حيث يحرم على المؤمن أن يهتك نفسه وأن يذلّها، ولكن إذا أصبح هذا الزيّ الجديد المتوافر على الشروط الشرعيّة زيّا مألوفًا لا يوجب التشهير والاستقباح والاستهجان خرج عن كونه «لباس شهرة» وخرج عن كونه محرّمًا.
فلسفة الحجاب في الإسلام
إنّ الحجاب في الإسلام جزء من الأحكام التي ترتبط بنظرة الإسلام إلى المرأة والمجتمع، وبالتالي تشكّل هذه الأحكام مجتمعة رؤية الإسلام إلى المرأة وأدوارها المختلفة في الحياة والمجتمع. وللحجاب -كحكم خاصّ بالمرأة- بحدّ ذاته فلسفة خاصّة ترتبط بالمرأة والمجتمع، يمكن إيجازها، بالآتي:
[1] الإمام الخامنئيّ، أجوبة الاستفتاءات، س282.
252
240
الموعظة السابعة والثلاثون: الحجاب عفّة وصلاح
أ.حفظ أخلاق المجتمع
تمتاز كلّ المجتمعات بأنّها تلتزم بمجموعة من المبادئ والقيم الأخلاقيّة التي يتربّى الفرد والمجتمع عليها، وتضمن سلامة المجتمع من الانحراف والتلوّث بالرذيلة والزنا وغيرها من الأمراض الفتّاكة والخطيرة التي تعود بالغالب إلى سيطرة الشهوات على سلوك الكثير من الناس.
وقد وضع الإسلام في تشريعاته أساليب علاجيّة مباشرة ترتبط بإلزام الفرد بالسلوك المستقيم والسويّ، والعمل الصالح في علاقته بالآخرة، حفظًا لنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه من الانحراف الأخلاقيّ فيما يرتبط بالعلاقة بين الجنسين. والحجاب كتشريع يلزم المرأة بالتستّر عن غير المحارم يأتي في هذا السياق ولتحقيق هذه الأهداف وغيرها.
ب.الحجاب يحمي المجتمع
إنّ حماية المجتمع من الانحراف وانتشار الرذيلة، يكون بمعالجة أسبابه الكثيرة والتي يأتي على رأسها كثرة أسباب إثارة الشهوات وتنوّعها في هذا الزمان، وهو ما نراه بوضوح في ظاهرة السفور الفاضح عند العديد من النساء التي انتشرت في الكثير من المجتمعات الإسلاميّة، ولهذا فإنّ الالتزام بالحجاب والستر يقضي على ظاهرة السفور ويرفع الكثير من الأسباب والمثيرات التي تؤدّي إلى الانحراف، ويُساهم كثيرًا في تحقيق هدف حماية المجتمع.
253
241
الموعظة السابعة والثلاثون: الحجاب عفّة وصلاح
ج.تحقيق الاستقرار النفسيّ عند المرأة
الحجاب يحمي المرأة من الاضطراب الذي تعيشه المرأة السافرة باستمرار، نتيجة انهماكها المستمرّ في أمر التبرّج وقلقها الدائم بشأن لباسها وزينتها ومظهرها وكيفيّة استقبال الناس لها، وماذا سيقولون عنها وعن «قصّة» شعرها و«الموديل» الذي اختارته، إنّ هذا الاهتمام سيضْعُفُ ويخفُّ كثيرًا بالنسبة للمرأة المحجّبة؛ لأنّ طبيعة الحجاب تخفّف عليها الكثير من الأعباء، دون أن نُنكر مشروعيّة أنْ تهتمّ المرأة المحجّبة بمظهرها وأناقتها، لكنّ هذا الاهتمام شيء، وذاك الانهماك لدى المرأة غير المحجّبة شيء آخر.
د. حماية الأسرة
لا شكّ في أنّ المرأة (كزوجة وأمّ) هي أحد أعمدة بناء الأسرة وحفظها واستقرارها، وأيّ خللٍ أو انحراف في أحد هذه الأعمدة، فإنّ ذلك سيؤدّي إلى سقوط الأسرة وضياع أفرادها، ولهذا نجد الآخرين يسخّرون وسائلهم الإعلاميّة وإمكانيّاتهم لترويج ثقافاتهم المنحلّة، في سبيل إضعاف المجتمع الإسلامي، ويستخدمون لهذه الغاية أكثر العناوين حساسية وهي المرأة.
هـ. حماية المرأة نفسها
الحجاب يحقّق الأمن الأخلاقيّ والسلوكيّ في المجتمع، فهو حماية من إرسال النظر، وحماية للقلب من مرض جموح الشهوة، وكلّ هذه تتحقّق بأن تتحجّب المرأة المسلمة وأن تغطّي محاسنها ومواضع
254
242
الموعظة السابعة والثلاثون: الحجاب عفّة وصلاح
الفتنة فيها، وأن تبقى كما قال الله -عزّ وجلّ-: ﴿وَقَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ ٱلجَٰهِلِيَّةِ ٱلأُولَىٰ﴾[1]؛ لأنّ التبرّج والسفور يعقبه ذلك النظر المحرّم وقد يتلوه ارتكاب الفاحشة، بما فيها الاعتداء على المرأة نفسها، كما تشهد الكثير من الوقائع والدراسات التي توثِّق حالات الاعتداء على المرأة.
[1] سورة الأنبياء، الآية 33.
255
243
الموعظة الثامنة والثلاثون: المدد الغيبيّ
الموعظة الثامنة والثلاثون: المدد الغيبيّ
تعرُّف مفهوم الإيمان بالغيب، وآثاره في حياة الإنسان، ودوره في إقامة دولة العدل.
محاور الموعظة
معنى الإيمان بالغيب
الإيمان بالغيب والنصر
أعمال الإنسان في ميزان الإيمان بالغيب
المدد الغيبيّ للإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
القائم منّا منصورٌ بالرعب
تصدير الموعظة
﴿كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةٗ كَثِيرَةَ بِإِذنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾[1].
[1] سورة البقرة، الآية 249.
256
244
الموعظة الثامنة والثلاثون: المدد الغيبيّ
معنى الإيمان بالغيب
الغيب لغةً: كلّ ما غاب عن الإنسان وما لا يدركه حِسُّه، يُقال: غاب الشيء، إذا استتر واحتجب.
أمّا اصطلاحًا: فهو ما استأثر اللهُ بعلمه، ولم يُطلِع عليه أحدًا من خلقه، إلّا من ارتضى.
والمقصود بالإيمان بالغيب: التصديق الجازم بالمغيّبات كلّها التي أخبرنَا اللهُ ورسولُه عنها، دون تردُّد أو شكّ. قال -تعالى-: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطلِعَكُم عَلَى ٱلغَيبِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجتَبِي مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَاءُ﴾[1]. والغيب في المصطلحات القرآنيّة والحديثيّة، يُطلَق على الأمور التي لا تُعرَف بأسباب متعارفة عادةً.
الإيمان بالغيب والنصر
لَمّا خرج طالوت بجنوده لقتال العمالقة، قال لهم: إنّ الله ممتحنُكم على الصبر بنهر أمامكم تعبرونه؛ ليتميَّز المؤمن من المنافق، فمن شرب منكم من ماء النهر فليس منّي، ولا يصلح للجهاد معي، ومن لم يذق الماء فإنّه مني؛ لأنّه مطيعٌ لأمري وصالحٌ للجهاد، إلّا مَن ترخَّص واغترف غُرْفةً واحدةً بيِدَهِ، فلا لَوْمَ عليه. فلمّا وصلوا إلى النهر، انكبّوا على الماء، وأفرطوا في الشرب منه، إلّا عددًا قليلًا منهم صبروا على العطش والحرّ، واكتفوا بغُرْفة اليد؛ وحينئذٍ، تخلّف العصاة. ولَمّا عبر طالوت النهر، هو والقلّة المؤمنة معه -وهم ثلاثمئة وبضعة
[1] سورة آل عمران، الآية 179.
257
245
الموعظة الثامنة والثلاثون: المدد الغيبيّ
عشر رجلًا- لملاقاة العدوّ، ورأَوا كثرة عدوّهم وعدَّتهم، قالوا: لا قدرة لنا اليوم بجالوت وجنوده الأشدّاء! فذكَّرَ الذين يوقنون بلقاء الله، ويؤمنون بالغيب الذي يبعث فيهم القوّة والأمل والصبر والتحمُّل، إخوانَهم بالله وقدرته، قائلين: كم من جماعة قليلة مؤمنة صابرة، غلبَت -بإذن الله وأمره- جماعةً كثيرةً كافرةً باغيةً، والله مع الصابرين، بتوفيقه ونصره.
أعمال الإنسان في ميزان الإيمان بالغيب
حين نقرأ النصوص الشرعيّة، نجدها تؤكّد على أهمّيّة وجود تفسير شامل للوجود، يتعامل الإنسان مع الكون على أساسه، وهذا التفسير يُقَرِّبُ الحقائق الكبرى وعلاقتها بالحياة. ولذلك، يربط القرآن بين جميع تصرّفات الإنسان وبين مستوى إيمانه بالغيب، كما يطرح قضيّة الغيب كمعيار تفسيريّ لتصرّفات المكلّفين ودوافعهم؛ فنجد أوّل سورة في القرآن بعد الفاتحة، تربط الإيمان بالقرآن والهداية به بالإيمان بالغيب، قال -تعالى-: ﴿ذَٰلِكَ ٱلكِتَٰبُ لَا رَيبَ فِيهِ هُدٗى لِّلمُتَّقِينَ ٢ ٱلَّذِينَ يُؤمِنُونَ بِٱلغَيبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقنَٰهُم يُنفِقُونَ﴾[1].
ولهذا، فإنّ الإنسان لا يتحرّك في هذه الدنيا قيد أنملة دون أن يكون عمله وسلوكه منعكسًا عن إيمانه واعتقاده بالغيب. ومن ثمّ ما يصدر عنه، سواء أكان عملًا منصوصًا في السنّة الشريفة، أو عملًا يرتبط بأصلٍ أو تشريعٍ عامٍّ وكلّيٍّ في الشريعة الإسلاميّة، أو ممّا
[1] سورة البقرة، الآيتان 2 - 3.
258
246
الموعظة الثامنة والثلاثون: المدد الغيبيّ
اصطُلِح عليه «التسامح في أدلّة السنن» عند العلماء، يدور في دائرة الطاعة والإيمان بالغيب.
فمثلًا، حين نقرأ في أدعية طلب الرزق المرويّة عن أهل البيت (عليهم السلام)، والموزَّعة على أوقات متعدّدة من الليل والنهار، ولا سيّما بعد الصلوات الواجبة والمستحبّة، ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) في طلب الرزق عقب صلاة العشاء الآخرة، ومنها ما ورد دبر صلاة الليل: «يا خَيْرَ مَدْعُوٍّ، وَيا خَيْرَ مَسْؤُولٍ، وَيا أَوْسَعَ مَنْ أَعْطى، وَيا خَيْرَ مُرْتـَجى، اُرْزُقـْني وَأوسِعْ عَلـَيَّ مِنْ رِزْقِكَ، وَسَبِّبْ لي رِزْقًا مِنْ قِبَلِكَ، إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»[1]. وكذا ما ورد في مفاتيح الجنان في موارد متعدّدة، ويمكن جمعها في ثلاثة محاور، وهي: أصل طلب الرزق، وطلب السَعة في الرزق، وطلب الرزق الحلال: «أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ»[2]، و«يَا مَنْ لَا يَبْسُطُ الرِّزْقَ إِلَّا هُو»[3] و«وتُوَسِّعَ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ»[4]، وغيرها الكثير من الأدعية والأذكار.
والملاحَظ في مضامين هذا الأدعية، أنّها تستند إلى الاستغفار والتوبة والإيمان بالغيب، حيث تستند إلى التوحيد في الرازقيّة وتسليم الأمر إلى الله؛ وهذا ما يدلّ على أنّهم (عليهم السلام) يعودون إلى الله -تعالى- في طلب الرزق، كما يتوكّلون عليه -سبحانه وتعالى- في الجانب العمليّ في أمورهم كلّها، وأنّ سيرتهم التربويّة تقوم على
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص551 - 552.
[2] المصدر نفسه، ج4، ص407.
[3] الشيخ إبراهيم الكفعمي، البلد الأمين والدرع الحصين، ص410.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج4، ص71.
259
247
الموعظة الثامنة والثلاثون: المدد الغيبيّ
هذه العلاقة الصحيحة بالله، التي ترتكز على التوحيد، لتنطلق منه في الاحتياجات الدنيويّة كلّها، بصرف النظر عن مصاديقها.
المدد الغيبيّ للإمام المهديّ(عجل الله تعالى فرجه)
إذا عرفنا أنّ الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) مقرونٌ، بلا فصلٍ، بالإرادة الربّانيّة التي إذا أراد شيئًا يقول له: كن فيكون، وأنّه (عجل الله تعالى فرجه) مزوَّدٌ بالقوّة الإلهيّة القاهرة، والمدد السماويّ المظفَّر، والميراث النبويّ الباهر، سندرك كيف يخضع له الجميع، ويهيمن على الجميع، ويغلب جميع الظالمين والمستكبرين، وقد أراد الله -تعالى- ذلك بصريح قوله -تعالى-: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱستُضعِفُواْ فِي ٱلأَرضِ وَنَجعَلَهُم أَئِمَّةٗ وَنَجعَلَهُمُ ٱلوَٰرِثِينَ﴾[1].
وقد استفاضت السنّة فيما يدلّ على أنّه(عجل الله تعالى فرجه) منصورٌ، وأنّ الغيب معه، نذكر منها:
1. له الاسم الإلهيّ الأعظم، الذي هو معدن القُدرات، اثنان وسبعون منه[2].
2. وله الاسم الإلهيّ الخاصّ، الذي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا جعله بين المسلمين والمشركين، لم تصل من المشركين إلى المسلمين نشّابةٌ قطّ[3].
2. وله عصا موسى (عليه السلام)، التي تأتي بالعجب العُجاب[4].
[1] سورة القصص، الآية 5.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج1، ص230.
[3] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص188.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج1، ص231.
260
248
الموعظة الثامنة والثلاثون: المدد الغيبيّ
4. وله خاتم سليمان (عليه السلام)، الذي كان إذا لبسه سخّر الله -تعالى- له الملائكة والإنس والجنّ والطير والريح[1].
5. وله تابوت بني إسرائيل، الذي فيه السكينة والعلم والحكمة، ويدور معه العلم والنبوّة والمُلك[2].
6. وله امتلاك الرعب في قلوب الأعداء، يسير معه أمامه وخلفه، وعن يمينه وشماله.
ولا يخفى شدّة تأثير هذا الرعب في دهشة العدوّ، وعدم تسلُّطه على استعمال السلاح أساسًا[3].
7. وله نصرة الله -تعالى-، التي لا يفوقها شيء: ﴿إِن يَنصُركُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُم﴾[4]، فإنّ الله -تعالى- ينصره حتّى بزلازل الأرض وصواعق السماء.
8. وله الولاية الإلهيّة العظمى، التي جعلها اللهُ -تعالى- لهم تكوينًا وتشريعًا، كما ثبت بالأدلّة المتواترة[5].
9. وله الاحتجاجات والحجج الكاملة، التي يحتجّ بها بأوصافه وعلائمه الموجودة في التوراة والألواح، ثمّ اقتداء النبيّ عيسى (عليه السلام) به في الصلاة التي توجب خضوع كثير من اليهود والنصارى له[6].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج1، ص231.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج26، ص203
[3] الشيخ النعمانيّ، الغيبة، ص307.
[4] سورة آل عمران، الآية 160.
[5] الشيخ محمّد السند، في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة، ص595.
[6] راجع أحاديثه المتظافرة من الفريقَين في: الگلپایگاني، الشيخ لطف الله الصافي، منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر (عليه السلام)، ص206.
261
249
الموعظة الثامنة والثلاثون: المدد الغيبيّ
وبهذا، تعرف أنّ الإمام المهديّ(عجل الله تعالى فرجه) يقوم بالقوّة الإلهيّة، التي لا تقاومها القوّةُ البشريّة، مهما بلغَت وتطوّرَت.
فبمثل هذه القوّة الإلهيّة، يقوم الإمام المنتظر(عجل الله تعالى فرجه) بأمر الله، ويُقيم دولةَ الله، فيرث الأرضَ عبادُه الصالحون.
القائم منّا منصورٌ بالرعب
ويمكن إيجاز ما ذكرناه من عناصر القوّة والنصرة للإمام المهديّ(عجل الله تعالى فرجه) في العديد من الروايات، نكتفي بروايتين:
عن الإمام الباقر (عليه السلام): «لَوْ قَدْ خَرَجَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام)، لَنَصَرَهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ الْمُسَوِّمِينَ وَالْمُرْدِفِينَ وَالْمُنْزَلِينَ وَالْكَرُوبِيِّينَ، يَكُونُ جَبْرَئِيلُ أَمَامَهُ، وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِسْرَافِيلُ عَنْ يَسَارِهِ، وَالرُّعْبُ يَسِيرُ مَسِيرَةَ شَهْرٍ أَمَامَهُ وَخَلْفَهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ حِذَاه»[1].
وعنه (عليه السلام) أيضًا: «الْقَائِمُ مِنَّا مَنْصُورٌ بِالرُّعْبِ، مُؤَيَّدٌ بِالنَّصْرِ، تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ، وَتَظْهَرُ لَهُ الْكُنُوزُ، يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ، وَيُظْهِرُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- بِهِ دَيْنَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ خَرَابٌ إِلَّا عُمِرَ، وَيَنْزِلُ رُوحُ اللَّهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (عليه السلام) فَيُصَلِّي خَلْفَه...»[2].
[1] الشيخ النعمانيّ، الغيبة، ص234.
[2] الشيخ عليّ الكورانيّ، معجم أحاديث الإمام المهديّ (عليه السلام)، ج5، ص174.
262
250
الموعظة التاسعة والثلاثون: التعلّم والتفقّه
الموعظة التاسعة والثلاثون: التعلّم والتفقّه
حثّ الناس على التعلّم والحضور في مجالس العلماء ومعرفة الأحكام والمسائل الأساسيّة.
محاور الموعظة
أهمّيّة العلم والتفقّه
الدعوة الى العلم والتفقّه
أثر العلم في القرآن
تصدير الموعظة
﴿وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلعِلمَ ٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلحَقَّ وَيَهدِي إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلعَزِيزِ ٱلحَمِيدِ﴾[1].
[1] سورة سبأ، الآية 6.
263
251
الموعظة التاسعة والثلاثون: التعلّم والتفقّه
أهمّيّة العلم والتفقّه
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «العلم حياة الإسلام وعماد الإيمان»[1].
اهتمّت الشريعة اهتمامًا بالغًا بموضوع العلم حتّى اعتبرته فريضة على كلّ مسلم ومسلمة، فبه تعمر البلاد ويعبد الله وتقضى حوائج الناس.
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «قلب ليس فيه شيء من الحكمة كبيت خرب، فتعلّموا وعلّموا وتفقّهوا ولا تموتوا جهّالًا، فإنّ الله لا يعذر على الجهل»[2].
عن الإمام الباقر (عليه السلام): «العلم رأس الخير كلّه والجهل رأس الشرّ كلّه»[3].
الدعوة الى العلم والتفقّه
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «لوددت أنّ أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتّى يتفقّهوا»[4].
وعن الإمام عليّ بن الحسين (عليه السلام): «لو يعلم الناس ما في العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج»[5].
[1] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص463.
[2] المتّقي الهنديّ، كنز العمّال، ج10، ص147.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج77، ص175.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج1، ص31.
[5] المصدر نفسه، ص35.
264
252
الموعظة التاسعة والثلاثون: التعلّم والتفقّه
أثر العلم في القرآن
تناول القرآن الكريم مجموعة من الآثار والبركات التي ينعم بها أهل العلم، ومنها:
1. علوّ الدرجات: فكلّما ازداد المرء علمًا مقترنًا بالإيمان كلّما رفعه الله، قال -تعالى-: ﴿يَرفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلعِلمَ دَرَجَٰتٖ﴾[1].
2. الإيمان: فالعلم سبيل إلى الإيمان بالله، قال -تعالى-: ﴿وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلعِلمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ﴾[2].
وقال -تعالى-: ﴿وَلِيَعلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلعِلمَ أَنَّهُ ٱلحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤمِنُواْ بِهِ فَتُخبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّستَقِيمٖ﴾[3].
3. توحيد الله: فالعالم يدرك أنّ هذا الوجود هو فيضٌ من إلهٍ واحدٍ أحد، قال -تعالى-: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلمَلَٰئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلعِلمِ﴾[4].
4. البكاء والخشوع: لأنّ العلم ينظّم طبيعة العلاقة بين الإنسان وربّه، قال -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلعِلمَ مِن قَبلِهِ... وَيَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ يَبكُونَ وَيَزِيدُهُم خُشُوعٗا﴾[5].
[1] سورة المجادلة، الآية 11.
[2] سورة آل عمران، الآية 7.
[3] سورة الحجّ، الآية 54.
[4] سورة آل عمران، الآية 18.
[5] سورة الإسراء، الآيات 107 - 109.
265
253
الموعظة التاسعة والثلاثون: التعلّم والتفقّه
أثر العلم في القرآن
تناول القرآن الكريم مجموعة من الآثار والبركات التي ينعم بها أهل العلم، ومنها:
1. علوّ الدرجات: فكلّما ازداد المرء علمًا مقترنًا بالإيمان كلّما رفعه الله، قال -تعالى-: ﴿يَرفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلعِلمَ دَرَجَٰتٖ﴾[1].
2. الإيمان: فالعلم سبيل إلى الإيمان بالله، قال -تعالى-: ﴿وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلعِلمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ﴾[2].
وقال -تعالى-: ﴿وَلِيَعلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلعِلمَ أَنَّهُ ٱلحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤمِنُواْ بِهِ فَتُخبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّستَقِيمٖ﴾[3].
3. توحيد الله: فالعالم يدرك أنّ هذا الوجود هو فيضٌ من إلهٍ واحدٍ أحد، قال -تعالى-: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلمَلَٰئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلعِلمِ﴾[4].
4. البكاء والخشوع: لأنّ العلم ينظّم طبيعة العلاقة بين الإنسان وربّه، قال -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلعِلمَ مِن قَبلِهِ... وَيَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ يَبكُونَ وَيَزِيدُهُم خُشُوعٗا﴾[5].
[1] سورة المجادلة، الآية 11.
[2] سورة آل عمران، الآية 7.
[3] سورة الحجّ، الآية 54.
[4] سورة آل عمران، الآية 18.
[5] سورة الإسراء، الآيات 107 - 109.
265
254
الموعظة التاسعة والثلاثون: التعلّم والتفقّه
5. الخشية من الله: فالإنسان كلّما ازداد علمًا وأدرك بعض أسرار الوجود كلّما عَظُمَ الله في نفسه وقويت خشيته منه، قال -تعالى-: ﴿إِنَّمَا يَخشَى ٱللَّهَ مِن عِبَادِهِ ٱلعُلَمَٰؤُاْ﴾[1].
6. فضل العلم: قربه من درجة النبوّة: فالنبيّ يبلّغ عن الله والعالم يبلّغ عن النبيّ، فعن الإمام الباقر (عليه السلام): «أقرب الناس من درجة النبوّة أهل العلم والجهاد»[2].
7. فضل العلم على العبادة: لأنّ العبادة في الواقع أثرٌ من آثار العلم، فعن الإمام الباقر (عليه السلام): «من خرج يطلب بابًا من علم ليردّ به باطلًا الى حقٍّ أو ضلالة الى هدى كان عمله ذلك كعبادة متعبّد أربعين عاما»[3].
وعنه (عليه السلام): «فضل العلم أحبّ الى الله من فضل العبادة»[4].
8. العلم سبيل الى الجنّة: فعن الإمام الباقر (عليه السلام): «من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنّة»[5]. وفي الحديث إشارة لطيفة إلى عون الله لطالب العلم وتسديده له.
9. استغفار الكائنات لطالب العلم: فعن الإمام الباقر (عليه السلام): «إنّ طالب العلم يستغفر له كلّ شيءٍ حتّى الحيتان في البحر»[6].
[1] سورة فاطر، الآية 28.
[2] الفيض الكاشانيّ، المحجّة البيضاء، ج1، ص14.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج1، ص182.
[4] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج20، ص358.
[5] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج3، ص2073.
[6] المصدر نفسه.
266
255
الموعظة الأربعون: الموت خير واعظ
الموعظة الأربعون: الموت خير واعظ
تعرُّف مؤثّريّة الموت في تربية الإنسان ممّا ورد في نهج البلاغة.
محاور الموعظة
سرعة سفر أهل الدنيا
شوق اللقاء والأنس بالموت
أثر ذكر الموت في التربية
فوائد ذكر الموت
حتميّة الموت للإنسان
سرعة انقضاء الدنيا وحلول الموت
الاستعداد للموت
تصدير الموعظة
أمير المؤمنين (عليه السلام): «وَبَادِرُوا الْمَوْتَ وَغَمَرَاتِهِ، وَامْهَدُوا لَهُ قَبْلَ حُلُولِهِ، وَأَعِدُّوا لَهُ قَبْلَ نُزُولِهِ... وَبَادِرُوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، فَإِنَّكُمْ مُرْتَهَنُونَ بِمَا أَسْلَفْتُمْ، وَمَدِينُونَ بِمَا قَدَّمْتُمْ، وَكَأَنْ قَدْ نَزَلَ بِكُمُ الْمَخُوفُ، فَلَا رَجْعَةً تَنَالُونَ، وَلَاعَثْرَةً تُقَالُونَ»[1].
[1] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص281.
267
256
الموعظة الأربعون: الموت خير واعظ
سرعة سفر أهل الدنيا
يؤكّد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة، أنّ الإنسان في هذه الدنيا مسافر، وسيرحل عنها إلى داره ومقرِّه، حيث قال: «وَأَنْتُمْ بَنُو سَبِيلٍ عَلَى سَفَرٍ مِنْ دَارٍ لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ، وَقَدْ أُوذِنْتُمْ مِنْهَا بِالِارْتِحَالِ، وَأُمِرْتُمْ فِيهَا بِالزَّادِ»[1].
وقال (عليه السلام) أيضًا: «فَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهَا [أي الدنيا] كَسَفْرٍ سَلَكُوا سَبِيلًا، فَكَأَنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوهُ، وَأَمُّوا عَلَمًا فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوهُ...»[2].
وقال أيضًا: «إِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا كَرَكْبٍ، بَيْنَا هُمْ حَلُّوا، إِذْ صَاحَ بِهِمْ سَائِقُهُمْ فَارْتَحَلُوا»[3].
شوق اللقاء والأنس بالموت
إنّ شوق اللقاء والأنس بالموت لَمِن أبرز صفات الأولياء. وهذا الشوق نراه في أمير المؤمنين (عليه السلام)، حيث كان يقول: «وَاللَّهِ، لَابْنُ أَبِي طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْيِ أُمِّهِ»[4] ويقول أيضًا: «وَإِنِّي إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ لَمُشْتَاقٌ، وَحُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ»[5] ويقول تارةً أخرى: «وَإِنَّ أَحَبَّ مَا أَنَا لَاقٍ إِلَيَّ الْمَوْتُ»[6].
[1] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص266.
[2] المصدر نفسه، ص144.
[3] المصدر نفسه، ص548.
[4] المصدر نفسه، ص52.
[5] المصدر نفسه، ص452.
[6] المصدر نفسه، ص259.
268
257
الموعظة الأربعون: الموت خير واعظ
ولَمّا بشّره رسولُ الله (صلى الله عليه وآله) بالشهادة، وسأله عن صبره حينذاك، قال (عليه السلام): «يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ هَذَا مِنْ مَوَاطِنِ الصَّبْرِ، وَلَكِنْ مِنْ مَوَاطِنِ الْبُشْرَى وَالشُّكْرِ»[1].
وهذا الخُلُق تجسَّد في أولاده وأحفاده. ولذا، نرى القاسم بن الإمام الحسن (عليهما السلام) في كربلاء رابطَ الجأش، مستبشرًا ببشارة الشهادة، وقائلًا لعمِّه الحسين (عليه السلام) لَمّا سأله عن الموت: «يَا عَمّ، أَحْلَى مِنَ العَسَلِ»[2]. وهكذا كان أصحاب الحسين (عليه السلام)، حيث وصفَهُم بقوله: «يَسْتَأْنِسُونَ بِالمَنِيَّةِ دُونِي اسْتِئْنَاسَ الطِّفْلِ بِلَبَنِ أُمِّهِ»[3].
وقال (عليه السلام): «وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، شَوْقًا إِلَى الثَّوَابِ، وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ»[4].
وقال (عليه السلام): «أَيْنَ عَمَّارٌ، وَأَيْنَ ابْنُ التَّيِّهَانِ، وَأَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ، وَأَيْنَ نُظَرَاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ؟»[5]. فهؤلاء هم الذين «صَحِبُوا الدُّنْيَا بِأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى»[6].
ويركّز أمير المؤمنين (عليه السلام) في استذكار نِعَمِ الله -تعالى- في الجنّة، فيقول: «شَوِّقُوا أَنْفُسَكُمْ إِلَى نَعِيمِ الجَنَّةِ، تُحِبُّوا المَوْتَ، وَتَمْقَتُوا الحَيَاةَ»[7].
[1] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص220.
[2] الشيخ البحرانيّ، مدينة المعاجز، ج4، ص215.
[3] السيّد عبد الحسين شرف الدين، المجالس الفاخرة، ص231.
[4] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص303.
[5] المصدر نفسه، ص264.
[6] المصدر نفسه، ص497.
[7] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص297.
269
258
الموعظة الأربعون: الموت خير واعظ
ويقول (عليه السلام) أيضًا، بعدما وصف الجنّة: «فَلَوْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ، أَيُّهَا الْمُسْتَمِعُ، بِالْوُصُولِ إِلَى مَا يَهْجُمُ عَلَيْكَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَةِ، لَزَهِقَتْ نَفْسُكَ شَوْقًا إِلَيْهَا، وَلَتَحَمَّلْتَ مِنْ مَجْلِسِي هَذَا إِلَى مُجَاوَرَةِ أَهْلِ الْقُبُورِ اسْتِعْجَالًا بِهَا»[1].
ومع هذا كلّه، فإنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) يلفت انتباهنا إلى نقطة مهمّة، وهي أن لا نتمنّى الموت قبل أن نستعدّ له، فقد قال (عليه السلام): «وَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِلَّا بِشَرْطٍ وَثِيقٍ»[2]؛ أي لا تتمنَّ الموت إلّا وأنت واثقٌ من أعمالك الصالحة، وتحصيل ما يوجب رفع الدرجات في الآخرة.
أثر ذكر الموت في التربية
إنّ من أهمّ دواعي التنفير من الدنيا والتزوُّد للأخرى، ذكرَ الموت. قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّته للإمام الحسن (عليه السلام): «يَا بُنَيَّ، أَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ، وَذِكْرِ مَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ، وَتُفْضِي بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَأْتِيَكَ وَقَدْ أَخَذْتَ مِنْهُ حِذْرَكَ، وَشَدَدْتَ لَهُأَزْرَكَ، وَلَا يَأْتِيَكَ بَغْتَةً فَيَبْهَرَكَ»[3]. ويقول أيضًا: «طُوبَى لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعَاد،َ وَعَمِلَ لِلْحِسَابِ»[4].
ويوصي (عليه السلام) المسلمين عمومًا، ويقول: «وَأُوصِيكُمْ بِذِكْرِ الْمَوْتِ، وَإِقْلَالِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ؛ وَكَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا لَيْسَ يُغْفِلُكُمْ، وَطَمَعُكُمْ
[1] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص239.
[2] المصدر نفسه، ص459.
[3] المصدر نفسه، ص400.
[4] المصدر نفسه، ص477.
270
259
الموعظة الأربعون: الموت خير واعظ
فِيمَنْ لَيْسَ يُمْهِلُكُمْ؟!»[1]، وأيضًا: «أَسْمِعُوا دَعْوَةَ الْمَوْتِ آذَانَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُدْعَى بِكُمْ»[2].
وقد وَصَفَ (عليه السلام) خُلَّص صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقال: «وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِم»[3].
فوائد ذكر الموت
ولذِكر الموت فوائد كثيرة ومنافع جمّة، وقد ورد ذكر بعضها في نهج البلاغة، وهي:
1. ترك اللهو واللعب: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أَمَا وَاللَّهِ، إِنِّي لَيَمْنَعُنِي مِنَ اللَّعِبِ ذِكْرُ الْمَوْتِ»[4].
2. ترك الشهوات والملاذ الدنيويّة: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أَلَا فَاذْكُرُوا هَادِمَ اللَّذَّاتِ، وَمُنَغِّصَ الشَّهَوَاتِ، وَقَاطِعَ الْأُمْنِيَاتِ، عِنْدَ الْمُسَاوَرَةِ لِلْأَعْمَالِ الْقَبِيحَةِ»[5]. وقال (عليه السلام): «فَإِنَّ الْمَوْتَ هَادِمُ لَذَّاتِكُمْ، وَمُكَدِّرُ شَهَوَاتِكُمْ، وَمُبَاعِدُ طِيَّاتِكُمْ»[6]. وقال (عليه السلام): «اذْكُرُوا انْقِطَاعَ اللَّذَّاتِ، وَبَقَاءَ التَّبِعَاتِ»[7].
[1] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص278.
[2] المصدر نفسه، ص168.
[3] المصدر نفسه، ص143.
[4] المصدر نفسه، ص115.
[5] المصدر نفسه، ص145.
[6] المصدر نفسه، ص351.
[7] المصدر نفسه، ص553.
271
260
الموعظة الأربعون: الموت خير واعظ
3. خشوع القلب: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه الحسن (عليه السلام): «وَأَحْيِ قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ... وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ». وقال: «وَبَقِيَ رِجَالٌ غَضَّ أَبْصَارَهُمْ ذِكْرُ الْمَرْجِعِ، وَأَرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشَرِ»[1].
4. القناعة: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ، رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ»[2].
حتميّة الموت للإنسان
إنّ من نتائج الانغمار في ملاذ الدنيا، نسيان الموت، على الرغم ممّا نرى من كثرة الموتى حولنا، فكأنّ الموت فيها على غيرنا كُتِب. وهذه آفة لا بدّ أن نتخلَّص منها، ونتيقَّن بأنّنا ميِّتون. وتقريرًا لذلك، يذكر أمير المؤمنين (عليه السلام) شواهد ممّن مات من الأنبياء والعظماء، ويقول: «فَلَوْ أَن أَحَدًا يَجِدُ إِلَى الْبَقَاءِ سُلَّمًا، أَوْ لِدَفْعِ الْمَوْتِ سَبِيلًا، لَكَانَ ذَلِكَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ (عليه السلام)، الَّذِي سُخِّرَ لَهُ مُلْكُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ مَعَ النُّبُوَّةِ وَعَظِيمِ الزُّلْفَةِ، فَلَمَّا اسْتَوْفَى طُعْمَتَهُ، وَاسْتَكْمَلَ مُدَّتَهُ، رَمَتْهُ قِسِيُّ الْفَنَاءِ بِنِبَالِ الْمَوْتِ، وَأَصْبَحَتِ الدِّيَارُ مِنْهُ خَالِيَةً، وَالْمَسَاكِنُ مُعَطَّلَةً، وَوَرِثَهَا قَوْمٌ آخَرُونَ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرُونِ السَّالِفَةِ لَعِبْرَةً»[3].
[1] المصدر نفسه، ص75.
[2] المصدر نفسه، ص536.
[3] المصدر نفسه، ص263.
272
261
الموعظة الأربعون: الموت خير واعظ
والموت يلازمنا ولا ينجو منه أحد، يقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «فَمَا يَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ خَافَهُ، وَلَا يُعْطَى الْبَقَاءَ مَنْ أَحَبَّهُ»[1]، «وَالدُّنْيَا دَارٌ مُنِيَ لَهَا الْفَنَاءُ، وَلِأَهْلِهَا مِنْهَا الْجَلَاءُ»[2].
وهذه الحتميّة وهذا اللزوم لا ينفعه الفرار، إذ «الْأَجَلُ مَسَاقُ النَّفْسِ، وَالْهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُهُ»[3]، والموت «طَالِبٌ حَثِيثٌ لَا يَفُوتُهُ الْمُقِيمُ، وَلَا يُعْجِزُهُ الْهَارِبُ»[4]. وقد قال (عليه السلام) أيضًا: «وَأَنْتُمْ طُرَدَاءُ الْمَوْتِ؛ إِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَخَذَكُمْ، وَإِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ، وَهُوَ أَلْزَمُ لَكُمْ مِنْ ظِلِّكُمْ، الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيكُمْ، وَالدُّنْيَا تُطْوَى مِنْ خَلْفِكُمْ»[5]. وأخيرًا، يوصي ابنَه الإمام الحسن (عليه السلام) ويذكّره ويقول له: «وَأَنَّكَ طَرِيدُ الْمَوْتِ الَّذِي لَا يَنْجُو مِنْهُ هَارِبُهُ، وَلَا يَفُوتُهُ طَالِبُهُ، وَلَا بُدَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهُ»[6].
سرعة انقضاء الدنيا وحلول الموت
إنّ كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) مشحونٌ بالتذكير بسرعة انقضاء الدنيا وحلول الموت، فيقول (عليه السلام): «إِنَّ غَدًا مِنَ الْيَوْمِ قَرِيبٌ. مَا أَسْرَعَ السَّاعَاتِ فِي الْيَوْمِ، وَأَسْرَعَ الْأَيَّامَ فِي الشَّهْر،ِ وَأَسْرَعَ الشُّهُورَ فِي السَّنَةِ، وَأَسْرَعَ السِّنِينَ فِي الْعُمُرِ!»[7].
[1] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص81.
[2] المصدر نفسه، ص86.
[3] المصدر نفسه، ص207.
[4] المصدر نفسه، ص180.
[5] المصدر نفسه، ص384.
[6] المصدر نفسه، ص400.
[7] المصدر نفسه، ص279.
273
262
الموعظة الأربعون: الموت خير واعظ
ويقول: «تَجَهَّزُوا، رَحِمَكُمُ اللَّهُ، فَقَدْ نُودِيَ فِيكُمْ بِالرَّحِيلِ، وَأَقِلُّوا الْعُرْجَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَانْقَلِبُوا بِصَالِحِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ مِنَ الزَّادِ»[1]. ويقول (عليه السلام): «فَاحْذَرُوا، عِبَادَ اللَّهِ، الْمَوْتَ وَقُرْبَهُ، وَأَعِدُّوا لَهُ عُدَّتَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَخَطْبٍ جَلِيلٍ، بِخَيْرٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ شَرٌّ أَبَدًا، أَوْ شَرٍّ لَا يَكُونُ مَعَهُ خَيْرٌ أَبَدًا»[2].
[1] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص321.
[2] المصدر نفسه، ص384.
275
263
الموعظة الحادية والأربعون: الأمل
الموعظة الحادية والأربعون: الأمل
تعرّف مفهوم الأمل، ومدى تأثيره في حياة الإنسان على الصعيدين، الدنيويّ والأخرويّ.
محاور الموعظة
الدنيا دار بلاء
بين اليأس والأمل
الأمل من التوكّل
الأمل بالله لا بالدنيا
تصدير الموعظة
النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «الأمل رحمة لأمّتي، ولولا الأمل ما أرضعت أمّ ولدها، ولا غرس غارس شجرًا»[1].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج74، ص173.
278
264
الموعظة الحادية والأربعون: الأمل
الدنيا دار بلاء
إنّ الدّنيا ليست محلًّا للراحة والسعادة النهائيّة، فهي محلّ بلاء وامتحان، يُبتلى فيها المرء في كثير ممّا يتعلق بأمور حياته، قال الله -تعالى-: ﴿وَلَنَبلُوَنَّكُم بِشَيءٖ مِّنَ ٱلخَوفِ وَٱلجُوعِ وَنَقصٖ مِّنَ ٱلأَموَٰلِ وَٱلأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾[1].
وعن الإمام الحسن بن عليّ (عليهما السلام): «إنّ الدّنيا دار بلاء وفتنة»[2].
وإنّ هذه البلاءات تتعدّد وتتشكّل كما أشارت إلى ذلك الآية المباركة آنفة الذكر، فقد تكون بالمال وقد تكون بالموت أو الخوف أو الجوع، وغير ذلك من مصائب هذه الدنيا.
بين اليأس والأمل
فإذا كانت الدّنيا دار بلاء، ولا مفرّ للإنسان من المصائب التي تحيط به فيها، فلا بدّ من أن يكون على استعداد تامّ لأن يواجه ذلك بقوّة وإرادة، وإلّا فإنّ ذلك يكون مدعاة للضعف والعجز، بل للسقوط في مواطن البلاءات، حتّى يصل به الأمر إلى اليأس والإحباط، بل إلى الكفر بنعم الله -تعالى-، مضافًا إلى سوء الظنّ به -عزّ وجلّ-، وبذلك يكون المرء عرضة لغضب الله، علاوة على الآثار السيّئة التي تنتج عن ذلك، كالهمّ والحزن والقلق، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إيّاك والجزع! فإنّه يقطع الأمل، ويُضعِف العمل، ويُورث الهمّ»[3].
[1] سورة البقرة، الآية 155.
[2] الشيخ الصدوق، التوحيد، ص378.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج79، ص144.
279
265
الموعظة الأربعون: الموت خير واعظ
من هنا، فإنّ المرء العاقل، هو من تسلّح بأدوات الصبر والثبات، ومن أبرز تلك الأدوات الأمل بالله، وبأنّ ما يصيبه إنّما هو بعينه وقدرته، وحكمته في ما يقدّر ويقضي.
بِمَ يكون الأمل؟
عندما نقول الأمل، إنّما نقصد به الأمل بالفرج، الذي بيد الله أوّلًا وآخرًا، وأيضًا الأمل بأنّ ما يصاب به الإنسان في هذه الحياة، لا يضيع عند الله -عزّ وجلّ-، ولهذا فإنّ آية الصبر تؤكّد أنّ للصبر على البلاء بشرًى عظيمة، إذ قال: ﴿وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾.
الأمل من التوكّل
إنّ الأمل الذي يعيش في كنفه الإنسان، إنّما هو علامة على حسن ظنّه بالله -سبحانه-، وتوكّله عليه، ذلك أنّه يوقن بأنّ كلّ ما في هذه الدّنيا إنّما هو بيده -سبحانه-، وبذلك تركن نفسه.
عن الإمام عليّ (عليه السلام): «واعلم أنّ استعفاءك البلاء من الجزع واستبطاءك العافية من اليأس، فدعِ اليأس والجزع، وقل: حسبي الله ونعم الوكيل!»[1].
وعن صفوان الجمّال، قال: شهدت أبا عبد الله [الصادق] (عليه السلام)، واستقبل القبلة قبل التكبير، وقال: «الّلهمّ، لا تؤيسني من روحك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تؤمنّي مكرك، فإنّه لا يأمن مكر الله إلّا القوم الخاسرون» قلت: جُعِلتُ فداك! ما سمعتُ بهذا من أحد قبلك،
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج8، ص207.
280
266
الموعظة الحادية والأربعون: الأمل
فقال: «إنّ من أكبر الكبائر عند الله اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله»[1].
الأمل منجاة
إنّ للأمل أثارًا عظيمة على حياة الإنسان، فهو المحرّك والدافع لإرادة الإنسان نحو التقدّم والعطاء، وقد ورد أنّ النبيّ عيسى (عليه السلام) رأى شيخًا يعمل بمسحاة يثير الأرض، فقال عيسى (عليه السلام): «اللهمّ، انزع منه الأمل» فوضع الشيخ المسحاة واضطجع، فلبث ساعة، فقال النبيّ عيسى (عليه السلام): «اللهمّ، اردد إليه الأمل» فقام فجعل يعمل، فسأله عيسى (عليه السلام) عن ذلك، فأجاب الشيخ: بينما أنا أعمل، إذ قالت لي نفسي: إلى متى تعمل، وأنت شيخ كبير؟! فألقيتُ المسحاة، واضطّجعت، ثمّ قالت لي نفسي: والله، لا بدَّ لك من عيش ما بقيت، فقمتُ إلى مسحاتي[2].
الأمل بالله لا بالدّنيا
قد يختلط مفهوم الأمل عند بعض الناس، حتّى يحسبون الأمل بالدّنيا هو نفسه الأمل بالله، إلّا أنّ ثمّة بونًا شاسعًا بينهما؛ ذلك أنّ الأمل بالله يعني أنّه -سبحانه- سوف يفرّج على الإنسان ما فيه من غمّ وهمّ، وأنّ هذا ليس بخارج عن قدرته وقدره؛ أمّا الأمل بالدّنيا، فهو ما كان فيه اطمئنان داخليّ نحوها، فيسعى الإنسان في سبيلها، وكأنّه مخلّدٌ فيها، إلى أن يصل في طلبها إلى الانحراف عن طريق الحقّ ولو بعد حين.
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص544.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج14، ص329.
281
267
الموعظة الحادية والأربعون: الأمل
يشير الإمام زين العابدين (عليه السلام) إلى هذا الفرق، في دعائه حيث قال: «اللهمّ، أسألك من الآمال أوفقها»[1]، وذلك أنّ أمالًا ما، قد يعيشها الإنسان، وهي ليست في مصلحته.
عن الإمام عليّ (عليه السلام): «انقطِع إلى الله -سبحانه-، فإنّه يقول: وعزّتي وجلالي... لأقطعنّ أمل كلِّ من يؤمِّل غيري باليأس»[2].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج91، ص155.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص66.
282
268
الموعظة الثانية والأربعون: نمط الحياة الإسلاميّ
الموعظة الثانية والأربعون: نمط الحياة الإسلاميّ
إدراك أهمّيّة بناء الاقتصاد وخطر التحوّل إلى مجتمع استهلاكيّ.
محاور الموعظة
المجتمع الاستهلاكيّ
الحرب الناعمة ودورها في زياد الاستهلاك
كيف دعا الإسلام إلى ضبط الاستهلاك؟
دولة العيش الرغيد
تصدير الموعظة
﴿يَٰبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشرَبُواْ وَلَا تُسرِفُواْ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلمُسرِفِينَ﴾[1].
[1] سورة الأعراف، الآية 31.
283
269
الموعظة الحادية والأربعون: الأمل
إنّ الالتزام بالنمط الحياتيّ الذي دعا إليه الإسلام إنّما يضمّن الحياة الهانئة والمستقرّة على الصعيدَين المعنويّ والماديّ على حدٍّ سواء.
ويدخل ضمن الحديث عن نمط الحياة الإسلاميّ ما له علاقة بنوع الطعام واللباس وغير ذلك من الأمور، حيث وردت آداب عدّة في التراث الإسلاميّ، ترتبط باللباس والطعام.
وسوف نتناول موضوعات هذه الموعظة ضمن نُقاط ثلاث:
أوّلًا: المجتمع الاستهلاكيّ
يتنامى مفعول مصطلح «المجتمع الاستهلاكيّ» في مجتمعنا أكثر فأكثر، وهذا يعني أنّ المسألة لها جذور وأسباب، ما يدفع الباحثين إلى وضع وسائل وأساليب للعلاج، وكذلك الوقاية من تمادي آثار ذلك على المجتمع.
ما المقصود بالمجتمع الاستهلاكيّ؟
يمكن لنا القول وباختصار: إنّ الاستهلاك المقصود به هنا، هو ليس الرغبة نفسها في شراء الشيء أو استهلاكه؛ ذلك أنّ الرغبة في الحصول على منتجٍ ما أمرٌ طبيعيّ، إنّما المقصود به هو نوع الاستهلاك الذي تغيّر من الزمن السابق إلى الزمن الحاليّ، حيث يتوافر تنوّع كبير للموادّ الاستهلاكيّة، والتي أصبحت سهلة المنال لدى المستهلك، ما دعا إلى زيادة الاستهلاك بشكل أكبر عمّا كان في الأزمنة السابقة.
ويدخل في أسباب زيادة الاستهلاك ظاهرة التشويق الإعلانيّ الذي يعتمده منتجو الموادّ الاستهلاكيّة المتنوّعة وأصحاب المؤسّسات،
284
270
الموعظة الثانية والأربعون: نمط الحياة الإسلاميّ
والتي تدفع المستهلك إلى الشراء في كثير من الأحيان دون تدبّر أو دراسة، ما يوقعه في مغبّة ضياع ماله دون وجه ضرورة.
وكذلك ترجع زيادة الاستهلاك إلى زيادة الدخل الفرديّ في المجتمعات، خاصّة الصناعيّة منها، وكان لهذا تأثير سلبيّ كبير على المجتمعات البشريّة الفقيرة أو النامية، حيث ازداد فيها العرض مع قلّة المال، ما جعل الطبقة الفقيرة استهلاكيّة بشكل سلبيّ للغاية.
وإنّ الإسلام -كما نقرأ في إرشاداته- قد وضع حدودًا لكيفيّة العلاقة والارتباط بالموادّ الاستهلاكيّة، سواء لجهة المأكل أو المشرب أو الملبس أو المسكن.
ثانيًا: الحرب الناعمة ودورها في زيادة الاستهلاك
قد يتساءل بعض الأشخاص قائلًا: ما علاقة الحرب الناعمة بزيادة الاستهلاك؟ أو ما علاقة الحرب الناعمة بعدم الاستقرار الاقتصاديّ؟
في الواقع، إنّ ساحة الحرب الناعمة هو في مثل هذه المواقع؛ أي في الحياة الشخصيّة للأفراد، حيث إنّها تعمل على خرق نمط حياتهم لتبديله وتحويره عمّا هو عليه إلى ما يضعه أصحاب هذه الحرب من سياسات في سبيل نيل أهدافهم، سواء أكان بشكل عاجل أم آجل.
وإنّ نمط الحياة المعيشيّة، لَهو أكثر الأمور استهدافًا من قبل أعداء المجتمع، وهذا ما شهدناه عبر التاريخ البشريّ، حيث قام المستعمرون بتغيير ثقافة بلاد بأكملها بغية احتلالها والتسلّط عليها، كما هي الحال في دول عديدة من الدول الإفريقيّة.
285
271
الموعظة الثانية والأربعون: نمط الحياة الإسلاميّ
وهكذا هي الحال في هذه الأيّام بالنسبة إلى المجتمع الإسلاميّ، وبالأخصّ المجتمع المقاوم، حيث تعمل دول الاستكبار جاهدة لخرق نمط الحياة الشخصيّة لأفراد بيئة المقاومة، ما يسمح لهم بإضعاف همّة هؤلاء الأفراد نحو الثورة والمقاومة واللهو بالأمور المادّيّة والاستهلاكيّة.
ثالثًا: كيف دعا الإسلام إلى ضبط الاستهلاك؟
وضع الإسلام ضوابط عديدة لضبط استهلاك الموادّ الطبيعيّة والمنتجة، تتمحور تحت مفردتي «حسن التدبير»، و«عدم التبذير والإسراف».
1. حسن التدبير
أمّا التدبير، فهو حسن الإدارة والتخطيط، والنظر في عواقب الأمور قبل الإقدام عليها، وإنّ هذا يرتبط بالأمور المعيشيّة والمنزليّة، بل يعدّ أساس العيش المتّزن والمستقرّ؛ وممّا روي في ذلك أنّ رجلًا قال للإمام جعفر الصادق (عليه السلام): بلغني أنّ الاقتصاد والتدبير في المعيشة نصف الكسب! فقال (عليه السلام): «لا، بَل هُو الكسبُ كلُّهُ، ومِن الدِّينِ التَّدبيرُ في المعيشةِ»[1].
وإنّ قوام التدبير هو العلم والمعرفة؛ أي أنْ يتدبّر المرء مآل الأمور، وهذا ما نستنبطه من كلام الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) حيث قال لابن مسعود: «يابن مسعود، إذا عملتَ عمَلًا فاعملْ بعلمٍ وعقلٍ، وإيّاكَ وأنْ تعملَ
[1] الشيخ الطوسيّ، الأمالي، ص670.
286
272
الموعظة الثانية والأربعون: نمط الحياة الإسلاميّ
عملًا بغيرِ تدبّرٍ وعلمٍ؛ فإنّه -جلَّ جلالهُ- يقولُ: ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَت غَزلَهَا مِن بَعدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثٗا﴾[1]»[2].
2. الحثّ على الاقتصاد
ونجد في مقلب آخر كيف دعا الإسلام إلى الاقتصاد في العيش، وهو شُعبة من شعب حسن التدبير، وممّا ورد في ذلك:
قوله -تعالى-: ﴿وَٱقصِد فِي مَشيِكَ﴾[3]؛ «أي امشِ مقتصدًا ليس بالبطيء المتثبّط، ولا بالسريع المفرط، بل عدلًا وسطًا، بين وبين»[4].
أمّا في الروايات، فمنها ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنّ المؤمن أخذ من الله أدبًا، إذا وسّع عليه اقتصد، وإذا أقتر عليه اقتصر»[5].
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) من كتاب له إلى زياد: «دعِ الإسراف مقتصدًا، واذكر في اليوم غدًا، وأمسك من المال بقدر ضرورتك، وقدِّم الفضل ليوم حاجتك»[6].
3. حرمة الإسراف والتبذير
الإسراف -لغةً- «مجاوزة القصد[...] يقال: أسرف في ماله: عجّل من غير قصد، وأصل هذه المادّة يدُلُّ على تعدِّي الحدِّ، والإغفال أيضًا للشيء»[7].
[1] سورة النحل، الآية 92.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج74، ص110.
[3] سورة لقمان، الآية 19.
[4] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)، ج3، ص455.
[5] الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج13، ص52.
[6] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج33، ص491.
[7] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج3، ص153.
287
273
الموعظة الثانية والأربعون: نمط الحياة الإسلاميّ
أمّا اصطلاحًا، فهو «تجاوز الحدّ في كلِّ فعل يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر»[1].
قال الله -تعالى-: ﴿يَٰبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشرَبُواْ وَلَا تُسرِفُواْ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلمُسرِفِينَ﴾[2]، وهذه الآية واضحة في النهي عن الإسراف في الطعام والشراب.
وورد النهي عن الإسراف بالماء عند الوضوء، كما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الوضوء مِدّ، والغسل صاع، وسيأتي أقوام من بعدي يستقلّون ذلك، فأولئك على خلاف سنّتي! والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس»[3].
ونلاحظ أنّ للإسراف أثارًا سلبيّة على المستوى الاقتصاديّ للفرد، وهذا أمر بديهيّ؛ ذلك أنّ ثمّة قسمًا من مدخول الفرد يذهب هدرًا دون مقابل، عن الإمام عليّ (عليه السلام): «الإسراف يفني الجزيل»[4].
أمّا التبذير، فهو: التفريق، وأصله: إلقاء البذر وطرحه، فاستعير لكلّ مضيّع لماله، فتبذير البذر تضييع في الظاهر لمن لم يعرف مآل ما يلقيه[5].
قال الله -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ﴾[6].
[1] الراغب الأصفهانيّ، مفردات ألفاظ القرآن، ص407.
[2] سورة الأعراف، الآية 31.
[3] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج1، ص34.
[4] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص39.
[5] الراغب الأصفهانيّ، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص40.
[6] سورة الإسراء، الآية 27.
288
274
الموعظة الثانية والأربعون: نمط الحياة الإسلاميّ
يقول العلّامة الطباطبائيّ في تفسير هذه الآية المباركة: «وكان وجه المؤاخاة بينهم أنّ الواحد منهم يصير ملازمًا لشيطانه وبالعكس، كالأخوين الذين هما شقيقان متلازمان في أصلهما الواحد، كما يشير إليه قوله -تعالى: ﴿وَقَيَّضنَا لَهُم قُرَنَاءَ﴾[1]»[2].
دولة العيش الرغيد
إنّ الأوامر والنواهي الإلهيّة واضحة في ضرورة الحفاظ على النعم الإلهيّة، وعلى الحياة الاقتصاديّة الهانئة والمستقرّة للإنسان؛ ذلك أنّه ينبغي استغلال تلك النعم بما يضمن صلاح عيش الإنسان ورغده.
حتّى أنّنا نجد ثقافة العيش الرغيد ضاربة في عمق الثقافة والمعتقدات الإسلاميّة، ونلاحظ ذلك من خلال توصيف دولة الإمام المهديّ المنتظر (عجل الله تعالى فرجه)، حيث نجد روايات عديدة تصف لنا رغد العيش في تلك الدولة الإلهيّة في ظلّ وجود الإمام الذي سيملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما مُلئت ظلمًا وجورًا.
ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «يخرج المهديّ حكمًا عدلًا، [...] ويُطاف بالمال في أهل الحواء، فلا يوجد أحد يقبله»[3].
[1] سورة فصّلت، الآية 25.
[2] العلّامة الطباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج13، ص82.
[3] المقدسيّ، عقد الدرر في أخبار المنتظر، ص166.
289
275
الموعظة الثالثة والأربعون: التكافل الاجتماعيّ
الموعظة الثالثة والأربعون: التكافل الاجتماعيّ
بيان أهمّيّة التعاطف والمواساة مع أهل الحاجة.
محاور الموعظة
الحثّ على مساعدة الآخرين
الآمنون يوم القيامة
إيّاك وعذر الطالب
فضل عيلولة المحتاجين
من لا ينبغي طلب الحاجة منه
تصدير الموعظة
الإمام الصادق (عليه السلام): «ويحقّ على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطف والمؤاساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض...»[1].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص175.
290
276
الموعظة الثالثة والثلاثون: آية المودّة
اهتمّ الإسلام كثيرًا بتربية الإنسان فكريًّا وعمليًّا على توثيق عرى التواصل بين عباده، وبيَّن منظومة من العلاقات الاجتماعيّة بين أفراد الإنسان تقوم على أساس التراحم والتعاطف حتّى يكونوا كما أمرهم الله -سبحانه وتعالى-: ﴿رُحَمَاءُ بَينَهُم﴾[1].
الحثّ على مساعدة الآخرين
هناك الكثير من التشريعات التي يُلحظ فيها حيثيّة مساعدة الآخرين، كالخمس والزكاة والصدقة والهديّة والهبة وغير ذلك، وأيضًا من خلال الأوامر والإرشادات التي تحثّ على تعزيز روح المحبّة والتعاطف بين الناس، وأن يكونوا يدًا واحدة في السرّاء والضرّاء، كأنّهم جسد واحد، وكلّ ذلك على قاعدة أنّ الناس كلّهم إنّما هم عيال الله، وأنّ أحبّ عيال الله إليه هم أولئك الذين ينفعون الناس ويمشون في قضاء حوائجهم وخدمتهم، عن الإمام الصادق (عليه السلام): «سُئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أحبّ الناس إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس»[2].
الآمنون يوم القيامة
إنّ لكلّ عمل يقوم به الإنسان في دار الدنيا، سوف يجده حاضرًا يوم القيامة، ثمّ يجزى به من دون فرق بين عمل أدَّاه الإنسان في محراب العبادة وبين عمل قدّمه في ساحة عباده. ومن هنا، فقد فاز بعض الناس حينما هيّأ لنفسه الأمان والسرور يوم القيامة نتيجة لما زرعه في الدنيا من سرور أدخله إلى قلوب المحزونين، أو لسعيه
[1] سورة الفتح، الآية 29.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص164.
291
277
الموعظة الثالثة والأربعون: التكافل الاجتماعيّ
في قضاء حوائج المحتاجين، ولقد فاز هؤلاء بنعمتين عظيمتين، واحدة في الدنيا حينما نسبهم الله -تعالى- لذاته المقدّسة، وأخرى حينما آمنهم يوم الفزع الأكبر، ودلّ على ذلك ما جاء عن مولانا الإمام الصادق (عليه السلام)، حيث قال: «إنّ لله عبادًا في الأرض يسعون في حوائج الناس، هم الآمنون يوم القيامة ومن أدخل على مؤمن سرورًا فرَّح الله قلبه يوم القيامة»[1].
إيّاك وعذر الطالب
من الجدير ذكره أنّه يجب أن يلتفت الإنسان إلى نقطة مهمّة جدًّا في مقام التعاطي مع الآخرين، من أنّ اعتذار المقتدر عن بذل خدمته لمن قدر عليها، فقد حجب عن نفسه الرحمة الإلهيّة في الدنيا وسلّط عليها من يفزعها في عالم البرزخ؛ وذلك لأنّه بذلك يفوّت على نفسه الخير الكثير، ومن الضروريّ أن يحاط الإنسان علمًا بأنّ مجيء صاحب الحاجة سببٌ لسوق الرحمة الإلهيّة إليه، فلينظر إلى كيفيّة تلقّيه للرحمة ولا يتمّ ذلك إلّا بإرجاع صاحب الحاجة بقضاء حاجته، ويشهد لذلك ما جاء في الأخبار أنّه من وضع الصدقة في يد الفقير فقد وقعت في يد الله قبل أن تقع في يده، ولذا يستحبّ له أن يقبّل المتصدِّق يد نفسه لملامستها يد الله -تعالى-، عن أبي الحسن (عليه السلام)، أنّه قال: «من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنّما هو رحمة من الله -تبارك وتعالى- ساقها إليه، فإن قبل ذلك فقد وصله
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج 2، ص197.
292
278
الموعظة الثالثة والأربعون: التكافل الاجتماعيّ
بولايتنا وهو موصول بولاية الله -تعالى-، وإن ردّه عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلّط الله عليه شجاعًا من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة مغفورًا له أو معذّبًا، فأعذره الطالب كان أسوأ حالًا»[1].
فضل عيلولة المحتاجين
قد يبذل المرء كثيرًا من المال ويجهد نفسه في طريق الحجّ المستحبّ، وقد يكون فيه إرضاء لربّه التزامًا باستحباب الحجّ وأنّه سنّة من سنن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، ولكن بإمكانه أن يبذل مالًا أقلّ ويتخلّص من عناء السفر الطويل ويعوّض على نفسه بكثرة النماء في المال وأضعاف مضاعفة للأجر والثواب، بأن يتولّى عيلولة أهل بيت من المسلمين، فعن الإمام الباقر (عليه السلام): «لئن أعول أهل بيت من المسلمين، أسدّ جوعتهم وأكسو عورتهم فأكفّ وجوههم عن الناس، أحبّ إليّ من أن أحجّ حجّة وحجّة مثلها ومثلها حتّى بلغ عشرًا»[2].
من لا ينبغي طلب الحاجة منه
1. شرار الخلق
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «فليس من أحد إلّا وهو محتاج إلى الناس»[3].
لا يستطيع المرء، أن يكمل حياته أو يتمّ أعماله من دون حاجته إلى الناس أو حاجة الناس إليه، ولكن المهمّ اختيار من يريد الاعتماد عليه والرجوع إليه، وليس من الصلاح الاعتماد على أيّ فرد والرجوع
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص196.
[2] المصدر نفسه، ج2، ص195.
[3] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج90، ص325.
293
279
الموعظة الثالثة والأربعون: التكافل الاجتماعيّ
إلى أيٍّ كان؛ إذ قد يترتّب بالاعتماد على بعض المفاسد ما لم يحتمل، ولكان في تحمّل الضير الذي كان فيه أقلّ مرارة من الضيم الذي أصابه من خلال الرجوع إلى بعض الذين هم شرار الخلق، ورد أنّ رجلًا قال بحضرة الإمام زين العابدين (عليه السلام): اللهمّ أغنني عن خلقك. فقال (عليه السلام): «ليس هكذا، إنّما الناس بالناس، ولكن قل: اللهمّ أغنني عن شرار خلقك»[1].
2. حديث النعمة
ومن جملة الأشخاص الذين لا ينبغي للإنسان أن يمدّ يده إليهم ليقضوا حاجته، هو حديث النعمة، عن الإمام الصادق (عليه السلام): «تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن له وكان»[2].
وعن الإمام الباقر (عليه السلام)، أنّه قال: «إنّما مثل الحاجة إلى من أصاب ماله حديثًا كمثل الدرهم في فم الأفعى أنت إليه محوج وأنت منها على خطر»[3].
تطلبُ الحاجة منه؟
إذا كان لا بدّ لك من أفراد ترفع حاجتك إليهم فلا ترفعها إلّا لواحد من ثلاثة إمّا صاحب دِين، أو صاحب مروءة، أو صاحب حسب، عن
[1] الشيخ ابن شعبة الحرّانيّ، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص278.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج78، ص248.
[3] المصدر نفسه، ص174.
294
280
الموعظة الثالثة والأربعون: التكافل الاجتماعيّ
الإمام الحسين (عليه السلام): «لا ترفع حاجتك إلّا إلى أحد ثلاثة: إلى ذي دِين أو مروة أو حسب، فأمّا ذو الدِّين فيصون دينه، وأمّا ذو المروّة فإنّه يستحي لمروّته، وأمّا ذو الحسب فيعلم أنّك لم تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتك، فهو يصون وجهك أن يردّك بغير قضاء حاجتك»[1].
[1] الشيخ ابن شعبة الحرّانيّ، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص247.
295
281
الموعظة الرابعة والأربعون: خدمة الناس وكفّ الأذى
الموعظة الرابعة والأربعون: خدمة الناس وكفّ الأذى
الحثّ على خدمة الآخرين وتجنّب توجيه الأذى إليهم.
محاور الموعظة
أهمّيّة خدمة الناس
ثمرات خدمة الناس
آثار الامتناع عن خدمة الناس
الآثار السلبيّة لأذيّة الناس
من أنواع الأذى
تصدير الموعظة
الإمام الصادق (عليه السلام): «قال الله -عزَّ وجلَّ-: الخلق عيالي، فأحبّهم إليّ ألطفهم بهم، وأسعاهم في حوائجهم»[1].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص199.
296
282
الموعظة الرابعة والأربعون: خدمة الناس وكفّ الأذى
من النعم الإلهيّة الكبرى أن يوفّق الإنسان للقيام بخدمة أو معروف تجاه إخوانه؛ لأنّه لو اطّلع على ما أعدّه الله -تعالى- له من عطاء أبديّ لا ينفد لأدرك أنّ الأمر بالعكس؛ بمعنى أنّ المحتاج والمخدوم هو الذي يسدي خدمة للخادم والباذل؛ لأنّه السبب في حصوله على هذه الهبة الربّانيّة والحيويّة الفريدة. وعليه، ليس من الصواب والعقل أن تُتاح فرصة لأحدنا كي يقوم بتقديم مساعدة للآخرين وقضاء حوائجهم فيفوّت تلك الفرصة عليه.
أهمّيّة خدمة الناس
1. خدمة الناس هي خدمة لله -سبحانه وتعالى-: عن الإمام الصادق (عليه السلام): «من قضى لأخيه المسلم حاجة كان كمن خدم الله -تعالى- عمره»[1].
2. خدمة الناس أفضل الأعمال: عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال: «احرصوا على قضاء حوائج المؤمنين وإدخال السرور عليهم ودفع المكروه عنهم فإنّه ليس من الأعمال عند الله -عزَّ وجلَّ- بعد الإيمان أفضل من إدخال السرور على المؤمنِين»[2].
3. خادم الناس محبوب من الله -تعالى-: وفي حديث آخر: «قال الله -عزَّ وجلَّ-: الخلق عيالي، فأحبّهم إليّ ألطفهم بهم، وأسعاهم في حوائجهم»[3].
[1] الشيخ الاحسائيّ، عوالي اللآلي، ج1، ص374.
[2] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج71، ص313.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص199.
297
283
الموعظة الرابعة والأربعون: خدمة الناس وكفّ الأذى
4. إنّه عمل أحبّه الأئمّة (عليهم السلام): الإمام الباقر (عليه السلام) عن مدى حبّه وتفضيله لخدمة المحرومين، إذ يقول: «ولأن أعول أهل بيت من المسلمين، أسدّ جوعتهم وأكسو عورتهم، فأكفّ وجوههم عن الناس، أحبّ إليّ من أن أحجّ حجّة وحجّة ومثلها ومثلها... (حتّى بلغ عشرًا) ومثلها ومثلها... (حتّى بلغ السبعين)»[1].
ثمرات خدمة الناس
1. الأمن يوم القيامة: روي عن مولانا الكاظم (عليه السلام)، أنّه قال: «إنّ للَّه عبادًا في الأرض يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة»[2].
2. ألف ألف حسنة: عن الباقر (عليه السلام): «من سعى في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله كتب الله له ألف ألف حسنة»[3].
3. ثواب عبادة تسعة آلاف سنة: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنّه قال: «من سعى في حاجة أخيه المؤمن فكأنّما عبد الله تسعة آلاف سنة، صائمًا نهاره قائمًا ليله»[4].
4. كان الله في حاجته: عن الإمام الصادق (عليه السلام): «من كان في حاجة أخيه المؤمن المسلم كان الله في حاجته ما كان في حاجة أخيه»[5].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص195.
[2] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج74، ص319.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص197.
[4] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج74، ص315.
[5] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج16، ص367.
298
284
الموعظة الرابعة والأربعون: خدمة الناس وكفّ الأذى
5. استغفار الملائكة له: في الحديث عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن، فيوكّل الله -عزَّ وجلَّ- به ملكين: واحدًا عن يمينه وآخر عن شماله، يستغفران له ربّه ويدعوان بقضاء حاجته»[1].
آثار الامتناع عن خدمة الناس
1. خذلان الله في الدنيا والآخرة: عن الإمام الصادق (عليه السلام): «ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلّا خذله الله في الدنيا والآخرة»[2].
2. لا يذوق طعام الجنّة: وعنه (عليه السلام) في حديث آخر، قال: «أيّما مؤمن حبس مؤمنًا عن ماله وهو محتاج إليه لم يذق والله من طعام الجنّة ولا يشرب من الرحيق المختوم»[3].
3. الابتلاء بمعونة تجرّ إثمًا: عن الإمام الباقر (عليه السلام): «من بخل بمعونة أخيه المسلم والقيام له في حاجته إلّا ابتلي بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر»[4].
4. عدم قبول الأعمال: في الحديث عن الإمام الكاظم (عليه السلام)، قال: «إنّ خواتم أعمالكم قضاء حوائج إخوانكم والإحسان إليهم ما قدرتم وإلّا لم يقبل منكم عمل»[5].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص195.
[2] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج74، ص312.
[3] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج16، ص38.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص366.
[5] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج75، ص379.
299
285
الموعظة الرابعة والأربعون: خدمة الناس وكفّ الأذى
5. يحشر مغلولًا يوم القيامة: رُوي عن الإمام الصادق (عليه السلام)، أنّه قال: «من سأله أخوه المؤمن حاجة من ضرّ فمنعه من سعة وهو يقدر عليها من عنده أو من عند غيره، حشره الله يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتّى يفرغ الله من حساب الخلق»[1].
الآثار السلبيّة لأذيّة الناس
1. الأذى من صفات المشركين: ﴿لَتُبلَوُنَّ فِي أَموَٰلِكُم وَأَنفُسِكُم وَلَتَسمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلكِتَٰبَ مِن قَبلِكُم وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشرَكُواْ أَذٗى كَثِيرٗا وَإِن تَصبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِن عَزمِ ٱلأُمُورِ﴾[2].
2. أذيّة المؤمن هي أذيّة لرسول الله (صلى الله عليه وآله): وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّه قال: «من أدخل السرور على مؤمن فقد أدخله على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومن أدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد وصل ذلك إلى الله -عزَّ وجلَّ-، وكذلك من أدخل عليه كربًا»[3].
3. وقوفه مقام الذلّ يوم القيامة: وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّه قال: «من روى على مؤمن رواية يريد بها عيبه، وهدم مروّته، أقامه الله -عزَّ وجلَّ- مقام الذلّ يوم القيامة حتّى يخرج ممّا قال»[4].
4. سلب صفة الإيمان: عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال: «المؤمن من آمن جاره بوائقه، قلت: وما بوائقه؟ قال: ظلمه وغشمه»[5].
[1] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج74، ص287.
[2] سورة آل عمران، الآية 186.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص192.
[4] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج9، ص133.
[5] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص668.
300
286
الموعظة الرابعة والأربعون: خدمة الناس وكفّ الأذى
5. أذيّة المؤمن محاربة الله: عن هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: «قال الله -عزَّ وجلَّ-: ليأذن بحرب منّي من آذى عبدي المؤمن وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن...»[1].
6. عاقبة السوء: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الصدود لأوليائي فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم، فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنّفوهم في دينهم، ثمّ يؤمر بهم إلى جهنّم»[2].
من أنواع الأذى
1. الأذى بعد الإنفاق وتقديم العون والمساعدة: قال -تعالى-: ﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَٰلَهُم فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَا أَذٗى لَّهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلَا خَوفٌ عَلَيهِم وَلَا هُم يَحزَنُونَ ٢٦٢ قَولٞ مَّعرُوفٞ وَمَغفِرَةٌ خَيرٞ مِّن صَدَقَةٖ يَتبَعُهَا أَذٗى وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٞ﴾[3].
2. إذاعة الفاحشة: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال النبيّ (صلى الله عليه وآله): «من أذاع فاحشة كان كمبتدئها، ومن عيّر مؤمنًا بشيء لم يمت حتّى يركبه»[4].
3. الخذلان: وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته، إلّا خذله الله -عزَّ وجلَّ- في الدنيا والآخرة»[5].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص350.
[2] المصدر نفسه، ص351.
[3] سورة البقرة، الآيتان 262 - 263.
[4] الشيخ البرقيّ، المحاسن، ج1، ص103.
[5] الشيخ الصدوق، الأمالي ص574.
301
287
الموعظة الرابعة والأربعون: خدمة الناس وكفّ الأذى
4. إهانة المؤمن: عن المعلى بن خنيس، قال: سمعته يقول: «إنّ الله -عزَّ وجلَّ- يقول: من أهان لي وليًّا فقد ارصد لمحاربتي، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي».
5. إذاعة سرّ المؤمن: عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: «نعم»، قلت: أعني سفليه؟ فقال: «ليس حيث تذهب، إنّما هو إذاعة سرّه»[1].
6. إخافة المؤمن: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله -عزَّ وجلَّ- يوم لا ظلّ إلّا ظلّه»[2].
7. ترويع المؤمن: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «من روّع مؤمنًا بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النّار ومن روّع مؤمنًا بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النّار»[3].
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج2، ص37.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص368.
[3] المصدر نفسه.
302
288
الموعظة الرابعة والأربعون: خدمة الناس وكفّ الأذى
قصّة وعبرة
عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «جاء رجل إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) فشكا إليه أذى من جاره. فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): اصبر، ثمّ أتاه ثانية، فقال له النبيّ (صلى الله عليه وآله): اصبر، ثمّ عاد إليه فشكاه ثالثة، فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله) للرجل الذي شكا: إذا كان عند رواح الناس إلى الجمعة فأخرج متاعك إلى الطريق حتّى يراه من يروح إلى الجمعة فإذا سألوك فأخبرهم، قال: ففعل، فأتاه جاره المؤذي له، فقال له: ردّ متاعك فلك الله عليّ أن لا أعود»[1].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص668.
303
289
الموعظة الخامسة والأربعون: ستْر العُيوب
الموعظة الخامسة والأربعون: ستْر العُيوب
تعرّف أهمّيّة الستر وفضله وآثاره، والتحذير مِن تَتَبُّع العيوب والعَثرات.
محاور الموعظة
اللّه ستّار العيوب
النهي عن تتبُّع العثرات والعيوب
فضل ستر عيوب المؤمنين، وآثاره
موارد لا يَصحّ فيها الستر
تصدير الموعظة
أمير المؤمنين (عليه السلام): «لو وَجَدْتُ مُؤمنًا على فاحشةٍ، لَسَتَرتُه بِثوبي»[1].
[1] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج12، ص424.
304
290
الموعظة الخامسة والأربعون: ستْر العُيوب
الستر مِن أجلّ الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتحلّى بها، لِما فيها مِن حفظٍ للأعراض وتَجاوُزٍ عن العورات وسترٍ على أصحاب المعاصي والسيّئات، وحَيلولةٍ دون إشاعة الفاحشة بين الناس. وقد نبّهَت الآيات الشريفة إلى عظيم خَطرها؛ يقول -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلأخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لَا تَعلَمُونَ﴾[1].
اللّه ستّار العيوب
لو الْتفَتَ أيٌّ مِنّا إلى نفسه، لَعَلِم كم مِن العيوب لديه سَتَرها المولى عليه، ولم يَكشِفها أمام الخلائق. والمُتأمِّل في كلمات المعصومين (عليهم السلام) وأدعيتهم -في ما يرتبط بِستر اللّه -تعالى- على عبده- يُدرك مَدى ألطافه بِخَلقه.
1. ستر الله على مَن يستحقّ الفضيحة مِن عباده
عن الإمام زين العابدين (عليه السلام): «يا إِلهي، فَلَكَ الحَمْدُ، فَكَمْ مِنْ عائِبَةٍ سَتَرْتَها عَلَيَّ فَلَمْ تَفْضَحْني، وكَمْ مِنْ ذَنْبٍ غَطَّيْتَه عَلَيَّ فَلَمْ تشْهرْني، وكَمْ مِنْ شائِبَةٍ أَلْمَمْتُ بِها فَلَمْ تَهْتِكْ عَنّي سِتْرَها، ولَمْ تُقَلِّدْني مَكْروه شَنارِها، ولَمْ تُبْدِ سَوْءاتِها لِمَنْ يَلْتَمِسُ مَعايِبي مِنْ جيرَتي وحَسَدَةِ نِعْمَتِكَ عِنْدي؟»[2].
[1] سورة النور، الآية 19.
[2] الإمام زين العابدين (عليه السلام)، الصحيفة السجّاديّة، ص80، الدعاء 16.
305
291
الموعظة الخامسة والأربعون: ستْر العُيوب
2. سيّئات أخفاها اللّه على الملائكة الكاتبين
وَرد في دعاء كميل بن زياد: «... وكلّ سيّئةٍ أمَرْتَ بإثباتها الكرام الكاتبين، الذين وَكّلتَهم بِحفظِ ما يكون منّي، وجعلتهم شهودًا عَلَيّ مع جوارحي، وكنتَ أنت الرقيب عَلَيّ مِن ورائهم، والشاهد لِما خَفِيَ عنهم، وبِرحمتك أخفيتَه، وبِفضلك سترتَه...»[1].
3. طلب الستر الإلهيّ يوم القيامة
ورَد في المناجاة الشعبانيّة لِأمير المؤمنين (عليه السلام): «إلهي، قد سترْتَ عَليّ ذنوبًا في الدنيا، وأنا أحْوَج إلى سترها عَليَّ مِنك في الأخرى. إلهي، قد أحسنْتَ إليَّ إذ لم تُظهرها لِأحدٍ مِن عبادك الصالحين، فلا تفضحني يوم القيامة على رُؤوس الأشهاد»[2].
4. الستر الإلهيّ الذي يَعقب التوبة
يَروي معاوية بن وهب، عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إذا تابَ العبد توبةً نصوحًا أحبَّه اللّه، فَسَتَر عليه في الدنيا والآخرة»، فقُلتُ: وكيف يَستر عليه؟ قال (عليه السلام): «يُنسي مَلَكَيْه ما كَتَبا عليه مِن الذنوب، ويوحي إلى جوارحه: اكتُمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض: اكتُمي ما كان يَعمل عليك مِن الذنوب. فيَلْقى اللّه حين يَلقاهُ، وليس شيءٌ يَشهد عليه بِشيءٍ مِن الذنوب»[3].
[1] الشيخ الطوسيّ، مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد، ص849.
[2] السيّد ابن طاووس، الإقبال بالأعمال الحسنة في ما يعمل مرّة في السَنة، ج3، ص297.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص430.
306
292
الموعظة الخامسة والأربعون: ستْر العُيوب
5. شِدّة ستر اللّه على عبده
ورَد في الحديث الشريف: «إنّه يُؤتى يوم القيامة بِعَبدٍ يبكي، فيقول اللّه -سبحانه- له: لِمَ تبكي؟ فيقول: أبكي على ما سينكشِف عنّي مِن عوراتي وعيوبي عند الناس والملائكة. فيقول اللّه: عبدي، ما افْتَضَحْتُك في الدنيا بِكَشْف عيوبك وفواحشك، وأنت تعصيني وتضحك. فكيف أفضحُك اليوم بِكَشْفِها، وأنت تعصيني وتبكي؟»[1].
النهي عن تتبُّع العثرات والعيوب
أمَرَنا الإسلام بالتعامل مع الآخرين على قاعدة حُسن الظاهر، وأن نحمل المؤمن على الأحسن، ما دمنا نَجِدُ لِذلك محملًا، بل إنّ الشريعة حَرّمَتْ تتبُّع عورات الناس وعَثراتهم، عادّةً ذلك نوعًا مِن التجسُّس الممنوع -شرعًا وأخلاقًا-، لِما يُسبّب مِن هَدْمٍ للبناء الاجتماعيّ، وقضاءٍ على تماسكه ولُحْمَته.
1. حُرمة إذاعة سِرّ المؤمن
عن عبد اللّه بن سِنان: قلتُ له[2]: عَورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال (عليه السلام): «نعم»، قلتُ: يعني سُفْلَيْه؟ قال (عليه السلام): «ليس حيث تذهب، إنّما هو إذاعة سِرِّه»[3].
[1] الشيخ النراقيّ، جامع السعادات، ج2، ص209.
[2] للإمام الصادق (عليه السلام).
[3] الشيخ الطوسيّ، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج1، ص375.
307
293
الموعظة الخامسة والأربعون: ستْر العُيوب
2. تتبُّع العثرات وإحصاؤها لِلحديث بها أقربُ إلى الكفر
عن الإمام الباقر (عليه السلام): «إنّ أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أنْ يُواخي الرجلُ الرجلَ على الدين، فيُحصي عليه عثراته وزلّاته، لِيُعَنّفه بها يومًا ما»[1].
3. المتتبّع لِلعورات مِن جُملة المنافقين
عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «يا معشر مَن آمن بِلسانه ولَمْ يخلص الإيمان إلى قلبه، لا تتَّبِعوا عورات المؤمنين، فإنّه مَن تتبّع عورات المؤمنين تَتَبَّع اللّه عورته، ومَن تتبّع اللّهُ عَورته فَضَحَه وَلَوْ في جَوْف بيتِه»[2].
4. مُذيع الذنْب كفاعله
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «مَن اطَّلَعَ مِن مؤمنٍ على ذنْبٍ أو سيّئة فَأَفشى ذلك عليه، ولَم يَكتمها، ولَم يستغفر اللّه له، كان عِند اللّه كعامِلها، وعليه وِزْر ذلك الذي أفشاه عليه، وكان مَغفورًا لِعامِلها، وكان عقابُه ما أفشى عليه في الدنيا مَستورًا عليه في الآخرة، ثمّ يَجِد اللّه أكرم مِن أن يُثنِّي عليه عقابًا في الآخرة»[3].
5. كذِّبْ سَمْعك وبَصَرك، ولا تَكُن ممَّن يُحبّون أن تشيعَ الفاحشة
عن الإمام الكاظم (عليه السلام) -في خِطابه إلى محمّد بن الفضيل-: «يا محمّد، كذِّبْ سَمْعَك وبَصَرك عن أخيك، وإنْ شَهِدَ عندك خَمسون قَسّامة. وقال لك قولًا فَصَدِّقْه وكَذِّبْهم، ولا تُذيعَنّ عليه شيئًا تشينُه
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص355.
[2] الشيخ البرقيّ، المحاسن، ص104.
[3] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج9، ص134 - 135.
308
294
الموعظة الخامسة والأربعون: ستْر العُيوب
به، وتَهدِم به مُروءته، فيكون مِن الذين قال اللّه -عزَّ وجلّ-: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلفَٰحِشَةُ﴾[1]»[2].
6. الأمر بالحُكم على الظاهر مِن دون الدخول إلى الباطن
عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «إنّي لَم أُؤْمَر أن أُنقّب عن قلوب الناس، ولا أشقّ بُطونهم»[3].
فضْل ستر عيوب المؤمنين، وآثاره
كفى بِستر العيوب فضلًا أنّه مِن أوصاف اللّه -تعالى-، الذي مِن شِدّة اعتنائه بِستر الفواحش، أناطَ ثبوت الزنا -وهو أفْحشها- بِما لا يمكن اتّفاقُه إلّا نادرًا، وهو مُشاهدة أربعةِ عدول الزنا -كالميل في المكحلة-. فانْظُر إلى أنّه -تعالى- كيف أسبَلَ الستر على عُصاة خَلْقِه في الدنيا بِتضييق الطُرُق المؤدّيةِ إلى كَشْفِه[4].
1. اسْتُر أخاك بِما تطيق
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لِأمير المؤمنين (عليه السلام): «لَوْ رأيتَ رجلًا على فاحشة؟ قال: أستره. قال: إن رأيته ثانيًا؟ قال: أستره بِإزاري ورِدائي -إلى ثلاث مرّات-. فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله): لا فتى إلّا عليّ». وقال (صلى الله عليه وآله): «اسْتُروا على إخوانكم»[5].
[1] سورة النور، الآية 19.
[2] الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال، ص247.
[3] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص390.
[4] الشيخ النراقيّ، جامع السعادات، ج2، ص209.
[5] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج12، ص424.
309
295
الموعظة الخامسة والأربعون: ستْر العُيوب
2. الستر في الدنيا والآخرة
قال (صلى الله عليه وآله): «مَن سَتَر على مُسلمٍ، سَتَرَه اللّه -تعالى- في الدنيا والآخرة»[1].
وعن الإمام الصادق (عليه السلام): «... ومَن سَتَر على مؤمن عَورةً يخافها، سَتَر اللّه عليه سَبعين عورة مِن عَورات الدنيا والآخرة...»[2].
موارد لا يَصحّ فيها الستر
الأصل في ذِكر العيوب هو المَنْع، ولكنّ الشريعة الإسلاميّة استَثْنَتْ جُملةً مِن الموارد مِن حُرمة إذاعة العيوب، بل إنّ بعضها لا يَصحّ فيها الستر. وقد تعرّض لها الفقهاء وعُلَماء الأخلاق في كُتُبِهم ومَجاميعهم. وهي:
1. تَظَلُّم المظلوم بِذِكر ظُلْم الظالم عِندَ مَن يرجو رَفْعَه الظُلم عنه
قال -سبحانه-: ﴿لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلجَهرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلقَولِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾[3]؛ عن ابن عباس: «لا يُحبّ اللّهُ الجهرَ بالسوء مِن القَول، لكنّ مَن ظُلِمَ فلا حَرَجَ عليه أنْ يُخبِر بِما نِيل منه»[4].
2. نُصْح المستشير
إنّ النّصيحة واجبة لِلمُستشير، وخِيانته قد تكون أقوى مَفسدة مِن مفسدة عدم الستر؛ قال النبيّ (صلى الله عليه وآله) لِفاطمة بنت قيْس -المُشاورة في
[1] الفيض الكاشانّي، المحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء، ج3، ص375.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص200.
[3] سورة النساء، الآية 148.
[4] الشيخ الطوسيّ، التبيان في تفسير القرآن، ج3، ص371.
310
296
الموعظة الخامسة والأربعون: ستْر العُيوب
خِطابها-: «مُعاوية صُعلوك لا مال له، وأبو الجهم لا يَضَعُ العصا على عاتِقه»[1].
3. تحذير المسلم مِن شَرّ الوقوع في الضرر لِدُنيا أو دين
فإنّ مصلحة دَفْع فتنة الشر والضرر أَوْلى مِن هَتْك شرّ المُغتاب، كالمبتدع الذي يُخاف مِن إضلاله الناس، فإذا رأيتَ مَن يتردّد إلى مُبتدِعٍ أو فاسق، وخِفْتَ أن يتعدّى إليه بِدعته أو فِسقه، فَلَكَ أن تكشِفَ مساوئه؛ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا رأيتم أهل الرَيْب والبِدَع مِن بَعدي فَأَظهِروا البراءة منهم، وأكثِروا مِن سَبِّهِم والقَولِ فيهم والوقيعة، وباهِتوهُم، كي لا يَطْمَعوا في الفساد في الإسلام، ويَحذَرهم الناس، ولا يتعلّمون مِن بِدَعِهم، يَكتُب اللّه لكم بِذلك الحسنات، ويَرفع لكم به الدرجات في الآخرة»[2].
4. غيبة المتجاهر بالفِسق في ما تجاهر به
فإنّ مَن لا يبالي بِظهور فِسقه بين الناس، لا يَكرَه ذِكْره بِالفسق، فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إذا جاهر الفاسق بِفِسقه، فلا حُرمة له ولا غيبة»[3].
[1] حبيب الله الهاشميّ الخوئيّ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ج8، ص375.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص374.
[3] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص93.
311
297
الموعظة السادسة والأربعون: حسن الجوار
الموعظة السادسة والأربعون: حسن الجوار
بيان جملة من الحقوق والواجبات المترتّبة على مجاورة الناس بعضهم لبعض.
محاور الموعظة
تفسير حسن الجوار
بركات حسن الجوار
الجار قبل الدار
إيذاء الجار
تفقّد الجار
تصدير الموضوع
﴿وَٱعبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشرِكُواْ بِهِ شَئٗا وَبِٱلوَٰلِدَينِ إِحسَٰنٗا وَبِذِي ٱلقُربَىٰ وَٱليَتَٰمَىٰ وَٱلمَسَٰكِينِ وَٱلجَارِ ذِي ٱلقُربَىٰ وَٱلجَارِ ٱلجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلجَنبِ﴾[1].
[1] سورة النساء، الآية 36.
312
298
الموعظة السادسة والأربعون: حسن الجوار
أوصت الشريعة بمراعاة حسن الجوار وأولته عناية خاصّة معتبرةً حسن الجوار من أفضل مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يتمتّع بها المسلم، وأنّ الجار له حرمته وقدسيّته التي لا يجوز التهاون بها.
فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما زال جبرئيل (عليه السلام) يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورّثه»[1].
تفسير حسن الجوار
عن الإمام الكاظم (عليه السلام): «ليس حسن الجوار كفّ الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى»[2].
بركات حسن الجوار
1. امتثال أمر الله: عن الإمام الصادق (عليه السلام): «عليكم بحسن الجوار فإنّ الله أمر بذلك»[3].
2. نموّ الرزق: عن الإمام عليّ (عليه السلام): «حسن الجوار يزيد في الرزق»[4].
3. عمران الديار: عن الإمام عليّ (عليه السلام): «حسن الجوار يعمر الديار، ويزيد في الأعمار»[5].
[1] الشيخ الطوسيّ، الأمالي، ص514.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص667.
[3] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص486.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص666.
[5] المصدر نفسه، ص667.
313
299
الموعظة السادسة والأربعون: حسن الجوار
4. زيادة الإخوان: عن الإمام عليّ (عليه السلام): «من حسن جواره كثر جيرانه»[1].
وعن الإمام عليّ (عليه السلام): «من أحسن إلى جيرانه كثر خدمه»[2].
الجار قبل الدار
والسؤال عن الجار قبل الدار؛ لأنّ الجار قد يكون مصدر سعادة وأنس وقد يكون مصدر إزعاج وتعاسة ممّا يؤثّر على حياة الإنسان، فعن الإمام عليّ (عليه السلام): «جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله! إنّي أردت شراء دار، أين تأمرني أشتري؟ في جهينة أم في مزينة أم في ثقيف أم في قريش؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): الجوار ثمّ الدار، الرفيق ثمّ السفر»[3].
وعن الإمام عليّ (عليه السلام): «سل عن الجار قبل الدار»[4].
جار السوء
قال لقمان (عليه السلام): «حملت الجندل والحديد وكلّ حمل ثقيل، فلم أحمل شيئًا أثقل من جار السوء»[5].
وفي الحديث إشارة لطيفة، وهي أنّ جار السوء عليك أن تتحمّله.
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «يا عليّ! أربعة من قواصم الظهر:.. وجار سوء في دار مقام»[6].
[1] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص486.
[2] المصدر نفسه.
[3] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج8، ص210.
[4] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص284.
[5] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص766.
[6] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص73.
314
300
الموعظة السادسة والأربعون: حسن الجوار
وعن الإمام عليّ (عليه السلام): «جار السوء أعظم الضرّاء وأشدّ البلاء»[1].
وذلك لأنّ العلاقة مع جار السوء ليست علاقة عابرة، بل علاقة دائمة ويوميّة وحياتيّة.
إيذاء الجار
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره»[2].
عن الإمام الرضا (عليه السلام): «ليس منّا من لم يأمن جاره بوائقه»[3].
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه رجل من الأنصار، فقال: إنّي اشتريت دارًا من بني فلان، وإنّ أقرب جيراني منّي جوارًا من لا أرجو خيره ولا آمن شرّه، قال: فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليًّا وسلمان وأبا ذرّ -ونسيت آخر وأظنّه المقداد- أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنّه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثا»[4].
تفقّد الجار
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما أقرّ بي من بات شبعانًا وجاره المسلم جائع»[5].
وعن (صلى الله عليه وآله): «من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة، ووكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله»[6].
[1] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص222.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص667.
[3] المصدر نفسه، ص666.
[4] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج12، ص125.
[5] الشيخ الطوسيّ، الأمالي، ص520.
[6] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص515.
315
301
الموعظة السادسة والأربعون: حسن الجوار
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) -لأصحابه-: «ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانًا وجاره جائع»، فقلنا: هلكنا يا رسول الله، فقال: «من فضل طعامكم ومن فضل تمركم وورقكم وخلقكم وخرقكم، تطفئون بها غضب الربّ»[1].
حقّ الجار
عن الإمام زين العابدين (عليه السلام): «أمّا حقّ جارك فحفظه غائبًا، وإكرامه شاهدًا، ونصرته إذا كان مظلومًا، ولا تتبع له عورة، فإن علمت عليه سوءًا سترته عليه، وإن علمت أنّه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه، ولا تسلمه عند شديدة، وتقيل عثرته، وتغفر ذنبه، وتعاشره معاشرة كريمة»[2].
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) -في حقوق الجار-: «إن استغاثك أغثته، وإن استقرضك أقرضته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابته مصيبة عزّيته، وإن أصابه خير هنّأته، وإن مرض عدته، وإن مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلّا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرّا، ولا تخرج بها ولدك تغيظ بها ولده، ولا تؤذه بريح قدرك إلّا أن تغرف له منها»[3].
حدّ الجار
عن الإمام عليّ (عليه السلام): «حريم المسجد أربعون ذراعا، والجوار أربعون دارًا من أربعة جوانبها»[4].
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج17، ص209.
[2] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص488.
[3] المصدر نفسه، ج1، ص488.
[4] المصدر نفسه.
316
302
الموعظة السابعة والأربعون: الاختلاط المحرّم
الموعظة السابعة والأربعون: الاختلاط المحرّم
التنبيه إلى كون الاختلاط من أكبر المفاسد الاجتماعيّة التي ينبغي محاربتها والحذر منها.
الموعظة
مفاسد الاختلاط المحرّم وآثاره
عدم الخضوع في القول
التزيّن والتبرّج في المجالس
الخوض في الأحاديث اللهويّة
اجتناب المزاح
تصدير الموعظة
الإمام عليّ (عليه السلام): «لا يخلو بامرأة رجل، فما من رجل خلا بامرأة إلّا كان الشيطان ثالثهما»[1].
[1] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج14، ص265.
317
303
الموعظة السابعة والأربعون: الاختلاط المحرّم
الموعظة السابعة والأربعون: الاختلاط المحرّم
التنبيه إلى كون الاختلاط من أكبر المفاسد الاجتماعيّة التي ينبغي محاربتها والحذر منها.
الموعظة
مفاسد الاختلاط المحرّم وآثاره
عدم الخضوع في القول
التزيّن والتبرّج في المجالس
الخوض في الأحاديث اللهويّة
اجتناب المزاح
تصدير الموعظة
الإمام عليّ (عليه السلام): «لا يخلو بامرأة رجل، فما من رجل خلا بامرأة إلّا كان الشيطان ثالثهما»[1].
[1] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج14، ص265.
317
304
الموعظة السابعة والأربعون: الاختلاط المحرّم
من الأمور المهمّة التي نبّهت عليها الشريعة في إطار تنظيم العلاقة بين الرجل بالمرأة خارج دائرة الزوجيّة والمحارم، أنّها دعت إلى تجنّب الاختلاط المحرّم الذي اعتبرته أرضًا خصبة للوقوع في الكثير من الانحرافات السلوكيّة التي قد يجد فيها الإنسان نفسه في لحظة ما قد فقد كلّ الدفاعات النفسيّة التي تقف في وجه وسوسات الشيطان والهوى والنفس الأمّارة بالسوء ليصبح صريعًا تحت سلطة إبليس.
فأرادت لهذه العلاقة أن تبقى في سموّها الإنسانيّ والإيمانيّ محذّرة من الوقوع في انحدارات الشهوة السلبيّة التي لا تشكّل خطرًا على الفرد فحسب، بل تدمّر مجتمعًا ودولًا، وهذا ما نشهده في الكثير من بقاع الأرض اليوم.
مفاسد الاختلاط المحرّم وآثاره
وأكّدت الروايات الشريفة الحنيفة على مراعاة جملة أمور في أيّ مجلس اختلاط حرصًا من الوقوع في الخطأ، بل ويمكن القول: إنّ كثيرًا من العلاقات المحرّمة والتي قد تصل إلى حدّ الزنا -أحيانًا- واللقاءات المحرّمة والخلوات المحرّمة وما يترتّب عليها من مفاسد اجتماعيّة تبدأ من الاختلاط المحرّم الذي ينبغي أن ينأى الإنسان بنفسه به حرصًا على نفسه وأهله وعياله.
عدم النظر
قال -تعالى-: ﴿قُل لِّلمُؤمِنِينَ يَغُضُّواْ مِن أَبصَٰرِهِم وَيَحفَظُواْ فُرُوجَهُم ذَٰلِكَ أَزكَىٰ لَهُم إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلمُؤمِنَٰتِ
318
305
الموعظة السابعة والأربعون: الاختلاط المحرّم
يَغضُضنَ مِن أَبصَٰرِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ﴾[1]. وغضّ البصر خفضه وهو يتحقّق من خلال عدم التحديق والإمعان. وعن الإمام الصادق (عليه السلام): «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة»[2].
وعندما تحذّر النصوص من النظر معنى ذلك أنّه من غير الممكن للإنسان أن يمعن النظر في الطرف الآخر المحرّم دون أن يدخله شكّ أو ريبة أو تلذّذ أو سوى ذلك ممّا يشكّل مقدّمة للحرام؛ لأنّه سيصبح حالةً طبيعيّة واعتياديّة يغفل المرء عن سلبيّاتها وأخطارها.
عدم الخضوع في القول
قـال -تعالى-: ﴿يَٰنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ لَستُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيتُنَّ فَلَا تَخضَعنَ بِٱلقَولِ فَيَطمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلبِهِ مَرَضٞ وَقُلنَ قَولٗا مَّعرُوفٗا﴾[3].
ومعنى الخضوع في القول أن تقدّم المرأة نفسها بطريقة مثيرة من خلال ترقيق القول وتلحين الكلام وتحسين الصوت وإبراز الأنا المصطنعة والظهور بمظهر الجمال والكمال المزيّف وكلّ ما من شأنه أن يحرف من في قلبه مرض من الرجال نحو الفساد والرذيلة.
التزيّن والتبرّج في المجالس
فإنّ الاختلاط بين الرجل والمرأة إذا رافقه تزيّن أو تطيّب أو لبس ألبسة ملفتة فإنّه من الطبيعي أن يدخل الشيطان إلى هذه المجالس
[1] سورة النور، الآية 30.
[2] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج20، ص52.
[3] سورة الأحزاب، الآية 32.
319
306
الموعظة السابعة والأربعون: الاختلاط المحرّم
ليجرّ أصحابها إلى النظر الحرام والقول الحرام ومن الممكن إلى الفعل الحرام كذلك.
الخوض في الأحاديث اللهويّة
والمراد أنّ طبيعة الحديث بين الرجل والمرأة غير المحارم إذا تمّ ينبغي الاقتصار فيه على حدّ الضرورة وعدم الدخول في أحاديث جانبيّة وحوارات مصطنعة ونقاشات لا تهدف إلّا لتقوية العلاقة بين الطرفين، ومع الأسف أن يعتبر البعض أنّ هذا المظهر من المظاهر الحضاريّة والتي تزيد من هامش الحرّيّة الفرديّة لدى الإنسان مع أنّ الإسلام اعتبره من أكبر المفاسد الاجتماعيّة وأبعدها عن الرقيّ والحضارة، وإنّ كثيرًا ممّا هو شائع اليوم من محادثات على صفحات الإنترنت ومواقع التعارف والأحاديث الخاصّة يندرج في هذا الإطار وتفتح الباب واسعًا أمام العلاقات المشبوهة والمحرّمة.
اجتناب المزاح
فإنّ كثرة المزاح تفتح الطريق للانزلاق في مسائل خاصّة والدخول في تفاصيل قد تؤدّي إلى محرّمات، فقد ورد عن أبي بصير أنّه قال: كنت أقرئ امرأة كنت أعلّمها القرآن، فمازحتها بشيء، فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام)، فقال لي: «أيّ شيء قلت للمرأة؟»، فغطّيت وجهي، فقال: «لا تعودنّ إليها»[1].
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج20، ص198.
320
307
الموعظة السابعة والأربعون: الاختلاط المحرّم
إنّ مراعاة ما ذكرناه من أمور كفيل بالحفاظ على المرأة ومكانتها وصونها عن الامتهان والمذلّة التي قد تتعرّض لها المرأة بفعل الاستغلال الرخيص لها... وهذا ما أكّد عليه أهل البيت (عليهم السلام) من خلال تعاليمهم وسيرة نسائهم الفاضلات اللواتي كنّ قدوة لنساء العالمين، كالسيّدة زينب (عليها السلام) التي كان يحرص أمير المؤمنين (عليه السلام) عليها- كما نقل- حتّى أنّه كان يطفأ سراج المسجد كي لا يرى أحد خيالها... ومن هنا، يعزّ على آل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما جرى على نسائهم يوم عاشوراء حيث سبيت فيه نساؤهم.
321
308
الموعظة الثامنة والأربعون: حرمة الدم في الإسلام
الموعظة الثامنة والأربعون: حرمة الدم في الإسلام
بيان خطورة قتل النفس بغير حقٍّ، وعِظم ذلك في الإسلام.
محاور الموعظة
أنواع القتل
قلب العبد قبل القتل
أوّل عمليّة قتل
من أعان على القتل
أعظم القتل
تصدير الموعظة
النبيّ (صلى الله عليه وآله): «لزوال الدنيا جميعًا أهون على الله من دمٍ سُفِكَ بغير حقٍّ»[1].
وعنه (صلى الله عليه وآله): «لا يغرَّنَّكم رحب الذِّراعين بالدم فإنّ له عند الله قاتلًا لا يموت». قالوا: يا رسول الله، وما قاتل لا يموت؟ فقال: «النّار»[2].
[1] المنذريّ، الترغيب والترهيب، ج3، ص293، رواه البيهقي وقريب منه مع اختلاف يسير عند مسلم والترمذيّ.
[2] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج19، ص4.
322
309
الموعظة الثامنة والأربعون: حرمة الدم في الإسلام
الأحكام الشرعيّة الصادرة متفاوتة من حيث الشدّة والضعف، وهي مختلفة باختلاف موضوعاتها، ولذا نجد أنّ الإسلام قد احتاط في بعضها كالفروج والدماء، ومعنى الاحتياط في الأوّل هو التشدّد في أحكام العلاقات الجنسيّة؛ وذلك لمنع التناسل من طريق الحرام أو الشبهة؛ وذلك لأنّ المولود من طريق الحرام سوف تترتّب عليه أحكام شرعيّة خاصّة علمًا أنّ كلّ ما حصل فهو خارج إرادته وليس له مدخليّة في ذلك، ومع هذا فلا يمكن إصلاحه تكوينيًّا، وأيضًا لا يجوز قتله تحت أيّ عنوان فالآثار المتأخّرة سببها الخطأ المتقدّم ولكيلا نصل إلى المتأخّر احتاطت الشريعة في المتقدّم.
وأمّا بالنسبة للاحتياط في الدماء، بمعنى أنّ الإسلام قد أصدر مجموعة من الأحكام يتشكّل منها منظومة من القوانين ذات الطابع التشريعيّ، وهي على مرحلتين: ففي الأولى منها، هي تلك الأحكام التي تقف حائلًا أمام كلّ من يوسوس له شيطانه للإقدام على القتل، وهي التي تحذّره من العواقب التي تنتظر القتلة والمجرمين سواء في الدنيا أو في الآخرة.
وفي المرحلة الثانية، هي الأحكام التي تقع عقيب حصول الجريمة لترشد إلى سبل كيفيّة المعالجة حتّى لا يعالج القتل بالقتل. وأمّا حكمة الاحتياط في الدماء فلعلّه لأجل أنّ النفس إذا أزهقت فلا تعالج بإرجاع الروح إلى الجسد ولذا شُرّعت أحكام تجبر هنا النقص ولتمنع الفساد الذي ربّما يحصل بسبب القتل وحتّى لا يستسهل الناس القتل.
323
310
الموعظة الثامنة والأربعون: حرمة الدم في الإسلام
أنواع القتل
تارة يقدم الإنسان على قتل نفسه وهو المعبّر عنه بالانتحار، وأخرى يقدم على قتل الغير، وهذا بدوره ينقسم إلى نوعين، فقد يكون القتل أصاب امرًا في عالم الدنيا، وقد يكون أصاب من هو في عالم الأرحام.
أمّا قتل الإنسان نفسه عمدًا فممَّا لا شكّ فيه هو عمل حرام وجريمة كأيّة جريمة قتل موصوفة، وباعتبار أنّه قاتل حقيقيّ فسوف يحاسب على أنّه قاتل، فعن الإمام الصادق (عليه السلام)، أنّه قال: «من قتل نفسه متعمّدًا فهو في نار جهنّم خالدًا فيها»[1].
نعم، باعتبار أنّه لم يبق على قيد الحياة فتسقط الأحكام المعيّنة في خصوص دار الدنيا المتوجّبة على القاتل من القصاص وتسقط الديّة عنه وأيضًا الكفّارة الواجبة في بعض الصور لعدم إمكانيّة أن يؤخذ منه شيء، ولا تخرج من تركته وأمّا محاسبته وحسابه يوم القيامة فذاك إلى الله -سبحانه وتعالى-.
وأمّا النوع الآخر من القتل، وهو قتل الأغيار، فلو أقدم على قتل الجنين في بطن أمّه فتارة يكون الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح وأخرى بعد نفخ الروح فيه، ففي الأولى فعليه الكفّارة المقرّرة بحسب المراحلالمذكورة في الكتب الفقهيّة، وأمّا في الثانية فهو قاتل للنفس المحترمة ويترتّب على ذلك دفع الديّة كاملة.
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج19، ص13.
324
311
الموعظة الثامنة والأربعون: حرمة الدم في الإسلام
قلب العبد قبل القتل
طالما لم يرتكب العبد جريمة قتل في دار الدنيا فيبقى في فسحة من دينه ويبقى قلبه يقبل الرغبة والرهبة إلى أن يصبح قاتلًا فينكس قلبه ويخسر دينه، وجزاؤه بنصّ القرآن الكريم هو جهنّم؛ إذ هناك موازاة بين بقاء الروح في الجسد وسلامة دين الإنسان، فإذا أزهق الروح فقد نكس قلبه، ويدلّ عليه ما جاء عن النبيّ (صلى الله عليه وآله): «لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا»[1].
وممّا روي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أيضًا: «لا يزال قلب العبد يقبل الرغبة والرهبة حتّى يسفك الدم الحرام، فإذا سفكه نكس قلبه...»[2].
أوّل عمليّة قتل
يحدّثنا القرآن الكريم أنّ أوّل عمليّة قتل حصلت عندما أقدم قابيل على قتل أخيه هابيل بسبب الحسد والغيرة، وقد أشار إلى هذا الموضوع بقوله -تعالى-: ﴿وَٱتلُ عَلَيهِم نَبَأَ ٱبنَي ءَادَمَ بِٱلحَقِّ إِذ قَرَّبَا قُربَانٗا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَم يُتَقَبَّل مِنَ ٱلأخَرِ قَالَ لَأَقتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلمُتَّقِينَ ٢٧ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٖ يَدِيَ إِلَيكَ لِأَقتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلعَٰلَمِينَ ٢٨ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوأَ بِإِثمِي وَإِثمِكَ فَتَكُونَ مِن أَصحَٰبِ ٱلنَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَٰؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾[3].
[1] المتّقي الهنديّ، كنز العمّال، ج15، ص24.
[2] المصدر نفسه، ج15، ص33.
[3] سورة المائدة، الآيات 27 - 29.
325
312
الموعظة الثامنة والأربعون: حرمة الدم في الإسلام
يمكن الاستفادة من الأمور الآتية:
أوّلًا: أنّ الحاجز الأساسيّ عن الإقدام على عمليّة القتل هو الخوف من الله-سبحانه وتعالى-، ولذا فإنّ زوال الخوف من النّفوس يسهِّل على البعض إزهاق النفوس بغير حقّ.
ثانيًا: يضاف إلى الإثم الذي يتحمّله القاتل بسبب القتل إثم المقتول وذنوبه، وقد دلَّ عليه ما رُوي عن الإمام الباقر (عليه السلام)، قال: «من قتل مؤمنًا متعمّدًا أثبت الله على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها، وذلك قوله -عزَّ وجلَّ- مستشهدًا بالآية المذكورة»[1].
ثالثًا: إنّ القتل العمديّ بغير صورة حقّ فجزاؤه جهنّم ويدلّ عليه قوله -تعالى-: ﴿وَمَن يَقتُل مُؤمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمٗا﴾[2].
رابعًا: إنّ بعض الملكات الخبيثة التي تبتلى بها النفس تكون سببًا مساعدًا على ارتكاب الجريمة وسفك الدماء.
فكأنّما قتل الناس جميعًا
النفس إن كانت محقونة الدم فهي ممّا حرّم الله -تعالى- ولذا نهى عن قتلها، وهنا لو تجاوز أحد حدود ما حرّم الله -تعالى- وأقدم على إزهاق الروح وسفك دمها من دون حقّ فهو عمل حرام يؤدّي إلى الفساد في الأرض؛ لكونه يجرُؤ على الجريمة، ولذا نزل منزلة من قتل الناس جميعًا، وهنا قد سأل حمران بن أعين الإمام الباقر (عليه السلام) عن معنى فكأنّما قتل
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج19، ص7.
[2] سورة النساء، الآية 93.
326
313
الموعظة الثامنة والأربعون: حرمة الدم في الإسلام
الناس جميعًا، فإنّما قتل واحدًا؟ فقال (عليه السلام): «يوضع في موضع من جهنّم إليه منتهى شدّة عذاب أهلها، ولو قتل النّاس جميعًا إنّما كان يدخل ذلك المكان»، قلت فإن قتل آخر؟ فقال: «يُضاعَف عليه»[1].
ويؤيّد ذلك ما جاء في الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لَزوالُ الدنيا جميعًا أهون على الله من دمٍ سُفِكَ بغير حقّ»[2].
أوّل قضيّة يُحكَم بها
الأحكام الصادرة عن المحكمة الإلهيّة العادلة يوم القيامة تختلف باختلاف الجنايات والجنح والمخالفات في دار الدنيا وأمّا جدولة الموضوعات للمحاكمة إنّما هي خاضعة للمهمّ والأهمّ، وباعتبار أنّ الموضوع الأوّل الذي يحضر بين يدي الله-تعالى- هو الدماء فهذا يكشف كشفًا مبيّنًا عن عظمة الذنب المرتكَب وخطورة الجناية المفتعلة بما لها علاقة بالدماء.
فقد ورد في الحديث عن النبيّ (صلى الله عليه وآله): «أوّل ما يحاكم الله فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف ابنَيْ آدم فيفصل بينهما، ثمّ الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتّى لا يبقى منهم أحد، ثمّ النّاس بعد ذلك حتّى يأتي المقتول بقاتله فيتشخّب في دمه وجهه فيقول: هذا قتلني، فيقول: أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثًا»[3].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج7، ص271.
[2] المنذريّ، الترغيب والترهيب، ج3، ص293.
[3] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج19، ص4 وأيضًا ورد في مجموعة كتب من الصحاح وغيرها عند السنّة باختلاف يسير.
327
314
الموعظة الثامنة والأربعون: حرمة الدم في الإسلام
من أعان على القتل
قد يكون الإنسان قاتلًا وإن لم يباشر عمليّة القتل، كما لو أعان غيره على قتل غيره فيما لو أرشده إلى مكان المقتول أو قدّم له معلومات تسهِّل الوصول إليه، أو أثار مشاعر بعضهم فتحرّك وقتل أحدًا، إلى غير ذلك من الأسباب غير المباشرة لعمليّة القتل، فهذا له محجمة من دم المقتول، ويدلّ عليه ما جاء في الروايات: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة الله»[1] وأيضًا: «إنّ الرجل لَيُدفع عن باب الجنّة أن ينظر إليها بمحجمة من دم يُريقه من مسلم بغير حقّ»[2].
أعظم القتل
لقد تبيّن أنّ سفك الدم الحرام هو من أعظم الذنوب، وهو أوّل ما يحضر للمحاكمة بين يدي الله -تعالى-، ولكنَّ أعظم شيء في القتل هو قتل المؤمن لأجل إيمانه، فهذا له العقوبات الآتية:
-جزاؤه جهنّم.
-مخلَّد فيها.
-الله غاضب عليه.
-ملعون.
-له عذاب عظيم.
وهذه العقوبات الخمس قد ترجمتها الآية 93 من سورة النساء، ويضاف إليه، فلا يوفّق للتوبة في دار الدنيا.
[1] المتّقي الهنديّ، كنز العمّال، ج15، ص22.
[2] المصدر نفسه، ص27.
328
315
الموعظة التاسعة والأربعون: الظلم في الحياة الاجتماعيّة
الموعظة التاسعة والأربعون: الظلم في الحياة الاجتماعيّة
إيضاح نظرة الإسلام إلى الظلم، وموقفه من الظالمين، ومظاهر الظلم في الحياة العامّة والاجتماعيّة.
محاور الموعظة
قبح الظلم عند البشر
وجوب نصرة المظلوم في الإسلام
مظاهر الظلم في الحياة الاجتماعيّة
الظلم في الحياة الاجتماعيّة بين الأسر والأرحام
الآثار الإيجابيّة لمراعاة حقوق المجتمع
تصدير الموعظة
الإمام الصادق (عليه السلام): «ما من مؤمن يعين مؤمنًا مظلومًا إلّا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام، وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته إلّا نصره الله في الدنيا والآخرة، وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلّا خذله الله في الدنيا والآخرة»[1].
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج12، ص292.
329
316
الموعظة التاسعة والأربعون: الظلم في الحياة الاجتماعيّة
الظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء: وضع الشيء في غير موضعه المختّصّ به، إمّا بنقصان أو بزيادة، وإمّا بعدول عن وقته أو مكانه... والظلم يقال في مجاوزة الحقّ الذي يجري مجرى نقطة في الدائرة ويقال فيما يكثر وفيما يقلّ من التجاوز[1].
قبح الظلم عند البشر
تشهد دراسة التاريخ البشريّ بأنّ الإنسان مهما كان دينه ومسلكه وانتماؤه، وأينما حلّ في بقاع الأرض، يُدرك بنفسه قُبح الظلم وحُسن العدل، كما يُدرك بنفسه حسن الوفاء بالعهد وقبح نقضه، وحُسن معونةِ المظلومين ونصرتهم، وقُبح إعانه الظالمين ونصرتهم.
ولهذا فإنّ الخروج على هذه القاعدة من قبل المتكبّرين في الماضي والحاضر، وظلم الشعوب وسلب مقدّراتها وعدم إعطائها ما تستحقّه هو من أجلى مصاديق الظلم والتكبّر والتعالي، بخاصّة أن أساس الظلم نابع إمّا من جهل الفاعل بقبح الظلم، أو كونه سفيهًا غير حكيم فهو يمارس الظلم مع علمه بقبحه وبرغم قدرته على القيام بالعدل، أو من احتياجه للظلم لحفظ مصالحه ومشاريعه وإن كان على حساب حقّ الناس وكرامتهم.
وجوب نصرة المظلوم في الإسلام
جاء الإسلام والناس متفرّقون شيعًا وأحزابًا وقبائل، فجمع الله به الناس، وألَّف به بين قلوبهم: قال الله -تعالى: ﴿وَٱذكُرُواْ نِعمَتَ ٱللَّهِ
[1] الراغب الأصفهانيّ، مفردات ألفاظ القرآن، ص537.
330
317
الموعظة التاسعة والأربعون: الظلم في الحياة الاجتماعيّة
عَلَيكُم إِذ كُنتُم أَعدَاءٗ فَأَلَّفَ بَينَ قُلُوبِكُم فَأَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخوَٰنٗا﴾[1].
وقد ربَّى الإسلام أبناءه على استشعار أنّهم أفراد في مجموعة وأنّهم أجزاء من هذه الجماعة الكبيرة، فالمسلم بشعوره أنّه جزء من الجماعة يحبّ للأجزاء الأخرى مثل ما يحبّ لنفسه. فإنّ انتماء المسلم للجماعة يترتّب عليه حقوق وواجبات، ومن أعظمها واجب التناصر بين المسلمين. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول الله -عزّ وجلّ-: «وعزّتي وجلالي لأنتقمّنّ من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمّنّ ممّن رأى مظلومًا فقدر أن ينصره فلم ينصره»[2]. وقد أوصى الإمام علي (عليه السلام) ولديه الحسن والحسين (عليه السلام) بقوله: «وكونا للظالم خصمًا، وللمظلوم عَوْنًا»[3].
ودعا الإمام الصادق (عليه السلام) إلى الالتصاق والاندكاك بجماعة المسلمين، فقال: «من فارق جماعة المسلمين قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»[4].
مظاهر الظلم في الحياة الاجتماعيّة
جعل الإسلام كلّ مسلم مسؤولًا في بيئته الاجتماعيّة، يمارس دوره الاجتماعيّ من موقعه، ولتنظيم الحياة الاجتماعيّة شرّع العديد من التشريعات التي تحفظ حقوق الفرد والمجتمع في آن واحد، وبمراعاتها
[1] سورة آل عمران، الآية 103.
[2] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج2، ص1774.
[3] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص421.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج1، ص405.
331
318
الموعظة التاسعة والأربعون: الظلم في الحياة الاجتماعيّة
تتحقّق السعادة لجميع الناس، والخروج على هذا النظام الاجتماعيّ يعني ظلم الآخرين وإيقاع الظلم عليهم، ونحن لتتضّح الصورة أكثر، سنطرح مصاديق الظلم الاجتماعيّ بملاحظة التشريعات الاجتماعيّة.
1. حرمة الظلم: إنّ حرمة ظلم النفس أو الآخرين من الواضحات في الدين الإسلاميّ، بل من واجبات كلّ مسلم تجاه أخيه المسلم تقديم العون له متى احتاج إليه، ودفع الظلم عنه إن كان مظلومًا، وكان النبيّ (صلى الله عليه وآله) يشحذ همم المسلمين ويحثّهم على نصرة المظلوم مبيّنًا أنّ الجزاء سيكون من جنس العمل: «ما من امرئ يخذل ٱمرأ مسلمًا عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه عرضه إلّا خذله الله -عزّ وجلّ- في موطن يحبّ فيه نصرته وما من ٱمرئ ينصر ٱمرأ مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلّا نصره الله في موطن يحبّ فيه نصرته»[1].
2. النهي عن كلّ ما يفسد الأواصر الاجتماعيّة: نهى القرآن الكريم عن الاعتداء على الآخرين، بالظلم أو القتل أو غصب الأموال والممتلكات والاعتداء على الأعراض: ﴿وَلَا تَعتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلمُعتَدِينَ﴾[2].
وحصر التعاون بالبرّ ونهى عن الإثم والعدوان، قال -تعالى-: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلبِرِّ وَٱلتَّقوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثمِ وَٱلعُدوَٰنِ﴾[3].
[1] أحمد بن حنبل، المسند (مسند أحمد)، ج4، ص30.
[2] سورة المائدة، الآية 87.
[3] سورة المائدة، الآية 2.
332
319
الموعظة التاسعة والأربعون: الظلم في الحياة الاجتماعيّة
3. النهي عن السخرية واللمز: قال -تعالى- ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسخَر قَومٞ مِّن قَومٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيرٗا مِّنهُم وَلَا نِسَاءٞ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيرٗا مِّنهُنَّ وَلَا تَلمِزُواْ أَنفُسَكُم وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلأَلقَٰبِ بِئسَ ٱلِٱسمُ ٱلفُسُوقُ بَعدَ ٱلإِيمَٰنِ﴾[1].
4. النهي عن هتك حرمات البيوت: وحرّم دخول بيوت الآخرين دون إذن منهم: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدخُلُواْ بُيُوتًا غَيرَ بُيُوتِكُم حَتَّىٰ تَستَأنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهلِهَا﴾[2].
5. حرّمة الظنّ الآثم والتجسّس على الناس: قال -تعالى-: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعضَ ٱلظَّنِّ إِثمٞ وَ لَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغتَب بَّعضُكُم بَعضًا﴾[3].
6. حرمة إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلاميّ: قال -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾[4].
وهكذا يوفِّر القرآن في هذه اللائحة الطويلة والعريضة، ما يضمن توفير الحصانة للمجتمع البشريّ، وهو يضع النظام الدقيق والشامل، من أحكام، وقيم أخلاقيّة، ليكون الأمان والتآلف والتعايش والتكافل معالم أصيلة في الحياة الاجتماعيّة.
[1] سورة الحجرات، الآية 11.
[2] سورة النور، الآية 27.
[3] سورة الحجرات، الآية 12.
[4] سورة النور، الآية 19.
333
320
الموعظة التاسعة والأربعون: الظلم في الحياة الاجتماعيّة
الظلم في الحياة الاجتماعيّة بين الأسر والأرحام
أكثر ما يتجلّى الظلم الاجتماعيّ في هذه الدائرة في ظلم الأزواج لزوجاتهم، وفي ظلم الأبناء لأبويهم، وفي ظلم الأرحام بعضهم لبعض.
1. ظلم الأزواج لزوجاتهم: ويكون بالإيذاء بالكلام الجارح والإهانة والضرب المبرّح، ومنع النفقة الواجبة، وعدم إعطائها لحقوقها الواجبة في الإسلام. ومن الواضح أنّه يجب على الزوج مراعاة زوجته بمعاشرتها بالمعروف، قال الله -تعالى-: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلمَعرُوفِ فَإِن كَرِهتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكرَهُواْ شَئٗا وَيَجعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيرٗا كَثِيرٗا﴾[1]. ومن مصاديق العشرة بالمعروف حسن الصحبة، قال الإمام عليُّ بن أبي طالب (عليه السلام) في وصيّته لمحمد بن الحنفية: «إنَّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فدارها على كلِّ حال، وأحسن الصحبة لها، ليصفو عيشك»[2].
ومن حقّها أن يتعامل زوجها معها بحسن الخلق، وهو أحد العوامل التي تُعمّق المودّة والرحمة والحبّ داخل الأُسرة، قال الإمام عليّ بن الحسين (عليه السلام): «لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته، وهي: الموافقة، ليجتلب بها موافقتها ومحبّتها وهواها، وحسن خُلقه معها واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها، وتوسعته عليها...»[3].
[1] سورة النساء، الآية 19.
[2] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص556.
[3] الشيخ ابن شعبة الحرّانيّ، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص323.
334
321
الموعظة التاسعة والأربعون: الظلم في الحياة الاجتماعيّة
والنهي عن استخدام القسوة مع المرأة، وجعل من حقّ الزوجة عدم ضربها والصياح في وجهها، ففي جوابه عن سؤال خولة بنت الأسود حول حقّ المرأة، قال: «حقّك عليه أن يطعمك ممّا يأكل، ويكسوك ممّا يلبس، ولا يلطم ولا يصيح في وجهك»[1].
2. ظلم الوالدين: ويكون بعقّهما بأيّ كيفيّة أو سلوك حتّى بالنظر إليهما بمقت، وقد حدّد القرآن صراحة كيفيّة التعامل معهما في الآيات 23- 24 من سورة الإسراء، حيث قال -تعالى-:
- ﴿وَبِٱلوَٰلِدَينِ إِحسَٰنًا﴾.
- ﴿وَقُل لَّهُمَا قَولٗا كَرِيمٗا﴾.
- ﴿وَٱخفِض لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحمَةِ﴾.
- ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفّٖ﴾.
- ﴿وَلَا تَنهَرهُمَا﴾.
- ﴿وَقُل رَّبِّ ٱرحَمهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا﴾[2].
3. ظلم الأرحام: ويكون بقطع الصلة معهم أو أكل حقوقهم بغير حقّ، خلافًا لما دعا إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأهل البيت (عليهم السلام). عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنّ الرحم معلّقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافىء، ولكنّ الواصل من الذي إذا انقطعت رحمه وصلها»[3].
[1] الشيخ الطبرسيّ، مكارم الأخلاق، ص218.
[2] سورة الإسراء، الآيتان 23 24
[3] أحمد بن حنبل، المسند (مسند أحمد)، ج2، ص164.
335
322
الموعظة التاسعة والأربعون: الظلم في الحياة الاجتماعيّة
وقال أبو ذرّ الغِفاريّ (رضي الله عنه): «أوصاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن أصل رحمي وإن أدبَرَت»[1].
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «صِلُوا أرحامكم وإن قطعوكم»[2].
الآثار الإيجابيّة لمراعاة حقوق المجتمع
تحدّثت الروايات الكثيرة عن ثواب مَن راعى حقوق أفراد المجتمع، منها:
1. الدفاع عن الأعراض: روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من ردّ عن عرض أخيه المسلم وجبت له الجنّة البتّة»[3].
2. الإيثار والكرم: وروي عن الإمام عليّ بن الحسين (عليه السلام): «من أطعم مؤمنًا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنًا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسا مؤمنًا كساه الله من الثياب الخضر»[4].
[1] الشيخ الصدوق، الخصال، ص345.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج74، ص92.
[3] الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال، ص145.
[4] المصدر نفسه، ص136.
336
323
الموعظة الخمسون: حبس الحقوق والنَفَقات
الموعظة الخمسون: حبس الحقوق والنَفَقات
بيان ضرورة أداء الحقّ إلى صاحبه، وعدم الاستخفاف به.
محاور الموعظة
حقوق الأولاد وواجباتهم
حبس الحقوق والنفقات عن الزوجة
حبس حقوق الأجير
تصدير الموعظة
الإمام عليّ (عليه السلام): «مَن يمطل على ذي حقّ حقّه، وهو يقدر على أداء حقّه، فعليه كلّ خطيئة عشار»[1].
[1] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص16.
337
324
الموعظة الخمسون: حبس الحقوق والنَفَقات
حينما يبلغ الإنسان سنّ التكليف، ويبدأ القلم بتسجيل الحسنات والسيّئات، وإحصاء كلّ شيء من قول وفعل، عليه أن يراقب تصرّفاته وأعماله من عبادات ومعاملات، وعليه أيضًا مراعاة الحقوق والواجبات تجاه الآخرين. وليعلم أنّه مَن قصّر في حقّ الله -تعالى- ثمّ تاب إليه توبة نصوحًا، لوجد الله توّابًا رحيمًا، أمّا من قصّر في حقوق البشر، فإنّه، لو تاب إلى الله، فلا يتوب عليه حتّى يرضى صاحب الحقّ، أو يسامح بحقّه. فما أكثر الذين يتعلّقون بالآخرين يوم القيامة يريدون أن ينتزعوا منهم حقوقهم التي سُلبت منهم في دار الدنيا! وعلى سبيل المثال: الديون الماليّة. فإنّنا نلاحظ أنّ المتشاكسين فيها أكثر من المتراضين، والذين يستخفّون بالوفاء بها أكثر من المبادرين لإيفاء الديون المترتّبة عليهم. وكم عدد الذين يموتون من دون أن يوصوا! فقد روى معاوية بن وهب: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنّه ذُكر لنا أنّ رجلًا من الأنصار مات وعليه ديناران دَيْنًا، فلم يصلِّ عليه النبيّ (صلى الله عليه وآله)، وقال: «صلّوا على صاحبكم»، حتّى ضمنها عنه بعض قرابته. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «ذلك الحقّ، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنّما فعل ذلك ليتّعظوا، وليردّ بعضهم على بعض، ولئلّا يستخفّوا بالدَين...»[1].
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من يمطل على ذي حقّ حقّه، وهو يقدر على أداء حقّه، فعليه كلّ يوم خطيئة عشار»[2].
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة،ج13، ص79.
[2] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص16.
338
325
الموعظة الخمسون: حبس الحقوق والنَفَقات
ومن أجل ما ذكر، كان تشدّد الشرع بما يتعلّق بحقوق الآخرين، وعدم التساهل. ولعلّ بعضهم يعتقد أنّ التساهل في حقوق بعض أقاربه كالزوجة والأولاد والوالدين لا يضرّه، فهي أدنى من حقوق الآخرين، لكنّ الحقّ هو الحقّ، سواء أكان قريبًا أم بعيدًا. وسنتناول حقوق وواجبات بعض الأفراد لبيان الحقّ فيها.
حقوق الأولاد وواجباتهم
كما أنّ الوالد يعتقد أنّ له واجبات وحقوقًا على ولده، فعليه أن يعلم أنّ لولَدِه عليه أمثالها. وإن كانت حقوق الوالدين أعظم، فعلى الوالد أن يقوم بخطوتين:
الأولى: التعرّف إلى حقوق وواجبات ولده عليه.
الثانية: أن يقوم بأدائها إليه.
أمّا بالنسبة إلى الخطوة الأولى، فيمكن أن نستخلص الحقوق جُلَّها من مجموعة الروايات الواردة في المقام، وهي:
1. أن يُحسن اسمه.
2. أن يُحسن أدبه.
3. أن يعلّمه الكتابة.
4. أن يعلّمه القرآن الكريم.
5. أن يعلّمه السباحة والرماية.
6. أن يضعه موضعًا حسنًا.
339
326
الموعظة الخمسون: حبس الحقوق والنَفَقات
7. أن يطعمه الطعام الحلال.
8. أن يزوّجه إذا بلغ.
فقد روي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) قوله: «حقّ الولد على والده أن يعلّمه الكتابة، والسباحة، والرماية، وألّا يرزقه إلّا طيبًا»[1].
وجاء في نهج البلاغة: «حقّ الولد على الوالد أن يُحسن اسمه، ويُحسن أدبه، ويعلّمه القرآن»[2].
وقد ورد عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن طريق العامّة قوله: «مَن بلغ ولده النّكاح، وعنده ما ينكحه، فلم ينكحه، ثمّ أحدث حدثًا، فالإثم عليه»[3].
وكما نلاحظ، فإنّ أكثر الحقوق المتوجّبة على الوالد تحتاج نفقات ماليّة، فلا يجوز للوالد أن يحبس عن ولده ما يستوجب من نفقات. وعليه أيضًا ألّا يستخفّ بحقّه ليحرص على ماله بحجّة عدم الضرورة، فأكثر الأولاد الذين قصّر في حقّهم آباءَهم غاضبون أو عاتبون. وهنا نقول كلمة واحدة: رحم الله والدًا أعان ولده على برّه. وكما قال الإمام الصادق (عليه السلام): «برّ الرجل بولده برّه بوالديه»[4].
حبس الحقوق والنفقات عن الزوجة
هنا لا بدّ من بيان حقوقها المتوجّبة على الزوج، لنعرف إذا كان ما حبسه عن زوجته هو من الحقوق ومن ضمن النفقات الواجبة أم
[1] المتّقيّ الهنديّ، كنز العمّال، ج16، ص443.
[2] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص546.
[3]
[4] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج104، ص93.
340
327
الموعظة الخمسون: حبس الحقوق والنَفَقات
لا. والحديث هنا خاصّ بالحقوق الماليّة فقط، وهي على النحو الآتي:
1. النفقة.
2. المهر.
تتضمّن النفقة المطعم والملبس والمسكن. فأمّا المطعم والملبس، فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله): «حقّ المرأة على زوجها أن يسدّ جوعتها، وأن يستر عورتها...»[1].
والجدير ذكره أنّ هذه النفقات لم تعد في الشرع أحكامًا فحسب، بل من الحقوق بالمعنى الخاصّ؛ بمعنى أنّ ما كان حكمًا، فلو تركه المكلّف فلا يجب قضاؤه -ومن هذا القبيل نفقات الوالدين والأولاد-، أمّا ما كان حقًّا، فلو تركه وجب قضاؤه وأداء ما عليه، ولا تبرأ الذمّة بمضيّ عامل الزمن. ومن هذا القبيل نفقات الزوجة.
أمّا المهر، فهو من أكثر الحقوق التي يستخفّ الرجال بأدائها لزوجاتهم، فإن أمسكها فلا يؤدّيها المعجّل، وإن أراد تسريحها فلا يطلّقها حتّى تتنازل عن حقّها المؤجّل -وهو أشبه بالإكراه-. وهنا يجب على الزوج أن يؤدّي الصداق إليها، إلّا ما طابت نفسها عنه وتركته له، فقد قال -تعالى-: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحلَةٗ فَإِن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٖ مِّنهُ نَفسٗا فَكُلُوهُ هَنِئٗا مَّرِئٗا﴾[2].
ومع عدم تنازلها عن حقّها أو عن شيء منه، فعليه أن يؤدّيه، ولا
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج103، ص254.
[2] سورة النساء، الآية 4.
341
328
الموعظة الخمسون: حبس الحقوق والنَفَقات
يحلّ له مهرها بِنَصّ القرآن، إذ يقول -سبحانه وتعالى-: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُم أَن تَأخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيتُمُوهُنَّ شَئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِن خِفتُم أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا ٱفتَدَت بِهِ تِلكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾[1]. وعن النبيّ (صلى الله عليه وآله): «إنّ الله غافر كلّ ذنب إلّا رجل اغتصب... أو مهر امرأة»[2].
حبس حقوق الأجير
لا يؤجّر الإنسانُ الآخرينَ نفسه إلّا نتيجة الحاجة التي يواجهها، وإلّا فلا يرضى الإنسان أن يسلّط الآخرين على نفسه أو عمله. من هنا، ينبغي على المستأجر أن يقدّر الأجير؛ بمعنى أن يعلم جيّدًا أنّ هذا الذي يريد أن يدفع إليه شيئًا من ماله قد سخّر قدرته وإمكاناته له، ووضع نفسه تحت تصرّفه، فعليه أن يُشعره بالمحافظة على عزّة نفسه، وأنّه أحرص عليها من المال البخس الذي سيدفعه إليه لقاء عمله.
أمّا بالنسبة إلى حقوقه، فعلى المستأجر أن يقوم بالإجراءات الآتية:
أوّلًا: أن يُعلِمه بالأجرة.
ثانيًا: أن يؤدّي الأجرة المتّفق عليها سابقًا، وإيّاه وظلم الأجير أجره.
ثالثًا: من الآداب أن يؤدّي الحقّ من قبل أن يجفّ عرقه.
ويدلّ على الأوّل ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيرًا حتّى يعلم ما أجره...»[3].
[1] سورة البقرة، الآية 229.
[2] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج2، ص508.
[3] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة،ج3، ص245.
342
329
الموعظة الخمسون: حبس الحقوق والنَفَقات
ويدلّ على الثاني ما ورد عن النبيّ (صلى الله عليه وآله): «مَن ظلم أجيرًا أجره أحبط الله عمله وحرّم عليه الجنّة، وإنّ ريحها لتوجد من مسيرة خمسمئة عام»[1].
وعن الأصبغ بن نباتة قال: كنت جالسًا عند أمير المؤمنين (عليه السلام) في مسجد الكوفة، فأتاه رجل من بجيلة يُكنّى أبا خديجة، قال: يا أمير المؤمنين أعندك سرّ من سرّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) تحدّثنا به؟ قال: «نعم. يا قنبر، إيتني بالكتابة... مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم أنّ لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على مَن انتمى إلى غير مواليه... ولعنة الله وملائكته والناس أجمعين على مَن ظلم أجيرًا أجره»[2].
ويدلّ على الثالث ما ورد عن شعيب: تَكارَيْنا لأبي عبد الله (عليه السلام) قومًا يعملون في بستان له، وكان أجلهم إلى العصر، فلمّا فرغوا قال لمعتّب: «أعطهم أجورهم قبل أن يجفّ عرقهم»[3].
خاتمة
قال الإمام الرضا (عليه السلام): «اعلم أنّه ما من أحد يعمل لك شيئًا بغير مقاطعة، ثمّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته، إلّا ظنّ أنّك قد نقصته أجرته. وإذا قاطعته، ثمّ أعطيته أجرته، حمدك على الوفاء، فإن زدته حبّة عرف ذلك، ورأى أنّك زدته»[4].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج103، ص166.
[2] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج2، ص508.
[3] المصدر نفسه، ج13، ص246.
[4] المصدر نفسه، ص245.
343
330
الموعظة الحادية والخمسون: الحياة الزوجيّة مودّة ورحمة
الموعظة الحادية والخمسون: الحياة الزوجيّة مودّة ورحمة
تعرّف أخلاقيّات الحياة الزوجيّة في الإسلام.
محاور الموعظة
أهمّيّة الزواج في الإسلام
التربية على الصبر في الإسلام
الصبر وسعة الصدر في الحياة الزوجيّة
أصالة علاقة المودّة والمحبّة
تصدير الموعظة
الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: تزوّجوا، فإنّي مكاثر بكم الأمم غـدًا في القيامـة، حتّى إنّ السقط ليجيء محبنطئًا على باب الجنـة، فيقال له: أدخل الجنّة، فيقول: لا، حتّى يدخل أبواي الجنّة قبلي»[1].
[1] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج20، ص14. وفيه (إنّ السقط يجيء محبنطيًا) بالياء.
344
331
الموعظة الحادية والخمسون: الحياة الزوجيّة مودّة ورحمة
أهمّيّة الزواج في الإسلام
يُفهم من الروايات الكثيرة التي تحثّ على الزواج في السُنّة المطهّرة حرصُ النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام) على إرساء قواعد نظام الزواج وأُسسه في الإسلام. وبالإمكان تصنيف هذه الروايات إلى طوائف:
الأولى: الزواج سُنّة النبيّ (صلى الله عليه وآله)
عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «تزوّجوا، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كثيرًا ما كان يقول: مَن كان يحبّ أن يتّبع سنّتي فليتزوّج، فإنّ من سنّتي التزويج، واطلبوا الولد، فإنّي أكاثر بكم الأمم غدًا»[1].
الثانية: كمال العبادة في الزواج
روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قولـه: «مَن تزوّج، أحرز نصف دينه»، وفي خبر آخر: «فليتّقِ الله في النصف الآخر أو الباقي»[2]. وعن الإمام الباقر (عليه السلام): «ركعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيهما أعزب»[3].
الثالثة: الزواج يجلب الرزق
روي عن الرسول (صلى الله عليه وآله) قوله: «مَن تَرَك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنّه بالله -عزّ وجلّ-؛ إنّ الله -عـزّ وجلّ- يقول: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضلِهِ﴾[4]»[5].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج100، ص218.
[2] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص38317.
[3] المصدر نفسه، ج3، ص384.
[4] سورة النور، الآية 32.
[5] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص331.
345
332
الموعظة الخمسون: حبس الحقوق والنَفَقات
وعن أبي عبد الله (عليه السلام): «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اتّخذوا الأهل، فإنّه أرزق لكم»[1].
التربية على الصبر في الإسلام
يمثّل الصبر والحِلم الدرع المثاليّة لصدّ مشاكل الأُسرة والحياة الزوجيّة ومعالجتها، فإذا جزع الزوجان عند أوّل مشكلة تطرأ، فسيكون الخلاف الأُسريّ أمرًا لا مفرّ منه. والصبر -بوصفه سمة نفسانيّة- يستطيع أن يردع الأزمات، وقد عدّته النصوص الإسلاميّة جزءًا لا يتجزّأ من الإيمان؛ «فإنّ الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد»[2]. وإنّ الفرد الذي لا يتمتّع برباطة الجأش ليس إلّا عبئًا على الآخرين، فضلًا عن أنّه يُعلّق علامة استفهام كبيرة على صدق إيمانه؛ «فإنّه لا دين لمن لا صبر له»[3]. وفي ما يتعلّق بمسائل الأُسرة، قد يتطلّب تحقيق الأهداف المنشودة وقتًا طويلًا، فإذا لم يتحلَّ الأعضاء بالصبر اللازم، وأظهروا -بالمقابل- تسرُّعًا واستعجالًا، فسيقعون في الارتباك والتخبُّط، وبالتالي، سيزيدون من صعوبة الموقف، وهذا يكون حائلًا كبيرًا أمام ما يرومونه[4]. فيما لو تحلّوا بالصبر، سيبلغون مقاصدهم عاجلًا أو آجلًا؛ ورد عن الإمام عليّ (عليه السلام) قوله: «لا يُعدم الصبور
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص329.
[2] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص482.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج48، ص92.
[4] «من صبر خفّت محنته، وهانت مصيبته» و«إذا صبرت للمحنة، فللتَ حدّها»: مصطفي درايتي، معجم ألفاظ غرر الحكم، ص577، «فاصبر مغمومًا أو مُتْ متأسّفًا»: نهج البلاغة، الخطبة 217 و«إنّ للنكبات غايات لا بدّ من أن ينتهي إليها... فإنّ إعمال الحيلة فيها عند إقبالها زائد في مكروهها» العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج71، ص95.
346
333
الموعظة الحادية والخمسون: الحياة الزوجيّة مودّة ورحمة
المرأة تجاهه؛ جاء في وصية الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) إلى محمّد بن الحنفيّة: «إنَّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فدارِها على كلِّ حال، وأحسن الصحبة لها، فيصفو عيشك».
2. الإكرام والرحمة
من أدنى حقوق الزوجة على زوجها إكرامها، والرفق بها، وإحاطتها بالرحمة، والمؤانسة؛ عن الإمام عليّ بن الحسين (عليه السلام): «وأمّا حقُّ رعيّتك بملك النكاح، فأن تعلم أنّ الله جعلها سكنًا ومستراحًا وأُنسًا وواقية، وكذلك كلّ واحد منكما يجب أن يحمد الله على صاحبه، ويعلم أنّ ذلك نعمة منه عليه، ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بها، وإن كان حقّك عليها أغلظ، وطاعتك بها ألزم في ما أحبّت وكرهت ما لم تكن معصية، فإنّ لها حقّ الرحمة، والمؤانسة، وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لا بدّ من قضائها»[1].
3. عدم استخدام القسوة
نهى الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) عن استخدام القسوة مع المرأة، وجعل من حقّ الزوجة عدم ضربها والصياح في وجهها، ففي جوابه عن سؤال خولة بنت الأسود عن حقّ المرأة، قال: «حقّكِ عليه أن يُطعمك ممّا يأكل، ويكسوك ممّا يلبس، ولا يلطم، ولا يصيح في وجهك»[2]. وقال (صلى الله عليه وآله): «خير الرجال من أُمّتي الذين لا يتطاولون على أهليهم، ويحنّون عليهم، ولا يظلمونهم»[3].
[2] الشيخ الطبرسيّ، مكارم الأخلاق، ص188.
[3] المصدر نفسه، ص218.
[4] المصدر نفسه، ص216 - 217.
348
334
الموعظة الحادية والخمسون: الحياة الزوجيّة مودّة ورحمة
4. عدم الضرب
ورد عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ألا أخبركم بشرّ رجالكم؟ فقلنا: بلى، فقال: إنّ مـن شرّ رجالكم البهّات، البخيل، الفاحش، الآكل وحده، المانع رفده، الضـارب أهـله...»[1]. وعن شهاب بن عبد ربّه: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال: «يسدّ جوعتها، ويستر عورتها، ولا يُقبّح لها وجهًا، فإذا فعل ذلك فقد -والله- أدّى حقّها»[2].
5. إطاعة الزوجة لزوجها
تجب طاعةُ الزوجِ في غير معصية؛ روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنّ من القِسم المصلح للمرء المسلم أن يكون له المرأة، إذا نَظَرَ إليها سَرَّتْهُ، وإذا غابَ عنها حَفِظَتْهُ، وإذا أَمَرَها أَطاعَتْهُ»[3].
6. مراعاة إمكانيّات الشريك
على الزوجة أن تراعي إمكانيّات الزوج في النفقة وغيرها، فلا تكلّف الزوج ما لا يطيقه من أمر النفقة، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «أيّما امرأة أدخلت على زوجها في أمر النفقة، وكلّفته ما لا يطيق، لا يقبل الله منها صرفًا ولا عدلًا، إلّا أن تتوب وترجع وتطلب منه طاقته»[4].
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج20، ص34.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص511.
[3] المصدر نفسه، ج5، ص327.
[4] الطبرسيّ، مكارم الأخلاق، ص202.
349
335
الموعظة الحادية والخمسون: الحياة الزوجيّة مودّة ورحمة
ونِعمَ الواعظ في ذلك ما ورد في سيرة الزهراء (عليها السلام)، سيّدة نساء العالمين، ففي الخبر عن أبي سعيد الخدريّ، قال: أصبح عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ذات يوم ساغبًا، فقال: «يا فاطمة، هل عندك شيء تغذّينيه؟ قالت: لا والذي أكرم أبي بالنبوّة وأكرمك بالوصيّة، ما أصبح الغداة عندي شيء، وما كان شيء أَطعمنا مذ يومين، إلّا شيء كنت أؤثرك به على نفسي وعلى ابنيَّ هذين الحسن والحسين، فقال علي (عليه السلام): فاطمة، ألا كنتِ أعلمتني فأبغيكم شيئًا؟ فقالت: يا أبا الحسن، إنّي لأستحيي من إلهي أن أكلّفك ما لا تقدر عليه»[1].
7. الصبر على أذى الزوج وغيرته
ينبغي للزوجة أن تصبر على أذى الزوج، فلا تقابل الأذى بالأذى والإساءة بالإساءة؛ قال الإمام الباقر (عليه السلام): «وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته»[2].
8. لا تغضب زوجها
روي عن الرسـول (صلى الله عليه وآله) قوله: «ويـل لامرأة أغضبت زوجها، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها»[3]. وعن أبي عبد الله (عليه السلام): «ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط...»[4] ؛ فمن حقّ الزوج على زوجته أن تتجنّب كلّ ما يؤدّي إلى سخطه وإثارته وغضبه، وينكّد عيشته واستقراره.
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج43، ص59.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص9.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج100، ص146.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص507.
350
336
الموعظة الحادية والخمسون: الحياة الزوجيّة مودّة ورحمة
أصالة علاقة المودّة والمحبّة
ينبغي أن تسود الحياةَ الزوجيّة روحُ المودّة والمحبَّة والصفاء؛ لأنَّ الحياةَ الخالية من الحبّ لا معنى لها. والمودَّة في نظر القرآن هي الحبّ الفعّال، لا ذلك الحبّ الذي يطفو على السطح كالزَبَد. فالحبّ المنشود هو الحبّ الذي يضرب بجذوره في الأعماق، والذي يظهر من القلب إلى الحياة بواسطة الأعمال. وإنّ الإسلام يُوجب أن نبرز عواطفنا تجاه من نُحبّهم، وهو أمرّ تتجلّى ضرورته في الحياة الزوجيّة؛ فالمرأة -كما يؤكِّد الحديث الشريف- لا تنسى كلمة الحبّ التي ينطقها زوجها أبدًا؛ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «قول الرجل للمرأة: إنّي أحبّك لا يذهب من قلبها أبدًا»[1].
يقول السيّد الطباطبائيّ (قدس سره) في تفسيره الميزان في تفسير قوله -تعالى- ﴿وَجَعَلَ بَينَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحمَةً﴾[2]: «المودّة، كأنّها الحبّ الظاهر أثره في مقام العمل، فنسبة المودّة إلى الحبّ، كنسبة الخضوع الظاهر أثره في مقام العمل إلى الخشوع -الذي هو نوع تأثُّرٍ نفسانيٍّ عن العظمة والكبرياء- (...) ومن أَجَلِّ موارد المودّة والرحمة: المجتمع المنزليّ؛ فإنّ الزوجين يتلازمان بالمودّة والمحبّة...»[3].
ومن آثار علاقة المودّة والرحمة هدوء الأعصاب وسكن النفس وطمأنينة الروح وراحة الجسد، فهي رابطة تؤدّي إلى تماسك الأُسرة،
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج 5، ص569.
[2] سورة الروم، الآية 21.
[3] العلّامة الطبطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج16، ص166.
351
337
الموعظة الثانية والخمسون: اقتصاد الأُسرة وتدبير شؤونها
وتقوية بنائها، واستمرار كيانها الموّحد. والمودّة والرحمة تؤدّيان إلى الاحترام المتبادل والتعاون الواقعيّ في حلّ المشاكل الطارئة جميعها على الأُسرة. وهما ضروريّتان للتوازن الانفعاليّ عند الطفل، فإنّ «اطمئنان الطفل الشخصيّ والأساسيّ يحتاج دائمًا إلى تماسك العلاقة بين الوالدين، ويحتاج إلى انسجام الاثنين في مواجهة مسؤوليّات الحياة»[1].
[1] الدكتور سپوق، مشاكل الآباء في تربية الأبناء، المؤسّسة العربيّة للدراسة والنشر، لا.م، 1980هـ، ط3، ص44.
352
338
الموعظة الثانية والخمسون: اقتصاد الأُسرة وتدبير شؤونها
الموعظة الثانية والخمسون: اقتصاد الأُسرة وتدبير شؤونها
بيان أهمّيّة تدبير شؤون الأُسرة مِن الناحية الاقتصاديّة.
محاور الموعظة
الإنفاق واقتصاد الأُسرة
تدبير شؤون الأُسرة ونظمها
التربية على استثمار الموارد
اجتناب الإسراف والتبذير
تصدير الموعظة
الإمام الصادق (عليه السلام) -في موعظةٍ للقمان الحكيم-: «اعْلَم أَنَّكَ سَتُسأَلُ غَدًا إذا وَقَفتَ بَينَ يَدَي اللهِ -عزّ وجلّ- عَن أربع: شبابِكَ في ما أَبلَيتَهُ، وَعُمرِكَ في ما أَفنيتَهُ، وَمالِكَ مِمّا اكتَسبتَهُ، وَفي ما أَنفَقتَهُ، فَتَأَهَّبْ لِذلِكَ، وَأَعِدَّ لَهُ جَوابًا»[1].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص135.
353
339
الموعظة الثانية والخمسون: اقتصاد الأُسرة وتدبير شؤونها
الإنفاق واقتصاد الأُسرة
قال الله -تعالى-: ﴿يَسَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل مَا أَنفَقتُم مِّن خَيرٖ فَلِلوَٰلِدَينِ وَٱلأَقرَبِينَ وَٱليَتَٰمَىٰ وَٱلمَسَٰكِينِ وَٱبنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفعَلُواْ مِن خَيرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ﴾[1].
وعدَّ القرآنُ الإمساكَ وعدمَ الإنفاق سبيلًا إلى التهلكة، فقال -تعالى-: ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى ٱلتَّهلُكَةِ وَأَحسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلمُحسِنِينَ﴾[2]. كما عدَّ الكنـزَ وحجبَ المال عن وظيفته الاجتماعيّة مدعاةً للعذاب الأليم، فوَرَد: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ﴾[3]. وقد نفى الرسولُ (صلى الله عليه وآله) كمالَ الإيمان عمَّنْ يبيت شبعانَ وجاره جائع وهو يعلم، بِقوله: «ما آمن بي مَن باتَ شبعانَ وجارُه جائع وهو يعلم»[4].
تدبير شؤون الأُسرة ونظمها
لا يختلف اثنان في أنّ تدبير شؤون الأُسرة يُعدّ من الأمور الرئيسة لكلّ إنسانٍ. ولرسول الله (صلى الله عليه وآله) كلامٌ رائعٌ في هذا المجال، عندما خاطب ابن مسعود قائلًا: «يابن مسعود، إذا عملتَ عمَلًا فاعملْ بعلمٍ وعقلٍ، وإيّاكَ أنْ تعملَ عملًا بغيرِ تدبّرٍ وعلمٍ، فإنّه -جلَّ جلالهُ- يقولُ: وَلا تَكونوا كَالتي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثًا»[5].
[1] سورة البقرة، الآية 215.
[2] سورة البقرة، الآية 195.
[3] سورة التوبة، الآية 34.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص668.
[5] الشيخ الطبرسيّ، مكارم الأخلاق، ص458.
354
340
الموعظة الثانية والخمسون: اقتصاد الأُسرة وتدبير شؤونها
وقد أكّد الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) هذه الحقيقة بقوله: «لا يَصلُحُ المؤمنُ إلّا على ثَلاثِ خِصالٍ: التفقُّهِ في الدينِ، وحُسنِ التقديرِ في المعيشةِ، والصبرِ على النائبَةِ»[1].
ورُوي عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «كانَ أميرُ المؤمنينَ (عليه السلام) يَحتطِبُ ويَستقي ويَكنِسُ، وكانتْ فاطمةُ (عليها السلام) تَطحَنُ وتَعجِنُ وتَخبزُ»[2].
وعن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام): «اجْتَهِدوا في أَنْ يَكونَ زَمانُكُمْ أَرْبَعَ ساعاتٍ: ساعَةً لِمُناجاةِ اللهِ، وساعَةً لأَمْرِ المَعاشِ، وساعَةً لِمُعاشَرَةِ الإِخْوانِ والثقاتِ الذينَ يُعَرِّفونَكُمْ عُيوبَكُمْ ويُخْلِصونَ لَكُمْ في الباطِنِ، وسَاعَةً تَخْلونَ فيها لِلَذّاتِكُمْ في غَيْرِ مُحَرَّمٍ، وبِهذِهِ الساعَة تَقْدِرونَ عَلى الثلاثِ ساعاتٍ. لا تُحَدِّثوا أَنْفُسَكُمْ بِفَقرٍ، ولا بِطولِ عُمُرٍ، فَإِنَّهُ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالفَقرِ بَخِلَ، ومَنْ حَدَّثَها بِطولِ العُمُرِ يَحْرِصُ. اجْعَلوا لأَنفُسِكُمْ حَظًّا مِن الدنْيا بِإِعْطائِها ما تَشْتَهي مِن الحلالِ، وما لا يَثْلِمُ المُرُوَّةَ، وما لا سَرَفَ فِيهِ، واسْتَعِينوا بذلِكَ عَلى أُمورِ الدينِ، فَإِنَّهُ رُوِيَ: لَيْسَ مِنّا مَنْ تَرَكَ دُنْياهُ لِدينهِ، أَو تَرَكَ دينَهُ لِدُنْياهُ»[3].
العمل والمثابرة رأس مال اقتصاد الأُسرة
كان دَيدَنُ أنبياء الله -تعالى- وأوليائه الصالحين (عليهم السلام) هذا النهج، وقد أشار الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) إلى هذه الحقيقة. فعن الحسن
[1] الشيخ ابن شعبة الحرّانيّ، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص358.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص86.
[3] الشيخ ابن شعبة الحرّانيّ، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص410.
355
341
الموعظة الثانية والخمسون: اقتصاد الأُسرة وتدبير شؤونها
بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، قال: رأيتُ أبا الحسن (عليه السلام) يعمل في أرضٍ له، وقد استنقعت قدماه في العرَق، فقلت: جُعلت فداك، أين الرجال؟ فقال (عليه السلام): «يا عَليّ، قَد عَملَ بِاليدِ مَن هُو خيرٌ مِنّي في أرضِهِ، ومِن أبي». فقلت: ومن هو؟ فقال: «رَسولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) وأَميرُ المؤمِنينَ (عليه السلام) وآبائي كُلُّهُم كانوا قَد عَملوا بأَيديهِم، وهُو مِن عَملِ النبييِّنَ والمُرسَلينَ والأوصياءِ والصالحينَ»[1].
ورُوي عن زرارة أنّ رجلًا أتى الإمام الصادق (عليه السلام)، فقال له: إنّي لا أُحسن أن أعمل عملًا بيدي، ولا أُحسن أن أتّجر، وأنا محارفٌ[2] محتاجٌ. فقال له الإمام (عليه السلام): «اعْمَلْ، فَاحمِلْ على رَأسِكَ، واسْتغنِ عَن الناسِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ (صلى الله عليه وآله) قَد حَمَلَ حَجَرًا عَلى عُنُقِهِ، فَوَضَعَهُ في حائطٍ مِن حيطانِهِ، وإنَّ الحجَرَ لَفِي مَكانِهِ، ولا يُدرى كَمْ عُمقُهُ»[3].
التربية على استثمار الموارد
صرّح القرآن الكريم بمشروعيّة جمع الثروة، وأهمّيّة تأمين المصادر الاقتصاديّة واستثمارها في مجال الإنتاج، وأشار إلى أنّ الله -تعالى- خلق الإنسان من الأرض، وسخّرها له، وأوكل إليه إعمارها، إذ قال: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلأَرضِ وَٱستَعمَرَكُم فِيهَا﴾[4]. وعمران الأرض لا يتمّ إلّا عن طريق الاستثمار.
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص75 - 76.
[2] المحارف: المحروم، يطلب فلا يُرزق، وهو خلاف المبارك.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص67 - 77.
[4] سورة هود، الآية 61.
356
342
الموعظة الثانية والخمسون: اقتصاد الأُسرة وتدبير شؤونها
وروى محمّد بن عذافر، عن أبيه: أعطى أبو عبد الله (عليه السلام) أبي ألفًا وسبعمئة دينارٍ، فقال له: «اتَّجِر لي بِها». ثمّ قال (عليه السلام): «أَما إنّهُ لَيسَ لي رَغبَةٌ في رِبحِها، وإنْ كانَ الربحُ مَرغوبًا فيهِ، ولكِنّني أحبَبتُ أن يَراني اللهُ -عزّ وجلّ- مُتعرِّضًا لفَوائدِهِ». قال: فربحت له فيها مئة دينارٍ، ثمّ لقيته، فقلت له: قد ربحتُ لك فيها مئة دينارٍ، ففرح أبو عبد الله (عليه السلام) بذلك فرحًا شديدًا، وقال لي: «أَثبِتْها في رَأسِ مالي»[1].
وقد أوصى الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) أحد أصحابه أن يشتري مزرعةً أو بستانًا، لأنّ الذي يمتلك رصيدًا مادّيًّا يؤمّن به حاجاته وحاجات عياله لن يعاني كثيرًا، وسيرتاح باله لو تعرّض إلى نائبةٍ أو حادثةٍ. فقد روى محمّد بن مرازم، عن أبيه: إنّ أبا عبد الله (عليه السلام) قال لمصادف مولاه: «اتّخِذْ عقدةً أو ضَيعةً، فإنّ الرجلَ إذا نزَلت بهِ النازِلةُ أو المصيبةُ، فذَكرَ أنّ وَراءَ ظهرِهِ ما يقيمُ عيالَهُ، كانَ أسخى لنفسِهِ»[2].
وأوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناس باستثمار أموالهم، وعدَّ ذلك من المروءة، إذ قال: «مِن المروءَةِ استصلاحُ المالِ»[3].
وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله: «إنَّما أعطاكُمْ اللهُ هذهِ الفُضولَ مِن الأموالِ، لتُوجِّهوها حيثُ وَجّهَها اللهُ، ولَم يُعطِكُموها لتكنِزوها»[4].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص76.
[2] المصدر نفسه، ج5، ص92.
[3] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص166.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج4، ص32.
357
343
الموعظة الثانية والخمسون: اقتصاد الأُسرة وتدبير شؤونها
الدخل والكسب الحلال
بما أنّ الدخل من مواضيع الأحكام الإسلاميّة، فمن الضروريّ للمسلم أن يعلم مصدر تحصيل دَخله، وكيف يحصل عليه، وأين ينفقه؛ عن الإمام عليّ (عليه السلام): «إنَّ مَعايشَ الخلقِ خمسَةٌ: الإمارَةُ والعمارةُ والتجارَةُ والإجارَةُ والصدَقاتُ»[1].
وروي عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام): «وأمّا وُجوهُ الحرامِ مِن البيعِ والشراءِ، فكُلُّ أمرٍ يكونُ فيه الفسادُ مِمّا هو مَنهيٌّ عَنهُ، مِن جِهةِ أكلِهِ وشُربِهِ أو كسبِهِ أو نِكاحِهِ أو مُلكِهِ أو إمساكِهِ أو هِبَتِهِ أو عاريَتِهِ، أو شَيء يَكونُ فيهِ وَجهٌ من وُجوهِ الفَسادِ».[2]
وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الروايات أطلقت على اقتناء المال الحرام عنوان (أكل السُحت)، وعَدَّته من كبائر الذنوب، إذ نهت عنه نهيًا شديدًا؛ لذا يجب القول إنّ المراد من أكل السُحت لا يعني -بالضرورة- الأكل والشرب، بل يعني مطلق التصرّفات بالأموال المحرّمة، وعدم إرجاعها إلى أهلها. وثمّة روايات مستفيضة حثّت الناس على ضرورة السعي في كسب لقمة العيش بطُرُقٍ مشروعةٍ، منها ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «العِبادَةُ سَبعونَ جُزءًا، أفضلُها طَلَبُ الحلالِ»[3]. وعنه (صلى الله عليه وآله) أيضًا: «مَن باتَ كالًّا مِن طَلَبِ الحلالِ، باتَ
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج19، ص35.
[2] السيّد عبد الحسين دستغيب، كبائر الذنوب، ج1، ص384 - 385.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص78.
358
344
الموعظة الثانية والخمسون: اقتصاد الأُسرة وتدبير شؤونها
مَغفُورًا لَهُ»[1]. وعن الإمام الصادق (عليه السلام): «فبَكِّروا في طَلبِ الرزقِ، واطلُبوا الحلالَ، فإنَّ اللهَ سيرزُقُكُم ويُعينُكُم عَليهِ»[2].
وللإمام الرضا (عليه السلام) كلامٌ طويلٌ ذكر فيه ما حرّم الله -تعالى-، منه: «... واجتنابُ الكبائرِ، وهي قَتلُ النَفسِ التي حرَّمَ اللهُ -تعالى-... وأكلُ الرِبا بَعدَ البيّنَةِ... والبَخسُ في المكيالِ والميزانِ... والإسرافُ، والتبذيرُ، والخيانَةُ»[3].
اجتناب الإسراف والتبذير
1. وجوب اجتناب الإسراف: «السرف هو تجاوز الحدّ في كلّ فعلٍ يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر»[4]. ونستلهم من آيات القرآن الكريم أنّ الإسراف يقابل التقتير، إذ قال -تعالى-: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَم يُسرِفُواْ وَلَم يَقتُرُواْ وَكَانَ بَينَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا﴾[5]. وقد عدّ الله الإسراف من السُنَن الفرعونيّة: ﴿وَإِنَّ فِرعَونَ لَعَالٖ فِي ٱلأَرضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلمُسرِفِينَ﴾[6]، وتوعّد المسرفين بعذابٍ أليمٍ: ﴿وَأَنَّ ٱلمُسرِفِينَ هُم أَصحَٰبُ ٱلنَّارِ﴾[7]. ويُعَدّ الإسراف في استهلاك الموارد الطبيعيّة تعدّيًا على حقوق الآخرين، وإهدارًا للثروة العامّة التي هي حقٌّ للبشر جميعهم وللأجيال كافّة. وبِحسب
[1] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص289.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص78 - 79.
[3] الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج2، ص134.
[4] الراغب الأصفهانيّ، المفردات في غريب القرآن، مادّة «سرف».
[5] سورة الفرقان، الآية 67.
[6] سورة يونس، الآية 83.
[7] سورة غافر، الآية 43.
359
345
الموعظة الثانية والخمسون: اقتصاد الأُسرة وتدبير شؤونها
الرؤية الإسلاميّة، فإنّ نتيجة الإسراف والإنفاق المفرط ليست سوى إهدار الثروة العامّة، وبالتالي، حرمان الشعب منها؛ قال الإمام عليّ (عليه السلام) في هذا الصدد: «السرفُ مَثواةٌ»[1]، لأنّ الإسراف خروج عن مستوى التوازن؛ أي عن حكم العقل، والإذعان لأهواء النفس، فهو -بذلك- إهدارٌ للنعمة التي أكرم الله -تعالى- بها عباده لتأمين معاشهم. ونتيجة هذا الإهدار البُعدُ عن رحمة الله -تعالى- ورضوانه[2].
2. وجوب اجتناب التبذير: التبذير: التفريق، وأصله إلقاء البذر وطرحه، فاستعير لكلِّ مُضيِّعٍ لماله، فتبذير البذر: تضييعٌ في الظاهر لمن لم يعرف مآل ما يلقيه[3]. والقرآن الكريم -بِدوره- عَدَّ المبذّرين إخوانَ الشياطين، فقال -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيطَٰنُ لِرَبِّهِ كَفُورٗا﴾[4]؛ وَكَون المبذّرين إخوان الشياطين، فلأنّهم كفروا بنعم الله، إذ وضعوها في غير مواضعها، تمامًا كما فعل الشيطان مع نِعم الله -تعالى-. ثمّ إنّ استخدام (إخوان) يعني أنّ أعمالهم متطابقةٌ ومتناسقةٌ مع أعمال الشيطان، كالأخَوين اللذَين تكون أعمالهما متشابهةً[5].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج68، ص347.
[2] مير معزيّ، نظام الإسلام الاقتصاديّ -نظام اقتصادى إسلام-، ج2، ص102.
[3] الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مادة «بذر».
[4] سورة الإسراء، الآية 27.
[5] ناصر مكارم الشيرازيّ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج8، ص453.
360
346
الموعظة الثانية والخمسون: اقتصاد الأُسرة وتدبير شؤونها
وقد أنّب القرآن الكريم المسرفين والمبذّرين تأنيبًا شديدًا، وذمّ تصرّفاتهم في موارد كثيرة، إذ أكّد أنّهم سيُحرَمون من محبّة الله -تعالى-: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَومَ حَصَادِهِ وَلَا تُسرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلمُسرِفِينَ﴾[1]. وقال -تعالى- في الصدد نفسه: ﴿يَٰبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشرَبُواْ وَلَا تُسرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلمُسرِفِينَ﴾[2].
[1] سورة الأنعام، الآية 141.
[2] سورة الأعراف، الآية 31.
361
347
الموعظة الثالثة والخمسون: ترشيد الاستهلاك
الموعظة الثالثة والخمسون: ترشيد الاستهلاك
الحثّ على ضبط الإنفاق وبيان فوائده ومفاسد التبذير والهدر على المستوى الفرديّ والعامّ.
محاور الموعظة
ذمّ السرف
موقف الشريعة من الإسراف وعدم الترشيد
مجالات ترشيد الاستهلاك
تصدير الموعظة
﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَم يُسرِفُواْ وَلَم يَقتُرُواْ وَكَانَ بَينَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا﴾[1].
تلا الإمام الصادق (عليه السلام) هذه الآية فأخذ قبضةً من حصى وقبضها بيده، فقال: «هذا الإقتار الذي ذكره الله -عزّ وجلّ- في كتابه، ثمّ قبض قبضةً أخرى فأرخى كفّه كلّها، ثمّ قال: هذا الإسراف، ثمّ أخذ قبضةً أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها، وقال: هذا القوام»[2].
[1] سورة الفرقان، الآية 67.
[2] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج21، ص560.
362
348
الموعظة الثانية والخمسون: اقتصاد الأُسرة وتدبير شؤونها
ذمّ السرف
ترشيد الإنفاق من الأمور التي تحتاج إلى توعية دائمة للفرد والأسرة والمتصدّين للشأن العامّ لما يشكّل من ركيزة مهمّة على مستوى استقرار المجتمع واكتفائه واستغنائه عن الآخرين من خلال دراسة الأولويّات والحاجات الضروريّة، فقد ورد عن عبد الله بن عمر: «مرّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسعد وهو يتوضّأ، فقال: «لا تسرف، ما هذا السرف يا سعد»، قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: «نعم، وإن كنت على نهرٍ جار»[1]. ليؤكّد أنّ مسألة الإنفاق ليست مرتبطة بالوفرة وعدمها، بل بروحيّة التدبير وعدم السرف.
واعتبرت الشريعة الإسراف صفةً للطغاة والجبابرة كما هو الحال الذي نراه عند الحكّام والأمراء والملوك في العالم، قال -تعالى-: ﴿وَإِنَّ فِرعَونَ لَعَالٖ فِي ٱلأَرضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلمُسرِفِينَ﴾[2].
موقف الشريعة من الإسراف وعدم الترشيد
حثّت الشريعة على ضرورة ضبط الإنفاق وترشيده حفظًا لمقدّرات الأمّة من الضياع وصونًا للمجتمع من الفقر والعوز، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إيّاكم والسرف في المال والنفقة، وعليكم بالاقتصاد، فما افتقر قوم قطّ اقتصدوا»[3].
[1] المحقّق النراقيّ، عوائد الأيام، ص619.
[2] سورة يونس، الآية 83.
[3] المتّقي الهنديّ، كنز العمّال، ج3، ص53.
363
349
الموعظة الثالثة والخمسون: ترشيد الاستهلاك
وحاجات الأثاث والمقتنيات الضروريّة للمنزل، فعن الإمام الصادق (عليه السلام): «للمسرف ثلاث علامات: يشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له، ويأكل ما ليس له»[1].
ووضع سياسة تتوازن بين الراتب وموارد الصرف وفي الانتباه للمسائل الصحّيّة والعلميّة، فقد ورد عن الإمام عليّ (عليه السلام): «حسن التدبير مع الكفاف أكفى لك من الكثير مع الإسراف»[2].
وعنه (عليه السلام): «حسن التدبير ينمّي قليل المال، وسوء التدبير يفني كثير»[3].
3. ترشيد الإنفاق على مستوى المجتمع
ويتجلّى في عدم التفريط بالمال العامّ لأمور شخصيّة، وصرف هذا المال في الموارد التي هي حاجة الناس الضروريّة والابتعاد عن مظاهر الترف عند المسؤولين، كما يتطلّب من الفرد التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وكافّة مقدّرات البلاد.
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ القصد أمر يحبّه الله -عزّ وجلّ-، وإنّ السرف يبغضه الله حتّى طرحك للنواة فإنّها تصلح لشيء، وحتّى صبّك شرابك».
[1] الشيخ الصدوق، الخصال، ص121.
[2] الشيخ عليّ الشهروديّ، مستدرك سفينة البحار، ج3، ص255.
[3] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ج20، ص228.
365
350
الموعظة الثالثة والخمسون: ترشيد الاستهلاك
إنّ من أبرز آثار عدم ترشيد الإنفاق ونتائجه ما نراه اليوم من تفاوت كبير بين طبقات المجتمع، ففي حين ترى فئات من الناس تنعم بوسائل الراحة كافّة، ترى هناك الكثيرين ممّن يرزحون تحت خطّ الفقر ويتوسّلون أبسط مقدّرات الحياة.
وهذا الموضوع يقودنا إلى الحوراء زينب (عليها السلام) أثناء مسيرة السبي وكيف كانت توزّع الطعام والماء على الأطفال والنساء بالمقدار الذي يكفيهم لتجاوز محنتهم.
366
351
الموعظة الرابعة والخمسون: ثقافة القناعة
الموعظة الرابعة والخمسون: ثقافة القناعة
بيان أهمّيّة نموّ ملكة القناعة في النفس لبلوغ درجة الغنى.
محاور الموعظة
القناعة تُغني
الحياة الطيّبة
كيف نربّي أنفسنا على القناعة؟
القناعة باليسير تغنيه عن الكثير
ثمرة القناعة وآثارها
تصدير الموضوع
أمير المؤمنين (عليه السلام): «طلبت الغنى فما وجدته إلّا بالقناعة، عليكم بالقناعة تستغنوا»[1].
الإمام الرضا (عليه السلام): «لا يسلك طريق القناعة إلّا رجلان: إمّا متعبّد يريد أجر الآخرة أو كريم متنزّه عن لئام الناس»[2].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج69، ص399.
[2] المصدر نفسه، ج78، ص349.
367
352
الموعظة الرابعة والخمسون: ثقافة القناعة
القناعة تُغني
الفَقْرُ والفُقْر ضدّ الغنى، مثل: الضعف والضُعف. وعن الليث: الفُقْر لغة رديئة، وعن ابن سيده: وقدْرُ ذلك أن يكون له ما يكفي عياله، وعن ابن السكّيت: الفقير الذي له بُلْغة من العيش، وقال ابن عرفة: الفقير عند العرب المحتاج، قال الله -تعالى-: ﴿أَنتُمُ ٱلفُقَرَاءُ إِلَى ٱللَّهِ﴾[1] أي المحتاجون.
والغنى ضدّ الفقر، هذا لغويًّا، وأمّا شرعًا، فالفقير هو الذي لا يملك قوت سنته، وأمّا الغني فهو ما زاد عنده عن قوت سنته.
وإنّما تحدّثنا عن الفقر والغنى باعتبار أنّهما نتيجتان طبيعيّتان للقناعة، وهنا فإنّ كلّ من رضي بما قسم الله له من الرزق فهو قنوع ويكتفي به من دون أن يلتفت إلى ما في أيدي الناس فضلًا عن أن يمدّ يده إليهم؛ فإنّ هذا وأمثاله وإن كان فقيرًا بالمعنى الشرعيّ، أي لا يمتلك قوت سنته إلّا أنّه غنيّ بالمعنى الأخلاقيّ أي يحافظ على عزّة نفسه ولا يستذلّها بالانقياد إلى الآخرين. ومقابل ذلك، فقد نجد أنّ كثيرًا من أصحاب الثروات الطائلة فإنّهم لا يقفون عند حدّ لإشباع غريزة حبّ المال عندهم، وهم أحرص الناس على جمعه، فهؤلاء وإن كانوا أغنياء بالمصطلح الشرعيّ إلّا أنّهم فقراء أخلاقيًّا؛ لأنّ الواحد منهم نفسُه منهومة لا تشبع، ولذا تجده أحيانًا يعرّض نفسه للمذلّة مقابل أن يحصل على دراهم معدودة، وعلى ضوء ذلك نقول: إنّ
[1] سورة فاطر، الآية 15.
368
353
الموعظة الرابعة والخمسون: ثقافة القناعة
الفقير فقيران والغني غنيّان، فقير لا يملك مالًا وفقير هو مملوك للمال الذي يمتلكه، وغنيّ يملك مالًا وغنيّ لا يملكه المال لقنوعه بما قسم الله، وأحيانًا يصبح مِلكًا وهو صاحب كنوز، بينما أولئك أرقّاء لا يأتون بخير أينما كان توجّههم.
وعلى هذا المعنى تضافرت الروايات الكثيرة، منها: «كفى بالقناعة ملكًا»[1]، «القناعة تغني»[2]، «القناعة غنيّة»[3]، «القانع غنيّ وإن جاع وعرى»[4]، «لا كنز أغنى من القناعة»[5]، «من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس»[6].
الحياة الطيّبة
كلّ إنسان يسعى إلى حياة طيّبة يسعد فيها، ولكنّ المشكلة التي تواجه الكثيرين في تشخيص هذه الحياة أن يعتبر بعض الناس أنّها تتحقّق بجمع المال وكثرته، بخلاف آخرين، فقد يعتبرونها تكمن في القناعة، ومن النماذج التي نجدها في القرآن الكريم حينما خرج قارون في زينته على الناس، فقد انقسموا إلى فئتين، وهما: الفئة التي تريد الحياة الدنيا والفئة التي أوتيت العلم، فالفئة الأولى، قالت: ﴿يَٰلَيتَ لَنَا مِثلَ مَا أُوتِيَ قَٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٖ﴾. وأمّا
[1] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص508.
[2] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص35.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج78، ص10.
[4] الآمديّ، غرر الحكم ودرر الكلم، ص75.
[5] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج69، ص399.
[6] المصدر نفسه، ج77، ص45.
369
354
الموعظة الرابعة والخمسون: ثقافة القناعة
الفئة الثانية، فقالت: ﴿وَيلَكُم ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيرٞ لِّمَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَلَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ﴾[1].
وأمَّا حقيقة الحياة الطيّبة وجوهرها، فهو القناعة، ويدلّ عليه ما جاء في الحديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حينما سُئِل عن قوله -تعالى-: ﴿مَن عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَو أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤمِنٞ فَلَنُحيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗ وَلَنَجزِيَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ مَا كَانُواْ يَعمَلُونَ﴾[2] فقال: «هي القناعة»[3]، ومن هنا فإنّ طالبي المال لا يجدون طعم الحياة الطيّبة.
كيف نربّي أنفسنا على القناعة؟
القناعة صفة نفسانيّة تتحصَّل في النفس وتنمو إلى أن تصبح ملكة راسخة، وهي تفتقر إلى مجاهدة النفس كأيّ صفة أخلاقيّة يرغب الإنسان بالتحلّي بها، ولكي يحصل الإنسان عليها فلا بدّ من إزالة صفات بالترويض والتهذيب، والذي يحول دون تحلِّي النفس بها الطمعُ والحرصُ وعدم العفّة، وطبيعة الإنسان إذا ازداد طمعه بالاستكثار من جمع المال أو حرصه على ماله من النفاذ أو لم ينزّه نفسه عن المذلّة بمدّ يده إلى الآخرين فحينئذٍ تكون جميع السبل مقفلة أمام حلول القناعة في النفس. ولذا، لا بدّ من أن يبدأ المرء بإزالة هاتيك الصفات أوّلًا، وإلى ذلك أشار الإمام الباقر (عليه السلام)، بقوله: «أنزل ساحة القناعة باتقاء الحرص وادفع عظيم الحرص بإيثار
[1] سورة القصص، الآيتان 79 - 80.
[2] سورة النحل، الآية 97.
[3] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص509.
370
355
الموعظة الرابعة والخمسون: ثقافة القناعة
القناعة»[1]. وعن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «لن توجد القناعة حتّى يفقد الحرص»[2]، وهنا توجد مجموعة من الوصايا التي تفضَّل بها الأئمة (عليهم السلام) في مقام تربية النفس على صفة القناعة، فقد ورد أنّ رجلًا شكا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه يطلب فيصيب ولا يقنع، وتنازعه نفسه إلى ما هو أكثر منه، وقال: علّمني شيئًا أنتفع به، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن كان ما يكفيك يغنيك، فأدنى ما فيها يغنيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكلُّ ما فيها لا يغنيك»[3].
وأمّا كيف يغنى بما يكفيه، فمثال ذلك ما رواه الإمام الباقر (عليه السلام)، قال: «أكل عليّ من تمر دَقَل (اردأ التمور) ثمّ شرب عليه الماء، ثمّ ضرب على بطنه، وقال: من أدخله بطنه النار فأبعده الله»[4].
وممّا يساهم في بناء ملكة القناعة في النفس أن يتخلّى عن أمرين:
الأوّل: لا ينظر إلى ما عند الغير.
الثاني: لا يتمنّى ما لم ينله.
وإليهما أشارت الرواية عن الإمام الصادق (عليه السلام)، فقال: «اقنع بما قسم الله لك ولا تنظر إلى ما عند غيرك ولا تَتَمَنَّ ما لست نائله، فإنّه من قنع شبع ومن لم يقنع لم يشبع وخذ حظّك من آخرتك»[5].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج78، ص163.
[2] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص407.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص139.
[4] المتّقي الهنديّ، كنز العمّال، ج3، ص782.
[5] الشيخ الكلينيّ، الكافي ج8، ص243.
371
356
الموعظة الرابعة والخمسون: ثقافة القناعة
القناعة باليسير تغنيه عن الكثير
هذه معادلة طبيعيّة بين القناعة والغنى -كما أشرنا إليها آنفًا، والذي يجدر الإشارة إليه أنّ من يقنعه اليسير فإنّه يستغني عن الكثير وأمّا من لم يقنعه اليسير فلا ينفعه الكثير، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام)، بقوله: «من لم يقنعه اليسير لم ينفعه الكثير»[1]، وفي مورد آخر، قال: «من كان بيسير الدنيا لا يقنع، لم يغنه من كثيرها ما يجمع»[2]. إذن، المعيار الأساسيّ للحياة السعيدة الكفاف والاكتفاء برزقه المقسوم، وإلّا فلو اجتمع عليه مال الدنيا فلا يكفيه ولا يكفّ نفسه عن النظر إلى ما عند الآخرين، فهذا أمير المؤمنين (عليه السلام) يخاطب ابن آدم، بقوله -كما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام)-: «ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإنّ أيسر ما فيها يكفيك، وإن كنت إنّما تريد ما لا يكفيك فإنّ كلّ ما فيها لا يكفيك»[3].
ثمرة القناعة وآثارها
ممّا لا شكّ فيه أنّ للقناعة ثمارًا وآثارًا عظيمة على باطن القانع وظاهره وفي دنياه وآخرته:
فمن الآثار الباطنيّة: النزاهة والعفاف، فعن أمير المؤمنين، قال:
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج78، ص71.
[2] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص456.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص138، ح6.
372
357
الموعظة الرابعة والخمسون: ثقافة القناعة
«من قنعت نفسه أعانته على النزاهة والعفاف»[1]، ومنها: عزّة النفس، فعنه (عليه السلام): «مِن عزّ النفس لزوم القناعة»[2].
ومنها: العزوف عن الطلب، فعنه (عليه السلام): «ثمرة القناعة الإجمال في المكتسب والعزوف عن الطلب»[3].
ومنها: راحة الأبدان وإزالة الغمّ من النفس، فعن الإمام الحسين (عليه السلام)، قال: «القنوع راحة الأبدان»[4]، «من قنع لم يغتمّ»[5].
وأمَّا عن آثارها في الدين والدنيا: فيقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «اقنعوا بالقليل من دنياكم لسلامة دينكم فإنّ المؤمن البلغة اليسيرة من الدنيا تقنعه»[6].
وأيضًا: فإنّ العيش الهانئ في الدنيا لا يتمّ إلّا بالقناعة؛ فعن الإمام عليّ (عليه السلام)، قال: «أنعم الناس عيشًا من منحه الله -سبحانه- القناعة وأصلح له زوجه»[7].
وقال: «القناعة أهنأ عيش»[8]. وأمَّا عن ثمارها في الآخرة، فيقول النبيّ (صلى الله عليه وآله): «أقنع بما أوتيته يخفّ عليك الحساب»[9].
[1] الآمديّ، غرر الحكم، ص629.
[2] المصدر نفسه، ص682.
[3] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص208.
[4] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج78، ص128.
[5] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص429.
[6] الآمديّ، غرر الحكم، ص156.
[7] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص124.
[8] المصدر نفسه، ص23.
[9] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج77، ص187.
373
358
الموعظة الخامسة والخمسون: أكل الحرام
الموعظة الخامسة والخمسون: أكل الحرام
بيان آثار أكل الحرام، والحثّ على اجتنابه.
محاور الموعظة
أكل الحرام يُسقِم القلب
تأثير أكل الحرام
الحرام يُحبِط العمل
تصدير الموعظة
أمير المؤمنين (عليه السلام): «بئس الطعام الحرام!»[1].
[1] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص402.
374
359
الموعظة الخامسة والخمسون: أكل الحرام
أكل الحرام يُسقِم القلب
إنّ المراقب لتصرّفات النّاس وأساليب حياتهم يستطيع ببساطة أن يلحظ تلك الغفلة التي يغرق فيها أغلبهم عن حقيقة عظيمة من حقائق وجودهم، وهي تكوّنهم من روح ونفس إضافة إلى الجسد، فتراهم يستغرقون في البعد المادّيّ لوجودهم ألا وهو الجسد فيحرصون عليه، وهو الفاني، فيما يلقون أرواحهم خلف جدران سميكة من الإهمال والنسيان، كإخوة يوسف، ألقوا ذلك البعد الملكوتيّ في غيابة جبّ الجسد والمادّة.
فكم يعمدون، كما في هذه الأيّام، إلى نيل شهوات ولذائذ جسديّة حيوانيّة ويعملون على حماية الجسد وحفظه وتجميله فيلجؤون إلى الأطبّاء لمجرّد الشكّ في طروء المرض أو الضعف على أجسادهم، وبالخلاصة فغالب أناس هذا الزمن يبتعدون -غالبًا- عن كلّ ما يحتمل أن يؤذي الجسد أو يضرّ بنظافته أو جماله ويمارسون لأجل ذلك أنواعًا مرهقة ومجهدة من الحمية والتمارين الرياضيّة إضافة إلى بذل الأثمان الباهظة لقاء الحصول على مساحيق التجميل.
لكن هل فكّرنا يومًا بما يشوّه جمال أرواحنا، ويضعف النفوس، ويمرضها؟! هل سألنا ما هي الأمور التي إن تعاطيناها أدّت إلى مرض النفوس والقلوب ولوّثتها؟
نعم، ثمّة أمور كثيرة تسقم القلوب، وتمرض النفوس وتلوّثها وتضعفها، ومن أهمّ ذلك أكل المال الحرام.
375
360
الموعظة الخامسة والخمسون: أكل الحرام
تأثير أكل الحرام
قبل الكلام في تأثير أكل المال الحرام على الروح والنفس، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ أكل الحرام يشمل كلّ طعام حرّم الله -تعالى- علينا أن ندخله إلى بطوننا، فتارة يكون بنفسه محرّمًا كالميتة والخنزير والشراب المسكر كالخمر وغيرها، وأخرى لعروض أمر على ما هو حلال بأصله لكن بسبب اتّصافه بوصف ما كالمتنجّس قبل تطهيره، أو تحصيله بطريقة غير شرعيّة حيث يتّصف بكونه مغصوبًا، ليصدق عليه عنوان أكل مال الناس بغير حقّ.
وأمّا عن تأثيره في الإنسان، فقد جاء عن الإمام عليّ (عليه السلام): «بئس الطعام الحرام»[1]، فمن آثار أكل الحرام:
1. مرض القلوب وقسوتها
ومنه نستفيد أنّ أسوأ ما يمكن أن يأكله الإنسان هو الحرام من الطعام، ويمكن لنا القول: إنّه كما يؤثّر في الجسد أكل الطعام الفاسد فيؤدّي إلى التسمّم وأعراضه من ارتفاع الحرارة والغثيان، كذلك أكل الحرام يؤثّر في النفس والروح والقلب، فيؤدّي إلى مرض القلب وتراكم الرَين عليه بما يضعف بصيرته؛ لكونه مصداقًا لقوله -تعالى-: ﴿كَلَّا بَل رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكسِبُونَ﴾[2].
[1] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص402.
[2] سورة المطفّفين، الآية 14.
376
361
الموعظة الخامسة والخمسون: أكل الحرام
وقد يؤدّي إلى قساوة القلب فلا يعود الإنسان صاحب القلب القاسي يتأثّر بالموعظة والهداية ويفقد صفة الرحمة خصوصًا مع إدمان أكل الحرام.
2. إصابة الذرّيّة
بل إنّ مؤثّريّة أكل المال الحرام لا تقتصر على الشخص الآكل للحرام، بل تمتدّ لتصيب الذرّيّة، فعن الإمام الصادق (عليه السلام): «كسب الحرام يبين في الذرّيّة»[1].
3. أكل الحرام أكل للنار
ولأكل مال الحرام صورة ملكوتيّة أو على الأقلّ برزخيّة؛ إذ إنّ الإنسان الذي يأكل المال الحرام في الوقت نفسه وفي الواقع يأكل نارًا إلّا أنّه لا يشعر بها نتيجة انغماسه في الدنيا ولذائذها وغفلته عن الآخرة وحقائقها، فعن أبي عبد الله (عليه السلام): «من أكل من مال أخيه ظلمًا ولم يردّه إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة»[2].
وقال الله -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموَٰلَ ٱليَتَٰمَىٰ ظُلمًا إِنَّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَارٗا وَسَيَصلَونَ سَعِيرٗا﴾[3].
4. لا بركة فيه ولا أجر على إنفاقه
إنّ من آثار الطعام إنبات اللحم وتقوية الجسم وغير ذلك فعندما
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص125.
[2] المصدر نفسه، ج2، ص333.
[3] سورة النساء، الآية 10.
377
362
الموعظة الخامسة والخمسون: أكل الحرام
يكون ذلك على الحرام فمعنى ذلك أنّ لإبليس وجنوده حصّة في أجسادنا وممرًّا إلى نفوسنا، وهذا يؤدّي إلى سطوته علينا وسهولة استدراجه لنا إلى حبائله ومكائده فسيدرجنا من حرام إلى حرام، وهذا معنى كونه غير مبارك، قال أبو الحسن (عليه السلام) لأحد أصحابه: «يا داود، إنّ الحرام وإن نما لم يبارك له وفيه، وما أنفقه لم يؤجر عليه، وما خلّفه كان زاده إلى النّار»[1] فضلًا عن كونه ما دام في جسده ومعه وعنده موجبًا للعن الله والملائكة ككلّ مغصوب.
5. عدم التوفيق للطاعات والمكرمات
فيما روي أنّ من صفات المحتشدين في مواجهة الإمام الحسين (عليه السلام) مع جيش ابن سعد وفي الذين تخلّفوا كذلك عن نصرته أنّهم مُلئت بطونهم حرامًا.
وهذا كافٍ لنعرف أنّ أكل المال الحرام قد يمنع الإنسان من نصرة الحقّ، بل خذلانه وربّما نصرة الباطل والكون في زمرة قتلة أبناء الأنبياء (عليهم السلام).
الحرام يُحبِط العمل
قال الله -تعالى-: ﴿وَقَدِمنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِن عَمَلٖ فَجَعَلنَٰهُ هَبَاءٗ مَّنثُورًا﴾[2] هذه الآية تؤكّد ما قلناه من أنّ الإنسان الذي يجمع ماله من حرام ولو فعل أفعال البرّ فحجّ وزار وصام وصلّى وتصدّق فإنّ
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص125.
[2] سورة الفرقان، الآية 23.
378
363
الموعظة الخامسة والخمسون: أكل الحرام
عمله سيكون هباءً منثورًا لن يجده شيئًا، والأسوأ من ذلك أنّه قد يكون أطعم من ماله وسقى وأسكن وألبس منه وأنفقه على زوجته وأبنائه، فعندما ينكشف لهم يوم القيامة أنّ مسكنهم كان من حرام ومأكلهم من حرام ومشربهم من حرام وملبسهم من حرام سيصبحون ألدّ أعداء هذا الرجل وسيكونون ناقمين عليه وسيكونون من الشاكين منه وعليه، ويطلبون من الله أن يزيد في عذابه، والأشدّ من ذلك أن يرث ماله من يحسن إلى أهل الفاقة وينفقه في وجوه الطاعة والبرّ فيدخل الجاني للمال النار بسببه، ويدخل الوارث الجنّة بسبب إنفاقه في البرّ والإحسان ويا لها حينها من حسرة.
379
364
الموعظة السادسة والخمسون: قيمة العمل في الشريعة الإسلاميّة
الموعظة السادسة والخمسون: قيمة العمل في الشريعة الإسلاميّة
نشر ثقافة السعي والجدّ في تحصيل الرزق الحلال وتكريسه بالعمل ومراعاة الضوابط الشرعيّة.
محاور الموعظة
مفهوم العمل في الشريعة
اقتران العمل بالإيمان والإتقان
مبدأ تحصيل الرزق والتعامل معه
الفوائد والآثار الفرديّة والاجتماعيّة للعمل
تصدير الموعظة
قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قال لأقعدنّ في بيتي ولأصلينّ ولأصومنّ ولأعبدنّ ربّي، فأمّا رزقي فسيأتيني، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «هذا أحد الثلاثة الذين لا يُستجاب لهم»[1].
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج12، ص4.
380
365
الموعظة السادسة والخمسون: قيمة العمل في الشريعة الإسلاميّة
وعن الشيبانيّ، قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وبيده مسحاة، وعليه إزار غليظ، يعمل في حائط له، والعرق يتصابّ عن ظهره، فقلت: جُعِلت فداك! أعطني أكفّك، فقال لي: «إنّي أحبّ أنْ يتأذّى الرجل بحرِّ الشمس في طلب المعيشة»[1].
للعامل أهمّيّة خاصّة في الشريعة الإسلاميّة، فقد ندب الإسلام إلى طلب الرزق بالعمل، وجعل له أجرًا كبيرًا، وقرّر له حقوقًا وواجبات، وإذا لم يكفه ما حصّل، وجب على الوالي إعطاؤه كفايته من مسكن ومأكل وسائر الحوائج، حتّى يغنيه الله من فضله، وهذا ما يستفاد من النصوص الكثيرة في هذا المجال:
قال -تعالى-: ﴿وَفِي أَموَٰلِهِم حَقّٞ لِّلسَّائِلِ وَٱلمَحرُومِ﴾[2].
مفهوم العمل في الشريعة
لا يقتصر العمل في الشريعة الإسلاميّة على النظرة الشائعة التي تنظر إلى العمل على أنّه مجرّد تقديم كدّ بدنيّ مقابل أجرة زهيدة.
بل الشريعة تنظر إلى مفهوم العمل وتربطه بعمل الدنيا والدين معًا. أي العمل الدنيويّ بشتّى أشكاله وأنواعه من جهد بدنيّ وفكريّ واستثمار الأموال لتنمية البطّالينوتشغيلهم وسدّ حاجة المحتاجين. وقد ورد تعبير العمل ومعناه في 360 آية قرآنيّة تقريبًا.
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج12، ص23.
[2] سورة الذاريات،الآية 19.
381
366
الموعظة السادسة والخمسون: قيمة العمل في الشريعة الإسلاميّة
وعن الشيبانيّ، قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وبيده مسحاة، وعليه إزار غليظ، يعمل في حائط له، والعرق يتصابّ عن ظهره، فقلت: جُعِلت فداك! أعطني أكفّك، فقال لي: «إنّي أحبّ أنْ يتأذّى الرجل بحرِّ الشمس في طلب المعيشة»[1].
للعامل أهمّيّة خاصّة في الشريعة الإسلاميّة، فقد ندب الإسلام إلى طلب الرزق بالعمل، وجعل له أجرًا كبيرًا، وقرّر له حقوقًا وواجبات، وإذا لم يكفه ما حصّل، وجب على الوالي إعطاؤه كفايته من مسكن ومأكل وسائر الحوائج، حتّى يغنيه الله من فضله، وهذا ما يستفاد من النصوص الكثيرة في هذا المجال:
قال -تعالى-: ﴿وَفِي أَموَٰلِهِم حَقّٞ لِّلسَّائِلِ وَٱلمَحرُومِ﴾[2].
مفهوم العمل في الشريعة
لا يقتصر العمل في الشريعة الإسلاميّة على النظرة الشائعة التي تنظر إلى العمل على أنّه مجرّد تقديم كدّ بدنيّ مقابل أجرة زهيدة.
بل الشريعة تنظر إلى مفهوم العمل وتربطه بعمل الدنيا والدين معًا. أي العمل الدنيويّ بشتّى أشكاله وأنواعه من جهد بدنيّ وفكريّ واستثمار الأموال لتنمية البطّالينوتشغيلهم وسدّ حاجة المحتاجين. وقد ورد تعبير العمل ومعناه في 360 آية قرآنيّة تقريبًا.
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج12، ص23.
[2] سورة الذاريات،الآية 19.
381
367
الموعظة السادسة والخمسون: قيمة العمل في الشريعة الإسلاميّة
1. اقتران العمل بالإيمان والإتقان
في مجال الربط بين العمل والإيمان، يقول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿وَقُلِ ٱعمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُۥ وَٱلمُؤمِنُونَ﴾[1]، وفي آية أخرى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلأَرضِ وَٱبتَغُواْ مِن فَضلِ ٱللَّهِ﴾[2].
وأمّا السنّة النبويّة فقد أشادت هي الأخرى قولًا وعملًا بالعمل حاثّة عليه وعلى إتقانه. قال (صلى الله عليه وآله): «ما أكل أحد طعامًا قطّ خيرًا من أن يأكل من عمل يده»[3]. وفي مجال ربط العمل بالإتقان جاء عنه(صلى الله عليه وآله)، أنّه قال: «إنّ الله يحبّ إذا عمل أحدكم عملًا فليتقنه»[4].
لأنّ إتقان الأعمال والإخلاص فيها من أهمّ عوامل التطوّر والرقيّ والازدهار والتقدّم.
وكما حثّ الإسلام العمّال على الكدّ والجدّ حثّ أيضًا أصحاب العمل على إنصاف العمّال وإعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، فقد جاء عنه (صلى الله عليه وآله)، أنّه قال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه»[5].
2. العمل عبادة وفريضة
يرى الإسلام العمل عبادة، بشرط أن تكون النيّة لله -تعالى-، فالعامل في أيّ حقل يعمل، سواء كان معلّمًا أو أستاذًا أو مهندسًا
[1] سورة التوبة، الآية 105.
[2] سورة الجمعة، الآية 10.
[3] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج3، ص7699.
[4] المصدر نفسه، ص2131.
[5] المصدر نفسه، ج1، ص76.
382
368
الموعظة السادسة والخمسون: قيمة العمل في الشريعة الإسلاميّة
أو طبيبًا أو مزارعًا أو تاجرًا أو... له أجر العمل وثوابه، فقد روي عن الرسول (صلى الله عليه وآله) قوله: «العبادة عشرة أجزاء تسعة أجزاء في طلب الحلال»[1]، وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: «الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل الله». وطلب الرزق الحلال فريضة وجهاد، فقد روي عن الرسول (صلى الله عليه وآله)، قوله: «طلب الحلال فريضة على كلّ مسلم ومسلمة»[2]، وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: «طلب الحلال فريضة بعد الفريضة»[3]، وقوله (صلى الله عليه وآله): «طلب الحلال جهاد»[4].
3. التأكيد على تعلّم الحرفة
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا نظر إلى الرجل فأعجبه، قال لأصحابه: «هل له حرفة؟»فإن قالوا: لا، قال: «سقط من عيني»، قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟! قال: «لأنّ المؤمن إذا لم تكن له حرفة يعيش بدينه»[5]، وقال (صلى الله عليه وآله): «إنّ الله -تعالى- يحبّ العبد المؤمن المحترف»[6]، ونقل عن الإمام عليّ (عليه السلام) قوله: «إنّ الله يحبّ المحترف الأمين»[7].
4. مكانة العمل والعامل في الإسلام
عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «من طلب الدنيا استعفافًا عن الناس
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج74، ص21.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج100، ص1.
[3] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج2، ص1075.
[4] المصدر نفسه، ص1075.
[5] الدراميّ، سنن النبيّ، ص176.
[6] الشيخ الصدوق، الخصال، ص610.
[7] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص313.
383
369
الموعظة السادسة والخمسون: قيمة العمل في الشريعة الإسلاميّة
وسعيًا على أهله وتعطّفًا على جاره، لقي الله -عزَّ وجلَّ- يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر»[1].
وعن أيّوب، قال: كنّا جلوسًا عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ أقبل علاء بن كامل، فجلس قدّام أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: ادع الله أنْ يرزقني في دعة، قال (عليه السلام): «لا أدعو لك، اطلب كما أمرك الله -عزَّ وجلَّ- »[2].
وعن موسى بن بكير، قال: قال لي أبو الحسن موسى (عليه السلام):«من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله، كان كالمجاهد في سبيل الله»[3].
وعن خالد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «اقرؤوا من لقيكم من أصحابكم السلام، وقولوا لهم إنّ فلان بن فلان يقرئكم السلام وقولوا لهم: عليكم بتقوى الله، وما ينال به ما عند الله، إنّي والله، ما آمركم إلّا بما نأمر به أنفسنا، فعليكم بالجدّ والاجتهاد، وإذا صلّيتم الصبح فانصرفتم فبكِّروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال، فإنّ الله سيرزقكم ويعينكم عليه»[4].
وعن العلاء، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: «أيعجز أحدكم أنْ يكون مثل النملة، فإنّ النملة تجرّ إلى حجرها»[5].
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج12، ص11، الباب4، ح5.
[2] المصدر نفسه، ص10، الباب4، ح3.
[3] المصدر نفسه، ص11، الباب 4، ح4.
[4] المصدر نفسه، ص12، الباب4، ح8.
[5] المصدر نفسه، ص2، الباب 4، ح9.
384
370
الموعظة السادسة والخمسون: قيمة العمل في الشريعة الإسلاميّة
وعن الصدوق، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يخرج في الهاجرة في الحاجة قد كفيها، يريد أنْ يراه الله يتعب نفسه في طلب الحلال[1].
وعن أبي حمزة، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق، فقلت: جعلت فداك، أين الرجال؟ فقال: «يا عليّ، قد عمل باليد من هو خير منّي ومن أبي في أرضه»، فقلت: ومن هو؟ فقال: «رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وأميرالمؤمنين (عليه السلام)، وآبائي كلّهم كانوا قد عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيّين والمرسلين والأوصياء والصالحين»[2].
5. حق العامل وواجبه
«العمل» شعار رفعه الإسلام لمجتمعه وحدّد حقوق العامل وواجباته:
أ. حقّ العامل
- أن يوفّى أجره المكافى لجهده من دون حيف عليه أو مماطلة له، «اعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه».
- أن توفَّر له حياة كريمة تتناسب مع ما يبذله من جهد وعرق، قال -سبحانه-: ﴿وَلِكُلّٖ دَرَجَٰتٞ مِّمَّا عَمِلُواْ﴾[3]
- أن يُمنح ما هو جدير به من تكريم المجتمع كلّه له، قال -سبحانه-: ﴿وَقُلِ ٱعمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُۥ وَٱلمُؤمِنُونَ﴾[4].
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج17، ص19.
[2] المصدر نفسه، ج12، ص23.
[3] سورة الأنعام، الآية 132.
[4] سورة التوبة، الآية 105.
385
371
الموعظة السادسة والخمسون: قيمة العمل في الشريعة الإسلاميّة
- أن يجد الحماية التي تحول من دون غبنه واستغلال ظروفه، قال -سبحانه- في الحديث القدسيّ الجليل: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثمّ غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره»[1].
ب. واجبات العامل
- أن يؤدّي عمله على الوجه الأكمل، وهو ما عُبِّر عنه في الروايات بالإتقان.
- أن يتّبع توجيهات إدارة العمل.
- أن يحافظ على أسرار المهنة والعمل.
- أن يأخذ في اعتباره مصلحة صاحب العمل.
-أن لا يتعاون بأيّ بشكل مع المؤسّسة المنافسة للمؤسّسة التي يعمل بها بما يخالف أنظمة عمله.
6. مبدأ تحصيل الرزق والتعامل معه
لقد وضعت الشريعة ضوابط دينيّة وأخلاقيّة في كيفيّة تحصيل الرزق، والتعامل معه، أهمّها:
أ. ألاَّ يكتسب المال من غير حلّه، كالخمر والقمار والأشياء الضارّة.
ب. ألاَّ ينفق المال في غير حلّه، كالمحرّمات، ومنه الإسراف والتبذير.
ج. أنْ يعطي المال لأجل الضروريّات الإسلاميّة، إذا توقّف عليه بأنْ لم يكن للدولة مورد آخر، ومن ذلك شؤون الدفاع والجهاد، قال -سبحانه-: ﴿وَجَٰهِدُواْ بِأَموَٰلِكُم وَأَنفُسِكُم﴾[2].
[1] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج14، ص37.
[2] سورة التوبة، الآية 41.
386
372
الموعظة السادسة والخمسون: قيمة العمل في الشريعة الإسلاميّة
د. ندب الإسلام إلى الصدقات والخيرات والمبرّات، كما ندب ألاَّ يربح المؤمن من المؤمن إلاّ بقدر، وأن يوسّع على عياله، وأن تظهر النعمة عليه، دون تبذير أو إسراف.
7. الفوائد والآثار الفرديّة والاجتماعيّة للعمل
أ. إشباع الحاجات النفسيّة
يساهم العمل في إشباع الحاجات النفسيّة للإنسان كالحاجة إلى الاحترام والتقدير، والحاجة إلى إثبات الذات. والعمل يقوّي كيان الإنسان المعنويّ وينمّي الروح الاجتماعيّة، ويصنع الإرادة القويّة.
ب. توفير المتطلّبات المادّيّة
العمل هو الذي يجعل الإنسان قادرًا على توفير حاجاته المادّيّة.
ج. تنشيط الاقتصاد
إنّ توظيف الشباب يحقّق تنشيطًا للاقتصاد؛ إذ إنّ الاقتصاد عبارة عن دورة ماليّة متكاملة.
د. الحفاظ على الأمن الاجتماعيّ
يؤدّي توفير فرص وظيفيّة للشباب إلى خلق حالة من الأمن الاجتماعيّ، في حين أنّ البطالة وعدم قدرة الشباب في الحصول على الوظائف والأعمال المناسبة يساهم في انتشار الجرائم، وكثرة السرقات، ممّا يؤدّي إلى الإخلال بالأمن الاجتماعيّ العامّ.
387
373
الموعظة السابعة والخمسون: الشباب عماد المجتمع الصالح
الموعظة السابعة والخمسون: الشباب عماد المجتمع الصالح
تعرّف قيمة الشباب المؤمن ودوره في المجتمع، وكيفيّة المحافظة عليه من الفساد والانحراف.
محاور الموعظة
معنى الشباب سبيل العطاء والبذل
أهمّيّة مرحلة الشباب
الاستفادة القصوى سبيل النجاة
أين نُفني أعمارنا؟
الدواء في بيوت الله
تصدير الموعظة
﴿قُل هَل نُنَبِّئُكُم بِٱلأَخسَرِينَ أَعمَٰلًا ١٠٣ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعيُهُم فِي ٱلحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا وَهُم يَحسَبُونَ أَنَّهُم يُحسِنُونَ صُنعًا﴾[1].
[1] سورة الكهف، الآيتان 103 - 104.
388
374
الموعظة السابعة والخمسون: الشباب عماد المجتمع الصالح
إنّ للعمر قيمةً لا تُقدَّر بثمن على الإطلاق، فالعمر يتصرّم مع مرور الأيّام، وينبغي للإنسان المؤمن أن يستغلّ هذا الوقت المتاح له في الدنيا، كي ينعم بنعيم الآخرة، فيمرّ الإنسان بمرحلة الطفولة التي يقضي عمره فيها باللعب والمرح، ثمّ تأتي عليه مرحلة الشباب وهي مرحلة الجِدّ والعمل والنشاط والعطاء، ثمّ تأتي عليه مرحلة الشيخوخة، وهي مرحلة الهرم والعجز عن أداء الأمور بجميع حدودها، فمرحلة الشباب هي المرحلة الأساسيّة والوحيدة التي يتمكّن فيها الإنسان من العطاء والنشاط، فينبغي أن تستغلّ هذه بشكل كبير، وهذا ما دعا إليه الدين الحنيف في منظومته الفكريّة والثقافيّة.
معنى الشباب سبيل العطاء والبذل
فُسِّرت «الفتوّة» في الثقافة الدينيّة، بشكل من أشكال البذل والعطاء، الإحسان للآخرين، البشاشة، العفاف وصون النفس، تجنّب أذيّة الآخرين، والابتعاد عن الدناءة والحقارة، روي عن أبي قتادة القُميّ، قال: كنّا عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ تذاكروا عنده الفتوّة، فقال: «كلا، إنّما الفتوّة طعام موضوع، ونائل مبذول، وبشر مقبول، وعفاف معروف، وأذى مكفوف، وأمّا تلك فشطارة وفسوق»[1].
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «نظام الفتوّة احتمال عثرات الإخوان، وحسن تعهّد الجيران»[2].
[1] الشيخ الطوسيّ، الأمالي، ص301.
[2] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص499.
389
375
الموعظة السابعة والخمسون: الشباب عماد المجتمع الصالح
وقد أطلق القرآن الكريم على الشباب الموحِّدين الذين فرّوا في عهد دقيانوس من الظلم والشرك ولجأوا إلى الغار (أصحاب الكهف) عبارة «فتية» (أهل مروءة وشهامة).
أهمّيّة مرحلة الشباب
يعتبر الإسلام أنّ مرحلة الشباب هي من المراحل المهمّة والحسّاسة في حياة الإنسان المؤمن، ولذا اعتبر بحسب القرآن الكريم مرحلة القوّة والثبات في مقابل مراحل الضعف في حياة الإنسان، قال -تعالى-: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعفٖ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعدِ ضَعفٖ قُوَّةٗ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعدِ قُوَّةٖ ضَعفٗا وَشَيبَةٗ يَخلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ ٱلعَلِيمُ ٱلقَدِيرُ﴾[1].
فمرحلة الشباب مرحلة القوّة والشجاعة والثبات التي تقع بين مرحلة الطفولة وهي مرحلة ضعف، ومرحلة الشيخوخة وهي مرحلة ضعف أيضًا، ولا يمكن أن نفهم هذه المرحلة إلّا بضرورة التركيز فيها وتنميتها وتهذيبها، بل حفظها من الانحراف على غير الطريق الذي رسمه الله -سبحانه وتعالى-، وهذا كلّه يكشف عن أهمّيّة مرحلة الشباب وخطورتها في حياة الإنسان المؤمن.
ومن جهة أخرى، إنّ الروايات أكّدت وبشكل قويّ هذه المرحلة، حيث اعتبرتها المرحلة التي يجب على الإنسان أن يغتنمها بالخير والعمل الصالح، وترك المفاسد والمحرّمات، فقد جاء في وصيّة النبيّ (صلى الله عليه وآله) لأبي ذرّ، أنّه قال: «شبابك قبل هرمك، وصحّتك قبل سقمك،
[1] سورة الروم، الآية 54.
390
376
الموعظة السابعة والخمسون: الشباب عماد المجتمع الصالح
وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك»[1].
وكذلك من جهة ثانية اعتبرتها المرحلة الوحيدة التي يسأل عنها الإنسان، ويحاسب عليها بشكل تفصيليّ، وهذا كلّه يكشف عن خطورة هذه المرحلة وحساسيّتها في حياة الإنسان الشابّ المؤمن، وهذا ما حدّثت به رقيّة حفيدة الإمام الكاظم (عليه السلام) عن أبيها عن الإمام الكاظم (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تزول قدَمَا عبد يوم القيامة حتّى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن حبّنا أهل البيت»[2].
الاستفادة القصوى سبيل النجاة
أشار القرآن المجيد في سورة النحل إلى ضرورة الاستفادة القصوى من العمر، وأنّ العمر يضيع من يدي الإنسان بسرعة، بل قد تصل فيه المرحلة إلى الخسارة الكبرى، قال -تعالى-: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَتَوَفَّىٰكُم وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرذَلِ ٱلعُمُرِ لِكَي لَا يَعلَمَ بَعدَ عِلمٖ شَئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٞ قَدِيرٞ﴾[3].
والأرذل اسم تفضيل من الرذالة وهى الرداءة والرذل الدون والرديء والمراد بأرذل العمر بقرينة قوله لكي لا يعلم سنّ الشيخوخة والهرم التي فيها انحطاط قُوى الشعور والإدراك وهى تختلف باختلاف
[1] الشيخ قطب الدين الراوندي، الدعوات (سلوة الحزين)، ص113.
[2] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص93.
[3] سورة النحل، الآية 70.
391
377
الموعظة الرابعة عشرة: دروس من عاشوراء
الأمزجة وتبتدئ على الأغلب من الخمس والسبعين[1]. ولذا، فقد ورد في بعض الروايات أنّ من جاوز السبعين حيًّا فهو «أسير الله في الأرض»[2].
فالآية تريد القول: بأنّ هذه القدرة والقوّة اللتين عندكم لو لم تكونا على سبيل «العارية» لما أُخِذتا منكم بهذه البساطة. اعلموا أنّ فوقكم قدرة أخرى قادرة على كلّ شيء، فقبل أن تصلوا إلى تلك المرحلة خلِّصوا أنفسكم، وقبل أن يتحوّل هذا النشاط والجمال إلى موت وذبول. اجمعوا الورد من هذا الروض، وتزوّدوا بالزاد من هذه الدنيا لطريق الآخرة البعيد، لأنّه لم يمكنكم أداء أيّ عمل ذي قيمة في وقت الشيب والضعف والمرض[3]. ولذا، فإنّ من ضمن ما أوصى به النبيّ (صلى الله عليه وآله) أبا ذرّ، أنّه قال: «شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك»[4].
أين نُفني أعمارنا؟
أهمّ ما في الدِّين هو أنّه يعطينا، حتّى في أشدّ الظروف والأوضاع الصعبة، الطمأنينة وهدوء النفس والاستقرار والسكينة والأمل والرجاء. ولا يوجد شيء في هذا الوجود يمكنه أن يمنح الإنسان هذا المستوى في مواجهة المشاكل والصعوبات والمآسي والأحزان غير الدين.
[1] العلّامة الطبطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج12، ص294.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج8، ص108.
[3] الشيخ ناصر مكارم الشيرازيّ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج14، ص228.
[4] قطب الدين الراونديّ، الدعوات (سلوة الحزين)، ص113.
392
378
الموعظة الخامسة والخمسون: أكل الحرام
يقول الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكرِ ٱللَّهِ تَطمَئِنُّ ٱلقُلُوبُ﴾[1]. أيًّا تكن المأساة والأحزان والمعاناة الّتي تعيشها بسبب ظروف شخصيّة أو اجتماعيّة أو سياسيّة أو أمنيّة أو تهديدات أو جوع أو فقر، وغير ذلك... عندما تلجأ إلى الله -سبحانه وتعالى-، عندما تذكر الله -سبحانه وتعالى- وتعود إلى الله -عزّ وجلّ، عندما تجلس بين يدي الله -سبحانه وتعالى- لمناجاته ولدعائه، يمكنك أن تشكو له كلّ آلامك ومعاناتك وصعوباتك وأحزانك ومآسيك. وهنا، أنت لا تتكلّم مع فقير مثلك، حين تقول له أنا فقير، فيجيبك: أنا فقير مثلك، أنت لا تشكو إلى مثيل لك ولا حتّى إلى قادر أو غنيّ محدود القدرة ومحدود الغنى، أنت تشكو إلى الله -سبحانه وتعالى-، وتتحدّث مع الله -سبحانه وتعالى-، وتلجأ إلى الله -سبحانه وتعالى- الغنيّ القادر العالم الذي يعلم ما في أنفسنا، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، والقادر الكريم؛ لأنّه يوجد قادر من الممكن ألّا يساعدك، والغنيّ الجواد؛ لأنّه ممكن أن يكون هناك غنيّ ولا يمدّ لك يد العون.
يقول -تعالى-: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَليَستَجِيبُواْ لِي وَليُؤمِنُواْ بِي لَعَلَّهُم يَرشُدُونَ﴾[2].
وعن النبيّ (صلى الله عليه وآله): «لا تعجزوا عن الدعاء، فإنّه لم يهلك مع الدعاء أحد. وليسأل أحدكم ربّه، حتّى يسأله شسعَ نعله إذا انقطع. واسألوا
[1] سورة الرعد، الآية 28.
[2] سورة البقرة، الآية 186.
393
379
الموعظة السابعة والخمسون: الشباب عماد المجتمع الصالح
الله من فضله فإنّه يحبّ أن يُسأل. وما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة رَحِم إلّا أعطاه الله -تعالى- بها إحدى ثلاث: «إمّا أن يعجّل له دعوته، وإمّا أن يدّخرها له في الآخرة، وإمّا أن يكفّ عنه من الشرّ مثلها، قالوا: يا رسول الله إذن نكثر، قال: الله أكثر»[1].
أنت تتكلّم مع من بيده ملكوت السماوات والأرض، تناجيه وتلجأ إليه. هذا اللجوء إلى الله -سبحانه وتعالى-، أُولى نتائجه السريعة الهدوء والطمأنينة والسكينة. مهما فتّشتم في علم النفس التربويّ والاجتماعيّ ولدى أطبّاء النفس وغيرهم فلن تجدوا هذا العلاج عند أحد، ولكنّكم ستجدون العلاج عند محمّد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله) وفي آيات الله الّتي أنزلت على قلبه الشريف، وفي الآيات الكريمة: ﴿وَلَنَبلُوَنَّكُم بِشَيءٖ مِّنَ ٱلخَوفِ وَٱلجُوعِ وَنَقصٖ مِّنَ ٱلأَموَٰلِ وَٱلأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَٰبَتهُم مُّصِيبَةٞ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَٰجِعُونَ﴾[2]، كيف نواجه هذا النقص وهذا البلاء وهذه المحنة في الأموال، في الأنفس، في الثروات؟!
«إنّا لله» ليست مجرّد كلمة تقال، «إنّا لله» تعني نحن مُلك له، ونحن عبيده، نواصينا بيده، يفعل بنا ما يشاء. «إنّا لله وإنّا إليه راجعون» فعندما نكون عبيدًا له، نرضى بما يرضاه لنا، نرضى ونهدأ ونطلب منه أن يُعيننا، وأن يدفع عنّا البلاء، وأن يرفع عنّا الامتحان، وأن يُعطينا الصبر والثبات والنجاح والنصر والعزّة. «وإنّا إليه راجعون»
[1] قطب الدين الراوندي، الدعوات (سلوة الحزين)، ص19.
[2] سورة البقرة، الآيتان 155 - 156.
394
380
الموعظة السابعة والخمسون: الشباب عماد المجتمع الصالح
عبارة تقول لنا إنّ هذه الحياة الّتي نعيشها هي حياة محدودة، وبالتالي، لا تستحقّ أن تضيّع آخرتك من أجل بعض المحن وبعض الصعوبات وبعض الأحزان في الدنيا، فترتكب المعاصي والذنوب وتفرّ من الشيطان.
وروي أنّ الإمام الرضا (عليه السلام)، قال[1]:
نعى نفسي إلى نفسي المشيب
وعند الشيب يتّعظ اللبيب
فقد ولّى الشباب إلى مداه
فلست أرى مواضعه يؤب
سأبكيه وأندبه طويلًا
وأدعوه إليّ عسى يُجيب
فإن يكن الشباب مضى حبيبًا
فإنّ الشيب أيضًا لي حبيب
سأصحبه بتقوى الله حتّى
يفرق بيننا الأجل القريب
الدواء في بيوت الله
يقول -تعالى-: ﴿يَٰبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشرَبُواْ وَلَا تُسرِفُواْ إِنَّه لَا يُحِبُّ ٱلمُسرِفِينَ﴾[2]، المساجد، هذه المؤسّسات العباديّة الإيمانيّة التربويّة هي شفاء للناس وهي حاجة روحيّة ونفسيّة واجتماعيّة وأخلاقيّة، هي حاجة جهاديّة وسياسيّة وأمنيّة أيضًا، في بيوت الله -عزّ وجلّ-، نقرأ القرآن ونستمع إلى الوعظ والإرشاد ونتعرّف إلى حقائق الوجود، فنفهم معنى الدنيا ومعنى الآخرة، ومعنى الامتحان ومعنى البلاء، ومعنى الصبر ومعنى تحمّل المسؤوليّة. في بيوت الله -عزّ وجلّ-، نشحذ الهمم والعزائم والإرادات، في بيوت الله -عزّ وجلّ- ،
[1] الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج2، ص191.
[2] سورة الأعراف، الآية 31.
395
381
الموعظة الخامسة والخمسون: أكل الحرام
نحمل روح الإنسانيّة ونجسِّدها ونعمِّقها في أرواحنا وفي أنفسنا. في بيوت الله -عزّ وجلّ-، نداوي قلوبنا وجروح أنفسنا الّتي تُصيبها السهام من كلّ حدب وصوب، وبالدرجة الأولى نحصل على هذا الهدوء وعلى هذه الطمأنينة. في الدِّين وفي بيوت الله يتحصّل لنا الأمل.
نعم، الدين والنبيّ (صلى الله عليه وآله) وآيات القرآن هي القادرة على أن تمنح هذا الأمل. الإمام الخمينيّ (قدس سره) قبل خمسين سنة أو ستين سنة، كان يقول للشاه: «كلّما عمّرنا في قرية أو في مدينة مسجدًا يمكنكم أن تقلّلوا عدد المخافر وعدد الدرك وعدد قوى الأمن»، لماذا؟ لأنّه عندما يتربّى الناس على التديّن، سيشكّل ذلك حاجزًا ورادعًا ذاتيًّا عن القتل، والسرقة، والغشّ، والظلم، والتجسّس على الآخرين، وإيذاء الآخرين.
المسؤوليّة في هذه المرحلة الصعبة والخطرة هي أن نلجأ إلى الله -سبحانه وتعالى-، أن نتمسّك بديننا وثقافتنا وقيمنا، أن نثق بالله -سبحانه وتعالى-، أن نعرف أنّ أمامنا آمالًا كبيرة نحن قادرون على تحقيقها، أن نستعين بثقافتنا وتعاليمنا وقيمنا لنكون من أصحاب الأنفس المطمئنة الواثقة الشجاعة المريدة العازمة. ونحن قادرون على تجاوز كلّ هذه الأخطار إذا تحمّلنا المسؤوليّة وكنّا أصحاب الوعي وأصحاب الأمل، وكنّا أوّلًا وآخرًا من اللاجئين إلى الله، مستعيذين به في مواجهة الشيطان، مستعينين به على مواجهة التحدّيات، قال -تعالى-: ﴿فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنهُ نَذِيرٞ مُّبِينٞ﴾[1].
[1] سورة الذاريات، الآية 50.
396
382
الموعظة الثامنة والخمسون: مَضارُّ الكَسَل
الموعظة الثامنة والخمسون: مَضارُّ الكَسَل
بيان الكَسَلِ وأضرارِه، والحثّ على الجِدّ والنشاط والعمل واتّخاذِ الحِرْفة.
محاور الموعظة
الكسل يَضُرُّ بالدين والدُنيا
آثار الكسل ونتائجه
ما العلاج؟
بِالعمل نُواجِه المستكبرين
تصدير الموعظة
الإمام الباقر (عليه السلام): «الكَسَل يَضُرُّ بالدين والدُنيا»[1].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج75، ص180.
398
383
الموعظة الثامنة والخمسون: مَضارُّ الكَسَل
الكسل يَضُرُّ بالدين والدُنيا
مِن الآفات التي يُبتلى بها الإنسانُ الكسل، ولِخُطورته في حياة الفَرد والأُمّة، وإدراكًا مِنه لِما للعمل والجِدّ والنشاط مِنْ أهمّيّة في رقِيّ الأُمم وتَطوُّرها وتقدُّمها، حثَّ الإسلامُ على العمل والجِدّ والنشاط، ومَدَح ذَوي الهِمَم العالية وأصحاب الطُموح في العِلْم والعمل، وشنَّ حملةً على البَطالة والكَسل والتَكاسُل؛ عن الإمام الباقر (عليه السلام): «الكَسَل يَضُرُّ بالدين والدُنيا».
ولَمّا كان بعضهم يَتوهّم أنّ العملَ في سبيل تحصيل المعاش طلبٌ للدُنيا -وهذا مُنافٍ ومُشوِّه للدين-، جاء الحديث الشريف، لِيُصوِّب هذه النَظرة، قائلًا: «اعمَلْ لِدُنياكَ كأنّكَ تعيش أبدًا، واعمَلْ لِآخرتِكَ كأنّكَ تموت غَدًا»[1]. فالعمل في سبيل المعاش أمرٌ ضروريّ، والإسلام يَبغُضُ مَن يكون كَلًّا على غيره، يُلقي عليه مسؤوليّة إعالَته.
والشبهة السابقة مِن مُنافاة العمل -زُهدًا وتديُّنًا- واجَهَها أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) بِصورة مُباشَرة، فقد وَرَد عن الإمام الباقر (عليه السلام): «لَيْسَ منّا مَن تَرَك دُنياه لِآخرته، ولا آخرته لِدُنياه»[2]. فلا بُدّ مِن الموازنة بين الدُنيا والآخرة، لِيَستقيم الإنسان وتَستقيم حَرَكته.
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج17، ص76.
[2] المصدر نفسه، ج12، ص49.
399
384
الموعظة الثامنة والخمسون: مَضارُّ الكَسَل
آثار الكسل ونتائجه
معروف عند العُقَلاء أنّ الكَسل مِن الأمور التي تَمْقُتها النفوس السليمة ويَبغُضها العُقَلاء، لِآثارها المُدمِّرة في الأفراد والمجتمعات؛ فعلى الصعيد الفرديّ، يُؤدّي الكسل إلى هَدْم الشخصيّة، فهو مَرَضٌ يَجعل صاحبه مُتثاقلًا عن العمل وتَحَمُّلِ المسؤوليّات. وممّا ذُكِرَ في الروايات حول نتائج الكسل:
1. عدم أداء الحقوق
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إيّاك وخصلتَيْن: الضَجَرُ والكَسل. فإنّك إنْ ضَجرْتَ لمْ تَصْبِر على حَقّ، وإنْ كَسلْتَ لمْ تُؤدِّ حَقًّا»[1]؛ فمِن الطبيعيّ جِدًّا ألّا يستطيع الكسول تأديةَ حقوق نفْسه والقيامَ بما يَلزم مِن عملٍ لِنَفْعِها. فإذا لمْ يُؤدِّ حَقّها، فكيف له ألّا يكون عاجزًا عَن تأدية حقوق الآخرين؟
2. التقصير في طاعة الله
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إيّاكم والكَسل، فإنّه مَنْ كَسلَ لمْ يُؤدِّ حَقّ الله -عزَّ وجلَّ-»[2].
3. الفقر
هو نتيجة وثمرة طبيعيّة؛ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّ الأشياء
[1] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج12، ص65.
[2] المصدر نفسه.
400
385
الموعظة الثامنة والخمسون: مَضارُّ الكَسَل
لَمّا ازدوجَتْ، ازدَوَجَ الكسل والعَجْز، فَنَتَجَ بينهما الفَقر»[1]. لذا، فإنّ مَصير الكسول هوان نفْسِه عليه، حتّى يَصِلَ إلى إراقة ماءِ وَجهه بِالاستعطاء والاستِجداء والسؤال والتَسكُّع ومَدّ يَدِه سائلًا المساعدة. وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «مَسألة الناس مِن الفَواحِش»[2].
4. الكَسل مانعٌ مِن الحظوظ
عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إيّاك والكسل والضَجر، فإنّهما يمنعانِك مِن حَظِّك مِنَ الدُنيا والآخرة»[3].
وعن باقر العلوم (عليه السلام): «إنّي لَأبغضُ الرجل أنْ يكون كسلانَ عن أَمْرِ دُنياه، ومَن كَسل عن أمرِ دُنياه فَهو عن أمْرِ آخرته أَكسَل»[4].
5. البغض مِن الله والناس
بُغضُ الناس أمرٌ لا يستطيع عاقلٌ إِنكارَه، وهو جارٍ على كلِّ لِسانٍ مِن ألسِنة العُقَلاء. أمّا مَبغوضيّة الكَسل والكَسول عِند الله، فَقد وَرَد في قول الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ الله -عزَّ وجلَّ- يَبغُضُ العبدَ النوّامَ الفارغ»[5].
6. ضياع الأفراد والمجتمعات
إنّ الأفراد الكسولين عِبءٌ على عائلاتهم وثِقلٌ عليها وعلى
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص86.
[2] النراقيّ، جامع السعادات، ج2، ص89.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص85.
[4] المصدر نفسه، ص88.
[5] المصدر نفسه، ص85.
401
386
الموعظة الثامنة والخمسون: مَضارُّ الكَسَل
المجتمعات التي ينتمون إليها، فَهُم فِئةٌ تستهلك ولا تنتج، عاجزةٌ بِسبب مَرَض الكَسَل، وتُصيب المجتمع بِالعَجز أيضًا. والعَجْزُ يوجب الذلّ لِصاحبه ولِمُجتمعه، فَعن الإمام عليّ (عليه السلام): «العَجْزُ مَهانة»[1]، وعنه (عليه السلام): «العَجْزُ آفة»[2].
وأيّة آفة أعظم مِن مرض يُصيب الفرد والمجتمعات بالشَلل؟ فكما تُشَلُّ يدا الكَسول فلا تَجْلِبُ خيرًا ولا تدفع سوءًا، فإنّ الكسل كذلك، إذا انتشرَ يَشلّ الأُمّة؛ فهو سببُ تأخُّر الأُمم وانحطاطها. وهو مَرضٌ يَجُرُّ بَعضه بعضًا، فَمَن كَسل عن شيءٍ، فإنّه لا يَنفكّ يكسل عن غيره، حتّى يُصبح مَيْتًا قبلَ أنْ يَموت.
ما العلاج؟
1. النشاط
النشاط عَكسُ الكَسل؛ فَلَئِن كان الكسل يُمثّل الموت، فإنّ النشاط هو الحياة. ولولا أنّ أجدادنا كانوا نشيطين، لَما ورِثْنا هذا البنيان وتلك الحضارات والعمران والثقافة والعلوم والخِبرات الهندسيّة والطبّيّة والزراعيّة وغير ذلك؛ رُوِيَ أنّ الإمام الصادق (عليه السلام) كان يَشكو الكسل المستشري في زَمانه، فيقول: «لا تكسَلوا في طَلَبِ مَعايشكم، فإنّ آباءَنا كانوا يَركضون فيها ويَطلبونها»[3].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج66، ص159.
[2] المصدر نفسه، ص160.
[3] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج12، ص38.
402
387
الموعظة الثامنة والخمسون: مَضارُّ الكَسَل
2. اتّخاذ الحِرْفة
لقد كان النبيّ (صلى الله عليه وآله) وأئمّة أهل البيت (عليهم السلام) مثالًا للعمل والنشاط والجِدّ. ومِن الروايات الرائعة في حَثِّهِم على العمل، بل على اتّخاذ الحِرفة: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا نَظَر إلى الرجل، فأَعْجَبَه، قال: «هل له حِرفة؟» فإنْ قالوا: لا، قال: «سَقَطَ مِن عَيْني»، قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله): «لِأنّ المؤمن إذا لمْ يَكُنْ له حِرْفة، يَعيش بِدينِه»[1]. وهذا تحذير مِن أمرٍ خطير، هو أنّ صاحب الدين إذا لم يَستَطِع أن يستقلّ ماليًّا، ويُنتج ما يكفيه، فمعنى ذلك أنّه إذا أراد ما يَعيش به، فَلَنْ يَجِدَ سِلعة يَبيعها إلّا دينه.
بِالعمل نُواجِه المستكبرين
إنّ مطالعة الواقع السياسيّ والسياسات العالميّة والإقليميّة تُفضي إلى نتيجة مفادها أنّ ثمّة حربًا يَشُنّها المستكبرون والطُغاة وأذنابهم مِن مالكي الثروات، بل ناهبي ثروات الشعوب. وهذه الحرب هدفها الإضعاف، عن طريق تَحويلنا إلى شعوب لا كرامة لها، فقيرة ومُتسوّلة.
ولا يمكن مواجهة سياسات الإفقار والإذلال إلّا بالعَمل والنشاط والجِدّ والاجتهاد، فَلْنُلاقِ جِهاد المجاهدين في ساحات القتال بِجِهادنا في ساحات العَمل والإنتاج، لِيَكون لنا مِثْل أَجْرِهم؛ عن الإمام الصادق (عليه السلام): «أَجْرُ العامِل أَجْرُ المجاهد في سبيل الله»[2].
[1] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج13، ص12.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص88.
403
388
الموعظة التاسعة والخمسون: اللَهْوُ والعَبَثيّة
الموعظة التاسعة والخمسون: اللَهْوُ والعَبَثيّة
بيان أنّ اللَهْوَ وإضاعةَ الوقت مِن الأمور المذمومة، وأنّ التحديّات وحَجْمَ المؤامرات تَفرِض علينا الاستفادة القُصوى مِن إمكاناتِنا كلّها.
محاور الموعظة
آثار تَرْكِ اللَهْو
اللَهْوُ عِند أهلِ الإيمان
اللَهْوُ عند أهل الدنيا
تصدير الموعظة
﴿أَفَحَسِبتُم أَنَّمَا خَلَقنَٰكُم عَبَثٗا وَأَنَّكُم إِلَينَا لَا تُرجَعُونَ﴾[1].
[1] سورة المؤمنون، الآية 115.
404
389
الموعظة التاسعة والخمسون: اللَهْوُ والعَبَثيّة
آثار تَرْكِ اللَهْو
إنّ بعض الصِبْية قالوا لِنَبيّ الله يحيى (عليه السلام) -عندما كان صغيرًا-: اذْهَبْ بِنا نَلعب. فقال: «ما لِلَعِبِ خُلِقْنا»، فأنزل الله -تعالى-: ﴿وَءَاتَينَٰهُ ٱلحُكمَ صَبِيّٗا﴾[1] [2].
اللَهْوُ عِند أهلِ الإيمان
قال -تعالى-: ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٖ ١٠ لَّا تَسمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةٗ﴾[3]؛ وَرَدَ في تفسير القُمّيّ أنّ اللَغْوَ في الآية هُو الهزل والكَذِب.
وقال -تعالى-: ﴿وَٱلَّذِينَ هُم عَنِ ٱللَّغوِ مُعرِضُونَ﴾[4]. وإنّما قال مُعْرِضون، ولمْ يَقُلْ تارِكون، للإشارة إلى أنّ الإعراض يستلزم الانشغال بما هو أهمّ؛ لأنّ الإنسان المؤمن إنّما يُعرِض عن الأمور التي لا تتناسب مع كرامته وشَرافة نفسه، وتتعلّق نفْسه بِعَظائم الأمور، لِعُلُوِّ هِمّته، فَعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «اشتغال النفْس بِما لا يَصحَبها بعد الموت مِن أكبر الوَهْن»[5]. وعنه (عليه السلام): «أيّها الناس، اتّقوا الله، فَما خُلِقَ امرؤٌ عَبثًا فَيَلْهو، ولا تُرِكَ سُدًى فَيَلْغو»[6].
والإعراض عن اللَهْوِ لا يعني أنّ المؤمن يَنبغي أن يكون جادًّا وقاسيًا، بل وَرَدَ استحباب مُفاكهة الإخوان وإدخال السرور على المؤمنين.
[1] سورة مريم، الآية 12.
[2] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج4، ص2804.
[3] سورة الغاشية، الآيتان 10 - 11.
[4] سورة المؤمنون، الآية 3.
[5] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج4، ص2791.
[6] المصدر نفسه، ص2802.
405
390
الموعظة التاسعة والخمسون: اللَهْوُ والعَبَثيّة
اللَهْوُ عند أهل الدنيا
قال -تعالى-: ﴿وَإِذَا رَأَواْ تِجَٰرَةً أَو لَهوًا ٱنفَضُّواْ إِلَيهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمٗا قُل مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيرٞ مِّنَ ٱللَّهوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِ وَٱللَّهُ خَيرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾[1].
وقال -تعالى-: ﴿فَذَرهُم يَخُوضُواْ وَيَلعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَٰقُواْ يَومَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ﴾[2].
مَفاسد اللَهْوِ واللَعِب
عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «اللَهْوُ يُسْخِطُ الرحمن ويُرْضي الشيطان ويُنَسّي القرآن»[3].
وعنه (عليه السلام): «مَجالس اللَهْوِ تُفْسِد الإيمان»[4].
وعن أبي عبد الله (عليه السلام): «... فإنّ الملاهي تُوَرِّث قَساوةَ القلب، وتُوَرِّث النِفاق»[5].
وممّا وَرَدَ في دعاء إدريس (عليه السلام): «اللهمّ سَلِّ قلبي عن كلِّ شيءٍ لا أتزوَّدُه إليك، ولا أنتفِع به يوم ألقاكَ، مِن حلالٍ أو حرام»[6].
وفي دعاء مكارم الأخلاق: «اللهمّ صلِّ على محمّد وآله، واكْفِني ما يَشْغلُني الاهتمام به، واستَعْمِلْني بما تَسألني غَدًا عنه، واستفرِغ أيّامي في ما خلَقْتَني له»[7].
[2] سورة الزخرف، الآية 83.
[3] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج4، ص2802.
[4] المصدر نفسه.
[5] السيّد البروجرديّ، جامع أحاديث الشيعة، ج17، ص303.
[6] السيّد ابن طاووس، إقبال الأعمال، ج1، ص182.
[7] الامام زين العابدين (عليه السلام)، الصحيفة السجاديّة، ص92.
406
391
الموعظة الستّون: المدرسة الأخلاقيّة عِند أهل البيت (عليهم السلام)
الموعظة الستّون: المدرسة الأخلاقيّة عِند أهل البيت (عليهم السلام)
بيان مَعالم المدرسة والسيرة الأخلاقيّة للنبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام)، والاقتداء بهم.
محاور الموعظة
تعريف حُسْن الخُلُق
التربية الأخلاقيّة في القرآن
دَوْرُ حُسْن الخُلُق في التربية
الثواب والآثار المادّيّة والمعنويّة للخُلُق الحَسَن
سيرة أهل البيت الأخلاقيّة
آثار سوء الخُلُق
تصدير الموعظة
الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ اللهَ -عزَّ وجلَّ- أَدّبَ نَبِيَّهُ فَأَحسَنَ أَدَبَهُ، فَلَمّا أَكمَلَ لَهُ الأَدَبَ قـالَ: إِنَّكَ لَعلى خُلُق عَظيم»[1].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج1، ص226.
410
392
الموعظة الحادية والستّون: وبشِّر الصابرين
تعريف حُسْن الخُلُق
حُسْنُ الخُلُق مجموعةٌ مِن الصِفات والسلوكيّات التي تتمثّل بِمُداراة الناس، البشاشة، الكلام الطَيِّب، إظهار المحبّة، رعاية الأدب، التبسُّم، التحمُّل، والحِلْم مُقابل أذى الآخرين، وأمثال ذلك. فَلَو امتزجَتْ هذه الصفات مع العمل، وتَرْجَمَها الإنسان في حركة الواقع الخارجيّ، سُمّيَ ذلك حُسْن الخُلُق. وفي حديث جامعٍ جميلٍ عن الإمام الصادق (عليه السلام) -في تعريف حُسْن الخُلُق-، إذ سأله أحدُ أصحابه: مـا حَدُّ حُسنِ الخُلُقِ؟ قال الإمام (عليه السلام): «تُلَيِّنُ جـانِبَكَ، وَتُطَيِّبُ كَلامَكَ، وَتَلقى أَخـاكَ بِبِشرٍ حَسَن»[1].
التربية الأخلاقيّة في القرآن
قال الله -تعالى- مُخاطِبًا نبيَّه (صلى الله عليه وآله): ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ﴾[2].
تُشير الآية إلى حُسْن الخُلُق العجيب للنبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله)، إذ تُعبِّر عنه بالخُلُق العظيم. وإنّ وَصْفَ النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) بهذا الوصف يَدلُّ على أنّ هذه الصِفة الأخلاقيّة مِن أعظم صِفات الأنبياء. ومِن الواضح أنّ الخُلُق العظيم للنبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) يتمثّل في صَبْرِه وتحمُّله في طريق الحقّ، وَسَعَة بَذْله وكَرَمه، وتدبير أمور الرسالة والدعوة، والرِفْقِ ومُداراة الناس، وتَحمُّل الصعوبات الكبيرة في مواجهة تحدّيات الواقع الصعب في طريق الدعوة إلى الله، والجهاد في سبيله، وتَرْك الحِرْص
[1] الشيخ الصدوق، مَن لا يحضره الفقيه، ج4، ص412. العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج68، ص389، ح42.
[2] سورة القلم، الآية 4.
411
393
الموعظة الستّون: المدرسة الأخلاقيّة عِند أهل البيت (عليهم السلام)
تعريف حُسْن الخُلُق
حُسْنُ الخُلُق مجموعةٌ مِن الصِفات والسلوكيّات التي تتمثّل بِمُداراة الناس، البشاشة، الكلام الطَيِّب، إظهار المحبّة، رعاية الأدب، التبسُّم، التحمُّل، والحِلْم مُقابل أذى الآخرين، وأمثال ذلك. فَلَو امتزجَتْ هذه الصفات مع العمل، وتَرْجَمَها الإنسان في حركة الواقع الخارجيّ، سُمّيَ ذلك حُسْن الخُلُق. وفي حديث جامعٍ جميلٍ عن الإمام الصادق (عليه السلام) -في تعريف حُسْن الخُلُق-، إذ سأله أحدُ أصحابه: مـا حَدُّ حُسنِ الخُلُقِ؟ قال الإمام (عليه السلام): «تُلَيِّنُ جـانِبَكَ، وَتُطَيِّبُ كَلامَكَ، وَتَلقى أَخـاكَ بِبِشرٍ حَسَن»[1].
التربية الأخلاقيّة في القرآن
قال الله -تعالى- مُخاطِبًا نبيَّه (صلى الله عليه وآله): ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ﴾[2].
تُشير الآية إلى حُسْن الخُلُق العجيب للنبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله)، إذ تُعبِّر عنه بالخُلُق العظيم. وإنّ وَصْفَ النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) بهذا الوصف يَدلُّ على أنّ هذه الصِفة الأخلاقيّة مِن أعظم صِفات الأنبياء. ومِن الواضح أنّ الخُلُق العظيم للنبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) يتمثّل في صَبْرِه وتحمُّله في طريق الحقّ، وَسَعَة بَذْله وكَرَمه، وتدبير أمور الرسالة والدعوة، والرِفْقِ ومُداراة الناس، وتَحمُّل الصعوبات الكبيرة في مواجهة تحدّيات الواقع الصعب في طريق الدعوة إلى الله، والجهاد في سبيله، وتَرْك الحِرْص
[1] الشيخ الصدوق، مَن لا يحضره الفقيه، ج4، ص412. العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج68، ص389، ح42.
[2] سورة القلم، الآية 4.
411
394
الموعظة الستّون: المدرسة الأخلاقيّة عِند أهل البيت (عليهم السلام)
تعريف حُسْن الخُلُق
حُسْنُ الخُلُق مجموعةٌ مِن الصِفات والسلوكيّات التي تتمثّل بِمُداراة الناس، البشاشة، الكلام الطَيِّب، إظهار المحبّة، رعاية الأدب، التبسُّم، التحمُّل، والحِلْم مُقابل أذى الآخرين، وأمثال ذلك. فَلَو امتزجَتْ هذه الصفات مع العمل، وتَرْجَمَها الإنسان في حركة الواقع الخارجيّ، سُمّيَ ذلك حُسْن الخُلُق. وفي حديث جامعٍ جميلٍ عن الإمام الصادق (عليه السلام) -في تعريف حُسْن الخُلُق-، إذ سأله أحدُ أصحابه: مـا حَدُّ حُسنِ الخُلُقِ؟ قال الإمام (عليه السلام): «تُلَيِّنُ جـانِبَكَ، وَتُطَيِّبُ كَلامَكَ، وَتَلقى أَخـاكَ بِبِشرٍ حَسَن»[1].
التربية الأخلاقيّة في القرآن
قال الله -تعالى- مُخاطِبًا نبيَّه (صلى الله عليه وآله): ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ﴾[2].
تُشير الآية إلى حُسْن الخُلُق العجيب للنبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله)، إذ تُعبِّر عنه بالخُلُق العظيم. وإنّ وَصْفَ النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) بهذا الوصف يَدلُّ على أنّ هذه الصِفة الأخلاقيّة مِن أعظم صِفات الأنبياء. ومِن الواضح أنّ الخُلُق العظيم للنبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) يتمثّل في صَبْرِه وتحمُّله في طريق الحقّ، وَسَعَة بَذْله وكَرَمه، وتدبير أمور الرسالة والدعوة، والرِفْقِ ومُداراة الناس، وتَحمُّل الصعوبات الكبيرة في مواجهة تحدّيات الواقع الصعب في طريق الدعوة إلى الله، والجهاد في سبيله، وتَرْك الحِرْص
[1] الشيخ الصدوق، مَن لا يحضره الفقيه، ج4، ص412. العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج68، ص389، ح42.
[2] سورة القلم، الآية 4.
411
395
الموعظة الستّون: المدرسة الأخلاقيّة عِند أهل البيت (عليهم السلام)
والحَسَد، والتعامل مع الأعداء والأصدقاء مِن مَوقع العَفْوِ واللُطْفِ والمحبّة.
وأورَدَ صاحب تفسير (نور الثقليْن) -في ذَيْل هذه الآية- حديثًا عن الإمام الصادق (عليه السلام)، إذ سُئِلَ عن حُسْن الخُلُق، فقال: «تُلَيِّنُ جـانِبَكَ، وَتُطَيِّبُ كَلامَكَ، وَتَلقى أَخـاكَ بِبِشرٍ حَسَن»[1].
وقال -تعالى- مُحدّدًا معايير السلوك مع المجتمع وعموم الناس: ﴿فَبِمَا رَحمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُم وَلَو كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلقَلبِ لَٱنفَضُّواْ مِن حَولِكَ فَٱعفُ عَنهُم وَٱستَغفِر لَهُم وَشَاوِرهُم فِي ٱلأَمرِ فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلمُتَوَكِّلِينَ﴾[2]. فقد وَرَدَتْ هذه الآية في توجيه النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) وعموم الناس -خاصّةً مَن هُمْ في موقع المسؤوليّة-، فإنّ حُسْنَ خُلُق النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) هو -في الحقيقة- رحمة إلهيّة له ولِأُمّته. والنقطة المقابِلة لهذا السلوك هو أن يكون الإنسان غليظَ القلب وسَيِّء الخُلُق وخَشِنًا في التعامل مع الآخرين، إذ تُشير الآية إلى نتائج مِثل هذا السلوك السلبيّ، وهي تَفَرُّق الناس وانفِضاضهم عن هذا الإنسان الخَشِن وابتعادهم عنه.
وكَلِمَتا (فظّ) و (غليظ القلب) تَرِدان بمعنى الخُشونة والجَفاء، ولكنّ إحداهما في الكلام، والأخرى في السلوك والفِعل.
[1] العروسيّ الحويزيّ، تفسير نور الثقلين، ج5، ص391.
[2] سورة آل عمران، الآية 159.
412
396
الموعظة الستّون: المدرسة الأخلاقيّة عِند أهل البيت (عليهم السلام)
فعلى أساس حُسن الخُلق، استقطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبْعَدَ الناس عن الله -تعالى- والدين والأخلاق، وجَذَبَهم إليه، وأصبح قُدْوَتَهم وأُسْوَتهم في حُسْنِ الأخلاق.
وقال -تعالى-: ﴿ٱدفَع بِٱلَّتِي هِيَ أَحسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَينَكَ وَبَينَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ ٣٤ وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٖ﴾[1].
تُقَرِّرُ هذه الآية أنّ المداراة واللين مُحبَّذان، حتّى مع الأعداء الشَرِسين، فإنّهما يُؤَثِّران في أعماق نُفوسهم تَأثيرًا بالغًا. وبالطبْع، فإنّ دَفْعَ السَيِّئات بالحَسَنات له طُرق ومصاديق مختلفة، إحداها أن يتعامل الشخص مِن موقع المداراة والأدب والبَشاشة مع عَدُوِّه المعاند الحقود؛ أي بما يمكن أن يَقلِب هذا الإنسانَ الحقود إلى صديقٍ مُحِبّ، ويُحوِّله مِن حالةِ العداوة والبَغضاء إلى حالةِ الصداقة والمحبّة.
والوصول إلى هذه المرتبة مِن حُسْنِ الخُلُق -بِحَيْث يواجه الإنسان السَيِّئات بِعَكسها مِن الحَسَنات- لَيْسَتْ مِن شأنِ كلِّ إنسان؛ لأنّها تحتاج إلى تَسَلُّطٍ كاملٍ على قِوى النفْسِ، ولا يستطيع ذلك إلّا مَن أوتِيَ حَظًّا عظيمًا مِن سَعَة الصدر، وتَخَلَّصَ مِن عقْدة الانتقام.
[1] سورة فصّلت، الآيتان 34 - 35.
413
397
الموعظة الستّون: المدرسة الأخلاقيّة عِند أهل البيت (عليهم السلام)
دَوْرُ حُسْن الخُلُق في التربية
ثمّة روايات كثيرة في كيّفية التعامل مع الناس في حركة التفاعل الاجتماعيّ. والتعبيرات الواردة في هذه الروايات عن هذه الفضيلة الأخلاقيّة كثيرة جدًّا، إلى حَدِّ أنّه قَلَّما نَجِدُ نَظيرًا لها في النصوص الإسلاميّة. نختار مِن بينها ما يأتي:
وَرَدَ عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «الإِسلامُ حُسنُ الخُلُقِ»[1].
وعنه (صلى الله عليه وآله): «أَكْثَرُ ما تَلِجُ بِهِ أُمَّتي الجَنَّةَ تَقْوى اللّهِ وَحُسْن الخُلُقِ»[2].
عن الإمام عليّ (عليه السلام): «عنوانُ صَحيفَة المُؤمن حُسنُ خُلُقِه»[3].
وعنه (عليه السلام): «أَكْمَلُكُم إيمـانًا أَحسَنكُم خُلُقًا»[4].
الثواب والآثار المادّيّة والمعنويّة للخُلُق الحَسَن
وَرَد في حديثٍ عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «الخُلقُ الحَسَنُ يُذيبُ السَيِّئَة»[5].
[1] المتّقيّ الهنديّ، كنز العمّال، ج3، ص17.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص100.
[3] الشيخ ابن شعبة الحرّانيّ، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص200. العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج68، ص392، ح59.
[4] الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج2، ص38. العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج68، ص387.
[5] الكراجكيّ، محمّد بن عليّ، كنز الفوائد، ج1، ص135.
414
398
الموعظة الستّون: المدرسة الأخلاقيّة عِند أهل البيت (عليهم السلام)
وعنه (صلى الله عليه وآله): «إِنَّ صـاحِبَ الخُلقِ الحَسَنِ لَهُ مِثلُ أَجْرِ الصائِم»[1].
وعنه (صلى الله عليه وآله): «حُسنُ الخُلقِ يُثَبِّتُ المَوَدّة»[2].
وفي حديثٍ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «حُسْنُ الأَخْلاقِ يدرُّ الأَرْزاقَ»[3].
وعنه (عليه السلام): «في سَعَةِ الأخلاقِ كُنوزُ الأرزاق»[4].
وعن الإمام الصادق (عليه السلام): «إِنَّ اللهَ -تَبـارَكَ وَتَعالى- لَيُعطي العَبدَ مِنَ الثوابِ عَلى حُسنِ الخُلقِ كَمـا يُعطي المُجـاهِد في سَبيلِ اللهِ»[5].
وعنه (عليه السلام): «البِرُّ وَحُسنُ الخُلقِ يَعمُران الدِيـارَ وَيَزيدانِ في الأَعمـار»[6].
ومِن مجموع هذه الروايات الإسلاميّة، نُدرِك جَيِّدًا الأهمّيّة البالغة لِحُسْنِ الخُلُق في حركة الحياة المادّيّة والمعنويّة للإنسان، ويتبيّن أنّ صاحبَ الخُلُق الحَسَن يَتميّز على مَن يقوم الليل في العبادة والمجاهدِ في سبيل الله، ويُضاهيهما في الثواب، إذ إنّ حُسْنَ الخُلُق يُطهّر النفْس الإنسانيّة مِن أدران الذنوب ومُلوِّثات الأهواء والنوازع الدنيويّة.
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص100.
[2] الشيخ ابن شعبة الحرّانيّ، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص45. العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج74، ص148.
[3] التميميّ الآمديّ، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص255.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج8، ص23؛ العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج75، ص53.
[5] المصدر نفسه، ج2، ص101.
[6] المصدر نفسه، ج2، ص100، ح8.
415
399
الموعظة الستّون: المدرسة الأخلاقيّة عِند أهل البيت (عليهم السلام)
سيرة أهل البيت الأخلاقيّة
مِن أفضل الطُرق إلى كَسْبِ فضيلة حُسْن الخُلق ومُلاحظة نتائجها الإيجابيّة على واقع الإنسان الاقتداءُ بِسيرة الأولياء العِظام.
فَمِمّا نقرأه في حديث الإمام الحسن (عليه السلام): «كانَ رَسولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) دائِمَ البِشر، سَهلَ الخُلق، لَيِّنَ الجانبِ، لَيسَ بِفَظٍّ، ولا غليظ، ولا سَخّاب، ولا فَحّاش، ولا عيّاب، ولا مزّاح، ولا مَدّاح، يَتَغافَلُ عَمّا لا يَشتهي، فلا يُؤيِسُ مِنهُ ولا يُخيِّب فيه مُؤمّليه. قَد تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلاث: المِراء، والإكثار، وما لا يعنيه. وتَرَك الناس مِن ثلاث: كانَ لا يَذُّمُ أَحدًا، ولا يُعيّرُه، ولا يَطلُبُ عَوْرَتَه، ولا يَتَكَلَّمُ إِلّا في ما يَرجو ثَوابه. إِذا تَكَلَّمَ أَطرَقَ جُلساؤُهُ كَأَنّما عَلى رُؤوسِهِم الطَيْرُ، وإذا تَكَلَّمَ سَكَتوا، وإذا سَكَتَ تَكَلَّموا. لا يُسارِعون عِندَهُ بِالحَديثِ، مَن تَكَلَّمَ نَصتوا لَهُ حَتّى يَفرَغَ. حَديثُهُم عِندَهُ حَديث إِلَيهم، يَضحَكُ ممّا يَضحَكونَ مِنهُ، وَيَتَعَجَّبُ ممّا يَتَعَجَّبونَ مِنهُ، يُصبِّرُ الغريبَ عَلى الجَفوةِ في المنطِق، وَيَقولُ: «إِذا رَأَيتُم صـاحِبَ الحاجَة يَطلُبُها فَارْفِدوهُ». ولا يَقبَلُ الثناءَ إلّا مِنْ مُكافِئ. ولا يَقطَعُ عَلى أَحدٍ حَديثَهُ، حَتّى يَجوزَهُ، فَيَقطَعهُ بِانتهاءٍ أَو قِيام»[1].
ونقرأ في الرواية المعروفة أنّ الإمام عليًّا (عليه السلام) كان قاصدًا الكوفة، فَصاحَبَ رجلًا ذِمِّيًّا، فقال له الذمّيّ: أين تريد يا عبد الله؟ قال (عليه السلام): «أُريد الكوفة». فلمّا عَدَل الطريق بالذمّيّ، عَدَلَ معه
[1] الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج1، ص318 - 319.
416
400
الموعظة الستّون: المدرسة الأخلاقيّة عِند أهل البيت (عليهم السلام)
الإمام عَليّ (عليه السلام)، فقال له الذمّيّ: ألَيْسَ زَعَمْتَ تُريدُ الكوفة؟ قال (عليه السلام): «بلى»، فقال له الذمّيّ: فَقَد تركْتَ الطريق. فقال (عليه السلام): «قد عَلِمْتُ»، فقال له: فَلِمَ عَدَلْتَ معي وقَد عَلِمْتَ ذلك؟ فقال له عليّ (عليه السلام): «هذا مِن تَمام الصُحبة؛ أَن يُشيِّعَ الرجلُ صـاحِبهُ هُنيئةً إذا فارَقَهُ، وَكَذلِكَ أَمَرَنـا نَبيُّنا». فقال له الذمّيّ: هكذا أمَرَكم نبيّكم؟ فقال (عليه السلام): «نعم». فقال له الذمّيّ: لا جَرَم إنّما تَبِعَهُ مَن تَبِعَه لِأفعاله الكريمة، وأنا أشهد على دينك. فرجِع الذمّيّ مع الإمام عليّ (عليه السلام)، فلمّا عَرَفَهُ أَسْلَم[1].
وفي حديثٍ آخر -في تفسير الإمام الحسن العسكريّ (عليه السلام)- قال: «حَضَرَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ الصِدّيقَةِ فاطِمَة الزهْراء (عليها السلام)، فَقالَتْ: إِنَّ لي والِدَةً ضَعيفَةً، وَقَدْ لُبِسَ عَلَيْها في أَمْرِ صَلاتِها شَيء، وَقَدْ بَعَثَتْني إِلَيْكِ أَسْأَلكِ».
فَأَجابَتْها فاطِمَة (عليها السلام) عَنْ ذلِكَ. ثُمَّ ثَنَّتْ، فَأَجابَتْ. ثُمَّ ثَلَّثَتْ، فَأَجابَتْ. إِلى أَنْ عَشَّرَتْ فَأَجابَتْ. ثُمَّ خَجِلَتْ مِنَ الكَثْرَة، فَقالَتْ: لا أَشُقُّ عَلَيْكِ -يا بِنْتَ رَسولِ اللّهِ-. قالَتْ فاطِمَة (عليها السلام): «هاتي وَسَلي عَمّا بَدا لَكِ، أَرَأَيْتِ مَنِ اكْتُرِيَ يَوْمًا يَصْعَدُ إِلى سَطْحٍ بِحمْلٍ ثَقيلٍ، وَكِراؤُهُ مِئَةُ أَلْفِ دينارٍ، أَيَثْقُلُ عَلَيْهِ؟» فَقالَتْ: لا.
فَقالَتْ: «اكْتُريتُ أَنا -لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ- بِأَكْثَر مِنْ مِلْء ما بَيْنَ الثَرى إِلى العَرْشِ لُؤْلُؤًا، فَأَحْرى أَلّا يَثْقُلَ عَلَيَّ. سَمِعْتُ أَبي [رَسولَ اللّهِ] (صلى الله عليه وآله)
[1] المجلسيّ، محمّد تقيّ بن مقصود عليّ، روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضره الفقيه، ج4، ص227.
417
401
الموعظة الستّون: المدرسة الأخلاقيّة عِند أهل البيت (عليهم السلام)
يَقولُ: إِنَّ عُلَماءَ شيعَتِنا يُحْشَرونَ، فَيُخْلَعُ عَلَيْهِمْ مِنْ خِلَعِ الكَراماتِ عَلى قَدْرِ كَثْرَةِ عُلومِهِمْ وَجِدِّهِمْ في إِرْشادِ عِبادِ اللّهِ»[1].
وممّا وَرَد عن حِلْم الإمام الحسن (عليه السلام)، أنّ شاميًّا رآه راكبًا (في بعض أزقّة المدينة)، فَجَعل يَلعنه، والحسن (عليه السلام) لا يَرُدّ. فلمّا فرَغَ، أقبل الحسن (عليه السلام)، فَسَلَّم عليه، وضَحِكَ، فَقال: «أيُّها الشيخ، أَظُنُّك غَريبًا، وَلَعلَّك شُبّهْتَ. فَلَو استَعتَبْتَنا أَعتَبناكَ، وَلَو سَأَلتَنا أَعطَيناكَ، وَلَو استَرشَدْتَنا أَرشدناك، وَلَو استَحمَلْتَنا أَحملناكَ، وإنْ كُنتَ جـائِعًا أَشبَعناك، وَإِن كُنتَ عُريانًا كَسوْناك، وإِنْ كُنتَ مُحتاجًا أَغنَيناكَ، وإِنْ كُنتَ طَريدًا آويناكَ، وإنْ كانَ لَكَ حـاجَة قَضَيْناها لَكَ، فَلَوْ حَرَّكْتَ رَحلَكَ إِلينا، وَكُنتَ ضَيفَنا إِلى وَقتِ ارتِحالِك، كانَ أَعْوَد عَلَيكَ؛ لأنَّ لَنا مَوضِعًا رَحبًا، وَجاهًا عَريضًا، وَمالًا كَثيرًا». فلمّا سَمِعَ الرجل كلامه، بَكى، ثمّ قال: أَشهدُ أَنّك خَليفة الله في أرضه. اللهُ أَعلَمُ حيثُ يَجعلُ رسالتهُ. وكنتَ أَنت وأبوك أبغضُ خَلْقِ الله إليَّ، والآن، أَنت وأبوكَ أَحَبُّ خَلْقِ اللهِ إليَّ. وَحَوَّل رَحْلَه إليه، وكان ضَيْفه إلى أن ارتَحَل، وصار مُعتقِدًا لِمَحبّتِهم[2].
وجاء في كتاب «تحف العقول» أنّ رَجلًا مِن الأنصار جاء إلى الإمام الحسين (عليه السلام) يُريد أن يسأله حاجة، فقال (عليه السلام): «يـا أخـا الأنصار، صُنْ وجَهك عَن بَذْلِ المسألةِ، وارْفعْ حـاجتَك في رقعة، فإنّي آتٍ فيها
[1] الإمام الحسن بن عليّ (عليه السلام)، التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريّ (عليه السلام)، ص340.
[2] راجع: العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج43، ص344.
418
402
الموعظة الستّون: المدرسة الأخلاقيّة عِند أهل البيت (عليهم السلام)
مـا سـارَّكَ -إن شاء الله». فكتب الأنصاريّ: يا أبا عبد الله، إنّ لِفُلان عَلَيَّ خمسمئة دينار، وقد ألجَّ بي، فَكَلِّمْه يُنْظرني إلى مَيْسرة. فلمّا قرأ الإمام الحسين (عليه السلام) الرقعة، دخل إلى منزله، فأَخْرَج صرّة فيها ألف دينار، وقال (عليه السلام) له: «أَمّا خمسمئة فَاقْضِ بِها دَيْنك، وأمّا خمسمئة فاسْتَعِنَ بِها على دَهرِكَ. ولا تَرفَعْ حـاجتَكَ إلّا إِلى أحدِ ثلاث: إِلى ذي دين، أَو مُروّة، أو حَسَب؛ فأمّا ذو الدين فَيصُون دِينهُ، وأَمّا ذو المُروّة فإنّه يَستحي لِمُروّته، وأَمّا ذو الحَسَب فَيَعلم أنّك لمْ تُكرِم وجهكَ أن تَبذله في حاجتِكَ، فَهو يَصون وَجهكَ أن يَرُدَّك بِغير قضاءِ حـاجتِك»[1].
ونقرأ في سيرة الإمام الباقر (عليه السلام)، عن محمّد بن سُليْمان، عن أبيه: كانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشامِ يَخْتَلِفُ إِلى أَبي جَعْفَرٍ (عليه السلام) -وَكانَ مَرْكَزُهُ في المدينَةِ-، فيَقولُ لَهُ: يا مُحَمَّدُ، أَلا تَرى أَنّي إِنَّما أغْشي مَجْلِسَكَ حَياءً مِنّي لَكَ، وَلا أَقولُ إِنَّ في الأَرْضِ أَحَدًا أَبْغَض إِلَيَّ مِنْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ، وَأَعْلَمُ أَنَّ طاعَةَ اللَّهِ وَطاعَةَ رَسولِهِ وَطاعَةَ أَميرِ المؤْمِنينَ في بُغْضِكُمْ؟ وَلَكِنْ أَراكَ رَجُلًا فَصيحًا، لَكَ أَدَبٌ وَحُسْنُ لَفْظٍ، وَإِنَّما الاخْتِلافُ إِلَيْكَ لِحُسْنِ أَدَبِكَ.
وَكانَ أَبو جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَقولُ لَهُ خَيْرًا: «لَنْ تَخْفى عَلى اللّهِ خافِيَة».
فَلَمْ يَلْبَثِ الشامِيُّ إِلّا قَليلًا، حَتّى مَرِضَ، وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ. فَلَمّا ثَقُلَ، دَعا وَلِيَّهُ، وَقالَ لَهُ: إِذا أَنْتَ مَدَدْتَ عَلَيَّ الثَوْبَ في النَعْشِ، فَأْتِ مُحَمَّدَ
[1] الشيخ ابن شعبة الحرّانيّ، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص247.
419
403
الموعظة الستّون: المدرسة الأخلاقيّة عِند أهل البيت (عليهم السلام)
بْنَ عَلِيٍّ، وَأَعْلِمْهُ أَنّي أَنا الذي أَمَرْتُكَ بِذلِك.
فَلَمّا أَنْ كانَ في نِصْفِ الليْلِ، ظَنّوا أَنَّهُ قَدْ بَرَدَ، وَسَجَّوْهُ، فَلَمّا أَصْبَحَ الناسُ، خَرَجَ وَلِيُّهُ إِلى المسْجِدِ، فَلَمّا أَنْ صَلّى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ (عليه السلام)، وَتَوَرَّكَ -وَكانَ إِذا صَلّى عَقَّبَ في مَجْلِسِهِ-، قالَ لَهُ: يا أَبا جَعْفَرٍ، إِنَّ فُلانًا الشامِيَّ قَدْ هَلَكَ، وَهُوَ يَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ.
فَقالَ أَبو جَعْفَرٍ (عليه السلام): «كَلّا، إِنَّ بِلادَ الشامِ بِلادُ صِرٍّ، وَبِلادَ الحِجازِ بِلادُ حَرٍّ، وَلحمها شَديدٌ، فَانْطَلِقْ فَلا تَعْجَلَنَّ عَلى صَاحِبِكَ حَتّى آتيكُمْ». ثُمَّ قامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَأَخَذَ وضوءًا، ثُمَّ عادَ فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ تِلْقاءَ وَجْهِهِ -ما شاءَ اللّهُ-، ثُمَّ خَرَّ ساجِدًا، حَتّى طَلَعَتِ الشّمْسُ.
ثُمَّ نَهَضَ، فَانْتَهى إِلى مَنْزِلِ الشامِيّ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَدَعاهُ، فَأَجابَهُ، ثُمَّ أَجْلَسَهُ، فَسَنَّدَهُ، وَدَعا لَهُ بِسَويقٍ، فَسَقاهُ، فَقالَ (عليه السلام) لِأَهْلِهِ: «امْلَؤوا جَوْفَهُ، وَبَرِّدوا صَدْرَهُ بِالطعامِ البارِدِ»، ثُمَّ انْصَرَفَ. فَلَمْ يَلْبَثْ إِلّا قَليلًا حَتّى عوفِيَ الشامِيُّ، فَأَتى أَبا جَعْفَرٍ (عليه السلام)، فَقالَ: أَخْلِني. فَأَخْلاهُ. فَقالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللّهِ عَلى خَلْقِهِ، وَبابُهُ الذي يُؤْتى مِنْهُ، فَمَنْ أَتى مِنْ غَيْرِكَ خابَ وَخَسِرَ وَضَلَّ ضَلالًا بَعيدًا.
فقالَ لَهُ أَبو جَعْفَرٍ (عليه السلام): «وَما بَدا لَكَ؟».
قالَ: أَشْهَدُ أَنِّي عَهِدْتُ بِروحي، وَعايَنْتُ بِعَيْني، فَلَمْ يَتَفاجَأني إِلّا وَمُنادٍ يُنادي. أَسْمَعُهُ بِأُذُني يُنادي، وَما أَنا بِالنائِمِ: رُدّوا عَلَيْهِ روحَهُ، فَقَدْ سَأَلَنا ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ. فَقالَ لَهُ أَبو جَعْفَرٍ (عليه السلام): «أَما عَلِمْتَ أَنَّ اللّهَ يُحِبُّ العَبْدَ وَيُبْغِضُ عَمَلَهُ، وَيُبْغِضُ العَبْدَ وَيُحِبُّ عَمَله؟».
420
404
الموعظة الستّون: المدرسة الأخلاقيّة عِند أهل البيت (عليهم السلام)
فَصارَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَصْحابِ أَبي جَعْفَرٍ (عليه السلام)[1].
وأَوْرَدَ الكُلينيّ في الجزء الأوّل مِن الكافي عن الإمام العسكري (عليه السلام): حُبِسَ أَبو مُحَمَّدٍ (الإمام العسكريّ) عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ نارْمَشَ -وَهُوَ أَنْصَبُ الناسِ، وَأَشَدُّهُمْ عَلى آلِ أَبي طالِبٍ-، وَقيلَ لَهُ: افْعَلْ بِهِ -وَافْعَلْ يعني مِن السوء وَالأذى-. فَما أَقامَ الإمام عِنْدَهُ إِلّا يَوْمًا، حَتّى وَضَعَ خَدَّيْهِ لَهُ، وَكانَ لا يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَيْهِ إِجْلالًا وَإِعْظامًا، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ أَحْسَنُ الناسِ بَصيرةً، وَأَحْسَنُهُمْ فيهِ قَوْلًا[2].
آثار سوء الخُلُق
إنّ سوء الخُلُق مِن أهمّ عوامل إيجاد الكراهيّة والتنفُّر والتفرُّق بين أفراد المجتمع؛ لذا وَرَد في الروايات تعبيرات شديدة تتحدّث عن سوء الخُلُق، نقرأ فيها -أحيانًا- كلمات مُذهلة ومخيفة عن النتائج الوخيمة والآثار السلبيّة لهذا المرض الأخلاقيّ. ومِن ذلك:
1. وَرَد في الحديث الشريف عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «إيّاكُم وَسوء الخُلقِ، فإنَّ سوءَ الخُلقِ في النارِ -لا مَحـالَةَ-»[3].
2. عن الإمام عليّ (عليه السلام) -في تقريره لِحالة سوء الخُلق-: «أشَدُّ المَصـائِبِ سوءُ الخُلق»[4].
[1] الشيخ الطوسيّ، الأمالي، ص410 - 411.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج1، ص508.
[3] الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج2، ص31؛ العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج68، ص383.
[4] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص118.
421
405
الموعظة الستّون: المدرسة الأخلاقيّة عِند أهل البيت (عليهم السلام)
الموعظة الحادية والستّون: وبشِّر الصابرين
بيان أهمّيّة الصبر وآثاره وضرورة التحلّي به، وعدم استعجال النتائج.
محاور الموعظة
الصبر، حكمةٌ وثمرة
ثمار الصبر في الدنيا
ثواب الصبر
لا تستعجلوا النصر
تصدير الموعظة
الإمام الصادق (عليه السلام): «الصبر يعقِّب خيرًا، فاصبروا ووطّنوا أنفسكم على الصبر، تؤجروا»[1].
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص89.
422
406
الموعظة الحادية والستّون: وبشِّر الصابرين
الصبر، حكمةٌ وثمرة
إنّ الإنسان في هذه الدنيا معرّض للبلاءات، وللاختبارات والامتحانات، ومن ثوابت التجربة الإنسانيّة أنّ مواجهة ذلك كلّه له عدّته الملائمة والمناسبة لرفع سوءته وجلب خيره، وسواءٌ كان ما يبتلى فيه الإنسان محبوبًا أو مكروهًا فلا بدّ له لإصابة وجه الخير والحسن فيه من عدّة، ورأس العدد كلّ العدد وقوام أيّ عدّة هو الصبر، فإنّ الله يكشف عن سنّة عامّة، بقوله: ﴿وَلَنَبلُوَنَّكُم بِشَيءٖ مِّنَ ٱلخَوفِ وَٱلجُوعِ وَنَقصٖ مِّنَ ٱلأَموَٰلِ وَٱلأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ﴾[1]. ولكنّه -تعالى- يقول إنّ هذه المعاناة مفتاح لشيء شديد الحسن والجمال والقيمة وهو لخاصّة هم الصابرون، فأتمّ قوله الآنف: ﴿وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾[2].
فالحكمة من سنّة الابتلاء والبلاء هو الصبر، مضافًا إلى كونه الثمرة المرجوّ حصولها في نفوس المؤمنين جرّاء مكابدة المشاقّ والمتاعب والآلام، والتعوّد على تحمّلها ومواجهتها بثبات وصمود. فإن كان الإنسان في وجوده الدنيويّ لا ينقل وجوده هذا عن احتمال تعرّضه في كلّ آن إلى المصائب والبلاءات كالأمراض وذهاب الأموال وخسارتها أو تعرّضها للتلف أو فقد الأعزّة والأحباب، أو أن يتسلّط عليه من الظلمة من يُفقِده الأمان والشعور به أو غير ذلك ممّا لا يكون في الحسبان عنده، فإنّه لا بدّ له من الصبر عدّة وسلامًا ودرعًا ووقاءً في مواجهة الدهر وعواديه.
[1] سورة البقرة، الآية 155.
[2] الآية نفسها.
423
407
الموعظة الحادية والستّون: وبشِّر الصابرين
معنى الصبر
عُرّف الصبر بتعاريف كثيرة وشُرح بشروح مختلفة، منها: «أنّه كفّ النفس عن الجزع أو امتناعها عن الشكوى»، والحقيقة أنّ معنى الصبر من الأمور الواضحة عند العرف والتي لا يشتبه فيها، وهو ضدّ الشكاية والجزع، ومعناه وجود قوّة تحمّل عند الإنسان وثباته عندما يواجه المصاعب والمتاعب والبلاءات، بحيث لا يضطرب ولا يتزلزل ولا يفقد الاتّزان، بل يبقى متماسكًا صامدًا مقاومًا حتّى تنتهي المحن ونزول الصعوبات، وينفتح باب الفرج ويُكتب له النصر والفوز والفلاح والنجاح.
فليس الصبر قيمة سلبيّة تعني الخضوع والخنوع وقبول الشقاء والذلّة والاستسلام وتحمّلها، بل هو تحمّل إيجابيّ للمعاناة المترتّبة على المواجهة إمّا مع النفس أو مع الأعداء أو مع الظروف والحوادث ذات الطبيعة المرّة والمؤلمة؛ بمعنى أن لا ينهار الإنسان ويستسلم لتدوسه عجلات الواقع السيّء متعلّلًا بالعجز؛ لأنّ «العجز آفة»[1]، أو لتطأه نعال المحتلّين والظالمين أو يتردّى في سلاسل أغلال النفس الأمّارة، فيمكث دهره في عبوديّتها ليحشر يوم القيامة وفي عنقه السلسلة التي ذرعها سبعون ذراعًا.
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج70، ص160.
424
408
الموعظة الحادية والستّون: وبشِّر الصابرين
ثمار الصبر في الدّنيا
إنّ للصبر آثارًا جمّة؛ لذا نرى العقلاء في طول المسيرة البشريّة -ومهما كانت توجّهاتهم الذكريّة والدينيّة- يمدحون هذه الصفة والمتحلّين بها ويحثّون عليها.
فالصبر أحد أهمّ مقوّيات الإرادة والعزم، ويعين الإنسان على ترويض نفسه في عمليّة بنائها وتكاملها؛ لذا فهو مفتاح أبواب السعادات، ووسيلة لرقيّ الإنسان وتطوّره، فالذي يريد المقامات العلميّة لا بدّ له من الصبر؛ لذا ورد أنّه: «من لم يصبر على ذلّ التعلّم ساعة، بقي في ذلّ الجهل إلى قيام الساعة»[1].
والصبر يهوّن الصعاب ويعين الإنسان على تجاوز المحن والمصائب ويهوّنها ويمنح الإنسان القدرة على التماسك وعدم السقوط والتزلزل والاضطراب بحيث يستطيع امتلاك القدرة على الفعل والمواجهة، والصبر كذلك يصون حرّيّة الإنسان وعزّته، فبالصبر عن المعصية لا تستذلّه الأهواء والشهوات والمطامع فيلج منه إلى التقوى، وبالصبر على البلايا يترقّى إلى مقامات كالرضا بالقضاء، وبالصبر على الطاعة يمكن أن يجد حلاوة العبادة فيستأنس بها ليرقى بعدها إلى الاستيناس بالمعبود.
وبالصبر على مخاوف المواجهة والحرب تحصل الشجاعة فالإقدام يكون النصر؛ لذا كان: «النصر صبر ساعة»[2].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج1، ص177.
[2] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج2، ص1556.
425
409
الموعظة الحادية والستّون: وبشِّر الصابرين
ثمار الصبر في الدّنيا
إنّ للصبر آثارًا جمّة؛ لذا نرى العقلاء في طول المسيرة البشريّة -ومهما كانت توجّهاتهم الذكريّة والدينيّة- يمدحون هذه الصفة والمتحلّين بها ويحثّون عليها.
فالصبر أحد أهمّ مقوّيات الإرادة والعزم، ويعين الإنسان على ترويض نفسه في عمليّة بنائها وتكاملها؛ لذا فهو مفتاح أبواب السعادات، ووسيلة لرقيّ الإنسان وتطوّره، فالذي يريد المقامات العلميّة لا بدّ له من الصبر؛ لذا ورد أنّه: «من لم يصبر على ذلّ التعلّم ساعة، بقي في ذلّ الجهل إلى قيام الساعة»[1].
والصبر يهوّن الصعاب ويعين الإنسان على تجاوز المحن والمصائب ويهوّنها ويمنح الإنسان القدرة على التماسك وعدم السقوط والتزلزل والاضطراب بحيث يستطيع امتلاك القدرة على الفعل والمواجهة، والصبر كذلك يصون حرّيّة الإنسان وعزّته، فبالصبر عن المعصية لا تستذلّه الأهواء والشهوات والمطامع فيلج منه إلى التقوى، وبالصبر على البلايا يترقّى إلى مقامات كالرضا بالقضاء، وبالصبر على الطاعة يمكن أن يجد حلاوة العبادة فيستأنس بها ليرقى بعدها إلى الاستيناس بالمعبود.
وبالصبر على مخاوف المواجهة والحرب تحصل الشجاعة فالإقدام يكون النصر؛ لذا كان: «النصر صبر ساعة»[2].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج1، ص177.
[2] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج2، ص1556.
425
410
الموعظة الحادية والستّون: وبشِّر الصابرين
ويكفي لمعرفة مقام الصبر وأثره أنّه وسيلة للاصطفاء الإلهيّ، فقد قال -تعالى-: ﴿وَجَعَلنَا مِنهُم أَئِمَّةٗ يَهدُونَ بِأَمرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بَِٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ﴾[1]، فالإمامة منصب يشكّل الصبر أحد أسباب استحقاقها، بل إنّ الصبر وسيلة لاستدرار المدد الغيبيّ: ﴿بَلَىٰ إِن تَصبِرُواْ وَتَتَّقُواْ﴾[2].
وكذلك فإنّ من ثمار الصبر هو المعيّة الإلهيّة: ﴿وَٱصبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾[3].
ثواب الصبر
لقد ورد أنّ ثمّة بابًا من أبواب الجنّة هو باب الصابرين يدخلون منه، ويكفي في ذلك أنّ الصابرين يدخلون الجنّة بلا حساب، فهم مُعفَون من المساءلة والمداقّة في الحساب، وقد قال -تعالى-: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجرَهُم بِغَيرِ حِسَابٖ﴾[4].
بل إنّ ثواب الصابرين هو إعطاؤهم الأجر على أحسن عملهم لا على أقلّه، إذ قال الله: ﴿وَلَنَجزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجرَهُم بِأَحسَنِ مَا كَانُواْ يَعمَلُونَ﴾[5].
وأيضًا من ثمار الصبر المغفرة الإلهيّة والصبر الكبير: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰئِكَ لَهُم مَّغفِرَةٞ وَأَجرٞ كَبِيرٞ﴾[6].
[1] سورة السجدة، الآية 24.
[2] سورة آل عمران، الآية 125.
[3] سورة الأنفال، الآية 46.
[4] سورة الزمر، الآية 10.
[5] سورة النحل، الآية 96.
[6] سورة هود، الآية 11.
426
411
الموعظة الحادية والستّون: وبشِّر الصابرين
وذلك كلّه إضافة إلى الجنّة ونعيمها: ﴿وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةٗ وَحَرِيرٗا﴾[1].
الثناء على الصابرين
إنّ أعظم ثناء يمكن أن يثنى عليه الصّابرون هو ما وعدهم به الله -سبحانه-، إذ قال: ﴿أُوْلَٰئِكَ عَلَيهِم صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِم وَرَحمَةٞ وَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلمُهتَدُونَ﴾[2]، وما وصفهم به من عظيم المنزلة بين يديه، ذلك أنّهم وتد مسيرة هذه الحياة، واستمراريّة ثبات وتقدّم المؤمنين في معترك هذه الحياة التي يملؤها الكثير من المواجهات المختلفة بين جنود الرّحمن وجنود الشيطان.
فليس الصّابرون إلّا مظهر أمل يُزرع في نفوس عامّة النّاس، كي يبقوا على ثبات، لا يتزلزلون عند البلااءات والمصاعب.
[1] سورة الإنسان، الآية 12.
[2] سورة البقرة، الآية 157.
427
412
الموعظة الثانية والستّون: عزّة النّفس
الموعظة الثانية والستّون: عزّة النّفس
تعرّف مكانة النّفس الإنسانيّة، وموارد عزّتها وصونها.
محاور الموعظة
كرامة الإنسان عند الله
عزّة النّفس
من مصاديق عزّة النفس
تصدير الموعظة
﴿وَلِلَّهِ ٱلعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلمُؤمِنِينَ﴾.[1]
[1] سورة المنافقون، الآية 8.
428
413
الموعظة الثانية والستّون: عزّة النّفس
الموعظة الثانية والستّون: عزّة النّفس
تعرّف مكانة النّفس الإنسانيّة، وموارد عزّتها وصونها.
محاور الموعظة
كرامة الإنسان عند الله
عزّة النّفس
من مصاديق عزّة النفس
تصدير الموعظة
﴿وَلِلَّهِ ٱلعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلمُؤمِنِينَ﴾.[1]
[1] سورة المنافقون، الآية 8.
428
414
الموعظة الثانية والستّون: عزّة النّفس
كرامة الإنسان عند الله
إنّ للإنسان كرامة عظيمة حفظها له الباري -سبحانه وتعالى-، بأن جعلها مقرونة بعزّة الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)، إذ قال: ﴿وَلِلَّهِ ٱلعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلمُؤمِنِينَ﴾[1]، وقال أيضًا: ﴿وَلَقَد كَرَّمنَا بَنِي ءَادَمَ﴾[2].
وإنّ كرامته إنّما منبثقة من أنّه المخلوق المدرك الذي حمّله الله -تعالى- أمانته الكبرى، حين أشفق منها غيره من المخلوقات، وهذا ما يعطيه مقامًا ومكانة عنده -سبحانه-.
وليست الأحكام والإرشادات التي وضعها الله -عزّ وجلّ-، في ما يتعلّق بحرمة الإنسان، وحرمة قتله، وحرمة أذيّته وإخافته وذلّته، إلّا تأكيدًا على هذا المعنى، وأنّ للنّفس الإنسانيّة كرامة ومقامًا.
من هنا، فإنّ الإنسان موكول بحفظ هذه النّفس، من كلّ ما يخرجها عن موضعها اللائق بها، فيُحرم عليه أن يقحمها في المهلكات، سواء أكانت الجسديّة منها أم المعنويّة.
عزّة النّفس
من أبرز ما ينبغي على الإنسان أن يتنبّه إليه في التعامل مع نفسه، هو أن لا يقحمها في ما يعرضها للذلّة والمهانة، وإلى هذا تشير بعض الأحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام)، والتي أشارت إلى أنّ كرامة النّفس الإنسانيّة أعزّ عند الله من الكعبة المشرّفة، كما عن
[1] سورة المنافقون، الآية 8.
[2] سورة الإسراء، الآية 70.
429
415
الموعظة الثانية والستّون: عزّة النّفس
الإمام الصادق (عليه السلام): «المؤمن أعظم حرمةً من الكعبة»[1]، وعن الإمام الباقر(عليه السلام): «إنّ الله -عزّ وجلّ- أعطى المؤمن ثلاث خِصال: العزّ في الدّنيا في دينه، والفلَج (الظفر والفلاح) في الآخرة، والمهابة في صدور العالمين»[2].
إذا كان الأمر كذلك، فلا بدّ من التحرز من الوقوع في الأمور التي تجعله ذليلًا، بل لا بدّ من أن ينتفض وينهض في وجه كلّ من يريد إذلاله وإهانته، كمن يعيش تحت رهن الظالمين، وهم يغتصبون حقوقه وأمواله وأملاكه، ويعتدون عليه، وغير ذلك من مظاهر الذلّ الذي تنفر منه النفوس الكريمة.
من مصاديق عزّة النفس
ثمّة الكثير من الأمور التي تدلّ على عزّة نفس الإنسان وغناها، ومن ذلك:
1. عفّتها عن الأمور الدنيئة: عن الإمام عليّ (عليه السلام): « وأكرم نفسك عن كلّ دنية، وإن ساقتك إلى الرغائب، فإنّك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضًا»[3].
2. اليأس ممّا في أيدي الناس: عن الإمام الباقر (عليه السلام): «اليأس ممّا في أيدي الناس عزّ المؤمن في دينه، أوما سمعت قول حاتم:
إِذَا مَا عَزَمْتَ الْيَأْسَ أَلْفَيْتَه الْغِنَى
إِذَا عَرَّفْتَه النَّفْسَ والطَّمَعُ الْفَقْرُ»[4].
[1] الشيخ الصدوق، الخصال، ص27.
[2] المصدر نفسه، ص139.
[3] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص401.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص149.
430
416
الموعظة الثانية والستّون: عزّة النّفس
3. الطلب بكرامة: عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «اطلبوا الحوائج بعزّة الأنفس»[1].
يوضّح الإمام عليّ (عليه السلام) هذا المعنى، كما عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم، فيكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك، يكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزّك»[2].
ومن الرّوايات الدالّة على أهمّيّة عزة النّفس لدى أهل البيت (عليهم السلام)، أنّ أحدهم دخل على الإمام الصادق (عليه السلام) يشكو إليه حاله، فأمر الإمام (عليه السلام) بأن يؤتى له بكيس فيه مال، فأعطاه للرّجل، وقال له: «هذا كيس فيه أربعمئة دينار، فاستعن به»، فقال الرّجل: والله، جُعِلت فداك! ما أردت هذا، ولكن أردت الدعاء لي، فقال (عليه السلام): «ولا أدع الدعاء، ولكن لا تخبر الناس بكل ما أنت فيه فتهون عليهم»[3].
4. عدم الرضوخ للأعداء: عن الإمام عليّ (عليه السلام): «فالموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين»[4].
5. إكرام الآخرين: عن الإمام عليّ (عليه السلام): «إن مكرمة صنعتها إلى أحد من الناس، إنّما أكرمتَ بها نفسَك وزيَّنت بها عِرْضَك، فلا تطلب من غيرِك شُكْرَ ما صَنعتَ إلى نفسك»[5].
[1] المتّقيّ الهنديّ، كنز العمّال، ج6، ص518.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص149.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج47، ص35.
[4] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص88.
[5] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص154.
431
417
الموعظة الثالثة والستّون: حِفْظ الإنسان بِصَوْن اللِسان
الموعظة الثالثة والستّون: حِفْظ الإنسان بِصَوْن اللِسان
تعرّف قيمة اللِسان، ودورِه في صَوْنِ الإنسانِ أو ضَياعه وانحرافه، والميزان الصحيح بين السُكوت والكلام.
محاور الموعظة
اللِسان؛ قيمته وخَطَره
اللِسان والإيمان
آفات اللِسان
عذاب اللِسان
كيف نستفيد مِن اللِسان؟
أيُّهما أفضل: الكلام أم الصَمت؟
تصدير الموعظة
أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنَّ أكثر خَطايا ابْنِ آدم في لِسانه»[1].
[1] المتّقيّ الهنديّ، كنز العمّال، ج3، ص556.
432
418
الموعظة الثالثة والستّون: حِفْظ الإنسان بِصَوْن اللِسان
اللِسان؛ قيمَته وخَطَره
اللِسان مَظهر إبداع الخِلْقة وعجيب الصنعة، فقد قالَ الإمام عليّ (عليه السلام): «اعْجَبوا لِهذا الإِنْسان، يَنْظُرُ بِشَحْمٍ، وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خرْمٍ»[1]. وهو المُعَبِّرُ الحاكي، والمُتَرْجِمُ الراوي لِخَلَجاتِ النفْس وما يجول في الفِكْر، وهو جالِبُ المحبّة، وباعثُ الفِتنة، ومِن أعظم الجوارح فِعْلًا وتَأثيرًا.
جِراحاتُ السِنانِ لها الْتِئامٌ
ولا يَلْتامُ ما جَرَحَ اللِسانُ
سَأَل سائلٌ رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: يا رسول الله، أَوْصِني. فقال (صلى الله عليه وآله): «احْفَظْ لِسانَك. وَيْحكَ! وهَل يُكَبُّ الناس على مَناخِرهم في النار إلّا حَصائِد ألسِنَتِهم»[2].
وعن الإمام عليّ بن الحسين (عليهما السلام): «إنّ لِسان ابْنِ آدم يُشْرِف كلّ يومٍ على جوارحه، كلَّ صَباح، فيقول: كيف أصبَحْتُم؟ فيقولون: بِخَيرٍ إنْ تركْتَنا. ويقولون: الله الله فينا. ويُناشدونَه، ويقولون: إنّما نُثاب ونُعاقَب بِك»[3].
وعن الإمام عليّ (عليه السلام): «اللِسان سَبُعٌ إنْ خُلِّيَ عنه عَقَر»[4].
ومِثله أيضًا ما رُوِيَ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «كَمْ مِن دَمٍ سَفَكَهُ فَم!»[5].
[1] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص470.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص115.
[3] المصدر نفسه، ج2، ص115.
[4] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص478.
[5] الآمديّ، غرر الحكم، 4158، ص512.
433
419
الموعظة الثالثة والستّون: حِفْظ الإنسان بِصَوْن اللِسان
اللِسان والإيمان
لا شكَّ في أنّ الإيمان الحقيقيّ مَوطنه القلب، واللِسان ترجمان هذا القلب، فما يظهر على اللِسان، غالبًا ما يكون تَجَلِّيًا لِما يُضمَر في القلب؛ رُوِيَ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا يَستقيم إيمان عبدٍ حتّى يَستقيم قلبُه. ولا يستقيم قلبه حتّى يستقيم لسانه. فَمَن استطاع مِنكم أن يَلقى الله -سبحانه- وهو نَقيُّ الراحة مِن دِماء المسلمين وأموالهم، سليم اللِسان مِن أعراضهم، فَلْيَفْعَل»[1].
وقال الشاعر:
إنّ الكـلامَ لَـفـي الـفـؤاد وإنـّمـا
جـُعـل اللِسانُ على الـفـؤاد دليلا
آفات اللِسان
اللِسان جارحةٌ لها الصَدارة في الخُطورة بين الجوارح، تَعتَريها الكثير مِن الآفات والموبقات الواجب اجتنابها والحَذر مِنها، مِنها:
1. الخَوْض في الباطل
يقول المولى الكريم -حِكايةً عن بعضِ أهل النار-: ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلخَائِضِينَ﴾[2]؛ والمُراد منه الدخول في أيّ حديثٍ وأيّ كلام بِلا حساب ولا تَدَبُّر ولا وعي. وقد وَرَدَ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله): «أعظم الناس خَطايا يوم القيامة أكثرُهم خَوْضًا في الباطل»[3].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج68، ص292.
[2] سورة المدّثّر، الآية 45.
[3] المتّقيّ الهنديّ، كنز العمّال، ج3، ص566، ح7932.
434
420
الموعظة الثالثة والستّون: حِفْظ الإنسان بِصَوْن اللِسان
2. المِراء والمجادلة
وَرَدَ في الحديث عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): «لا يَستكمِل عبدٌ حقيقةَ الإيمان حتّى يَدَعَ المِراء، وإنْ كان مُحقًّا»[1].
3. الفُحش والسبّ واللعن
عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله): «لَيْس المؤمن بالطعَّان، ولا اللعّان، ولا الفاحش، ولا البذيء»[2].
وعنه (صلى الله عليه وآله): «إنّ مِن شِرار عِباد الله مَن تَكْرَه مُجالسته لِفُحْشِه»[3].
4. السُخرية والاستهزاء
قال الله -تعالى-: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسخَر قَومٞ مِّن قَومٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيرٗا مِّنهُم وَلَا نِسَاءٞ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيرٗا مِّنهُنَّ﴾[4].
5. إفشاء السرّ
السرّ مِن أعظم الأمانات، وإفشاؤه خِيانة، والله لا يحبّ الخائنين؛ وَرَد في الحديث النبويّ أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لِأبي ذرّ (رضوان الله عليه): «يـا أبـا ذرّ، المجـالِس بِالأمـانَة، وإفشَـاءُ سِرِّ أَخيكَ خِيـانَة»[5].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج2، ص138.
[2] الهيثميّ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج1، ص97.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج22، ص131.
[4] سورة الحجرات، الآية 11.
[5] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج12، ص307.
435
421
الموعظة الثالثة والستّون: حِفْظ الإنسان بِصَوْن اللِسان
6. الكذب
مِن أعظم الخطايا، فقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أعظمُ الخطايا اللِسانُ الكَذوب»[1].
7. الغيبة
وَرَدَ النهْيُ الصريح عنها في القرآن الكريم بِقَوله -تعالى-: ﴿وَلَا يَغتَب بَّعضُكُم بَعضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأكُلَ لَحمَ أَخِيهِ مَيتٗا فَكَرِهتُمُوهُ﴾[2]. ورُوِيَ عن الإمام الصادق (عليه السلام): «مَن رَوى على مؤمن رِوايةً يُريد بها شَيْنَه وهَدْمَ مُروءته، لِيَسقط عن أعين الناس، أخرَجَه الله مِن ولايته إلى ولاية الشَيطان، فلا يَقْبله الشَيطان»[3].
عذاب اللِسان
رُوِيَ عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يُعذِّب الله اللِسان بِعَذابٍ لا يُعذِّب به شيئًا مِن الجوارح، فيقول: أيْ رَبِّ، عذَّبْتَني بِعذابٍ لم تُعذِّب به شيئًا، فيُقال له: خَرَجَتْ مِنك كلمة فَبَلَغَتْ مشارق الأرضِ ومغاربها، فَسُفِكَ بها الدمُ الحرام، وانتُهِبَ بها المالُ الحرام، وانتُهِكَ بها الفَرج الحرام. وعِزَّتي وجَلالي، لَأُعَذِّبنَّك بِعَذابٍ لا أُعذِّبُ به شيئًا مِن جوارحك»[4].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج74، ص135.
[2] سورة الحجرات، الآية 12.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص358.
[4] المصدر نفسه، ج2، ص115.
436
422
الموعظة الثالثة والستّون: حِفْظ الإنسان بِصَوْن اللِسان
كيف نستفيد مِن اللسان؟
تَجِبُ العَودة إلى تَوجيهات النبيّ (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) في كيفيّة الاستفادة مِن اللِسان، فقد وَرَدَ عنهم:
1. قَوْل الخير دائمًا
يقول -تعالى- في ذلك: ﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحسَنُ﴾[1].
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «مَن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر، فَلْيَقُلْ خيرًا أو لِيَسْكت»[2].
2. ذِكْر الله
فاللِسان آلةُ ذِكْر الله. وقد وَرَد الأمر في الذِكر الحكيم، إذ قال -تعالى-: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكرٗا كَثِيرٗا﴾[3].
3. التفَكُّر قبل الكلام
وَرَد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة: «وَإِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ، وَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَدَبَّرَهُ فِي نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا أَبْدَاهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا وَارَاهُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمُ بِمَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ، لَا يَدْرِي مَا ذَا لَهُ وَمَا ذَا عَلَيْه»[4].
[1] سورة الإسراء، الآية 53.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص667.
[3] سورة الأحزاب، الآية 41.
[4] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص253.
437
423
الموعظة الثالثة والستّون: حِفْظ الإنسان بِصَوْن اللِسان
كيف نستفيد مِن اللسان؟
تَجِبُ العَودة إلى تَوجيهات النبيّ (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) في كيفيّة الاستفادة مِن اللِسان، فقد وَرَدَ عنهم:
1. قَوْل الخير دائمًا
يقول -تعالى- في ذلك: ﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحسَنُ﴾[1].
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «مَن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر، فَلْيَقُلْ خيرًا أو لِيَسْكت»[2].
2. ذِكْر الله
فاللِسان آلةُ ذِكْر الله. وقد وَرَد الأمر في الذِكر الحكيم، إذ قال -تعالى-: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكرٗا كَثِيرٗا﴾[3].
3. التفَكُّر قبل الكلام
وَرَد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة: «وَإِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ، وَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَدَبَّرَهُ فِي نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا أَبْدَاهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا وَارَاهُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمُ بِمَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ، لَا يَدْرِي مَا ذَا لَهُ وَمَا ذَا عَلَيْه»[4].
[1] سورة الإسراء، الآية 53.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص667.
[3] سورة الأحزاب، الآية 41.
[4] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص253.
437
424
الموعظة الثالثة والستّون: حِفْظ الإنسان بِصَوْن اللِسان
4. الصَمت والسُكوت
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «مَن صَمَتَ، نَجا»[1].
وعنه (صلى الله عليه وآله): «الصَمت عِبادةٌ لِمَن ذَكَر الله»[2].
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «واجعلوا اللِسان واحدًا، وليَخْزن الرجل لسانه، فإنّ هذا اللِسان جَموح بِصاحبه. والله، ما أرى عبدًا يتّقي تقوًى تَنْفعه، حتّى يَخْتَزِن لِسانَه»[3].
وعن النبيِّ الأعظم (صلى الله عليه وآله): «إنّ أولياء الله سَكتوا فَكان سُكوتهم ذِكْرًا، ونَظَروا فَكان نَظَرهم عِبْرة، ونَطَقوا فَكان نُطْقهم حِكمة»[4].
وعن الإمام عليّ (عليه السلام): «إنَّ لله عبادًا كَسَرَتْ قلوبَهم خشيةُ الله، فأسْكَتَتْهُم عن النُطق، وإنّهم لَفُصَحاء عُقَلاء، يستبِقون إلى الله بِالأعمال الزكيّة...»[5].
أيُّهما أفضل: الكلام أم الصَمت؟
رُوِيَ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله): «السُكوت خير مِن إملاء الشرّ، وإملاء الخير خيرٌ مِن السُكوت»[6].
وسُئِل الإمام زين العابدين (عليه السلام) عن الكلام والسُكوت؛ أيُّهما أفضل؟ فقال (عليه السلام): «لكلِّ واحدٍ مِنهما آفات، فإذا سَلِما مِن الآفات،
[1] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج12، ص251.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج68، ص294.
[3] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص253.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص237.
[5] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج12، ص199.
[6] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج68، ص294.
438
425
الموعظة الثالثة والستّون: حِفْظ الإنسان بِصَوْن اللِسان
فالكلام أفضل مِن السُكوت». قيل: كيف ذلك يابْنَ رسول الله؟ قال (عليه السلام): «لأنَّ الله -عزَّ وجلَّ- ما بَعَثَ الأنبياء والأوصياء بالسُكوت، إنَّما بعثهم بِالكلام، ولا استُحِقَّت الجنّة بالسُكوت، ولا استُوجِبَتْ ولاية الله بالسُكوت، ولا تُوُقِّيَت النار بالسُكوت؛ إنّما ذلك كلّه بِالكلام»[1].
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ألا وإنَّ اللِسان الصالح يَجعله الله لِلمرء، خيرٌ له مِن المال، يورِثه مَن لا يَحمده»[2].
وعن الإمام عليّ بن الحسين (عليه السلام) في رسالة الحقوق: «وأمّا حقّ اللِسان فإكرامه عن الخَنى[3]، وتَعْويدهُ الخَيْرَ، وحَملُهُ على الأدب، وإِجْمامُهُ[4] إلّا لِمَوْضع الحاجة والمنفعة للدين والدُنيا، وإعفاؤه عن الفضول الشَنِعَةِ[5] القليلة الفائدة، التي لا يُؤمَن ضررها مع قِلّة عائدتها. ويعدّ شاهد العقل والدليل عليه، وتزَيُّنُ العاقل بِعَقله، (و) حُسْنُ سيرته في لسانه، ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم»[6].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج68، ص274.
[2] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص177.
[3] الخنى: الفحش في الكلام.
[4] الإجمام: الإراحة.
[5] الشنعة: القبيح.
[6] رسالة الحقوق للإمام زين العابدين. راجع: العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج71، ص11.
439
426
الموعظة الرابعة والستّون: الصِدْقُ مَنْجاة
الموعظة الرابعة والستّون: الصِدْقُ مَنْجاة
تعرّف قيمة الصِدق وأَثَرِه في تحصين الفَرْد والمجتمع.
محاور الموعظة
قيمة الصِدق وأهمّيّته
مِن آثار الصِدْق
الصِدق عَمَل الجنّة
تأثير الصِدق في حَياة الإنسان
بالصدق يَصلح السلوك
تصدير الموعظة
أمير المؤمنين (عليه السلام): «الصِدقُ صَلاحُ كُلِّ شَيء، والكَذِبُ فَسـادُ كُلِّ شَيء»[1].
[1] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص44.
440
427
الموعظة الرابعة والستّون: الصِدْقُ مَنْجاة
قيمة الصِدق وأهمّيّته
مُفردة الصِدق مُتّفَقٌ على حُسْنِها ومَدْحها وأهمّيّتها في المجتمعات البشريّة كلّها، فَهو زينة الحديث، ورمز الاستقامة والصَلاح، وسببُ النجاح والنجاة. وقد وَرَدَتْ آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدّث عن أهمّيّة الصِدق وقيمته ودَورِه في تحصين الشخصيّة، مُضافًا إلى ما وَرَدَ في الأحاديث عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام)، والذي يُعدّ الصِدق «رأس الإيمان[1]، ودعامة الإيمان[2]، ولِباس الدين[3]»، و«روح الكلام»[4]، و«فيه صلاح كلّ شيء». وقد كرَّم أهلُ البيت (عليهم السلام) هذا الخُلُق الرفيع.
قال -تعالى-: ﴿قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَومُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدقُهُم لَهُم جَنَّٰتٞ تَجرِي مِن تَحتِهَا ٱلأَنهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدٗا رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنهُم وَرَضُواْ عَنهُ ذَٰلِكَ ٱلفَوزُ ٱلعَظِيمُ﴾[5].
فَبَعد أن تَذْكر الآية ظاهرةَ انحراف النصارى عن دائرة التوحيد، وسؤال الله -تعالى- المسيح يوم القيامة عن سَبَبِ هذا الانحرافِ، وتبرئة المسيح لِنفْسه مِن هذه التُهْمة، تقول الآية: ﴿قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَومُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدقُهُم﴾، وتُبيِّن ما يترتَّب مِن نتائج إيجابيّة وثواب عظيمٍ لِهؤلاء الصادقين، فتقول: ﴿لَهُم جَنَّٰتٞ تَجرِي مِن تَحتِهَا ٱلأَنهَٰرُ﴾.
[1] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص60.
[2] المصدر نفسه، ص22.
[3] المصدر نفسه، ص26.
[4] المصدر نفسه، ص18.
[5] سورة المائدة، الآية 119.
441
428
الموعظة الرابعة والستّون: الصِدْقُ مَنْجاة
ويُخاطِب الله المؤمنين جميعهم مِن موقع الأمر بِتَقْوى الله -تعالى- الذي يَقْترن بالصِدق، فَيَقول: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾[1].
كما يُبشِّر الله طَوائف عدّة بالمغفرة والثواب الجزيل، والطائفة الرابعة الصادقون والصادِقات، فيقول -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلمُسلِمِينَ وَٱلمُسلِمَٰتِ وَٱلمُؤمِنِينَ وَٱلمُؤمِنَٰتِ وَٱلقَٰنِتِينَ وَٱلقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلخَٰشِعِينَ وَٱلخَٰشِعَٰتِ وَٱلمُتَصَدِّقِينَ وَٱلمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰئِمِينَ وَٱلصَّٰئِمَٰتِ وَٱلحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُم وَٱلحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغفِرَةٗ وَأَجرًا عَظِيمٗا﴾[2].
ووَرَد في الحديث الشريف عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) -في بيان أهمّيّة الصِدق- قوله: «لا تَنظُروا إلى كَثْرَةِ صَلاتِهِم وَصَومِهِم، وَكَثْرَةِ الحَجِّ وَالمَعرُوفِ، وَطَنطَنَتِهِم بِالليلِ، وَلَكِن انظُروا إِلى صِدقِ الحَديثِ وَأَداءِ الأَمانةِ»[3].
وعن الإمام الصادق (عليه السلام): «إِنّ اللهَ -عزّ وجلّ- لَم يَبعَثْ نَبيًّا إلّا بِصِدقِ الحَديثِ وَأَداءِ الأمـانةِ إِلى البرِّ والفـاجِرِ»[4].
[1] سورة التوبة، الآية 119.
[2] سورة الأحزاب، الآية 35.
[3] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص303. العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج68، ص9.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص104.
442
429
الموعظة الرابعة والستّون: الصِدْقُ مَنْجاة
مِن آثار الصِدْق
1. نَماء العمل
وَرَدَ عن الإمام الصادق (عليه السلام) في تأثير الصِدق في أعمال الإنسان وسلوكيّاته جميعها قوله: «مَن صَدَقَ لِسانُهُ، زَكا عَمَلُهُ»[1]؛ لأنّ الصِدق يُمثِّل الجَذْر والأساس للأعمال الصالحة جميعها.
2. القُرب مِن الصالحين
في حديث آخر عن الإمام الصادق (عليه السلام) في كتابه إلى أَحَدِ أصحابه -ويُدعى عبد الله بن أبي يعفور- قال: «انْظُرْ مَا بَلَغَ بِهِ عَلِيٌّ (عليه السلام) عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ (صلى الله عليه وآله)، فَالْزَمْهُ، فَإِنَّ عَلِيًّا (عليه السلام) إِنَّما بَلَغَ ما بَلَغَ بِهِ عِنْدَ رَسولِ اللّهِ (صلى الله عليه وآله) بِصِدْقِ الحَديثِ وَأَداءِ الأَمانَة»[2].
3. النجاة
وَرَد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حديثٌ يتحدّث فيه عن تأثيرِ الصِدق في نجاة الإنسان مِن الأخطار والمشكلات، يقول فيه: «الْزَموا الصِدق، فَإنّه مَنْجاة»[3].
4. حِفْظ الدين
عن أهمّيّة الصِدق، يَكفي أن نذكر الحديث الشريف الوارد عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، إذ يقول: «الصِدقُ رَأسُ الدِينِ»[4]؛ فالحفاظ على الدين يَكون عن طريق الصِدق.
[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج 2، ص 104.
[2] المصدر نفسه.
[3] الشيخ ابن شعبة الحرانيّ، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص104.
[4] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص25.
443
430
الموعظة الرابعة والستّون: الصِدْقُ مَنْجاة
ويقول في حديثٍ آخر: «الصِدقُ صَلاحُ كُلِّ شَيء»[1]، و«الصِدقُ أَقوى دَعـائِمِ الإيمـانِ»[2]، و«الصِدقُ جَمـالُ الإنسـانِ ودعـامَةُ الإيمـانِ»[3].
ويُضيف (عليه السلام) إلى ذلك تعبيرًا مُهمًّا عن الصدق، فيقول: «الصِدقُ أَشرَفُ خَلائِقِ الموقنِ»[4].
الصِدق عَمَل الجنّة
وَرَد حديثٌ شريف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتحدّث فيه عن مِفتاح الجنّة والنار، إذ جاء إليه رَجُلٌ، فَقـالَ: يـا رَسولَ اللهِ، مـا عَمَلُ الجَنَّة؟ قـالَ (صلى الله عليه وآله): «الصِدقُ؛ إِذا صَدَقَ العَبدُ بَرَّ، وإذا بَرَّ آمَنَ، وإذا آمَنَ دَخَلَ الجَنَّةَ». قالَ: يـا رَسولَ اللهِ، وَمـا عَمَلُ النارِ؟ قالَ (صلى الله عليه وآله): «الكذبُ؛ إِذا كَذَبَ العَبدُ فَجَرَ، وَإِذا فَجَرَ كَفَرَ، وإِذا كَفَرَ دَخَلَ النارَ»[5].
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطيهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدنْيا وَالآخِرَةِ: صِدْقُ حَديثٍ، وَأَداءُ أَمانَةٍ، وَعِفَّةُ بَطْنٍ، وَحُسْنُ خُلُق»[6].
تأثير الصِدق في حَياة الإنسان
1. الكذّاب كالميّت
عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «الكَذّابُ والمَيِّتُ سَواءٌ؛ فإنَّ فَضيلَةَ الحَيِّ عَلى المَيِّتِ الثِقَةُ بِهِ، فَإذا لَمْ يوثَقُ بَكلامِهِ، فَقَد بَطلَتْ حَيـاتُهُ»[7].
[1] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص44.
[2] التميميّ الآمديّ، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص218.
[3] المصدر نفسه.
[4] المصدر نفسه، ص217.
[5] ورّام بن أبي فراس، تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام، ج1، ص43.
[6] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص74.
[7] التميميّ الآمديّ، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص220.
444
431
الموعظة الرابعة والستّون: الصِدْقُ مَنْجاة
2. جلالة القَدْر
الصِدق يَهَبُ صاحبَه شخصيّة اجتماعيّة مرموقة، فالإنسان الصادق يعيش حياة العِزّة والكرامة دائمًا، أمّا الكاذب فَيعيش حالة الدَناءة والحَقارة والانتهازيّة؛ لذا وَرَد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله: «عَلَيكَ بِالصِدقِ، فَمَنْ صَدَقَ في أَقوالهِ جَلَّ قَدْرُهُ»[1].
3. المحبّة والثِقة
الصِدق يُوطِّد أركان المحبّة، ويُعمّق وشائِج المودّة بين أفراد المجتمع، وبِذلك يُفضي على شخصيّة هؤلاء الأفراد نورًا وبهاءً أكثر؛ وَرَد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله: «يَكتَسِبُ الصادِقُ بِصِدقِهِ ثَلاثًا: حُسن الثِقَةِ بِهِ، والمَحَبَّة لَهُ، وَالمَهـابَة مِنهُ»[2].
بالصدق يَصلح السلوك
وَرَدَ في الحديث الشريف عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) أنّه جاءَ رجلٌ إليه، فقال: أنا -يا رسول الله- أستسِرّ بِخِلالٍ أربع: الزِنا، وشرب الخمر، والسرقة، والكذب، فأيّتهنّ شِئْتَ تَرَكْتُها لك. فقال (صلى الله عليه وآله): «دَعِ الكَذِب»[3]. فلمّا ولّى هَمّ بالزِنا، فقال: يَسألني، فإنْ جَحَدْتُ نَقَضْتُ ما جَعَلْتُ له، وإنْ أَقْرَرْتُ حُدِدْت. ثمّ هَمَّ بِالسرقة، ثمّ بِشُرب الخَمر، ففكّر في مِثل ذلك، فَرجع إليه، فقال: قد أخذْتَ عَليَّ السبيل كلّه، فقد تَرَكْتُهُنّ أجمع[3].
[1] الشيخ الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص333.
[2] التميميّ الآمديّ، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص219.
[3] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج6، ص357.
445
432
الموعظة الخامسة والستّون: الحياء خُلق الإسلام
الموعظة الخامسة والستّون: الحياء خُلق الإسلام
بيان دور الحياء في تربية الإنسان في علاقته بربّه وبالناس.
محاور الموعظة
الحياء من الإيمان
إذا ذهب الحياء ذهب الإيمان
الحياء عاصم من العيب
مواطن لا حياء فيها
حياء أمير المؤمنين وبالغ زهده
تصدير الموعظة
رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنَّ لِكُلِّ دين خُلُقًا، وإنَّ خُلُق الإسلام الحياء»[1].
[1] الشيخ الطبرسيّ، مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، ص234.
446
433
الموعظة الخامسة والستّون: الحياء خُلق الإسلام
من صفات المسلم الحريص على طاعة ربِّه «الحياء»، فإنَّهُ خَيْرٌ كلُّه، كما ورد في النصوص الشريفة، فينضبط المتديِّن في قوله وفعله وشكله ضمن الموازين الشرعيّة والأعراف المحمودة السائدة، وذلك بترك ما يُخجل منه. روي عن الإمام عليّ (عليه السلام)، قال: «وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يُعْمَلُ بِهِ فِي السِّرِّ، وَيُسْتَحَى مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ»[1].
الحياء من الإيمان
لا ننسى أنَّ ربَّنا سبحانه حَييٌّ، ونبيَّنا كان كثير الحياء موصوفًا بهذه الصفة حَتَّى أنَّهُ اشتُهر بها، رُوي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الحياء من الإيمان، والإيمان من الجنَّة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار»[2].
و«إنَّ لِكُلِّ دين خُلُقًا، وإنَّ خُلُق الإسلام الحياء»[3].
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «مَنْ كساه الحياء ثوبه خفي على النَّاس عيبه»[4].
وكتب الإمام الصادق (عليه السلام) إلى أصحابه: «وعليكم بالحياء والتنزُّه عمَّا تنزَّه عنه الصالحون قبلكم»[5].
إذا ذهب الحياء ذهب الإيمان
روي عن علي (عليه السلام)، قوله: «لَا إِيمَانَ كَالْحَيَاءِ وَالصَّبْرِ»[6].
[1] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص459.
[2] الشيخ ابن شعبة الحرّانيّ، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص394.
[3] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج8، ص465.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج8، ص23.
[5] المصدر نفسه، ص2.
[6] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص488.
447
434
الموعظة الخامسة والستّون: الحياء خُلق الإسلام
ورُوي عن مولانا رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الحياء هو الدِّين كلُّه»[1].
وعن الإمام الباقر (عليه السلام)، قال: «الحياء والإيمان مقرونان في قرن، فإذا ذهب أحدهما تَبِعَهُ صاحبه»[2].
وعن الإمام الصَّادق (عليه السلام): «لا إيمان لِمَنْ لا حياء له»[3].
يقول الشيخ الأنصاري الذِي أوصى الإمام الخميني بقراءة كتابه (منازل السائرين): «قال الله -تعالى-: ﴿أَلَم يَعلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ﴾[4].
في الآية إشعار بأنَّ الحياء ينشأ من الإيمان، وأنَّ الله يرى عبده «فإنْ لم تكن تراه فإنَّهُ يراك».
الحياء عاصم من العيب
روي عن علي (عليه السلام) قوله: «مَنْ كَسَاهُ الْحَيَاءُ ثَوْبَهُ لَمْ يَرَ النَّاسُ عَيْبَهُ»[5].
وعنه(عليه السلام): «مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطَؤُهُ، وَمَنْ كَثُرَ خَطَؤُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ، وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ»[6].
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما كان الفُحْش في شيءٍ قط إلاَّ شانه، ولا كان الحياء في شيءٍ قط إلاَّ زانه»[7].
[1] المتّقي الهنديّ، كنز العمال، ج3، ص119.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص106.
[3] المصدر نفسه، ص106.
[4] سورة العلق، الآية 14.
[5] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص508.
[6] المصدر نفسه، ص536.
[7] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج68، ص334.
448
435
الموعظة الخامسة والستّون: الحياء خُلق الإسلام
وعنه (صلى الله عليه وآله): «إنَّ الله يُحبُّ الحيِيَّ المتعفِّف، ويُبْغض البذيء السائل المُلْحف»[1].
مواطن لا حياء فيها
1. التعلّم: عن الإمام علي (عليه السلام): «وَلَا يَسْتَحِيَنَّ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ»[2].
فالجهل مُردٍ، ومفتاح العلم المسألة والتعلّم، وما التخبّط والضلال إلا بترك العلم والمعرفة، والإنسان لم يولد عالمًا، فحياؤه بقاؤه جاهلًا «مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ»[3]. فلا بدّ له من رفع نقيصته، وبلوغه كماله من التزوّد بما يرفع ذلك ويرقيه إلى ما يليق به.
2. القول بغير علم: عن الإمام علي (عليه السلام): «وَلَا يَسْتَحِيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ»[4].
و«مَنْ تَرَكَ قَوْلَ (لَا أَدْرِي) أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ»[5].
3. إعطاء القليل: عن الإمام علي (عليه السلام): «لَا تَسْتَحِ مِنْ إِعْطَاءِ الْقَلِيلِ، فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلُّ مِنْهُ».
4. مواطن تحصيل الخير: عن الإمام علي (عليه السلام): «قُرِنَتِ الْهَيْبَةُ بِالْخَيْبَةِ، وَالْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانِ»[6].
[1] الشيخ الطوسيّ، الأمالي، ص39.
[2] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص483.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص106.
[4] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص482.
[5] المصدر نفسه.
[6] المصدر نفسه، ص471.
449
436
الموعظة الخامسة والستّون: الحياء خُلق الإسلام
5. وممّا يستحى منه: الفرار من الزحف: عن الإمام علي (عليه السلام): «وَاسْتَحْيُوا مِنَ الْفَرِّ فَإِنَّهُ عَارٌ فِي الْأَعْقَابِ، وَنَارٌ يَوْمَ الْحِسَابِ»[1].
حياء أمير المؤمنين وبالغ زهده
ما ورد عنه (عليه السلام) «وَاللَّهِ لَقَدْ رَقَّعْتُ مِدْرَعَتِي[2] هَذِهِ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا، وَلَقَدْ قَالَ لِي قَائِلٌ أَلَا تَنْبِذُهَا عَنْكَ؟ فَقُلْتُ: اغْرُبْ[3] عَنِّي فَعِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى»[4].
[1] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص97.
[2] المِدرعة: ثوب من صوف.
[3] اغْرُبْ: اذهب وأبعد.
[4] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص229.
450
437
الموعظة السادسة والستّون: العفاف وآثاره
الموعظة السادسة والستّون: العفاف وآثاره
زينب (عليها السلام) المخدّرة نموذجًا
بيان مفهوم العفاف، وحثّ المجتمع على التحلّي بهذه الصفة الجليلة.
محاور الموعظة
مفهوم العفّة
عوامل تنمية العفّة
العفّة الزينبيّة نموذجًا
تصدير الموعظة
﴿يَٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ ٱلمُؤمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدنَىٰ أَن يُعرَفنَ فَلَا يُؤذَينَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾[1].
[1] سورة الأحزاب، الآية 59.
451
438
الموعظة السادسة والستّون: العفاف وآثاره
إنّ العفّة تُعدّ واحدة من أمّهات الفضائل الأخلاقيّة الأربع (العفّة، الشجاعة، الحكمة، والعدالة)[1] ، وتبنى عليها الحياة الإنسانيّة والاجتماعيّة، لذا كان لهذه الفضيلة الأخلاقيّة آثار جليلة تنعكس على الشخصيّة الإنسانيّة في الدنيا والآخرة.
مفهوم العفّة
جاء في اللغة عن ابن منظور أنّها «الكفّ عمّا لا يحلّ ويَجمُلُ، عفّ عن المحارم والأطماع الدنيّة يعِفُّ عِفّة وعفَّا وعفافًا فهو عفيف، وعفّ أي كفّ»[2].
أمّا في الاصطلاح: فقد عرّفها النراقيّ، بأنّها «انقياد القوّة الشهويّة للعاقلة فيما تأمرها به وتنهاها عنه حتّى تكتسب الحرّيّة وتتخلّص من أسر عبوديّة الهوى».
وهي من الصفات الممدوحة لدى الناس، وأغلب الأخبار والروايات تُشير إلى عفّة البطن والفرج، وكفّهما عن مشتهياتهما المحرّمة، وهما من أفضل العبادات، وقد ورد عن الإمام أبي جعفر (عليه السلام): «إنّ أفضل العبادة عفّة البطن والفرج»[3].
عوامل تنمية العفّة
1. الزواج: جعِل الزواج وسيلة لتهذيب هذه الشهوة وإشباعها، وقد
[1] انظر: الملّا هادي السبزواريّ، شرح الأسماء الحسنى، ج2، ص81.
[2] ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص253.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص79.
452
439
الموعظة السادسة والستّون: العفاف وآثاره
جُعِلت شهوة الجنس في الإنسان من أجل: حفظ النسل البشريّ واستمراره، ولولا ذلك لما أقدم الإنسان على الزواج، ولما تحمّل العديد من المشاكل والصعوبات المترتّبة على وجود الولد والذرّيّة. ولهذا حثّ الإسلام على الزواج، وإليه أشار القرآن الكريم بقوله -تعالى-: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلأَيَٰمَىٰ مِنكُم وَٱلصَّٰلِحِينَ مِن عِبَادِكُم وَإِمَائِكُم إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضلِهِۦ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ﴾[1]، ويُقصد بالأيامى هنا العزّاب أي من لا أزواج لهم. وقد جاء عن الرسول (صلى الله عليه وآله): «إذا تزوّج العبد فقد استكمل نصف الدِّين فليتقّ الله في النصف الباقي»[2].
2. غضُّ البصر: أولى الله -تعالى- غضّ البصر أهمّيّة خاصّة بغية إرساء قواعد متينة وبناءها لتأسيس مجتمع عفيف، ولهذا نرى أنّه فصّل في الخطاب بين الذكر والأنثى عندما أمر بغضِّ البصر، للدلالة والإشارة إلى أهميّة الغضِّ ولما يتركه من آثار إيجابيّة على بناء النفس والمجتمع. والتكليف موجّه لكلٍّ من الرجل والمرأة على السواء، وقد بدأ توجيه الخطاب إلى الرجال قبل النساء تأكيدًا منه على الدور والمسؤوليّة الواقعة على عاتقهم وكأنّ بناء المجتمع العفيف يبدأ من غضِّ بصر الرجال أوّلًا، يقول -تعالى- في خطابهم ﴿قُل لِّلمُؤمِنِينَ يَغُضُّواْ مِن أَبصَٰرِهِم وَيَحفَظُواْ فُرُوجَهُم ذَٰلِكَ أَزكَىٰ لَهُم
[1] سورة النور، الآية 32.
[2] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج2، ص1179.
453
440
الموعظة السادسة والستّون: العفاف وآثاره
إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا يَصنَعُونَ﴾[1]، ثمّ أردف -تعالى- بعدها مباشرة الخطاب الخاصّ بالنساء مشيرًا إلى الحكم نفسه ومضيفًا إليه أمورًا أخرى تتعلّق بالمرأة: ﴿وَقُل لِّلمُؤمِنَٰتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَٰرِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنهَا وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَو ءَابَائِهِنَّ أَو ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو أَبنَائِهِنَّ أَو أَبنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو إِخوَٰنِهِنَّ أَو بَنِي إِخوَٰنِهِنَّ أَو بَنِي أَخَوَٰتِهِنَّ أَو نِسَائِهِنَّ أَو مَا مَلَكَت أَيمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيرِ أُوْلِي ٱلإِربَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفلِ ٱلَّذِينَ لَم يَظهَرُواْ عَلَىٰ عَورَٰتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضرِبنَ بِأَرجُلِهِنَّ لِيُعلَمَ مَا يُخفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلمُؤمِنُونَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ﴾[2].
اجتناب مثيرات الشهوة
وهي عديدة، نذكر منها:
1. وسائل الإعلام: الّتي تبثّ البرامج غير المحتشمة سواء كانت على شاشة التلفاز أم الإنترنت، وكذا الفضائيّات السامّة التي غزت المنازل والنفوس وعشّشت في القلوب الشابّة كالمسلسلات المدبلجة. فعلى الإنسان اجتناب هذه الوسائل أو تنظيمها بحيث تكون تحت رقابة ممنهجة بغية الاستفادة من البرامج المفيدة منها.
[1] سورة النور، الآية 30.
[2] سورة النور، الآية 31.
454
441
الموعظة السادسة والستّون: العفاف وآثاره
إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا يَصنَعُونَ﴾[1]، ثمّ أردف -تعالى- بعدها مباشرة الخطاب الخاصّ بالنساء مشيرًا إلى الحكم نفسه ومضيفًا إليه أمورًا أخرى تتعلّق بالمرأة: ﴿وَقُل لِّلمُؤمِنَٰتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَٰرِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنهَا وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَو ءَابَائِهِنَّ أَو ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو أَبنَائِهِنَّ أَو أَبنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو إِخوَٰنِهِنَّ أَو بَنِي إِخوَٰنِهِنَّ أَو بَنِي أَخَوَٰتِهِنَّ أَو نِسَائِهِنَّ أَو مَا مَلَكَت أَيمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيرِ أُوْلِي ٱلإِربَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفلِ ٱلَّذِينَ لَم يَظهَرُواْ عَلَىٰ عَورَٰتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضرِبنَ بِأَرجُلِهِنَّ لِيُعلَمَ مَا يُخفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلمُؤمِنُونَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ﴾[2].
اجتناب مثيرات الشهوة
وهي عديدة، نذكر منها:
1. وسائل الإعلام: الّتي تبثّ البرامج غير المحتشمة سواء كانت على شاشة التلفاز أم الإنترنت، وكذا الفضائيّات السامّة التي غزت المنازل والنفوس وعشّشت في القلوب الشابّة كالمسلسلات المدبلجة. فعلى الإنسان اجتناب هذه الوسائل أو تنظيمها بحيث تكون تحت رقابة ممنهجة بغية الاستفادة من البرامج المفيدة منها.
[1] سورة النور، الآية 30.
[2] سورة النور، الآية 31.
454
442
الموعظة السادسة والستّون: العفاف وآثاره
2. التفريق في المضاجع أثناء المبيت: إنّ لهذا الموضوع أثرًا مهمًّا على الحياة الجنسيّة لكلٍّ من الذكر والأنثى، حيث يعتبر ذهن الطفل بمثابة لاقط لكلِّ الصور والمشاهد التي تمرّ عليه في بداية عمره. وقد أمر الشرع المقدّس بالتفريق في المضاجع بين الذكور والإناث لأجل أن ينشؤوا نشأة عفيفة محتشمة بعيدة عن كلّ موجبات الإثارة وتحريك الشهوات الباطنيّة.
3. الأكل المتوازن: من المهمّ الالتفات إلى نوع الأكل الذي يتناوله الإنسان نفسه، وأن يُحاول الالتزام بنظام غذائيّ محدّد ومنظّم، فإنّ بعض الأطعمة من شأنها تهييج القدرة الجنسيّة وتأجيجها فعليه تجنّب هذه الأطعمة ممّا هو مذكور في محلِّه.
4. التقيُّد بالالتزام بالحجاب: الستر الشرعيّ وترك الزينة أمام الأجانب ممّا لا شكّ فيه أن التعرّي والتزيّن من شأنهما تحريك الغريزة الجنسيّة، بحيث ينجرّ إليها الشباب، ولهذا جاء الأمر الإلهيّ بوجوب ستر المرأة لكامل بدنها وتركها للزينة بالخصوص كونها عنصرًا إثارة للرجل. إلّا أنّه لا يُراد من الحجاب هنا هو القماش الذي تضعه المرأة وتُغطّي به جسدها الظاهريّ فحسب، فهو وإن كان مهمًّا وضروريًّا وأساسًا إلّا أنّه ليس هو الواجب كلّه من الحجاب، بل هو مطلوب بالإضافة إلى الحجاب الباطنيّ والذي يتمثّل بالعفاف الباطنيّ للمرأة وهو الأهمّ لها.
455
443
الموعظة السادسة والستّون: العفاف وآثاره
فالحجاب بالمفهوم القرآنيّ لا يكتمل إلّا بمجموعة مفردات يتشكّل منها الحجاب الكامل:
أ. ستر كامل الجسد بالجلباب: وهو اللباس الفضفاض الواسع كما قال -تعالى-: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ ٱلمُؤمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدنَىٰ أَن يُعرَفنَ فَلَا يُؤذَينَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾[1].
ب. إسدال الخمار: وهو المقنعة التي توضع على الرأس وتُغطّي الكتفين والرقبة والشقّ من الصدر ﴿وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾[2].
ج. عدم إبداء الزينة: باستثناء الظاهريّة منها، وهي الكفّان والوجه، شرط أن لا يكون عليها زينة خارجيّة من مساحيق التجميل وطلاء الأظافر، وإظهار الحليّ، وغير ذلك. وكذلك عدم إظهار الزينة الباطنيّة، وهي كلّ ما عدا الوجه والكفّين من الجسد للأجانب ما عدا طائفة من الناس وهم اثنا عشر صنفًا من المحارم وغيرهم، والتي حدّدها وذكرها القرآن الكريم في سورة النور.
د.غضُّ البصر: سواء كان النظر من الرجال إلى النساء وهو أساس أو العكس؛ إذ إنّ الحجاب لا يُمكن أن يتحقّق إلّا بغضِّ الطرف من الجنسين وعدم النظر بشهوة وريبة إلى بعضهما بعضًا، والرجل له دور في إرساء الحجاب لدى المرأة، وإيجاد العفّة؛ لأنّ النظر إلى الجنس الآخر يتنافى والحجاب الباطنيّ. يقول -تعالى-: ﴿قُل لِّلمُؤمِنِينَ
[1] سورة الأحزاب، الآية 59.
[2] سورة النور، الآية 31.
456
444
الموعظة السادسة والستّون: العفاف وآثاره
يَغُضُّواْ مِن أَبصَٰرِهِم وَيَحفَظُواْ فُرُوجَهُم ذَٰلِكَ أَزكَىٰ لَهُم إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلمُؤمِنَٰتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَٰرِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ﴾[1].
هـ. عدم الضرب بالأرجل: ويكون ذلك عادةً بالخلخال الذي يُخرج صوتًا يعلم منه الآخر بوجود زينة خفيّة لدى المرأة، وبذلك يدخل تحت هذا العنوان كلّ ما من شأنه أن يترك صوتًا ويجلب نظر الرجال وانتباههم للمرأة أمثال الحذاء الخاصّ بالمرأة ذي الكعب العالي.
و. عدم اختلاط الرجل بالمرأة والعكس: لا شكّ في أنّ مجتمعاتنا الحديثة والمعاصرة لا يُمكنها الفصل التامّ بين الرجل والمرأة؛ لأنّ المرأة اليوم أخذت دورًا اجتماعيًّا وهي تُشارك الرجل في العمل. إلّا أنّه يُمكن الاتّقاء والاجتناب عن الموارد غير الضروريّة وبهذا يُمكن للمجتمع أن يحصل على التقوى الجنسيّة وعلى العفّة الاجتماعيّة وطهارتها.
وإذا ما حصل الاختلاط بين الرجل والمرأة لضرورة ما، يجب أن يُقيَّد المجلس بمجموعة شروط، منها: عدم الضحك والمزاح الذي يُزيل الحجاب والعفّة بينهما، وشيئًا فشيئًا تنكسر الحشمة، وتقع المعصية بدرجاتها، فقد ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله): «من فاكه امرأة لا يملكها حبسه الله بكلِّ كلمة في الدنيا ألف عام»[2] والمفاكهة هي الممازحة.
[1] سورة النور، الآيتان 30 - 31.
[2] الشيخ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص198.
457
445
الموعظة السادسة والستّون: العفاف وآثاره
ز. اجتناب الخلوة التامّة: كأن يكونا في مكان خاصٍّ لا ثالث معهما، ففي الرواية عن الإمام عليّ (عليه السلام): «لا يخلو بامرأة رجل فما من رجل خلا بامرأة إلّا كان الشيطان ثالثهما»[1].
لذلك ينبغي أن يكون جلوس الرجل والمرأة بمرأى الآخرين، وأن تقتصر الجلسة على الأمور الضروريّة، وأن لا تطول مدّتها.
ح. ترك الزينة والتبرُّج والروائح العطرة: لأنّ كلّ ذلك من شأنه أن يُحرِّك الطرف الآخر ويُثيره.
ط. عدم اللّين في الكلام: فإنّ الخضوع في القول كما عبّر القرآن الكريم، وهو من نوع الميوعة والغنج الكلاميّ يحصل بطريقة خاصّة في الكلام، من شأنه أن يوقع الرجل في شرك المرأة.
ولهذا نهى الله -تعالى- عن ذلك بقوله: ﴿يَٰنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ لَستُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيتُنَّ فَلَا تَخضَعنَ بِٱلقَولِ فَيَطمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلنَ قَولٗا مَّعرُوفٗا﴾[2]. وهذا النهي ليس موجّهًا إلى نساء النبيّ فقط، بل يعمّ ليشمل نساء المؤمنين؛ لأنّ القرآن أُنزل من باب إيّاك أعني واسمعي يا جارة.
العفّة الزينبيّة نموذجًا
ومن أهمّ نماذج العفيفات التي قدّمها الإسلام بعد السيّدة الزهراء (عليها السلام) ابنتها عقيلة الطالبيّين زينب بنت عليّ بن أبي طالب (عليهما السلام) وقد بلغت من الحرص على الحجاب والستر حدّ أن تجعل في أوّل ما
[1] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج14، ص265.
[2] سورة الأحزاب، الآية 32.
458
446
الموعظة السادسة والستّون: العفاف وآثاره
وبَّخت يزيد الطاغية عليه رغم كثرة جرائمه وعظمها هتك ستور النساء وتعريضهنّ لأنظار القوم في مسير السبي.
ولا عجب فإنّ الحجاب والعفاف رافق حياة هذه العظيمة حيث يُروى أنّ يحيى المازنيّ، قال: كنت في جوار أمير المؤمنين (عليه السلام) في المدينة المنوّرة مدة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته، فوالله ما رأيت لها شخصًا ولا سمعت لها صوتًا، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدّها رسول الله (صلى الله عليه وآله) تخرج ليلًا والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين فأخمد ضوء القناديل، فسأله الحسن مرّة عن ذلك، فقال: «أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب»[1].
[1] البياتيّ، الأخلاق الحسينيّة، ص223.
459
447
الموعظة السابعة والستّون: فضل الجهاد وأهمّيّته
الموعظة السابعة والستّون: فضل الجهاد وأهمّيّته
بيان فضلِ الجهاد، ومراتبِه، وآثارِ تَرْكِه.
محاور الموعظة
فضل الجهاد
الجهاد في زيارات الأئمّة (عليهم السلام)
أذى المجاهدين
مراتب الجهاد
تصدير الموعظة
﴿يَٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلكُفَّارَ وَٱلمُنَٰفِقِينَ وَٱغلُظ عَلَيهِم وَمَأوَىٰهُم جَهَنَّمُ وَبِئسَ ٱلمَصِيرُ﴾[1].
[1] سورة التوبة، الآية 73.
462
448
الموعظة السابعة والستّون: فضل الجهاد وأهمّيّته
الموعظة السابعة والستّون: فضل الجهاد وأهمّيّته
بيان فضلِ الجهاد، ومراتبِه، وآثارِ تَرْكِه.
محاور الموعظة
فضل الجهاد
الجهاد في زيارات الأئمّة (عليهم السلام)
أذى المجاهدين
مراتب الجهاد
تصدير الموعظة
﴿يَٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلكُفَّارَ وَٱلمُنَٰفِقِينَ وَٱغلُظ عَلَيهِم وَمَأوَىٰهُم جَهَنَّمُ وَبِئسَ ٱلمَصِيرُ﴾[1].
[1] سورة التوبة، الآية 73.
462
449
الموعظة السابعة والستّون: فضل الجهاد وأهمّيّته
إنّ المتأمّل في تاريخ الإسلام يرى أنّ الله شرّع للمسلمين فريضة الجهاد في وجه مَن وقفوا في وجه الدعوة، للدفاع عن كيانهم ووجودهم -بعد أن يَئِس منهم-، عن طريق الكلمة الطيّبة والموعظة الحَسَنة، وحثّهم على الجهاد والشهادة دون ذلك، أو دون أيّة محاولةٍ مِن الأعداء للنيل مِنهم، مُشيرًا إلى أنّ الخير كلّه في السيف، أو تحت ظِلال السيوف. ونبّه المسلمين إلى عدم عَدِّه كرهًا؛ قال -تعالى-: ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ ٱلقِتَالُ وَهُوَ كُرهٞ لَّكُم وَعَسَىٰ أَن تَكرَهُواْ شَئٗا وَهُوَ خَيرٞ لَّكُم﴾[1].
فضل الجهاد
قال -تعالى-: ﴿لَّا يَستَوِي ٱلقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلمُؤمِنِينَ غَيرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾[2].
وقال -تعالى-: ﴿وَلَنَبلُوَنَّكُم حَتَّىٰ نَعلَمَ ٱلمُجَٰهِدِينَ مِنكُم وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبلُوَاْ أَخبَارَكُم﴾[3].
وعن الإمام عليّ (عليه السلام): «إنّ الجهاد بابٌ مِن أبواب الجنّة، فتحه الله لخاصّة أوليائه، وهو لباس التقوى، ودرع الله الحصينة، وجُنّته الوثيقة»[4].
وعنه (عليه السلام): «فَرَض الله الإيمان تطهيرًا مِن الشِرْك... والجهاد عزًّا للإسلام»[5].
[1] سورة البقرة، الآية 216.
[2] سورة النساء، الآية 95.
[3] سورة محمّد، الآية 31.
[4] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص69.
[5] المصدر نفسه، ص512.
463
450
الموعظة السابعة والستّون: فضل الجهاد وأهمّيّته
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنّ لكلّ أُمّة سياحة، وسياحة أُمّتي الجهاد في سبيل الله»[1].
وعنه (صلى الله عليه وآله): «ما مِن خُطوة أَحبّ إلى الله مِن خُطوتيْن: خطوة يَسدّ بها مؤمنٌ صفًّا في سبيل الله، وخطوة يخطوها مؤمنٌ إلى ذي رَحِم قاطعٍ يَصِلها»[2].
وعنه (صلى الله عليه وآله): «ما أعمال العباد كلّهم عند المجاهدين في سبيل الله، إلّا كمثل خُطّافٍ أخَذ بمنقاره مِن ماء البحر»[3].
وعن الإمام الباقر (عليه السلام): أتى رجلٌ رسولَ الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: إنّي راغبٌ نشيط في الجهاد. قال: «فجاهِد في سبيل الله، فإنّك إن تُقتلْ كنتَ حيًّا عند الله تُرْزق، وإن مُتّ فقد وقعَ أجْرك على الله، وإنْ رجعْتَ خرجْتَ مِن الذنوب إلى الله»[4].
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخان في جهنّم»[5].
الجهاد في زيارات الأئمّة (عليهم السلام)
عندما نقرأ في متون بعض الزيارات المأثورة -إقرارًا منّا بِجهاد الأئمّة (عليهم السلام)-: «جاهَدَ فيك الكفّار والمنافقين»، «جاهدْتَ في الله
[1] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص444.
[2] المصدر نفسه، ج1، ص444.
[3] المصدر نفسه، ج1، ص445.
[4] الميرزا النوريّ، مستدرك الوسائل، ج11، ص10.
[5] المصدر نفسه، ج11، ص13.
464
451
الموعظة السابعة والستّون: فضل الجهاد وأهمّيّته
حقَّ جهاده»، «جاهدْتَ عدوّك»، وفي زيارات الأصحاب: «أشهد أنّكم جاهدْتُم في سبيل الله»[1]، فإنّ ذلك في الواقع ليس اعترافًا بِفضلهم وحَسْب، بل إنّه حُجّةٌ بالغة مِنهم علينا بِعدم جواز ترْك هذه الفريضة التي أعزّ الله بها دينه وأولياءه.
أذى المجاهدين
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من اغتاب غازيًا في سبيل الله أو آذاه أو خلفه بسوء في أهله، نُصِب له يوم القيامة علم غدر، فيستفرغ حسناته، ثمّ يُركس في النار»[2].
وعنه (صلى الله عليه وآله): «اتّقوا أذى المجاهدين في سبيل الله، فإنّ الله يَغضب لهم كما يغضبُ للرُسل، ويستجيبُ لهم كما يستجيبُ لهم»[3].
مراتب الجهاد
تختلف أساليب الجهاد باختلاف الساحات والظروف المحيطة بالمسلمين، مِن دون أن يسقط أصل تكليفه عنهم؛ وهذا ما شهِدناه في الظروف المختلفة لِأئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، فقد تنوّعت أساليبهم في الجهاد وفقًا لِمُقتضيات كلّ مرحلة، والظروف المتنوّعة المحيطة بكلّ إمام (عليه السلام)؛ عن الإمام عليّ (عليه السلام): «جاهِدوا في سبيل الله بِأيديكم، فإن لم تقدِروا فجاهِدوا بِألسنتكم، فإن لم تقدِروا فجاهِدوا بِقلوبكم»[4].
[1] الشيخ المفيد، المقنعة، ص470.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج97، ص50.
[3] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص446.
[4] المصدر نفسه، ص447.
465
452
الموعظة الخامسة والخمسون: أكل الحرام
آثار تَرْك الجهاد
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «فَمَنْ تَرَك الجهادَ ألبَسَه اللهُ ذُلًا في نفْسِه، وفَقرًا في معيشته، ومَحْقًا في دينه. إنّ الله -تبارك وتعالى- أعزَّ أُمّتي بِسَنابِك خَيْلِها ومراكزِ رِماحِها»[1].
وعن الإمام عليّ (عليه السلام): «فَمَنْ تَرَكَه -يعني الجهاد-، رغبةً عنه، أَلبَسَه اللهُ ثوبَ الذلّ، وشمله البلاء، ودُيِّثَ بالصغار والقماءة، وضُرِبَ على قلبه بالإسهاب (بالأسداد)، وأُديل الحقُّ منه بِتضييع الجهاد»[2].
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «مَنْ لَقِيَ اللهَ بِغير أثرٍ مِن جهاد، لَقِيَ اللهَ وفيه ثلْمة»[3].
وعنه (صلى الله عليه وآله) أيضًا: «مَن مات ولم يَغْزُ، ولم يُحَدِّثْ به نفْسه، مات على شعبةٍ مِن نفاق»[4].
وقال الإمام الحسين (عليه السلام): «مَن رأى سلطانًا جائرًا مُستحلًّا لِحُرَم الله، ناكثًا لِعهد الله، مخالفًا لِسُنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يَعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يُغيِّر عليه بفعلٍ ولا قول، كان حقًّا على الله أن يُدخِله مدخَله»[5].
[1] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج1، ص448.
[2] المصدر نفسه، ج1، ص448.
[3] المصدر نفسه، ج1، ص444.
[4] المصدر نفسه، ج1، ص444.
[5] الطبريّ، تاريخ الطبريّ، ج3، ص307.
466
453
الموعظة الثامنة والستّون: شرائط الجهاد في سبيل الله وضوابطه
الموعظة الثامنة والستّون: شرائط الجهاد في سبيل الله وضوابطه
حثّ المؤمنين على الجهاد في سبيل الله، ومُقاومة الظلم، وردّ المعتدين عن المسلمين ومُقدّساتهم.
محاور الموعظة
شروط الجهاد
أهداف الجهاد
ضوابط الجهاد العامّة
آثار الجهاد في سبيل الله وفضله
تصدير الموعظة
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصرِهِم لَقَدِيرٌ ٣٩ ٱلَّذِينَ أُخرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَولَا دَفعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٖ لَّهُدِّمَت صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذكَرُ فِيهَا ٱسمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾[1].
[1] سورة الحجّ، الآيتان 39 - 40.
467
454
الموعظة الثامنة والستّون: شرائط الجهاد في سبيل الله وضوابطه
الموعظة الثامنة والستّون: شرائط الجهاد في سبيل الله وضوابطه
حثّ المؤمنين على الجهاد في سبيل الله، ومُقاومة الظلم، وردّ المعتدين عن المسلمين ومُقدّساتهم.
محاور الموعظة
شروط الجهاد
أهداف الجهاد
ضوابط الجهاد العامّة
آثار الجهاد في سبيل الله وفضله
تصدير الموعظة
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصرِهِم لَقَدِيرٌ ٣٩ ٱلَّذِينَ أُخرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَولَا دَفعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٖ لَّهُدِّمَت صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذكَرُ فِيهَا ٱسمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾[1].
[1] سورة الحجّ، الآيتان 39 - 40.
467
455
الموعظة الثامنة والستّون: شرائط الجهاد في سبيل الله وضوابطه
الموعظة الثامنة والستّون: شرائط الجهاد في سبيل الله وضوابطه
حثّ المؤمنين على الجهاد في سبيل الله، ومُقاومة الظلم، وردّ المعتدين عن المسلمين ومُقدّساتهم.
محاور الموعظة
شروط الجهاد
أهداف الجهاد
ضوابط الجهاد العامّة
آثار الجهاد في سبيل الله وفضله
تصدير الموعظة
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصرِهِم لَقَدِيرٌ ٣٩ ٱلَّذِينَ أُخرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَولَا دَفعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٖ لَّهُدِّمَت صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذكَرُ فِيهَا ٱسمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾[1].
[1] سورة الحجّ، الآيتان 39 - 40.
468
456
الموعظة الثامنة والستّون: شرائط الجهاد في سبيل الله وضوابطه
3. الالتزام بقواعد القتال
قال -تعالى-: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُم وَلَا تَعتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلمُعتَدِينَ﴾[1].
أهداف الجهاد
1. اجتثاث الفتنة والشرك
قال -تعالى-: ﴿وَقَٰتِلُوهُم حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعمَلُونَ بَصِيرٞ﴾[2].
2. إخافة أعداء الله وأعداء المسلمين
قال -تعالى-: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱستَطَعتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلخَيلِ تُرهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُم﴾[3].
3. حِفظ المعابد الدينيّة والمقدّسات
قال -تعالى-: ﴿وَلَولَا دَفعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٖ لَّهُدِّمَت صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذكَرُ فِيهَا ٱسمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗا﴾[4].
4. العذاب والخِزي على المعتدين
قال -تعالى-: ﴿قَٰتِلُوهُم يُعَذِّبهُمُ ٱللَّهُ بِأَيدِيكُم وَيُخزِهِم وَيَنصُركُم عَلَيهِم وَيَشفِ صُدُورَ قَومٖ مُّؤمِنِينَ﴾[5].
ضوابط عامّة في الجهاد
ذكر الله -تعالى- سِتًّا مِن الضوابط والقوانين التي لا بُدّ مِن مُراعاتها
[1] سورة البقرة، الآية 190.
[2] سورة الأنفال، الآية 39.
[3] سورة الأنفال، الآية 60.
[4] سورة الحجّ، الآية 40.
[5] سورة التوبة، الآية 14.
469
457
الموعظة الثامنة والستّون: شرائط الجهاد في سبيل الله وضوابطه
في الجهاد في ثلاثِ آياتٍ مِن سورة الأنفال، حَدّد فيها قوانين النصر على الأعداء في جبهات القتال، وهي:
1. الثبات
قال -تعالى-: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُم فِئَةٗ فَٱثبُتُواْ﴾.
2. ذِكر الله
قال -تعالى-: ﴿وَٱذكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُم تُفلِحُونَ﴾.
3. إطاعة الله ورسوله
قال -تعالى-: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾.
4. اجتناب التنازع
قال -تعالى-: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفشَلُواْ وَتَذهَبَ رِيحُكُم﴾.
5. الصبر
قال -تعالى-: ﴿وَٱصبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾.
6. اجتناب الغرور والرياء
قال -تعالى-: ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بَطَرٗا وَرِئَاءَ ٱلنَّاسِ﴾[1].
آثار الجهاد في سبيل الله وفضله
1. صلاح الدين والدنيا
عن الإمام عليّ (عليه السلام): «إنّ الله فرض الجهاد وعظّمه. والله، ما صلحَت دنيا ولا دين إلّا به»[2].
2. مَحوٌ للذنوب وعُلوٌّ للدرجات
[1] سورة الأنفال، الآيات 45-47.
[2] الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج11، ص9.
470
458
الموعظة الثامنة والستّون: شرائط الجهاد في سبيل الله وضوابطه
عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «مَن خرج مُرابِطًا في سبيل الله -تعالى- أو مجاهدًا، فله بِكُلّ خُطوة سبعمئة ألف حسنة، ويُمحى عنه سبعمئة ألف سيّئة، ويُرفع له سبعمئة ألف درجة»[1].
3. استجابة الدعاء
عن الإمام الصادق (عليه السلام): «ثلاثة دَعْوَتهم مُستجابة: الحاجّ فانظروا بما تخلفونه، والغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفونه، والمريض فلا تعرّضوه»[2].
4. الشفاعة
عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «ثلاثة يشفعون إلى الله -عزَّ وجلّ- فيُشفّعون: الأنبياء ثمّ العلماء ثمّ الشهداء»[3].
5. دخول الجنّة
عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «ألا إنّ الله -عزَّ وجلّ- لَيُدخِل بالسهم الواحد الثلاثة الجنّة: عامل الخشبة، والمقوّي به في سبيل الله، والرامي به في سبيل الله»[4].
قصّة وعِبرة
قال خيثمة أبو سعد بن خيثمة: يا رسول الله، إنّ قريشًا مكثَتْ حَولًا تجمع الجموع وتستجلب العرب في بواديها... وعسى الله أن يظفرنا بهم، فتلك عادة الله عندنا، أو يكون الأخرى فهي الشهادة؛ لقد أخطأَتْني وقعة بدر، وقد كنتُ عليها حريصًا، لقد بلغ مِن حِرصي أنْ ساهمتُ ابْني في الخروج، فخرج سهمُه، فَرُزق الشهادة. وقد رأيتُ
[1] الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال، ص293.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج81، ص225.
[3] الشيخ الصدوق، الخصال، ص156.
[4] الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج15، ص140.
471
459
الموعظة الثامنة والستّون: شرائط الجهاد في سبيل الله وضوابطه
ابْني البارحة في النوم في أحسنِ صورة، يسرح في ثمار الجنّة وأنهارها، وهو يقول: الْحَقْ بنا تُرافِقنا في الجنّة، فقد وجدتُ ما وعدني ربّي حقًّا. وقد -والله- يا رسول الله أصبحتُ مُشتاقًا إلى مرافقته في الجنّة. وقد كبرَتْ سِنّي، ورَقَّ عَظمي، وأحببتُ لقاء ربّي، فادعُ الله أن يرزقني الشهادة. فدعا له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك، فقُتِل بِأُحُد شهيدًا[1].
مِن صُوَر الجهاد في كربلاء
بعد أحداث الكوفة، التحق عابس بِسيّد الشهداء (عليه السلام). وفي يوم عاشوراء، وبعد استشهاد غلامه شوذب، تقدّمَ نحو الإمام (عليه السلام)، وقال له: يا أبا عبد الله، أما -والله- ما أمسى على ظهر الأرض قريبٌ ولا بعيدٌ أعزّ عَليّ ولا أحبّ إليّ منك، ولو قدِرتُ على أن أدفع عنك الضيم والقتل بِشيء أعزّ عَليّ مِن نفسي ودمي، لَفَعلتُه. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أنّي على هُداك وهُدى أبيك.
ثمّ مشى بالسيف مُصلّتًا نحو القوم، وكان شجاعًا إلى حدِّ لم يجرؤ أحدٌ مِن القوم على أن يبرز إليه لِيُقاتله وجهًا لوجه، فنادى عمر بن سعد: ويلكم! أرضِخوه بالحجارة. فرُمِيَ بالحجارة مِن كلّ جانب. فلمّا رأى ذلك، ألقى درعه وخوذته خلفه، وبرز بِقَميصه نحو جيش ابن سعد، ثمّ استُشهد (رضوان الله عليه)[2].
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج20، ص125.
[2] أبو مخنف، وقعة الطفّ، ص100.
472
460
الموعظة التاسعة والستّون: الدفاع عن المقدّسات
الموعظة التاسعة والستّون: الدفاع عن المقدّسات
بيان المقدّسات في الإسلام، وأهمّيّة الحفاظ عليها، ومشروعيّة القتال والشهادة دونها.
محاور الموعظة
معنى القداسة
مَن هم المقدّسون؟
واجباتنا تجاه المقدّسات
تصدير الموعظة
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصرِهِم لَقَدِيرٌ ٣٩ ٱلَّذِينَ أُخرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَولَا دَفعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٖ لَّهُدِّمَت صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذكَرُ فِيهَا ٱسمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾[1].
[1] سورة الحجّ، الآيتان 39 - 40.
473
461
الموعظة التاسعة والستّون: الدفاع عن المقدّسات
معنى القداسة
مِن أسماء الله -تعالى- القُدّوس، فَقد وردَ في سورة الجمعة: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلأَرضِ ٱلمَلِكِ ٱلقُدُّوسِ ٱلعَزِيزِ ٱلحَكِيمِ﴾[1]؛ ومعنى أنّه قُدّوس هو أنّه مُنزّه عن كلّ نقصٍ وحاجة، فهو كمالٌ مُطلق، لا يعتريه عَيْب، ولا تمسّه حاجة.
بالتالي، فإنّ معنى القداسة يَرجع إلى كَوْن المتّصف بها حائزًا على لَونٍ مِن ألوان الكمال والنزاهة والشرف والنُبْل.
ولمّا كان بعض مخلوقات الله ممّن تجلَّت في ذواتهم هذه الصفات، أو بعض لوازمها، أو كانوا على درجة عالية مِن الاتّصال بالله -الذي هو مبدأ القداسة-، كانوا مُقدّسين، سواء أكانوا ملائكة أو غير ذلك، بشرًا أو أمكنة؛ ﴿ٱدخُلُواْ ٱلأَرضَ ٱلمُقَدَّسَةَ﴾[2].
وفي الحقيقة، إنّ القداسة التي يتّصف بها هؤلاء مِن المخلوقات هي مُفاضة مِن القُدّوس، منزّلة عليهم وفيهم، ومحتومة إليهم. ولكن يبقى أفضل المقدّسين الذين كان تحلّيهم بها ناتج عن اختيارهم، وسيرهم في طريق التكامل اختيارًا، والطاعة للباري -عزَّ وجلّ- عن اختيار، فتقدّست ذواتهم بِنزاهتهم، ونجحوا في بلوغ مقامات القرب مِن القُدّوس، ليكونوا أولياءه، محلًّا تنعكس فيهم تلك القداسة.
[1] سورة الجمعة، الآية 1.
[2] سورة المائدة، الآية 21.
474
462
الموعظة التاسعة والستّون: الدفاع عن المقدّسات
ولأنّ هذا الأمر كان عن اختيار، فإنّ ابنَ آدم يرقى إلى أن يكون أعلى درجةً مِن الملائكة أنفسهم، فعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّ الله -عزَّ وجلّ- ركّب في الملائكة عقلًا بلا شهوة، وركّب في البهائم شهوة بلا عقل، وركّب في بني آدم كِلتيهما، فمن غلب عقلُه شهوتَه فهو خيرٌ مِن الملائكة، ومن غلبتْ شهوتُه عقلَه فهو شرٌّ مِن البهائم»[1].
مَن هم المقدّسون؟
يتّضح ممّا سبق أنّ القداسة هي التنزُّه عن العيوب والنقائص، ومعنى أن يُقدّسه الله يعني أنْ ينسبه إليه بِنسبة ما، ويَنحَله صِفةً مِن صِفاته، ومِنها البركة، لِيكون في وجوده نفعٌ للناس، بل للخلق. وعليه، فمِن المقدّسات الكعبة المشرّفة التي قال عنها -تعالى-: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيتٖ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٗا﴾[2].
بل إنّ كلّ مسجد بُنِيَ لله مُقدّس، فهو بيته، ومحلّ البركة؛ «أوحى الله إلى داوود: يا داوود، إنّ بُيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهّر في بَيْته، وزارَني في بَيْتي...»[3] ؛ لذا كان للمساجد حُرمة وآداب.
ومِن المقدّساتِ كتبُ الله المنزَلة لهداية الناس، ويأتي في طليعتها -وهو أعظمها- القرآن الكريم؛ ﴿كِتَٰبٌ أَنزَلنَٰهُ إِلَيكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُواْ ءَايَٰتِهِ﴾[4]. وتجلّيات قداسته أنّه محفوظ، لا يأتيه باطلٌ مِن
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج57، ص299.
[2] سورة آل عمران، الآية 96.
[3] الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ج2، ص318.
[4] سورة ص، الآية 29.
475
463
الموعظة التاسعة والستّون: الدفاع عن المقدّسات
بين يديه ولا مِن خلفه. ومِن أحكام تلك القداسة حرمةُ تدنيسه، بل أكثر؛ ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ﴾[1].
ومِن المقدّسين الملائكة، إذ سمّى بعضهم: «الروح القُدُس».
ومِن المقدّسين مِن البشر الأنبياء، ومِن هؤلاء الأنبياء عيسى (عليه السلام)، فقد كان نافعًا للناس، تكفي لمسة مِن يده للشفاء مِن الداء العُضال، بل حتّى لإحياء الموتى؛ قال -تعالى- عن لسانه (عليه السلام): ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَينَ مَا كُنتُ﴾[2].
ويأتي في طليعة المقدّسين النبيّ الأعظم محمّد (صلى الله عليه وآله)، الذي كان وجوده وإرساله رحمةً لجميع عوالم الوجود؛ ﴿وَمَا أَرسَلنَٰكَ إِلَّا رَحمَةٗ لِّلعَٰلَمِينَ﴾[3]، فرفع عن الناس عذابَ الاستئصال، وكان أمانًا مِن نزول العقاب الإلهيّ؛ ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم وَأَنتَ فِيهِم﴾[4].
وقد كان مِن توابع بركته وقداسته -أيضًا- أهلُ بيته الذين طهّرهم الله؛ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجسَ أَهلَ ٱلبَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيرٗا﴾[5]، لا لأنّهم قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بل لأنّهم جسّدوا أكمل مراتب التصديق بما جاء به (صلى الله عليه وآله)، واتّبعوا خطواته في سَيْرهم الاختياريّ نحوه -تعالى-، فقَبِلَهم ربّهم، ورفع لهم الدرجات، وجعل مودّتهم أجرًا على خِدمة خاتم رسله إلى البشريّة.
[1] سورة الواقعة، الآية 79.
[2] سورة مريم، الآية 31.
[3] سورة الأنبياء، الآية 107.
[4] سورة الأنفال، الآية 33.
[5] سورة الأحزاب، الآية 33.
476
464
الموعظة التاسعة والستّون: الدفاع عن المقدّسات
واجباتنا تجاه المقدّسات
إنّ مِن واجباتنا تجاه هذه المقدّسات احترامها بما يُلائمها، وبحبها وتبجيلها، وعدم تعريضها للتدنيس والإهانة والاعتداء والإيذاء. فعندما يكون المقدّسون مِن الأولياء، فإنّ التكاليف تتّسع لتشمل تصديقهم، وطاعتهم، وموالاتهم، وموالاة وليّهم، ومعاداة عدوّهم، والتصديق بمقاماتهم، والاقتداء بهم سلوكًا وسَمْتًا، ومنها أيضًا أن نقبل منهم ما يأتوننا به عن الله -تعالى-، وألّا نتقّدم عليهم، ولا نتأخّر عنهم، وأن نُظهر مودّتنا لهم، في الزيارة لمشاهدهم، وإحياء أمرهم، وذِكرهم، وتعظيم شأنهم، ونشر فضائلهم، وإكرام وليّهم.
الدفاع عن المقدّسات
مِن أهمّ الواجبات تجاه المقدّسات الدفاع عنها بما تقتضيه عمليّة الدفاع، وبحسب نوع الخطر الموَجّه إليها. فتارةً، بالفكر والقلم والكتابة، وأخرى بالفنّ والإعلام، وثالثة بالقتال والجهاد، وغير ذلك مِن المجالات والميادين.
وبالعودة إلى كتاب الله، فإنّنا نقرأ قوله -تعالى-: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصرِهِم لَقَدِيرٌ﴾[1]، إذ بيّن فيها أصل مشروعيّة الجهاد ومبرّراته. وقال بعدها: ﴿ٱلَّذِينَ أُخرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَولَا دَفعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٖ لَّهُدِّمَت صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذكَرُ فِيهَا ٱسمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن
[1] سورة الحجّ، الآية 39.
477
465
الموعظة التاسعة والستّون: الدفاع عن المقدّسات
يَنصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾[1]، مُنتقلًا إلى بيان وفلسفة تشريع الجهاد المأذون به على طول مسيرة الأديان السماويّة، الذي به حُفِظَتْ بيوت عبادة اليهود والنصارى، وبه تُحفظ بيوت عبادة المسلمين، بل به تحفظ العبادة نفسها؛ فمن الحِكَم المترتّبة على تشريع القتال حِفظُ المقدّسات وصَونها. وهذا يعني -بِصورة عكسيّة- لو أنّ أرباب الشرائع -وخاصّةً المسلمين- تكاسلوا عن النهوض لمواجهة المعتدين الخارجيّين أو الطغاة والظالمين الداخليّين، فإنّ هذا سيُغري هؤلاء لِيندفعوا في طغيانهم وينالوا مِن المقدّسات، إذ سيجدون الطرق مشرّعة منزوعة العوائق والروادع إلى تدنيس المقدّسات، أو تحوير دورها وتحريفه لِيخدم سلطانهم، وسيعمدون حينها إلى تهديم وإزالة كلّ ما يرونه تهديدًا لسلطانهم، ما يكون محلًّا لِتعبئة طاقات الناس، وشحذ هممهم في مواجهة الظالم ومجابهة الكفر، ويكون ساحة للتوعية. وهذا لا يختصّ بأماكن العبادة فقط، بل إنّه يشمل أولياء الله وعلماء الأُمّة وأحرارها.
إذًا، قيام المؤمنين بجهاد الأعداء وامتثال الأمر الإلهيّ يحفظ المقدّسات. فكيف لو كانت المقدّسات نفسها هي المعرّضة للخطر، وهي هدف الأعداء والطغاة؟ فمِن بابٍ أَولى أن تهبّ الأُمّة لجهاد أعدائها ومواجهة ظُلّامها، وأن تبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية تلك المقدّسات.
[1] سورة الحجّ، الآية 40.
478
466
الموعظة التاسعة والستّون: الدفاع عن المقدّسات
خاتمة
في كربلاء مشاهد مِن مصاديق الجهاد لحفظ المقدّسات، فالحسين (عليه السلام) رأى أنّ الإسلام نفسه سيكون في خطر إذا ما تولّى طاغيةٌ مثل يزيد الحكم؛ «على الإسلام السلام، إذ قد بُلِيَت الأمّة بِراعٍ مثل يزيد»[1].
فخرج ثائرًا، وخرج لنصرته مَن رأوا رأيه. مُضافًا إلى أنّ وليّ الله نفسه، وخامس أهل الكساء، سبط الرسول (صلى الله عليه وآله)، في مَعرض الخطر، فجادوا بأنفسهم عن نفسه، وقدّموا أرواحهم قرابين في ساحات الوغى، ولسان حالهم: نفوسنا دون نفسك يابن رسول الله؛ فعندما يتعرّض مقدّس -كوليّ الله- للخطر، ترخص التضحيات -مهما غلَتْ- لإجابة ندائه «هل مِن ناصر ينصرنا؟».
ونحن، على خطى أصحاب الحسين (عليه السلام)، نقدّم أنفسنا ذَودًا عن المقدّسات، ولن يكون شهداؤنا -شهداء الدفاع عن المقدّسات- إلّا أُسوةً بمن وَفى للحسين (عليه السلام) يوم العاشر مِن المحرّم.
[1] ابن نما الحلّيّ، مثير الأحزان، ص15.
479
467
الموعظة السبعون: مقام الشهادة في الإسلام
الموعظة السبعون: مقام الشهادة في الإسلام
بيان فضل الشهداء، ومقامهم في الدنيا والآخرة.
محاور الموعظة
معنى الشهيد
أهمّيّة الشهادة
مكانة الشهيد
شرائط الشهادة
تصدير الموعظة
﴿وَلَا تَحسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَموَٰتَا بَل أَحيَاءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقُونَ ١٦٩ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضلِهِ وَيَستَبشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَم يَلحَقُواْ بِهِم مِّن خَلفِهِم أَلَّا خَوفٌ عَلَيهِم وَلَا هُم يَحزَنُونَ ١٧٠ يَستَبشِرُونَ بِنِعمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضلٖ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجرَ ٱلمُؤمِنِينَ﴾[1].
[1] سورة آل عمران، الآيات 169-171.
480
468
الموعظة السبعون: مقام الشهادة في الإسلام
تُعدّ الشهادة مِن المقوّمات الأساسيّة في نهضة المسلمين وتحرُّك المستضعفين، وفي انتصار الانتفاضات والثورات ذات القيم والمبادئ، فلا يمكن أن تنتصر هذه النهضات والتحرّكات والانتفاضات والثورات إلّا بِتقديم تضحيات عزيزة، وإراقة دماء زكيّة غالية، وسقوط شهداء أوفياء فُضَلاء علماء. وقد تزيد نسبة الشهداء أو تقلّ، ولكنّ الشهادة ودماء الشهداء الأوفياء -في النتيجة- تكون إحدى مقوّمات الانتصار المبدئيّ، وإحدى أقوى الدعائم في الرسالات السماويّة[1].
معنى الشهيد
الشهيد في -اللُغةِ والشرْعِ- هو المقتول في سبيل الله؛ وسببُ تسميته بِذلك قيامُه بشهادةِ الحقِّ في أمر الله -تعالى-، حتّى قُتِل، أو لأنّه يشهدُ ما أعدّ الله له مِن الكرامة بالقَتْل، أو لأنّه شهِد المغازي، أو لأنّه شُهِدَ له بالإيمان، أو لأنّه خُتِم له بِخير، أو لأنّه حيّ لمْ يَمُتْ فكأنّه يُشاهد ويَحضر، أو لأنّه حاضرٌ عند ربّه، أو لأنّه يَشهَد ملكوتَ الله ومُلكَه، أو لِسُقوطه على الشاهدة -وهي الأرض[2]-. وقد يكون السببُ ما ذُكر كلّه.
أهمّيّة الشهادة
1. أعلى دَرجات البِرّ
عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «فوق كلِّ ذي برٍّ بِرّ، حتّى يُقتَل الرجلُ في سبيل الله، فإذا قُتِل في سبيل الله، فليس فوقه بِرّ»[3].
[1] من كلام للإمام القائد الخامنئيّ دام ظله.
[2] التبريزيّ الأنصاريّ، اللمعة البيضاء، ص368.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص348.
481
469
الموعظة السبعون: مقام الشهادة في الإسلام
2. إحدى الحُسنيَيْن
قال -تعالى-: ﴿قُل هَل تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحدَى ٱلحُسنَيَينِ﴾[1].
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «المؤمن يَقْظان مُترقّب خائف، ينتظر إحدى الحُسنيَيْن»[2].
3. أكرم الموت
رُوِي أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لِأصحابه في ساعة الحرب: «إنّ الموت طالبٌ حثيث، لا يفوته المقيم، ولا يُعجزه الهارب. إنّ أكرم الموت القَتْل»[3].
4. أشرف الموت
عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «أشرف الموت قَتْل الشهادة»[4].
مكانة الشهيد
1. الحياة الخاصّة
قال -تعالى-: ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَموَٰتُ بَل أَحيَاءٞ وَلَٰكِن لَّا تَشعُرُونَ﴾[5].
[1] سورة التوبة، الآية 52.
[2] الشيخ الصدوق، الخصال، ص633.
[3] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص180.
[4] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص576.
[5] سورة البقرة، الآية 154.
482
470
الموعظة السبعون: مقام الشهادة في الإسلام
2. ممّن أنعم الله عليهم
قال -تعالى-: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَٰئِكَ رَفِيقٗا﴾[1].
3. مِن المؤمنين الصادقين
قال -تعالى-:﴿مِّنَ ٱلمُؤمِنِينَ رِجَالٞ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيهِ فَمِنهُم مَّن قَضَىٰ نَحبَهُۥ وَمِنهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبدِيلٗا﴾[2].
4. مغفور له
قال -تعالى-: ﴿فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنهُم سَئَِّاتِهِم وَلَأُدخِلَنَّهُم جَنَّٰتٖ تَجرِي مِن تَحتِهَا ٱلأَنهَٰرُ ثَوَابٗا مِّن عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسنُ ٱلثَّوَابِ﴾[3].
وعن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «أوّل ما يهراق مِن دم الشهيد، يغفر له ذنبه كلّه، إلّا الدَيْن»[4].
وعن الإمام الباقر (عليه السلام): «أوّل قطرة مِن دم الشهيد كفّارةٌ لِذنوبه، إلّا الدَيْن، فإنّ كفّارَتَه قضاؤُه»[5].
[1] سورة النساء، الآية 69.
[2] سورة الأحزاب، الآية 23.
[3] سورة آل عمران، الآية 195.
[4] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج2، ص1514.
[5] الشيخ الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج18، ص324.
483
471
الموعظة السبعون: مقام الشهادة في الإسلام
5. مأمون مِن فِتنة القبر
عن النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله): «مَن لَقِيَ العدوّ، فَصبر حتّى يُقتَل أو يَغلب، لم يُفتنْ في قبره»[1].
ورُوي أنّه سُئل (صلى الله عليه وآله): ما بال الشهيد لا يُفتن في قبره؟ فقال (صلى الله عليه وآله): «كفى بالبارقةِ فوق رأسه فِتنة»[2].
6. لا يشعر بالألم
رُوي عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «ما يَجِد الشهيد مِن مسّ القَتْل إلّا كما يَجِد أحدكم مِن مَسّ القَرصة»[3].
شرائط الشهادة
يقول -تعالى- في كتابه الكريم: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشتَرَىٰ مِنَ ٱلمُؤمِنِينَ أَنفُسَهُم وَأَموَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلجَنَّةَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقتُلُونَ وَيُقتَلُونَ وَعدًا عَلَيهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّورَىٰةِ وَٱلإِنجِيلِ وَٱلقُرءَانِ وَمَن أَوفَىٰ بِعَهدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ فَٱستَبشِرُواْ بِبَيعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعتُم بِهِۦ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلفَوزُ ٱلعَظِيمُ ١١١ ٱلتَّٰئِبُونَ ٱلعَٰبِدُونَ ٱلحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ ٱلأمِرُونَ بِٱلمَعرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلمُنكَرِ وَٱلحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلمُؤمِنِينَ﴾[4].
[1] الشيخ الريشهريّ، ميزان الحكمة، ج2، ص1515.
[2] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج5، ص54.
[3] السيّوطيّ، الدرّ المنثور، ج2، ص99.
[4] سورة التوبة، الآيتان 111-112.
484
472
الموعظة السبعون: مقام الشهادة في الإسلام
فقد حدّد الله -تعالى- في هاتين الآيتين مجموعة مِن الشرائط والمواصفات التي تؤهّل الإنسان لِنيْل مقام الشهادة، ولِصحّة معاملة البيع والشراء، والثمن بين المخلوق والخالق -تعالى-. والشرائط التي حدّدتها الآيتان هي:
1. التائبون: الذين يَغسلون قلوبهم وأرواحهم مِن رَيْن الذنوب بِماء التوبة.
2. العابدون: الذين يُطهّرون أنفسهم بِنفحات الدعاء والمناجاة مع ربّهم.
3. الحامدون: الذين يَشكرون الله ويحمدونه على نِعَمِه المادّيّة والمعنويّة، ويَعيشون الحمد في الشِدّة والرخاء.
4. السائحون: الذين يتنقّلون مِن مكان عبادةٍ إلى آخر، أو الذين يَتوجّهون إلى ميادين الجهاد، لِمحاربة الأعداء؛ عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «إنّ سياحة أُمّتي الجهاد في سبيل الله»[1]، أو الصائمون، فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله): «إنّ السائحين هُم الصائمون»[2].
5. الراكعون: الذين يَركعون في مُقابل عَظَمة الله -تعالى-.
6. الساجدون: الذين يُطَأطِئون رؤوسهم أمام خالقهم، ويَسجدون له.
7. الآمرون بالمعروف: الذين يَدعون الناس إلى عَمل الخير.
8. الناهون عن المنكر: الذين لم يَقتنعوا بالدعوة إلى الخيْر وحسْب، بل حارَبوا كلّ منكر وفساد.
[1] المتّقي الهنديّ، كنز العمّال، ج4، ص286.
[2] راجع: الفخر الرازيّ، التفسير الكبير، ج16، ص203.
485
473
الموعظة السبعون: مقام الشهادة في الإسلام
فقد حدّد الله -تعالى- في هاتين الآيتين مجموعة مِن الشرائط والمواصفات التي تؤهّل الإنسان لِنيْل مقام الشهادة، ولِصحّة معاملة البيع والشراء، والثمن بين المخلوق والخالق -تعالى-. والشرائط التي حدّدتها الآيتان هي:
1. التائبون: الذين يَغسلون قلوبهم وأرواحهم مِن رَيْن الذنوب بِماء التوبة.
2. العابدون: الذين يُطهّرون أنفسهم بِنفحات الدعاء والمناجاة مع ربّهم.
3. الحامدون: الذين يَشكرون الله ويحمدونه على نِعَمِه المادّيّة والمعنويّة، ويَعيشون الحمد في الشِدّة والرخاء.
4. السائحون: الذين يتنقّلون مِن مكان عبادةٍ إلى آخر، أو الذين يَتوجّهون إلى ميادين الجهاد، لِمحاربة الأعداء؛ عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «إنّ سياحة أُمّتي الجهاد في سبيل الله»[1]، أو الصائمون، فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله): «إنّ السائحين هُم الصائمون»[2].
5. الراكعون: الذين يَركعون في مُقابل عَظَمة الله -تعالى-.
6. الساجدون: الذين يُطَأطِئون رؤوسهم أمام خالقهم، ويَسجدون له.
7. الآمرون بالمعروف: الذين يَدعون الناس إلى عَمل الخير.
8. الناهون عن المنكر: الذين لم يَقتنعوا بالدعوة إلى الخيْر وحسْب، بل حارَبوا كلّ منكر وفساد.
[1] المتّقي الهنديّ، كنز العمّال، ج4، ص286.
[2] راجع: الفخر الرازيّ، التفسير الكبير، ج16، ص203.
486
474
الموعظة السبعون: مقام الشهادة في الإسلام
9. الحافظون لحدود الله: الذين أَدّوا أهمّ واجب اجتماعيّ، وهو حِفظ الحدود الإلهيّة، وإجراء قوانين الله -تعالى-، وإقامة الحدود والعدالة.
فَإذا اجتمعَتْ هذه الصفات التِسْع المذكورة، يأتي بعدها قوله -تعالى-: ﴿وَبَشِّرِ ٱلمُؤمِنِينَ﴾[1].
قصّة وعِبرة
عن الإمام عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام)، عن الحسين بن عليّ (عليهما السلام): «بينما أمير المؤمنين يخطب ويحضّهم على الجهاد، إذ قام إليه شابّ، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبِرني عن فَضْل الغُزاة في سبيل الله. فقال: كنتُ رديف رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ناقته العضباء، ونحن مُنقلبون عن غزوةِ ذات السلاسل، فسألتُه عمّا سألتَني عنه، فقال: الغُزاة، إذا هَمّوا بالغزو، كتبَ الله لهم براءة مِن النار. فإذا تجهّزوا لِغَزوهم، باهى الله بهم الملائكة. فإذا ودّعهم أهلوهم، بَكَتْ عليهم الحيطان والبيوت، ويخرجون مِن الذنوب... ويُكتب له (أيْ لِكلّ شهيد وغازٍ) كلّ يومٍ عبادة ألفِ رجل يعبدون الله... وإذا صاروا بِحضرة عدوّهم، انقطع عِلْم أهل الدنيا عن ثواب الله إيّاهم. فإذا بَرزوا لِعدوّهم، وأُشرعَت الأسِنّة، وفُوِّقَت السِهام، وتَقدّم الرجل إلى الرجل، حفّتْهم الملائكة بِأجنحتها، يَدعون الله بالنُصرة والتثبيت، فيُنادي مُنادٍ: الجنّة تحت ظِلال السيوف. فتكون الطعنة والضربة على الشهيد أَهوَن مِن شُرب الماء البارد في اليوم الصائف. وإذا
[1] الشيخ ناصر مكارم الشيرازيّ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج6، ص213 - 215.
487
475
الموعظة السبعون: مقام الشهادة في الإسلام
زال الشهيد مِن فرسه، بِطعنة أو ضربة، لم يَصِلْ إلى الأرض حتّى يبعَثَ الله إليه زوجته مِن الحور العين، فتبشّره بما أعدّ الله له مِن الكرامة. فإذا وصلَ إلى الأرض، تقول له الأرض: مَرحبًا بالروح الطيّب، الذي خَرَج مِن البدن الطيّب. أبْشِر، فإنّ لك ما لا عين رأَتْ، ولا أُذن سمعَتْ، ولا خَطَر على قَلبِ بَشر. ويقول الله: أنا خليفته في أهله؛ مَن أرضاهم فقد أرضاني، ومَن أسخطهم فقد أسخطني»[1].
مقام الشهادة في كربلاء
لمّا جَمَع الحسين (عليه السلام) أصحابه في ليلة العاشر مِن المحرّم، وأحلّهم مِن بَيْعته، وطلب مِنهم الرجوع إلى أهليهم، تكلّم جَمْعٌ مِن بني هاشم والأصحاب، وتكلّم مِن بينهم سعيد، فمِمّا قاله للإمام (عليه السلام): لا -والله- يابن رسول الله، لا نخلّيك أبدًا، حتّى يعلم الله أنّا قد حفظنا فيك وصيّة رسوله محمّد (صلى الله عليه وآله). ولو علمْتُ أنّي أُقتل فيك، ثمّ أُحيا، ثمّ أُذرّى -يُفعل ذلك بي سبعين مرّة-، ما فارقْتُك، حتّى ألقى حِمامي دونك. وكيف لا أفعل ذلك؟ وإنّما هي قَتلة واحدة، ثمّ أنال الكرامة التي لا انقضاء لها أبدًا[2].
وتقدّم الإمام الحسين (عليه السلام) في ظُهر يوم عاشوراء، لِإقامة الصلاة، فصلّى بِأصحابه صلاة الخوف، ووَصل إلى الإمام الحسين (عليه السلام) سَهْم، فتقدّم سعيد بن عبد الله الحنفيّ، ووقف يَقيه بِنفسه، وجعلها درعًا
[1] الشيخ الطبرسيّ، تفسير مجمع البيان، ج2، ص444. الشيخ ناصر مكارم الشيرازيّ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج2، ص782.
[2] الطبريّ، تاريخ الأمم والملوك، ج3، ص315.
488
476
الموعظة السبعون: مقام الشهادة في الإسلام
للإمام (عليه السلام)، فرماه القوم بِسهامهم مِن كلّ جانب -يمنةً ويسرةً-، وكان يستقبل السهام بِوجهه وصدره ويديه ومقادم بَدنه، لئلّا تُصيب الحسين (عليه السلام)، ولم يتخطَّ، حتّى سقط إلى الأرض[1].
وعلى حدِّ قول ابن طاووس، فإنّ ثلاثة عشر سهمًا أصابَتْ جسد سعيد، سوى ضربات السيوف والرماح[2].
وعندما خرّ سعيد بن عبد الله صريعًا، كان يقول: اللهمّ الْعَنهُم لَعْنَ عادٍ وثمود. اللهمّ أبلغ نبيّك عنّي السلام. ثمّ الْتَفت إلى الحسين (عليه السلام)، فقال: أَوَفيتُ يابن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فجاء الإمام، ووقف عند رأسه، وقال: «نعم، أنت أمامي في الجنّة»، ثمّ فاضتْ نفسه، واستُشهد[2] (رضوان الله عليه).
[1] أبو مخنف، وقعة الطفّ، ص232.
[2] المصدر نفسه.
489
477
الموعظة الحادية والسبعون: دور الأهل في الحثّ على الجهاد والشهادة
الموعظة الحادية والسبعون: دور الأهل في الحثّ على الجهاد والشهادة
بيان أهمّيّة الدور الكبير الذي يقوم به الأهل في تفعيل العمل الجهاديّ.
محاور الموعظة
ميّزات البيئة الجهاديّة
صور من التاريخ لمواقف أسريّة
مواقف أبي طالب (عليه السلام)
محطّات مشرقة ومواقف مضيئة
تصدير الموعظة
أبو طالب (رضوان الله عليه): «اذهب يابنَ أخي، فقُلْ ما أحببتَ، فَوَالله لا أسلمكَ لشيء أبدًا»[1].
[1] الطبريّ، تاريخ الطبريّ، ج2، ص67.
490
478
الموعظة الحادية والسبعون: دور الأهل في الحثّ على الجهاد والشهادة
مِن جملة عناصر القوّة للمجاهدين -بل من أهمّها- في سبيل مقارعة الطواغيت وتحطيم عروشهم، وإلحاقهم بمتاحف التاريخ، البيئةُ الحاضنة لهم، المتمثّلة بالآباء والأمّهات والإخوة والأخوات والزوجات، وبقيّة الأرحام والجيران وأهل البلدة والمنطقة، ثمّ المجتمع كلّه.
ميّزات البيئة الجهاديّة
مِن أهمّ ميّزات هذه البيئة الأمور الآتية:
أوّلًا: تُعَدّ هذه البيئة مِن أهمّ عوامل الاستقطاب والتوجيه وتنمية الروح الجهاديّة.
ثانيًا: تُعَدّ عنصرًا مؤثّرًا في مستوى الدعم المعنويّ، والتحفيز للاستمرار في نهج الجهاد.
ثالثًا: مِن أهمّ الوسائل الإعلاميّة والتبليغيّة لنشر روح المقاومة في نفوس الآخرين.
رابعًا: إنّ المواقف المتقدّمة جدًّا، والتي تنمُّ عن مستوًى عالٍ من التحلِّي بالبصيرة لدى عوائل الشهداء والجرحى، لها تأثير إيجابيّ في محيطها.
خامسًا: إنّ لإظهار الافتخار والاعتزاز بالأبناء الشهداء أو الجرحى أو المجاهدين الأثر الكبير في نفوس الناس.
سادسًا: إنّ وجود البيئة الحاضنة للمجاهدين يُشكّل العروق المتجذّرة للمشروع الجهاديّ، بحيث يصعب على أعدائهم النيل منهم أو اجتثاثهم أو القضاء عليهم.
491
479
الموعظة الحادية والسبعون: دور الأهل في الحثّ على الجهاد والشهادة
صُوَر من التاريخ
عندما نتحدّث عن الفئات المتصارعة طوال التاريخ، يصعب علينا ألّا نرى مُشارَكةً لأحد من أفراد الأُسرة في عمليّة الصراع، بدءًا من آدم (عليه السلام) إلى عصر الظهور، بل إلى يوم القيامة.
فأوّل مواجهة بين خصمين كانت بين إبليس من جهة، وآدم (عليه السلام) وحواء من جهة ثانية -إذ كان لها حضورها في الميدان والمواجهة-؛ ﴿فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيطَٰنُ عَنهَا فَأَخرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلنَا ٱهبِطُواْ بَعضُكُم لِبَعضٍ عَدُوّٞ وَلَكُم فِي ٱلأَرضِ مُستَقَرّٞ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ﴾[1]. وهذه أيضًا مريم (عليها السلام)، في مواجهة رجالات الهيكل مِن بني إسرائيل، تقاوم وتدافع عن مولودها ضمن الدفاع عن مشروع الرسالة الإلهيّة؛ ﴿فَأَتَت بِهِۦ قَومَهَا تَحمِلُهُۥ قَالُواْ يَٰمَريَمُ لَقَد جِئتِ شَئٗا فَرِيّٗا ٢٧ يَٰأُختَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمرَأَ سَوءٖ وَمَا كَانَت أُمُّكِ بَغِيّٗا ٢٨ فَأَشَارَت إِلَيهِ قَالُواْ كَيفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلمَهدِ صَبِيّٗا﴾[2]. وما بينهما أسماء لنساء ورجال دوَّن التاريخ في سجلّاتهم مواقف رائعة، انتصارًا لرسالة السماء.
ومن الصُوَر لمواقف أُسريّة في جبهة الحقّ ضدّ الباطل في زمان خاتم النبيّين، تلك الصوَر التي تحكي لنا مؤازرة ابن عمّه عليّ ابن أبي طالب (عليه السلام) وزوجته خديجة بنت خويلد وزيد بن حارثة، إذ كانوا النواة الأولى في مجاهدة ومواجهة الأعداء.
[1] سورة البقرة، الآية 36.
[2] سورة مريم، الآيات 27 - 29.
492
480
الموعظة الحادية والسبعون: دور الأهل في الحثّ على الجهاد والشهادة
اذهب يابن أخي، فقُلْ ما أحببتَ
بعد أن انتقلت الدعوة من المرحلة السرّيّة إلى المرحلة العلنيّة، كانت للرسول (صلى الله عليه وآله) المؤازرة والتأييد من بعض رجالات عشيرته التي دعاها إلى لقاءٍ لِيصدع بالأمر. وقد أسفر عن ذلك إعلان أبي طالب عن نصرة ابن أخيه، إذ صرّح في مواقف أخرى مخاطبًا ابن أخيه بقوله: اذهب يابن أخي، فقُلْ ما أحببتَ، فوالله لا أسلمك لشيء أبدًا.
هذا الموقف العظيم من أبي طالب أضحى شعارًا للأحرار وأصحاب العزيمة كلّهم؛ يقولون للمجاهدين: اذهبوا وقولوا ما أحببتم. وأيّ شيء يقال في حقّ أبي طالب من مدح وثناء قليلٌ على مستوى البصيرة والإرادة والثبات في الموقف. فيحكي لنا التاريخ موقفًا آخر من مواقفه الفولاذيّة، عندما جاءته قريش مرّة أخرى تفاوضه في أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعرضت عليه أن تعطيه أجمل فتيان مكّة بدلًا من ابن أخيه، إذ قالوا له: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجملهم، فخُذه فلَكَ عقله ونصره، واتّخِذه ولدًا فهو لك، وأسلِم إلينا ابن أخيك هذا الذي فرّق جماعة قومك وسفَّه أحلامهم فنقتله، فإنّما هو رجل برجل. فردّهم أبو طالب مستاءً من هذه المساومة الظالمة، وقال: هذا -والله- لبئس ما تسومونني! أتعطوني ابنكم أغذوه لكم، وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا -والله- ما لا يكون أبدًا. فقال المطعم بن عديّ بن نوفل: والله يا أبا طالب، لقد أنصفك قومك، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئًا. فأجابه أبو طالب قائلًا: والله ما أنصفوني، ولكنّك قد أجمعتَ خِذلاني ومظاهرة القوم عَليَّ، فاصنعْ ما بدا لك.
493
481
الموعظة الحادية والسبعون: دور الأهل في الحثّ على الجهاد والشهادة
وعلى أثر المحاولات القرشيّة كلّها للقضاء على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، سارع أبو طالب في اتّخاذ تدابير وقائيّة لضمان سلامة ابن أخيه، واستمراره في نشر رسالته، فدعا بني هاشم وبني عبد المطّلب لمنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحِفظه والقيام دونه، فاستجابوا له سوى أبي لهب[1].
من مثل هذا نقرأ في التاريخ مواقف الأُسر والأهل، إمّا في المشاركة العمليّة في الدفاع -كما حصل مع أُسرة ياسر بن عمّار (رضوان الله عليهم)-، أو عن طريق دعم أبنائهم معنويًّا للانخراط في جبهة الحقّ ضدَّ الباطل- كما يحصل مع الكثير من المضَحّين والمخلصين-.
محطّات مُشرقة، ومواقف مُضيئة
مِن أبرز الشخصيّات التي تمثّل دور الأُسرة على مستوى الحضور في ميادين الجهاد مولاتنا فاطمة الزهراء (عليها السلام)، إذ إنّها قضت عمرها المبارك، من اللحظات الأولى إلى تاريخ شهادتها، ما بين مشاركة في جهادِ تبليغ الرسالة مع أبيها (صلى الله عليه وآله)، حتّى نالت أعظم وسام في تاريخ البشريّة؛ أي وسام أمّ أبيها، وبين دفاعها حتّى الشهادة بالنفس عن حريم الإمامة والولاية. يُضاف إلى سجلّها الجهاديّ المقدّس ما زرعته في قلبَيْ ولدَيْها من الثقة والمعنويّات والثبات، ويتجلّى ذلك في الوصايا التي أسرّت ببعضها إلى ابنتها السيّدة زينب (عليها السلام) في ما يتعلّق بواقعة كربلاء، وما كشفت عنه السيّدة زينب (عليها السلام) عن أمانة في ساحة كربلاء -حينما رأت أخاها وحيدًا فريدًا- مِن شمِّ صدرٍ
[1] الطبريّ، تاريخ الطبريّ، ج2، ص409 - 410.
494
482
الموعظة الحادية والسبعون: دور الأهل في الحثّ على الجهاد والشهادة
وتقبيل نحر، والتي كانت قد حملتها واحتفظت بها لمدّة زمنيّة طويلة. فما هذا إلّا رسالة دعم وحضور معنويّ وميدانيّ في كربلاء للشهيدة الصدِّيقة مع ولدها الإمام الحسين (عليه السلام).
والشيء نفسه نقرأه في المواقف الكلّيّة والتفصيليّة كلّها التي سطّرتها السيّدة زينب (عليها السلام)، وأهمّها تقديم الفرس لأخيها وتجهيزه وتوديعه، والدفاع حتّى الشهادة، إذ كانت تلقي بنفسها على ابن أخيها الإمام زين العابدين (عليه السلام) -وتكرّر منها في ثلاثة مواطن- للدفاع عن الإمامة والولاية المتجسّدتين فيه.
هذا هو شعب إيران
منذ اللحظات الأولى لانطلاق شرارة الثورة المباركة في إيران إلى اليوم -وقد مضى عليها منذ بدايتها ما يزيد على نصف قرن- لا يزال الشعب الإيرانيّ، رجالًا ونساءً وكبارًا وصغارًا، يحفّز بعضه داخل الأُسرة وخارجها، وبوتيرة متصاعدة، حتّى تحوّلت من ثورة إلى دولة، ثمّ إلى دولة نامية؛ هذا هو واقع الشعب المسلم في إيران. وقد عبّر عن هذه الحقيقة الإمام الخمينيّ (قدس سره) ووليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ (دام ظله)، فمن جملة كلماته: وأنا العبد أرى من الضروريّ أن أجدّد -ولو كرّرتُه مئة مرّة لما كان كثيرًا- شُكري لشعب إيران على هذه المشاركة المهابة والمليئة بالعزّة. فأمام هذه المشاعر والعواطف والبصيرة، لا يملك المرء إلّا أن يعظِّم ويقدِّر؛ هذا هو شعب إيران.
495
483
الموعظة الحادية والسبعون: دور الأهل في الحثّ على الجهاد والشهادة
وفي كلمة أخرى من نداء لملتقى سبعة آلاف شهيدة إيرانيّة قال: فالنسوة الإيرانيّات الشجاعات في الثورة والدفاع المقدّس قدّمنَ نموذجًا ثالثًا جديدًا هو المرأة اللاشرقيّة واللاغربيّة.
ها هم أشرف الناس
في ما خصَّ شعب المقاومة في بلدنا، ومنذ الانطلاقة الأولى إلى الآن، وبوتيرة تصاعديّة أيضًا، نجد الحضور الفعّال على مستوى التحفيز والتشجيع والتنافس في الأنشطة كلّها التي تساهم في دفع الحركة الجهاديّة نحو الإمام. فلم تفتَّ من عضده حروب عدّة تعرّض لها -خاصّة حرب تموز 2006 - أو مراحل حسّاسة. فإنّ هذا الشعب يواجه بصبر وثبات وإقدام وبصيرة، وما الانتصارات التي تتحقّق على أيدي المجاهدين إلّا ثمرة مساهمة الكثير من الآباء والأمّهات والإخوة والأخوات ماديًّا ومعنويًّا -ولا فرق بين ما قدّموه قبل الشهادة والجراح وبعدها-؛ لذا استحقّ هذا الشعب لقب أشرف الناسِ.
496
484
الموعظة الثانية والسبعون: المرأة ودورها الجهاديّ
الموعظة الثانية والسبعون: المرأة ودورها الجهاديّ
تعرّف الدور الجهاديّ للمرأة في كربلاء والدولة المهدويّة، ومواجهة التحدّيات المعاصرة.
محاور الموعظة
المرأة المجاهدة مع الإمام الحسين (عليه السلام)
المرأة في الدولة المهدويّة
تحدّيات المرأة في العصر الراهن
تصدير الموعظة
الإمام الباقر (عليه السلام) في عدد قادة جيش الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه): «ويجيء -والله- ثلاثمئة وبضعة عشر رجلًا، فيهم خمسون امرأة»[1].
497
485
الموعظة الثانية والسبعون: المرأة ودورها الجهاديّ
المرأة المجاهدة مع الإمام الحسين (عليه السلام)
النموذج الأوّل: إيثار زينب (عليها السلام) وجهادها
1. زينب (عليها السلام) في قلب المعركة
يقول الإمام الخامنئيّ (دام ظله): «عندما وصلت زينب إلى حيث يرقد جسد عزيزها على رمضاء كربلاء، بدل أن تبدي أيّ ردّ فعل، بدل أن تشتكي، ذهبت في اتّجاه جسد عزيزها أبي عبد الله وارتفع صوتها، وهي تخاطب جدّها: «يا رسول الله، صلّى عليك مليك السماء، هذا حسينك مرمّل بالدماء، مقطّع الأعضاء»[1]؛ أي يا جدّي العزيز، انظر نظرةً إلى صحراء كربلاء الحارقة، هذا حسين معفَّر بالتراب مخضّب بالدماء، ثمّ ينقلون أنّ زينب وضعت يديها تحت جسد الحسين بن عليّ وارتفع نداؤها إلى السماء: «اللهمّ، تقبّل من آل محمّد هذا القربان!»[2].
2. شجاعة زينب (عليها السلام)
عندما خاطبها ابن مرجانة، قائلًا: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم، وأبطل أحدوثتكم، أجابته (عليها السلام) بشجاعة أبيها محتقرة له: «الحمْدُ للهِ الَّذي أَكْرَمَنَا بِنَبِيِّهِ، وَطَهَّرَنا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيرًا، إِنَّمَا يَفْتَضِحُ الْفَاسِقُ وَيَكْذِبُ الْفَاجِرُ، وَهُوَ غَيْرُنَا والحمْدُ للهِ»[3].
[1] ابن نما الحلّيّ، مثير الأحزان، ص65.
[2] من خطبة له } في صلاة الجمعة، في 27 أيلول 1985م.
[3] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص115.
498
486
الموعظة الثانية والسبعون: المرأة ودورها الجهاديّ
3. تسليمها وثباتها
وكذلك عندما خاطبها مستهزئًا: كيف رأيتِ صنع الله بأخيك؟
فأجابته بكلمات الظفر والنصر لها ولأخيها: «ما رَأَيْتُ إلّا جَمِيلًا، هؤُلاَءَ قَوْمُ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْقَتَلَ، فَبَرَزُوا إِلى مَضَاجِعِهِمْ، وَسَيَجْمعُ اللهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، فَتُحَاجُّ وَتُخَاصَمُ، فَانْظُرْ لِمَنِ الْفَلَجُ يَومَئِذٍ، ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ يابْنَ مَرْجَانَةَ»[1].
وكذا عندما دخل موكب السبايا الكوفة، خرج الناس إلى الشوارع، بين مُتسائل لا يدري لمن أومأت زينب إلى الناس أنِ اسكتوا، فارتدّت الأنفاس، وسكنت الأجراس، ثمّ قالت: «الْحَمْدُ للهِ، وَالصَّلاَةُ عَلىَ جَدِّي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الأَخْيَارِ، يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، يَا أَهْلَ الْخَتْلِ والْغَدْرِ، أَتَبْكُونَ؟! فَلَا رَقَأَتِ الدَّمْعَةُ، ولَا هَدَأَتِ الرَّنَّةُ، إِنَّمَا مَثَلُكُمْ كَمَثَلِ الَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ... أَتَبْكُونَ وَتَنْتَحِبُونَ؟! إِيْ وَاللهِ، فَابْكُوا كَثِيرًا، واضْحَكُوا قَلِيلًا، فَلَقَدْ ذَهَبْتُمْ بِعَارِهَا وَشَناَرِهَا...»[2].
النموذج الثاني: دور النساء السياسيّ والتعبويّ في نهضة عاشوراء
1. أمّ وهب: روي أنّه بعد نزوله إلى الميدان، رجع وهب إلى أمّه قائلًا: أمّاه، أرضيتِ أم لا؟ قالت: ما رضيت حتّى تقتل بين يدي الحسين[3]!
2. زوجة زهير: على الرغم من أنّ زوجة زهير بين القين لم تشهد
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج45، ص116.
[2] السيّد ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص87.
[3] ابن نما الحلّيّ، مثير الأحزان، ص46.
499
487
الموعظة الثانية والسبعون: المرأة ودورها الجهاديّ
واقعة عاشوراء، ولكنّها كانت هي التي بعثت زوجها لنصرة الله وحرّضته على ذلك، يروي جماعة:... فبينا نحن جلوس نتغذّى من طعام لنا، إذ أقبل رسول الحسين (عليه السلام)، حتّى سلّم ثمّ دخل، فقال: يا زهير بن القين البجليّ، إنّ أبا عبد الله بعثني إليك لتأتينّه، فطرح كلّ إنسان منّا ما في يده، حتّى كأنّ على رؤوسنا الطير، فقالت امرأته: سبحان الله! أيبعث إليك ابن رسول الله، ثمّ لم تأتِه؟! لو أتيته فسمعت من كلامه، ثمّ انصرفت، فأتاه زهير بن القين، فما لبث أن جاء مستبشرًا قد أشرق وجهه، فأمر فسطاطه فقُوِّض، وحمل إلى الحسين (عليه السلام)[1].
النموذج الثالث: دور النساء اللواتي قاتل أزواجهنّ ضدّ الإمام الحسين (عليه السلام)
الواضح للمتتبّع أنّ الكثيرات من نساء مجتمع الكوفة لم يقفن مكتوفات الأيدي تجاه ما جرى في كربلاء، وهناك شواهد كثيرة تثبت ذلك، منها:
1. زوجة خولي: يروى أنّ أبا عمرة أحاط بدار خوليّ بن يزيد الأصبحيّ، وهو حامل رأس الحسين (عليه السلام) إلى عبيد الله بن زياد، فخرجت امرأته إليهم، وهي النوّار ابنة مالك... وكانت مُحبّةً لأهل البيت (عليهم السلام)، قالت: «لا أدري أين هو، وأشارت بيدها إلى بيت الخلا، فوجدوه، وعلى رأسه قوصرة، فأخذوه وقتلوه»[2].
2. وجاء مالك بن نسر الكنديّ بخوذته الملطّخة بالدم المبارك للإمام الحسين (عليه السلام)، فطردته زوجته من البيت، ولم تسمح له بالإقامة فيه.
[1] النيسابوريّ، روضة الواعظين، ص178.
[2] ابن نما الحلّيّ، مثير الأحزان، ص118.
500
488
الموعظة الثانية والسبعون: المرأة ودورها الجهاديّ
المرأة في الدولة المهدويّة
1. ذكرت بعض الروايات أنّ ثمّة عددًا من النساء في أصحاب الإمام الحجّة المقرّبين. ومن خلال ذكر بعض أسماء النساء يُفهم أنّ بعضهن ممّن يرجعن من نساء العصور السابقة... رُوي عن الإمام الباقر (عليه السلام): «... ويجيء -والله- ثلاثمئة وبضعة عشر رجلًا، فيهم خمسون امرأة، يجتمعون بمكّة على غير ميعاد، قزعًا كقزع الخريف، يتبع بعضهم بعضًا»[1].
2. تتميّز المرأة في عصر الظهور بمستوًى علميٍّ عالٍ، حتّى إنّها لتقضي بكتاب الله وسنّة رسوله، وهي في بيتها، كما عن الإمام الباقر (عليه السلام): «وتؤتَون الحكمة في زمانه، حتّى إنّ المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله وسنّة رسول الله»[2].
تحدّيات المرأة في العصر الراهن
كثرت الدراسات من قبل الغربيّين والمسلمين المتفاعلين مع الفكر الغربيّ في قضيّة المرأة والأسرة، وبدأت هذه الأفكار بالتسلّل إلى المجتمعات الإسلاميّة بآثارها ومفاعيلها السلبيّة كلّها على المرأة والأسرة والمجتمع. ولهذا، ينبغي التحذير من هذه الثقافة، وبيان خطرها في المجتمع الإسلاميّ، ومن هذه الثقافات:
1. الجندريّة: وهي القائمة على أساس تغيير، بل وإلغاء الأدوار
[1] العيّاشيّ، تفسير العيّاشيّ، ج1، ص65.
والقزع: السحب المتقطّعة، والمراد أنّهم يأتون متفرّقين، الواحد والاثنين وهكذا.
[2] الشيخ النعمانيّ، الغيبة، ص245.
501
489
الموعظة الثانية والسبعون: المرأة ودورها الجهاديّ
المنوطة بكلٍّ من الرجل والمرأة، بحيث يمكن للمرأة أن تقوم بأدوار الرجل، ويمكن للرجل أن يقوم بأدوار المرأة، وهذا يعني أنّ الجندرية تتنكّر لتأثير الفروق البيولوجيّة الفطريّة في تحديد أدوار الرجال.
توصّل الغرب إلى قناعة تامّة بأنّ السلاح الأمضى لمحاربة الأصوليّة الإسلاميّة هو في زعزعة كيان الأسرة، وتقديم بديل لنموذج العلاقة بين الرجل والمرأة، حيث إنّ الإسلام ينظر إلى الأسرة على أنّها القاعدة الصلبة التي تُبنى عليها القيم، والسور الذي يتصدّى لغزو الثقافة الرأسماليّة.
2. الحرّيّة: وهي ثمرة ثقافة الغرب الليبراليّة التي تتيح أمام الفرد خيارات مفتوحة ما دام لا يمسّ حرّيّة الآخرين؛ وعلى سبيل المثال، فإنّ ربط خروج المرأة من المنزل بإذن الزوج مرفوض بنظر هؤلاء؛ لأنّه يعدّ تحديدًا للحرّيّة، وكذلك تقريرًا للتمييز بين الجنسين، وكذا الأمر بالنسبة إلى قيمومة الرجل في الأسرة.
3. الاقتصاد: أهمّ شعار ترفعه أكثر الحركات المطالبة بحقوق المرأة، هو الاستقلال الماديّ والعمل للمرأة؛ فهم يرَون أنّ عمل المرأة يعزّز من ثقتها بنفسها، ويقلّل من هواجسها في المستقبل، علاوة على أنّه يحصّنهنّ ضدّ التجاوزات المحتملة للزوج.
4. استحداث منظومة حقوقيّة تنظر بعين المساواة إلى الهويّة الجنسيّة؛ بمعنى توحيد الأحكام لكلا الجنسين في قضايا، مثل: القضاء، الشهادة، الإرث، الدية، الزواج، الطلاق، حضانة الأسرة، وعشرات القضايا الأخرى.
502
490
الموعظة الثالثة والسبعون: العِزّة ودَوْرها في الانتصار
الموعظة الثالثة والسبعون: العِزّة ودَوْرها في الانتصار
بيان أنّ عِزّة الأُمّة مِن عِزّة قادتها.
محاور الموعظة
معنى العِزّة
العزّة لله
العِزّة الموهومة
عِزّة سيّد الشهداء (عليه السلام)
عِزّة القائد
تصدير الموعظة
الإمام الحسين (عليه السلام): «ألا وإنّ الدعيّ ابنَ الدعيّ قد تركَني بين السِلّة والذِلّة، وهيهاتَ له ذلك مِنّي! هيهات مِنّا الذِلّة!»[1].
[1] الشيخ الطبرسيّ، الاحتجاج، ج2، ص24 - 25.
503
491
الموعظة الثالثة والسبعون: العِزّة ودَوْرها في الانتصار
مِن الموضوعات المحوريّة التي ترتكز عليها الثورة الحسينيّة العظيمة، ذلك الشعار الخالد الذي أطلقه سيّد الشهداء (عليه السلام): «هيهات مِنّا الذلّة»[1]؛ فالابتعاد عن المذلّة هو طلب العِزّة بالله -تعالى-.
معنى العِزّة
يَنقل العلّامة الطباطبائيّ (قدس سره): العِزّة تُقابل الذِلّة. قال الراغب: العِزّة حالةٌ مانعةٌ للإنسان مِن أن يُغْلَبَ، مِن قولهم: أرض عزاز؛ أيْ صَلبة.
قال -تعالى-: ﴿أَيَبتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا﴾[2].
فعِزّة العزيز كَوْنه صعب المنال، وكذلك الوصول إليه. ومِنه: عزيز القوم، وهو الذي يَقهَرُ ولا يُقهَر؛ لأنّه ذو مقامٍ لا يصل إليه مَن قَصَده[...]
ومنه: العزيز، لِما قلَّ وُجودُه لِصعوبة نَيْله.
ومنه: العزيز، بمعنى الشاقّ؛ لأنّ الذي يشقّ على الإنسان يَصعب حُصوله؛ قال -تعالى-: ﴿عَزِيزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُّم﴾[3].
ومنه: قوله -تعالى-: ﴿وَعَزَّنِي فِي ٱلخِطَابِ﴾[4]؛ أيْ غَلَبَني -على ما فُسِّر به-[5].
[1] الشيخ الطبرسيّ، الإحتجاج، ج2، ص300.
[2] سورة النساء، الآية 139.
[3] سورة التوبة، الآية 128.
[4] سورة ص، الآية 23.
[5] العلّامة الطباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج12، ص10 - 11.
504
492
الموعظة الثالثة والسبعون: العِزّة ودَوْرها في الانتصار
مِن الموضوعات المحوريّة التي ترتكز عليها الثورة الحسينيّة العظيمة، ذلك الشعار الخالد الذي أطلقه سيّد الشهداء (عليه السلام): «هيهات مِنّا الذلّة»[1]؛ فالابتعاد عن المذلّة هو طلب العِزّة بالله -تعالى-.
معنى العِزّة
يَنقل العلّامة الطباطبائيّ (قدس سره): العِزّة تُقابل الذِلّة. قال الراغب: العِزّة حالةٌ مانعةٌ للإنسان مِن أن يُغْلَبَ، مِن قولهم: أرض عزاز؛ أيْ صَلبة.
قال -تعالى-: ﴿أَيَبتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا﴾[2].
فعِزّة العزيز كَوْنه صعب المنال، وكذلك الوصول إليه. ومِنه: عزيز القوم، وهو الذي يَقهَرُ ولا يُقهَر؛ لأنّه ذو مقامٍ لا يصل إليه مَن قَصَده[...]
ومنه: العزيز، لِما قلَّ وُجودُه لِصعوبة نَيْله.
ومنه: العزيز، بمعنى الشاقّ؛ لأنّ الذي يشقّ على الإنسان يَصعب حُصوله؛ قال -تعالى-: ﴿عَزِيزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُّم﴾[3].
ومنه: قوله -تعالى-: ﴿وَعَزَّنِي فِي ٱلخِطَابِ﴾[4]؛ أيْ غَلَبَني -على ما فُسِّر به-[5].
[1] الشيخ الطبرسيّ، الإحتجاج، ج2، ص300.
[2] سورة النساء، الآية 139.
[3] سورة التوبة، الآية 128.
[4] سورة ص، الآية 23.
[5] العلّامة الطباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج12، ص10 - 11.
504
493
الموعظة الثالثة والسبعون: العِزّة ودَوْرها في الانتصار
العِزّة لله
الله -سبحانه- عزيز؛ لأنّه الذات الذي لا يقهره شيء مِن جهة، وهُو يقهر كلّ شيءٍ مِن كُلِّ جِهة. لذا، انحصرت العِزّة فيه -تعالى-، فلا توجد عند غيره، إلّا باكتسابٍ منه وإذن؛ قال -تعالى-: ﴿أَيَبتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا﴾[1] و﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلعِزَّةُ جَمِيعًا﴾[2] [3].
وقد وَرَدَ في سورة (المنافقون) تصويرٌ لِما كان يدور على ألسِنة المنافقين: ﴿يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعنَا إِلَى ٱلمَدِينَةِ لَيُخرِجَنَّ ٱلأَعَزُّ مِنهَا ٱلأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلمُؤمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلمُنَٰفِقِينَ لَا يَعلَمُونَ﴾[4]؛ فالمنافقون كانوا يرَوْن أنفسهم أصحاب المِنعة والقوّة، استنادًا إلى الأسباب الدنيويّة الضيّقة، وما يملكونه مِن إمكانيّات مادّيّةٍ ودهاءٍ وعلاقاتٍ وسوءِ طَوِيّة، فتَبانوا على التعرُّض للمؤمنين والسعي إلى إخراجهم مِن المدينة المنوّرة، استنادًا إلى قِلّة المسلمين -عدّةً وعددًا-. فجاء الخطاب الربّانيّ واضحًا في الردّ على هؤلاء، كاشفًا عمّا يتداولونه في مجالسهم ونَواديهم، وموضّحًا أنّ الباري -تعالى- هو مصدر القوّة والمنعة لِمن التجأ إليه ولاذ به وتقلَّب في طاعته. فالعزّة لا تستند إلى المعايير المادّيّة -مهما بلغت-؛ لأنّها ستبقى محدودة في إطار هذه الحياة الضيّقة. في حين أنّ العزّة الحقيقيّة لخالق السماوات والأرض، ولِمَن التجأ إلى حِصنه، وسلكَ دروب هِدايته.
[1] سورة النساء، الآية 139.
[2] سورة فاطر، الآية 10.
[3] العلّامة الطباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج12، ص10 - 11.
[4] سورة المنافقون، الآية 8.
505
494
الموعظة الثالثة والسبعون: العِزّة ودَوْرها في الانتصار
العِزّة الموهومة
قد يتصوّر مَن يغفل عن السُنَن الإلهيّة والبصيرة الربّانيّة أنّ الحصول على المكانة والقُدرة والمنعة لا يتمّ إلّا عن طريق الالتصاق والالتحاق بِرَكب أصحاب القُدرة والتفوُّق، إلّا أنّ هذا تأكيدٌ على الاشتباه الذي يقع فيه البشر مَرّة بعد أخرى: ﴿ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلكَٰفِرِينَ أَولِيَاءَ مِن دُونِ ٱلمُؤمِنِينَ أَيَبتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا﴾[1]. تمامًا كَحال الأعراب المعاصرين الذين مَردوا على النفاق، فَهُم يخسرون في كلِّ يوم مِن رصيدهم على المستويات جميعها؛ مِن ماء الوجه -لو وُجد-، ومِن السلطة الموهومة المزعومة، ومِن المكانة في قلوب أتباعهم، ومِن كنوزهم التي يُصرّح مَن يلوذون بهم على الدوام مِن السُلطة الأمريكيّة -وغيرها- أنّها مُرادهم وهدفهم ومُبتغاهم، وأنّها حقّهم في مُقابل ما يَبذلونه في تثبيتهم على عروش طغيانهم، ويستحقرونهم ويستهزئون بهم، وينالون مِن كراماتهم في المجالس العامّة، وعلى الملأ، وهُم مُصرّون على اتّباعهم والالتجاء إليهم.
ولَوْ نظرْنا في جَنَبات الكتاب المجيد، لَرأينا الكثير مِن تلك المشاهد. ففي قِصّة قارون يقول -تعالى-: ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَومِهِۦ فِي زِينَتِهِۦ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا يَٰلَيتَ لَنَا مِثلَ مَا أُوتِيَ قَٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٖ﴾[2]، ويقول -تعالى-: ﴿فَخَسَفنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلأَرضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن
[1] سورة النساء، الآية 139.
[2] سورة القصص، الآية 79.
506
495
الموعظة الثالثة والسبعون: العِزّة ودَوْرها في الانتصار
فِئَةٖ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُنتَصِرِينَ﴾[1]. والأمثلة تطول -كما في غَرَق فِرعون- مِن نماذج التعزُّز بالدنيا والرُكون إليها.
عِزّة أولياء الله
في المقابل، نرى كيف يتلذّذ أمير المؤمنين (عليه السلام) في مناجاته: «إلهي، كَفى بي عِزًّا أَنْ أَكونَ لَكَ عَبْدًا، وَكَفى بي فَخْرًا أَنْ تَكونَ لي رَبًّا. أَنْتَ كَما أُحِبُّ، فَاجْعَلْني كَما تُحِبُّ»[2]؛ فالعِزّة الحقيقيّة أنْ نكون كما يُحبّ الله -تعالى- لنا، فإنّه لا يُريد لنا إلّا الخير والكمال. وطريق ذلك التسليم والعبوديّة المطلقة لله -تعالى-، التي تستبطن الاعتراف بحقيقة الضعف والعجز الذي يستدرُّ الرحمة والرأفة، تُؤدّي إلى العِزّة.
عِزّة سيّد الشهداء (عليه السلام)
الذِلّة هو ألّا يبقى للقيم وجود في حياتنا، وألّا تبقى لنا قيمة في وجودنا، فَنَهيم -كما البهائم- خَلف غرائز لا تزيد الإنسان إلّا تردِّيًا وسُقوطًا؛ قال -تعالى-: ﴿لَهُم قُلُوبٞ لَّا يَفقَهُونَ بِهَا وَلَهُم أَعيُنٞ لَّا يُبصِرُونَ بِهَا وَلَهُم ءَاذَانٞ لَّا يَسمَعُونَ بِهَا أُوْلَٰئِكَ كَٱلأَنعَٰمِ بَل هُم أَضَلُّ أُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلغَٰفِلُونَ﴾[3].
[1] سورة القصص، الآية 81.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج74، ص400.
[3] سورة الأعراف، الآية 179.
507
496
الموعظة الثالثة والسبعون: العِزّة ودَوْرها في الانتصار
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «مَن أراد عزًّا بِلا عشيرة، وهَيبة مِن غير سلطان، وغِنًى مِن غير مال، وطاعة مِن غير بَذْل، فلْيَتحوّل مِن ذُلِّ معصية الله إلى عِزِّ طاعته، فإنّه يجِدُ ذلك كلّه»[1]؛ فكُلّ ما يريده الإنسان مِن مكانةٍ، يمكن أن يحقّقه عندما ينتسب إلى حزب الله النُجَباء، فيُحصِّل العِزّة والهيبة والغِنى والمكانة بِطاعة الباري -تعالى- واللجوء إليه، ويؤدّي ما عليه مِن واجبات، ويقِف في وجه حزب الشيطان الطُلَقاء.
وهذا ما دفع سيّدَ الشهداء (عليه السلام) للخروج، ضانًّا بِخسارة قُرب الله وعِزّه، مُعلِنًا على الملأ مَقالته: «... ألا وإنّ الدعيّ ابن الدعيّ قد تركني بين السِلّة والذِلّة، وهيهاتَ له ذلك مِنّي! هيهات مِنّا الذلّة! أبى الله ذلك لنا ورسولُه والمؤمنون، وحُجورٌ طهُرَتْ، وجُدود طابَتْ، أنْ نُؤثِر طاعة اللِئام على مصارع الكِرام»[2].
عِزّة القائد
خطّت هذه المدرسة للأحرار نهجًا لم يحيدوا عنه على امتداد التاريخ. والشواهد على ذلك كثيرة قد شهِدناها وعاصرناها، ولا نزال نرى صُوَرَها يوميًّا.
1. الإمام الخمينيّ (قدس سره)
عندما سلكَ إمامُنا الخمينيّ (قدس سره) طريق تحقيق حُلم الأنبياء،
[1] الشيخ الطوسيّ، الأمالي، ص524.
[2] الشيخ الطبرسيّ، الاحتجاج، ج2، ص24 - 25.
508
497
الموعظة الثالثة والسبعون: العِزّة ودَوْرها في الانتصار
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «مَن أراد عزًّا بِلا عشيرة، وهَيبة مِن غير سلطان، وغِنًى مِن غير مال، وطاعة مِن غير بَذْل، فلْيَتحوّل مِن ذُلِّ معصية الله إلى عِزِّ طاعته، فإنّه يجِدُ ذلك كلّه»[1]؛ فكُلّ ما يريده الإنسان مِن مكانةٍ، يمكن أن يحقّقه عندما ينتسب إلى حزب الله النُجَباء، فيُحصِّل العِزّة والهيبة والغِنى والمكانة بِطاعة الباري -تعالى- واللجوء إليه، ويؤدّي ما عليه مِن واجبات، ويقِف في وجه حزب الشيطان الطُلَقاء.
وهذا ما دفع سيّدَ الشهداء (عليه السلام) للخروج، ضانًّا بِخسارة قُرب الله وعِزّه، مُعلِنًا على الملأ مَقالته: «... ألا وإنّ الدعيّ ابن الدعيّ قد تركني بين السِلّة والذِلّة، وهيهاتَ له ذلك مِنّي! هيهات مِنّا الذلّة! أبى الله ذلك لنا ورسولُه والمؤمنون، وحُجورٌ طهُرَتْ، وجُدود طابَتْ، أنْ نُؤثِر طاعة اللِئام على مصارع الكِرام»[2].
عِزّة القائد
خطّت هذه المدرسة للأحرار نهجًا لم يحيدوا عنه على امتداد التاريخ. والشواهد على ذلك كثيرة قد شهِدناها وعاصرناها، ولا نزال نرى صُوَرَها يوميًّا.
1. الإمام الخمينيّ (قدس سره)
عندما سلكَ إمامُنا الخمينيّ (قدس سره) طريق تحقيق حُلم الأنبياء،
[1] الشيخ الطوسيّ، الأمالي، ص524.
[2] الشيخ الطبرسيّ، الاحتجاج، ج2، ص24 - 25.
508
498
الموعظة الثالثة والسبعون: العِزّة ودَوْرها في الانتصار
رفض -وبكلّ عِزّة وشموخ- أن تستند الثورة إلى أيٍّ مِن قُطبَي العالم مِن الغرب والشرق، مُعلنًا مقالته: «لا شرقيّة ولا غربيّة». فانبرى المؤمنون متوكّلين على الله -تعالى-، لِيشهد العالم تلك المعجزة الربّانيّة لِفئةٍ آمنَتْ بِربّها فزادَها هدًى، وتوكّلَتْ عليه فكانَ حَسْبها.
2. الإمام الخامنئيّ (دام ظله)
ونرى ذلك -اليوم- في المواقف الشامخة للإمام الخامنئيّ (دام ظله) وهُو يقود الأُمّة، ولا يخاف في الله لومة لائم، فيعلن الموقف -بِكلّ شموخ وإباء- مِن السُلطة التي تحكم دولة الحِجاز، وتعتدي على القيَم الإسلاميّة. وبِالعزّة نفسها يُخاطِب مجتمع الغرب، ويبيّن ركاكة أنظمته، ومدى الوهْم الذي يعيش فيه. وحين تُعلن الإدارة الأمريكيّة حِصارها على دولة مولانا صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه)، يقف -بِكلّ حزْم- نافيًا وُجود الحرب، وكأنّه يقول إنّ كلامهم جعجعة مِن غيرِ طحين. وفي الوقت نفسه يُعلن رفْضَ التفاوض معهم.
وأمام الشاشات العالميّة، يستقبلُ رئيسَ الحكومة اليابانيّة، ويرفضُ تَسَلُّمَ الرسالة الأمريكيّة، مُعلنًا أنّ مِثله لا يخاطب مِثل الرئيس الأمريكيّ، لِيُذكّرنا بِكلام جدّه الحسين (عليه السلام): «ومِثلي لا يُبايع مثله»[1].
وبِكلّ قوّة واقتدار، تُسقِط الجمهوريّة الإسلاميّة طائرة التجسُّس الأمريكيّة، مُبيِّنة للعالم مَسارها منذ لحظة الانطلاق، مِن دون
[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج44، ص325.
509
499
الموعظة الثالثة والسبعون: العِزّة ودَوْرها في الانتصار
أن يجرؤ الأمريكيّ على الردّ؛ وهو تمامًا ما أعلن عنه سماحة القائد، مِن أنّهم غير مؤهّلين للحرب، ولا جديرين بها.
3. سماحة السيّد حسن نصر الله (حفظه الله)
على النهج نفسه، ومِن المدرسة الولائيّة نفسها، يُعلِن الأمين العامّ -في معرض الردّ على الموفد الأمريكيّ الذي أراد الضغط على الدولة اللبنانيّة بِخصوص صواريخ المقاومة الكاسِرة للتوازن- أنّ المقاومة، عندما تنفي شيئًا، أو يتحدّث قادتها عن شيء، فَهُمْ أصدق مِن ساسة العالم كلّه، ولدينا الجرأة التامّة لِنواجه كلّ احتمال. ويَطلب مِن الدولة ألّا تسمح للسلطة الأمريكيّة بأنْ تتدخّل بما لا يعنيها. ثمّ يخاطبها مُباشرة بأنّنا -مُقابل هذا الضغط- قد نتّخذ القرار الجِدّيّ بإنشاء مصانع للصواريخ الدقيقة.
وعلى هذا النهج، نعمل مِن أجل التمهيد لدولة صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه)، فنؤدّي الواجب والتكليف، ولا نخشى في الله لَومة لائم، ونتوكّل على الباري -تعالى-؛ لأنّه لا مُذِلَّ لِمَن أعزَّ الله.
510
500
الموعظة الرابعة والسبعون: ارتباط الشهداء بالإمام الحسين (عليه السلام)
الموعظة الرابعة والسبعون: ارتباط الشهداء بالإمام الحسين (عليه السلام)
إظهار علاقة شهداء كربلاء بالإمام الحسين (عليه السلام)، وعلاقة شهداء مسيرتنا الأبرار بالإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه).
محاور الموعظة
علاقة الأنصار بالإمام الحسين (عليه السلام)
علاقة شهدائنا بالإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
تصدير الموعظة
الإمام الحسين (عليه السلام): «أمّا بعد، فإنّي لا أعلم أصحابًا أوفى ولا خيرًا مِن أصحابي، ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل مِن أهل بيتي، فجزاكم الله عنّي خيرًا. ألا وإنّي لأظنّ أنّه آخر يوم لنا مِن هؤلاء، ألا وإنّي قد أذِنْتُ لكم، فانطلقوا جميعًا في حلٍّ، ليس عليكم منّي ذمام، هذا الليل قد غَشِيَكم، فاتّخِذوه جملًا»[1].
[1] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص91.
511
501
الموعظة الرابعة والسبعون: ارتباط الشهداء بالإمام الحسين (عليه السلام)
علاقة الأنصار بالإمام الحسين (عليه السلام)
لا شكّ في أنّ لشهداء كربلاء علاقةً مميّزةً بالإمام الحسين (عليه السلام) جعلتهم «الأوفى والأبرّ» على لسانه الشريف، وقد تجلّت تلك العلاقة في كلماتهم، ومواقفهم، وحِفظهم وصيّةَ رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سِبطه الحسين (عليه السلام)، ووقوفِهم إلى جانب الحقّ يوم عزَّ الناصرُ أمام ثلاثين ألفًا مِن جيش عمر بن سعد، وبذْلِهم أنفسهم، واستبسالهم في الدفاع عن إمام الحقّ، واستشهادهم بين يدَيه (عليه السلام). وتلك العلاقة -التي شملت الرجال والنساء مِن الفتية والشباب والكبار- لم تكُن وليدة ساعتها، بل كان لها أُسس ومرتكزات عميقة ومتجذّرة، أبرزها:
1. الإمام الحسين (عليه السلام) ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
لمّا دعا الإمامُ الحسين (عليه السلام) زهيرَ بن القين إلى صُحبته، أجابه بأنّه ليس راغبًا في مُرافقته، فقالت له زوجته دلهم: سبحان الله، يبعث إليك ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثمّ لا تأتيه![1] ولمّا سمع زهير كلام زوجته، انقلب وتغيّر، وأتى نحو الإمام الحسين (عليه السلام).
2. مِن ذرّيّة النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله)
لمّا برز زوجها عبد الله إلى الميدان، أصيبَ في يده اليسرى، فأخذتْ أمّ وهب عَمود خيمة، ثمّ أقبلت نحوه، وهي تقول له: فِداك أبي وأمّي، قاتِل دون الطيّبين، ذريّة محمّد (صلى الله عليه وآله)[2].
[1] ابن نما الحلّيّ، مثير الأحزان، ص33.
[2] الطبريّ، تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبريّ)، ج4، ص327.
512
502
الموعظة الثالثة والسبعون: العِزّة ودَوْرها في الانتصار
3. ابن السيّدة الزهراء (عليها السلام)
بعد استشهاد عمرو بن جنادة، قطع العدوّ رأسه، ورمى به نحو خيمة الإمام (عليه السلام)، فأخذت أمُّه عَمود الخيمة، وحملَت على القوم، وهي تقول:
أَنا عَجوزٌ في النساءِ ضَعيفَهْ بالِيَةٌ خالِيَةٌ نَحيفَهْ
أَضْرِبُكُمْ بِضَرْبَةٍ عَنيفَهْ دُونَ بَني فاطِمَةَ الشريفَهْ
وقد جمعَ هذه العناوين الثلاثة عبدُ الله بن يقطر الحميريّ، عندما أعلن مِن قصر ابن زيادٍ للناس المجتمعين أسفل القصر: أيّها الناس، أنا رسول الحسين بن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) إليكم، لِتنصروه وتُؤازروه على ابن مرجانة وابن سميّة الدعيّ ابن الدعيّ[1].
ولأنّ الإمام الحسين (عليه السلام) امتدادٌ لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، برزَت مظاهر الفداء بأبهى صُوَرِها. فعمرو بن قرظة الأنصاريّ، بعد أن قاتل مدّة مِن الزمن، رجع نحو الحسين (عليه السلام)، ووقف دونه لِيَقيه مِن العدوّ، فجعل يتلقّى السهام بجبهته وصدره، فلم يصل إلى الحسين (عليه السلام) سوء، حتّى أثخن بالجراح، فالتفت إلى الإمام (عليه السلام)، وقال له: أَوَفَيْتُ يابن رسول الله؟ فقال: «نعم، أنت أمامي في الجنّة، فأقرِئ رسول الله (صلى الله عليه وآله) السلام، وأعْلِمْه أنّي في الأثر»[2].
[1] الشيخ محمّد السماويّ، أبصار العين في أنصار الحسين (عليه السلام)، ص93.
[2] ابن نما الحلّيّ، مثير الأحزان، ص45.
513
503
الموعظة الرابعة والسبعون: ارتباط الشهداء بالإمام الحسين (عليه السلام)
4. إنّه (عليه السلام) خير الخَلق
كان قيس بن مسهّر الصيداويّ حاملًا رسالةً مِن الإمام الحسين (عليه السلام) إلى مسلم بن عقيل وإلى شيعة الكوفة، وقبل وصوله إلى الكوفة، كان قد لوحق، وقبض عليه الحصين بن تميم. وبعد اعتقاله، قام قيس بتمزيق الكتاب، ثمّ وجّه به الحصين إلى عبيد الله بن زياد. وبعد مشاجرة بينه وبين ابن زياد، قال له: اصعد المنبر والعن عليًّا والحسن والحسين (عليهم السلام)، فقَبِل قيس أن يتكلّم إلى الناس. ولمّا اجتمعوا في المسجد، صعد قيس المنبر، وتوجّه نحو أهل الكوفة، قائلًا لهم: أيّها الناس، إنّ الحسين بن عليّ خير خلق الله، وابن فاطمة بنت رسول الله، وأنا رسوله إليكم... فأَجيبوه[1].
5. إنّه (عليه السلام) الأحقّ بالولاية
عندما جعجع الحرُّ بالإمام الحسين (عليه السلام)، وضيّق عليه، خطب الإمام (عليه السلام) في أصحابه، وتحدَّث معهم عن غَدرِ الزمان والدهر الخؤون. ثمّ تكلّم نافعُ بن هلال مبيّنًا أنّ الإمام الحسين (عليه السلام) هو الأحقّ بالولاية والشهادة بين يديه: فَسِرْ بنا راشدًا معافًا، مُشرّقًا إن شئت، وإن شئت مغرّبًا، فوالله، ما أشفقنا مِن قَدَر الله، ولا كرِهنا لقاء ربّنا. وإنّا على نيّاتنا وبصائرنا، نُوالي مَن والاك، ونُعادي مَن عاداك[2].
[1] الشيخ محمّد السماويّ، أبصار العين في أنصار الحسين (عليه السلام)، ص113.
[2] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج44، ص382.
513
504
الموعظة الرابعة والسبعون: ارتباط الشهداء بالإمام الحسين (عليه السلام)
6. إنّه (عليه السلام) أَولى مِن أنفسهم
لمّا وقع القتال في اليوم العاشر، أُخبِر بِشْر الحضرميّ -وهو على تلك الحالة- بِأَسْرِ ابنه بِثَغْرِ الريّ، فقال ردًّا على ذلك: عند الله أحتسبه ونفسي، ما كنتُ أحبّ أن يُؤسَر، وأن أبقى بعده. فسمع الإمام الحسين (عليه السلام) مقالته، فقال له: «رحمك الله! أنتَ في حلٍّ مِن بَيعتي، فاذهب واعمل في فَكاك ابنك»، فأجابه بِشْر: أَكَلَتني السباع حيًّا إنْ أنا فارقتُك يا أبا عبد الله[1].
وفي مشهد آخر، لمّا مُنع الإمام الحسين (عليه السلام) مِن الماء، واشتدّ العطش بأصحابه، كان نافع بن هلال مِن جملة مَن ذهب لإحضار الماء -بِقيادة أبي الفضل العبّاس-، وعندما وصل إلى شريعة الفُرات امتنع عن شرب الماء، وقال لأحد قادة العدوّ: لا والله، لا أشرب مِنه قَطرة والحسينُ عطشان[2].
7. إنّه (عليه السلام) وصيّة رسول الله (صلى الله عليه وآله)
في ليلة العاشر مِن المحرّم، لمّا جَمع الحسينُ (عليه السلام) أصحابَه وأحلّهم مِن بيعته، وطلب منهم الرجوع إلى أهليهم، تكلّم جَمعٌ مِن بني هاشم والأصحاب، ثمّ تكلَّمَ سعيد بن عبد الله الحنفيّ، فقال للإمام (عليه السلام): لا والله -يابن رسول الله- لا نُخلّيك أبدًا، حتّى يعلم الله أنّا قد حفِظنا فيكَ وصيّةَ رسولِه محمّد (صلى الله عليه وآله). ولو علمتُ أنّي أُقتل فيك ثمّ أُحيا ثمّ أذرّى -يُفعل ذلك بي سبعين مرّة-، ما فارقتُك، حتّى ألقى
[1] الشيخ محمّد السماويّ، أبصار العين في أنصار الحسين (عليه السلام)، ص174.
[2] أبو الفرج الأصفهانيّ، مقاتل الطالبيّين، ص78.
515
505
الموعظة الرابعة والسبعون: ارتباط الشهداء بالإمام الحسين (عليه السلام)
حِمامي دونك. وكيف لا أفعل ذلك؟ وإنّما هي قَتلة واحدة، ثمّ أنال الكرامة التي لا انقضاء لها أبدًا[1].
وفي ظهر يوم عاشوراء، تقدّم الإمام الحسين (عليه السلام) لإقامة الصلاة، فصلّى بِأصحابه صلاةَ الخوف، فوصل إلى الإمام الحسين (عليه السلام) سهمٌ، فتقدّم سعيد بن عبد الله الحنفيّ، ووقف يَقيه بنفسه، وجعلها درعًا للإمام (عليه السلام)، فرماه القوم بِسهامهم مِن كلّ جانب -يمنةً ويسرةً-، فكان يستقبل السهام في وجهه وصدره ويديه ومقادم بدنه، لئلّا تُصيب الحسين (عليه السلام)، حتّى سقط إلى الأرض صريعًا. حينها التفت إلى الحسين (عليه السلام)، وقال: أَوَفَيْتُ يابن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فأجابه (عليه السلام): «نعم، أنت أمامي في الجنّة»[2]. (وعلى حدِّ قول ابن طاووس، فإنّ ثلاثة عشر سهمًا أصابت جسد سعيد، سوى ضربات السيوف والرماح).
8. إنّه (عليه السلام) الأعزّ والأَحبّ
في يوم عاشوراء، وبعد استشهاد غلامه شوذب، تقدّم عابس بن أبي شبيب الشاكريّ نحو الإمام (عليه السلام)، وقال له: يا أبا عبد الله، أما -والله- ما أمسى على ظهر الأرض قريبٌ ولا بعيدٌ أَعَزّ عَليّ ولا أَحبّ إليّ منك. ولو قدرتُ على أن أدفع عنك الضيم والقتل بِشيء أعزّ عَليّ مِن نفسي ودمي، لَفَعلتُه[3].
[1] السيّد ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص56.
[2] المصدر نفسه، ص64.
[3] الطبريّ، تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبريّ)، ج4، ص338.
516
506
الموعظة الرابعة والسبعون: ارتباط الشهداء بالإمام الحسين (عليه السلام)
شهداؤنا والإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
لِشهداء مسيرتنا الأبرار علاقة خاصّة بالإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه). كيف لا؟ وقد بذلوا مُهجَهم في طريق انتظاره والتمهيد له، وكانت قد فاضت وصاياهم بِكلمات نورانيّة، يفوح منها عبق الولاء له (عجل الله تعالى فرجه)، والشوق إلى رؤيته، والسلام عليه، والاستشهاد بين يديه.
1. سيّدي، فِداك روحي ودمي!
الشهيد حسن بافلاني لا يرى طعمًا للحياة في غياب معشوقه (عجل الله تعالى فرجه)، قائلًا: سيّدي، لقد سئِمْتُ الحياة بعيدًا عنك، أتراك تتعرّف عَليّ يا سيّدي، أم إنّ ذنوبي ستحجبني عنك؟!
ويُعبّر عن شوقه العميق له بقوله: سيّدي، فِداك روحي ودمي! ماذا أقول عن شوقي إليك؟ أم ماذا أقول عمّا يحلّ بنا، وأنت البعيد القريب؟ سيّدي لقد طال الانتظار.
بل إنّه يطلب منه (عجل الله تعالى فرجه) أن يُخرجه مِن قبره ليكون مِن أنصاره: وأظنّ أنّ القتل سيَحول بيني وبينك، فأرجوك يا سيّدي، أرجوك أخرِجني مِن قبري لِأقاتل وأُستشهد بين يديك.
2. قُمْ واخرج، ابحث عن الإمام
الشهيد حسن كمال حايك يَهيم في البحث عن الإمام (عجل الله تعالى فرجه): إيه يا قلبي القاسي! أما آن لك أن تتفطّر؟ قُمْ واخرج، ابحث عن الإمام في هذا الكون الفسيح، اذهب يمينًا وشمالًا، غرِّد مع الطيور، سافِر مع النسمات، هُبَّ مع الرياح، تعلّقْ بأوراق الأشجار، حلِّقْ مع النجوم،
517
507
الموعظة الرابعة والسبعون: ارتباط الشهداء بالإمام الحسين (عليه السلام)
سافِر إلى جهة كربلاء، أو إلى النجف وسامرّاء، أو إلى الكاظميّة وبغداد، أو إلى مشهد، أو إلى مسجد السهلة، أو إلى المسجد الأقصى، أو إلى جبل صافي، وجاهِدْ فيه مع المجاهدين، لا بُدَّ -في لحظةٍ ما مِن سفرك الطويل- مِن أنّ الإمام سَيرأف بحالك، ويمرّ طيفهُ لِيُسلِّم عليك، فترتاح وتنجلي عنك الهموم. وعندها، قِفْ وابكِ، وادعُ ورتّل مناجاة الحزين، واقضِ العمر في ذلك المكان حيث رأيتَ الإمام، وعِشْ على أطلاله، واقضِ الحياة مُشتاقًا إليه.
3. سنفرش لك الأرض بأجسامنا الممزَّقة
الشهيد أسامة حكيم مُستعدّ لِأَن يمهّد لظهوره الشريف بجسده الممزّق، فيقول: سيّدي يا صاحب الزمان، الشوق إلى رُؤياك عميق، وها نحن نمهّد لك الأرض، مُستعدّون لأن نُقدّمها لك ولِنهج آبائك البَرَرة في طريق إعلاء كلمة الله العليا، وجَعْل كلمة الباطل السفلى، ومستعدّون لِأن نفرشها بأجسامنا الممزَّقة، وأرواحنا التي تبكيك بدلَ الدموع دمًا، لِنُصرتك.
4. لتتّصل ثورتنا بثورة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)
الشهيد سليمان محمّد عواضة يُمنّي نفسه بأن تتّصل مقاومتنا بثورة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه): اللهمّ احفظ ثورتنا لتتّصل بثورة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه).
518
508
الموعظة الخامسة والسبعون: أخلاقيّات الحرب والقتال في كربلاء
الموعظة الخامسة والسبعون: أخلاقيّات الحرب والقتال في كربلاء
تعرّف أخلاق سيّد الشهداء أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في المواجهة والحروب.
محاور الموعظة
أخلاق الصراع السياسيّ عند الإمام الحسين مع الخصم
أخلاق الإمام الحسين (عليه السلام) مع أعدائه في الحرب
أخلاق الإمام (عليه السلام) مع أصحابه وأهل بيته في الحرب
أخلاق الإمام (عليه السلام) مع الجنود في معسكره
تصدير الموعظة
الإمام الحسين (عليه السلام): «والله، لا أُعطيكم بِيَدي إعطاء الذليل، ولا أقرّ لكم إقرار العبيد»[1].
[1] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص98.
519
509
الموعظة الخامسة والسبعون: أخلاقيّات الحرب والقتال في كربلاء
إنّ سيرة الإمام الحسين (عليه السلام) الأخلاقيّة في الحرب مُستنبطة مِن منظومة الأخلاق الإسلاميّة التي تربّى ونشأ عليها على يَدِ جدّه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبيه الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام). فالإمام أبو عبد الله الحسين (عليه السلام) تأدّبَ بآداب النبوّة، وحمل روح أخلاق جدّه المصطفى (صلى الله عليه وآله) في الحرب والسِلْم.
أخلاق الصراع السياسيّ عند الإمام الحسين مع الخصم
في نهضة الحسين (عليه السلام)، وبعد هلاك معاوية، طالبه والي المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بمبايعة يزيد، فرفض الإمام (عليه السلام) هذا العرض. ولكنّ أبا عبد الله الحسين (عليه السلام) بيّن سبب الرفض، فقال: «ويزيد رجل فاسق، شارب للخمر، قاتل للنفس المحرّمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله»[1].
فالإمام الحسين (عليه السلام)، بهذا الدرس العمليّ الأخلاقيّ، يُعلِّم الناس جميعًا أن يكونوا أحرارًا، ويرفضوا الذلّ والمهانة؛ لأنّ الإنسان العزيز لا يمكن أن يخضع لإنسانٍ وضيعٍ مُلحدٍ فاسقٍ فاجر، إلى غير ذلك مِن الصفات التي كان يتّصف بها يزيد الأمويّ. وقد عبّر عن ذلك بقوله: «والله، لا أعطيكم بِيَدي إعطاء الذليل، ولا أقرّ لكم إقرار العبيد»[2].
[1] السيّد ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص17.
[2] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص98.
520
510
الموعظة الخامسة والسبعون: أخلاقيّات الحرب والقتال في كربلاء
خروج الإمام (عليه السلام) لتلبية نداء الأُمّة
كانت الرسائل المتتالية الواردة إلى الإمام وهو في مكّة، والتي تضمّ بين طيّاتها الاستغاثة والنجدة مِن حُكم يزيد، مع المواثيق والعهود والبيعة، تُطالبه بأن يقوم بالثورة، ويقبل عليهم، وهي تُقدَّر بالآلاف. وقد وردَ في بعضها ما نصّه: «أمّا بعد، فقد اخضرّ الجناب، وأينعَت الثمار، وطمَت الجمام، فأقدِم على جُندٍ لك مُجنّدة، والسلام عليك»[1].
وبعد هذه الرسائل، لا يوجد أمام الإمام الحسين (عليه السلام) -المسؤول عن الأُمّة- إلّا الاستجابة والإقبال عليهم؛ فهذا التحرّك -بحدّ ذاته- نابع من القواعد الأخلاقيّة في الإسلام. وقد قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديثه مع جيش الحرّ بن يزيد الرياحيّ، بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «أيّها الناس، إنّها معذرة إلى الله -عزّ وجلّ- وإليكم، إنّي لم آتكم حتّى أتتني كتبكم، وقدِمت عَليّ رسلكم، أن أقدم علينا، فإنّه ليس لنا إمام، لعلّ الله يجمعنا بك على الهدى. فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فإن تعطوني ما أطمئنّ إليه مِن عهودكم ومواثيقكم أقدمُ مِصركم، وإن لم تفعلوا، وكنتم لمقدَمي كارهين، انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلتُ منه إليكم»[2].
[1] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص38.
[2] الطبريّ، تاريخ الطبريّ، ج4، ص303.
521
511
الموعظة الخامسة والسبعون: أخلاقيّات الحرب والقتال في كربلاء
أخلاق الإمام الحسين (عليه السلام) مع أعدائه في الحرب
كان شعار الإمام الحسين (عليه السلام): «إنّي أكره أنْ أبدأهم بقتال»[1].
والحوادث التي لم يبدأ الإمام فيها القتال أثناء خروجه إلى أرض كربلاء المقدّسة وواقعة الطفّ كثيرة، منها:
1. اللقاء مع الحرّ وجيشه في الصحراء
قدِم الحرّ بن يزيد الرياحيّ بألف فارسٍ قد أنهكهم العطش، في حرّ الظهيرة قبل صلاة الظهر بوقت قريب. وما إن التقى الحرُّ بن يزيد التميميّ الحسينَ (عليه السلام) وأصحابَه، حتّى وقفَ هو وخيله مقابل الحسين (عليه السلام)، فقال زهير بن القين للإمام: يابن رسول الله، إنّ قتال هؤلاء أَهوَن مِن قتال مَن يأتينا مِن بعدهم. لكنّ الإمام الحسين (عليه السلام) رفض[2]، وقال (عليه السلام) لِفِتيانه: «اسقوا القوم واروهم مِن الماء، ورشِّفوا الخيل ترشيفًا». فقام فتيانه فرشّفوا الخيل ترشيفًا، وقام فتية فَسقوا القوم مِن الماء حتّى رووهم، وأقبلوا يملؤون القِصاع والأتوار والطِساس مِن الماء، ثمّ يُدنونها مِن الفرس، فإذا عبَّ فيه ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا عُزلَت عنه، وسقوا آخر، حتّى سقوا الخيل كلّها. ولمّا حضرَ وقتُ الصلاة، قال الحسين (عليه السلام) للحرّ: أتريد أنْ تصلّي بأصحابك؟ فقال الحرّ: لا، بل تصلّي ونصلّي بِصلاتك[3].
[1] عمر بن أحمد العقيليّ الحلبيّ (ابن العديم)، بغية الطلب في تاريخ حلب، ج6، ص2625.
[2] الطبريّ، تاريخ الطبريّ، ج4، ص309.
[3] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص79.
522
512
الموعظة الخامسة والسبعون: أخلاقيّات الحرب والقتال في كربلاء
هنا نلاحظ الفرق في الأخلاق؛ فالعدوّ يمنع الماء ويخون، والإمام (عليه السلام) يسقي أعداءه الماء، ويرشّف خيلهم، وينصحهم بعد أن أكمل الصلاة وفرغ منها، قائلًا، بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النّبيّ محمّد: «أيّها الناس، إنّكم إنْ تتّقوا الله وتعرفوا الحقّ لأهله يَكُن أرضى لله، ونحن أهل بيت محمّد (صلى الله عليه وآله) أَولى بولاية هذا الأمر مِن هؤلاء المدّعين ما ليس لهم، والسائرين بالجور والعدوان. وإنْ أبَيْتم إلّا الكراهيّة لنا والجهل بحقّنا، وكان رأيكم الآن على غير ما أتتني به كتبكم، انصرفتُ عنكم»[1].
2. في اليوم التاسع مِن محرّم
في اليوم التاسع مِن محرّم، أقبل شمر بن ذي الجوشن على معسكر الإمام الحسين (عليه السلام)، وكان مِن أخوال إخوة الحسين، أبناء أمّ البنين، فنادى: أين بنو أختنا؟ فاستنكروا الردّ عليه. فالتفت إليهم الإمام الحسين (عليه السلام)، وقال: «أجيبوه، وإن كان فاسقًا، فإنّه مِن أخوالكم». فأقبلوا يسألونه حاجته، فقال: أنتم يا بني أختي آمنون. لكنّهم رفضوا أمانه[2].
ويُلاحَظ في هذه الحادثة تفعيل مسألة أخلاقيّة مهمّة جدًّا، هي عدم استغلال هذه المحاورة مِن أجل البدء بالقتال أو الغدر بالعدوّ؛ فالحسين (عليه السلام) -قبل الحرب- كان يعلِّم أصحابه وأنصاره مبدأ رفض
[1] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص79.
[2] أحمد بن أعثم الكوفيّ، الفتوح، ج5، ص95.
523
513
الموعظة الخامسة والسبعون: أخلاقيّات الحرب والقتال في كربلاء
الغدر بالعدوّ. وقد كان بمقدور الإمام (عليه السلام) أن يمنع أبناء أمّ البنين، أو يوصيهم بقتل شمر أثناء اللقاء والحديث، لكنّ أخلاقه (عليه السلام) تأبى هذه التصرّفات، حتّى في المواقف الصعبة.
3. في صبيحة العاشر مِن محرّم، عندما أراد مسلم بن عوسجة رمي العدوّ
عندما أقبل معسكر يزيد وجيشه يجولون حول خيام الحسين، ورَأوا الخندق في ظهورهم، والنار تضطرم في الحطب والقصب الذي كان أُلقي فيه، نادى شمر بن ذي الجوشن بأعلى صوته: يا حسين، أتعجّلت بالنار قبل يوم القيامة؟ فقال الحسين (عليه السلام): «مَن هذا؟ كأنّه شمر بن ذي الجوشن؟» فقالوا: نعم، فقال له: «يابن راعية المعزى، أنت أَولى بها صليًّا».
في هذه الحادثة أراد مسلم بن عوسجة -وهو مِن معسكر الإمام الحسين (عليه السلام)- أن يرمي شمرًا بِسهم، وقال للإمام: دعني حتّى أرميه، فإنّ الفاسق مِن أعداء الله وعظماء الجبّارين، وقد أمكن الله منه. فقال له الحسين (عليه السلام): «لا ترمِه، فإنّي أكره أن أبدأهم بقتال»[1].
أخلاق الإمام (عليه السلام) مع أصحابه وأهل بيته في الحرب
تبرز الأخلاق الحقيقيّة عند القائد في المواقف الصعبة والحسّاسة. فالإمام (عليه السلام) -بسبب سموّ أخلاقه ورفعتها- لم يبخل على أهل بيته
[1] ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب، ج6، ص2625.
524
514
الموعظة الخامسة والسبعون: أخلاقيّات الحرب والقتال في كربلاء
وأصحابه بالخطاب، بل تكرّر الخطاب مرّات عديدة مِن وقت خروجه مِن المدينة، إلى كربلاء قبل مقتله بليلة واحدة، حتّى صباح العاشر مِن محرّم.
فعندما سار الإمام (عليه السلام) مِن المدينة قال لأصحابه: «ما أراني إلّا مقتولًا، فإنّي رأيتُ في المنام كلابًا تنهشني، وأشدّها عليَّ كلبٌ أبقع»[1].
هُنا يكشف أبو عبد الله (عليه السلام) عن المصير المحتوم الذي ينتظره، فيمهِّد لخطابه القادم مع أصحابه، إذ خيّرهم -أكثر مِن مرّة- بين اللحاق به أو التخلّي عنه، وكان ذلك قريب المساء، فجمع أهل بيته وأصحابه، وخطب فيهم قائلًا: «اثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السرّاء والضرّاء، اللهمّ إنّي أحمدك على أنْ أكرمتنا بالنبوّة، وعلّمتنا القرآن، وفقّهتنا في الدين، وجعلتَ لنا أسماعًا وأبصارًا وأفئدةً، ولَم تجعلنا مِن المشركين. أمّا بعد، فإنّي لا أعلم أصحابًا أَولى ولا خيرًا مِن أصحابي، ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل مِن أهل بيتي، فجزاكم الله عنّي جميعًا. وقد أخبرني جدّي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأنّي سأُساق إلى العراق، فأنزلُ أرضًا يقال لها عمورا وكربلاء، وفيها اُستشهد. وقد قرب الموعد. ألا وإنّي أظنّ يومنا مِن هؤلاء الأعداء غدًا. وإنّي قد أذِنتُ لكم، فانطلقوا جميعًا في حلّ، ليس عليكم منّي ذمام. وهذا الليل قد غَشِيَكم، فاتّخذوه جَملًا، ولْيأخذ كلّ رجل
[1] ابن قولويه، كامل الزيارات، ص157.
525
515
الموعظة الخامسة والسبعون: أخلاقيّات الحرب والقتال في كربلاء
منكم بِيَد رجل مِن أهل بيتي، فجزاكم الله جميعًا خيرًا. وتفرّقوا في سوادكم ومدائنكم، فإنّ القوم إنّما يَطلبونني، ولَو أصابوني لَذهلوا عن طلب غيري»[1].
بعض المرافقين لمعسكره (عليه السلام) في ليلة التاسع
طلب بعض الأشخاص مِنه (عليه السلام) أن ينصرفوا، فأَذِن لهم، وكان مِن بينهم الطُرماح، إذ قال للإمام: أنا لديّ مِيرة لأهلي بالغذاء والطعام، فأْذَن لي حتّى أوصِل لهم مِيرتهم، وأعود إليك. فأَذِن له الإمام (عليه السلام)، فذهب الطُرماح، ولم يعد إلّا بعد استشهاد الإمام (عليه السلام) وأصحابه[2].
أخلاق الإمام (عليه السلام) مع الجنود في معسكره
1. أصغر جنديّ في معسكر الإمام الحسين (عليه السلام) هو عمرو بن جنادة، فقد كان غلامًا يبلغ من العمر الحادية عشرة. عندما أقبل يطلب الرخصة مِن أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) لِينزل إلى المعركة، التفت إليه الإمام الحسين، وقال: «هذا غلام قُتِل أبوه في الحملة الأولى، ولعلّ أمّه تكره ذلك»، فإذ بالغلام يتقدّم إلى الحسين (عليه السلام)، ودموعه تسيل على خدّيه، ولعلّ السيف الذي يحمله أطول مِن قامته، لِيقول: إنّ أمّي أَمَرَتني[3].
[1] الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص91.
[2] الطبريّ، تاريخ الطبريّ، ج4، ص307.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج45، ص27.
527